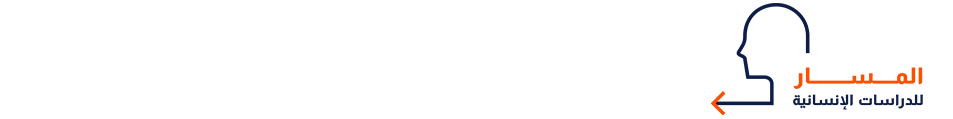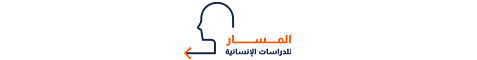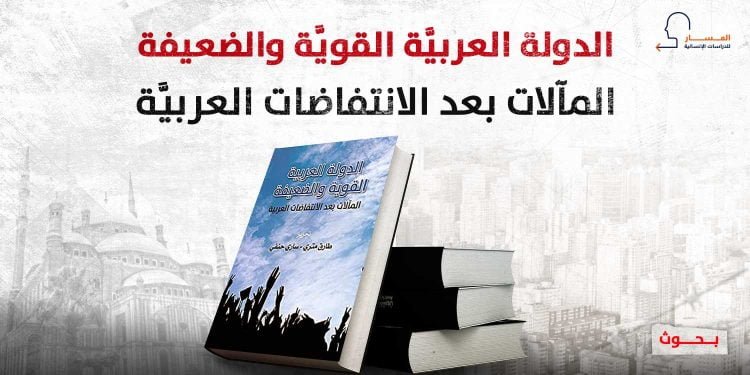الدولة العربيَّة القويَّة والضعيفة: المآلات بعد الانتفاضات العربيَّة
ثمَّة تفسيرات كثيرة قدِّمت للعنف الإرهابي وأسبابه وأشكال انفجاره، منها ما يُشدِّد على النصوص التي تحث على العنف أو تسوِّغه باسم الجهاد، ومنها ما يتوقف عند الأسباب النفسيَّة والاجتماعيَّة، ومنها ما يَبحث في الأسباب السياسيَّة المباشرة. غير أن البلدان العربيَّة التي تعاظمت فيها ظاهرة العنف تختصُّ بمسائل تحتاج إلى الغوص في أعماقها وسَبر أغوارها، ومِن هذه المسائل مسألة وضع الدولة الوطنيَّة مِن حيث الضعف والقوَّة وأثر ذلك في إنتاج العنف واستمراره.
وقد عولجت هذه المسألة في كتاب “الدولة العربيَّة القويَّة والضعيفة: المآلات بعد الانتفاضات العربيَّة”، والذي صَدر عام 2019م عن “الدار العربيَّة للعلوم ناشرون”، ويقع في 272 صفحة، موزعة على 7 فصول، يَحتوي كلٌّ منها على دراسة لباحثٍ مِن العالم العربي. وهي دراسات أشرف عليها “بيت علوم الإنسان” في باريس و”معهد عصام فارس” في الجامعة الأمريكيَّة في بيروت. وتهدف هذه الدراسات إلى إثارة الجدل بطريقة نقديَّة حول موضوع عنف الدولة العربيَّة، القويَّة منها والضعيفة، وكيف يَتِم التأثير المتبادل بين العنف مِن جهةٍ ونظام التوزيع والتبادلات الذي أسَّسَته السياسات العامَّة وارتبط بشبكات محليَّة أو طائفيَّة مِن جهةٍ أخرى. وكذلك كيف يَتِم التأثير المتبادل بين عنف الدولة وسياسات الهويَّة والظلم والسيطرة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

وفيما يلي عرض للدراسات التي اشتمل عليها الكتاب:
[1]
تصدَّرت الكتاب دراسة بعنوان: “أزمة الدولة الوطنيَّة وسؤال العنف السياسي في السياق العربي المعاصر”، وهي للباحث “سلمان بونعمان”، الذي يَنطلِق في دراسته مِن التعريفات النظريَّة لأنماط العلاقة بين الدولة والمجتمع، والتي تستند إلى معياري القوَّة والضعف. فالدولة القويَّة هي التي تتغلغل في المجتمع لإعادة تشكيل العلاقات الاجتماعيَّة واتخاذ السياسات العامَّة التي تصبُّ في مصلحة المجتمع. ويَتميَّز المجتمع القوي بروابطه الأفقيَّة التي تسود فيها الأحزاب وجماعات الضغط المُعبِّرة عن مصالح المواطنين، وهو ما يَجعل المجتمع سَندًا للدولة في تحقيق أهدافها القوميَّة. أمَّا الدولة الضعيفة فهي عاجزة عن تنظيم مجتمعها وتحقيق تطلعاته ومصالحه، حيث تتحوَّل إلى دولة تعمل ضد مصالح المجتمع وتسعى لتفكيكه وإضعاف مؤسَّسَاته وتعبيراته الاجتماعيَّة. وليس بالضرورة أن تكون الدولة القويَّة قمعيَّة، فقد تكون الدولة الضعيفة قمعيَّة، وغالبًا ما يكون القمع تعويضًا عن ضعف شرعيَّتها ومؤسَّسَاتها، ما يَجعلها تميل إلى تأسيس سطوتها مِن خلال أجهزة القهر والرقابة والتسلُّط.
وقد حَدَّد الباحث الأزمة التي تواجه دولة ما بعد الاستعمار في العالم العربي بأنها أزمة ديمقراطيَّة وهويَّات، فهي ما بين ديمقراطيَّة موؤودة وهويَّات قاتلة. وفسَّر ذلك بأن الدولة القوميَّة الحديثة عند المسلمين قد قامت على تدمير المؤسَّسَات التاريخيَّة التقليديَّة، مِن غير تمييز بين الأشكال الجامدة والأبعاد الصالحة التي يُمكِن الاستفادة منها، وإحلال مؤسَّسَات جديدة تمَّ تطويرها في إطار ثقافي مختلف. وهو ما أدَّى إلى تفكيك المؤسَّسَات التقليديَّة وفشل المؤسَّسَات الحديثة. وقد تجلَّى ذلك في نموذج الدولة العربيَّة الحديثة التي تمثلت في قِيَم العلمنة ومبدأ الاستبداد وتأميم الدين والسيطرة على المجتمع وأشكال التعبير التحرريَّة في ظِلِّ هندسة هشة لديمقراطيَّة شكليَّة ودولة مركزيَّة مهيمنة.
ويُمكِن القول إن الدولة العربيَّة الحديثة قد فشلت في تحقيق وعودها التحرريَّة والنهضويَّة، كما فشلت في بناء سياسات هويَّة قادرة على تثمين التنوُّع وإثراء التعدُّد، ما أنتج سياسات قائمة على تخويف الأقليَّات وزرع بذور التشكيك والتخوين والشقاق.
ثم انتقل الباحث إلى الحديث عن نقطة التلاقي بين الطائفيَّة والتطرُّف، وهي التعصُّب للذات أو المذهب أو الرأي وادعاء احتكار الحقيقة المُطلَقة والتشدُّد والأنانيَّة، ومِن ثمَّ استباحة إبادة المُخالِف باستخدام العنف المادي. ويَرى أن العنف الديني يَنهل مبرراته مِن مركبات الهويَّة والذاكرة والماضي ومِن نصوص التراث والوَحْي أيضًا، كما يَتغذى على هيمنة وعنف الآخر وإهانته لمقدسات الذات المسلمة المقهورة، فضلًا عن استحضار تأثير عنف الدولة ودوره في إنتاج العنف الديني المسيَّس ضد سياساتها وخياراتها الوطنيَّة ومواقفها الإقليميَّة والدوليَّة. وعليه، لا يُمكِن فصل العنف الديني عن العنف العلماني والعنف الإمبريالي وعنف الدولة الاستبداديَّة.
ولا يُمكِن فهم التطرُّف الديني والعنف السياسي دون فهم الاستراتيجيَّات التي تنتهجها النظم السياسيَّة العربيَّة، فكلما انغلق النسق السياسي وأحدث انسدادًا في الحياة السياسيَّة وضيَّق فرص المشاركة وإمكانات المنافسة وهوامش الحريَّات، انتعش خطاب العدميَّة والإحباط السياسي وفتحت أبواب التطرُّف الديني والسياسي المُوَلِّد للعنف المادي، وهو ما يَجُرُّ إلى استقطاب هوياتي وطائفي.
ويَخلُص الباحث إلى أنه لا يُمكِن بناء نظام سياسي عادل وفاعل وقادر على تفكيك العنف الطائفي ومحاصرة التعصُّب العرقي ومعالجة التطرُّف الديني المُسلَّح دون توطين ثقافة الإيمان بالتنوُّع والاختلاف واحترام الآخر والتمكين للتعايش في مناخ مِن الاعتراف المُتبادَل والعدالة الاجتماعيَّة، وهو ما يَحتاج إلى تحوُّل مِن نموذج “الدولة ضد الأمَّة” إلى نموذج “الدولة في خدمة الأمَّة” ومجاوزة مأزق الدولة الرخوة/الفاشلة أو الدولة البوليسيَّة/القمعيَّة لتجنب فوضى الانهيار والطائفيَّة والتقسيم.
[2]
اجتاتحت العلمانيَّة المتطرِّفة كثيرًا مِن الدول العربيَّة، ومع بداية التسعينيَّات بَرزت أصوات تتحدَّث عن التحوُّل مِن مرحلة العلمانيَّة إلى مرحلة “ما بعد العلمانيَّة” وانبعاث عصر التعدديَّة، وهو ما يقتضي تنقية العلمانيَّة مِن شوائبها بوصفها مسارًا مهمًّا نحو الديمقراطيَّة والحداثة. ومِن هنا يتساءل الباحث “ساري حنفي” حول الشكل المناسب لعلمنة الدولة العربيَّة، قويَّة كانت أم ضعيفة، في الدراسة الثانية التي تحمل عنوان: “الدولة العربيَّة في عصر ما بعد العلمانيَّة”.
سَلَّط الباحث الضوء على ثلاثة تحديَّات تواجه المجتمع ما بعد العلماني الذي يَعترف بدور الدين في المجال العام، وهي: مكانة الدين في مجتمع مُتعدِّد الأعراف والثقافات، وبروز الدين في المجال العام، والمداولات في المجال العام في ضوء النيوليبراليَّة.
وللتغلُّب على هذه التحديَّات، يلجأ الباحث إلى مقاربتين لتجاوز منطق المواجهة بين الديني والعلماني وتطبيع الدور العام للدين وتنظيمه، أولاهما مقاربة “تشارلز تايلر” التي تقوم على إعادة الاعتبار للديني مِن خلال إعادة اكتشاف الحداثة بتحريرها مِن الصيغة الواحديَّة ومِن العقلانيَّة المتحرِّرة مِن الالتزام، وانتقاد التجانس الليبرالي للحقوق الذي يَحدُّ مِن إدراك الهويَّات، والدفاع عن النظام المشجِّع لتعدُّد الثقافات، وهو ما يَسمح باحترام النخب الثقافيَّة المختلفة لبعضها البعض، فالدياني له مخيال اجتماعي يَعود إلى فهمه للدين والعلماني له مخيال آخر مربوط بفهمه للمجتمع والعالم. أمَّا المقاربة الثانية فهي لـ”ميف كوك”، والتي تقوم على أن المجتمع ما بعد العلماني هو المجتمع الذي يُشجِّع التفكير العلمي غير الاستبدادي بينما تتفاعل الآراء والأيديولوجيَّات المختلفة.
وتتجلَّى هذه التحديَّات الثلاثة لمجتمع ما بعد العلمانيَّة في العالم العربي مِن خلال المواجهة بين الخطاب الديني والخطاب العلماني، خاصَّة مِن قِبل النخب اليساريَّة. وقد قلَّلت الثورات العربيَّة مِن حِدَّة هذه المواجهة بما حملته مطالبها مِن قِيَم كالنقاش حول الدولة المدنيَّة وتطوير مفهوم المواطنة، وصِرنا أمام إمكانيَّة للعلمنة في العالم العربي بعد ظهور أجواء مواتية لنشوء حركات إسلاميَّة جديدة تدفع أو تتعايش مع سياقات علمنة متدرجة، ولكن هذه الإمكانيَّة مرتبطة بما بين أنماط التديُّن (المؤسَّسَاتي والإحيائي وتديُّن الحركات الإسلاميَّة الجديدة أو “ما بعد الإسلامي” والتديُّن الشعبي أو الصوفي) وأنماط العلمنة (العلمانيَّة المؤمنة والرخوة والصوريَّة والعلمانيَّة الجزئيَّة أو الأخلاقيَّة أو الإنسانيَّة) مِن علاقة جدليَّة.
وتختلف ردود الفعل على مجتمع ما بعد العلمانيَّة على حسب أنماط التديُّن وتعاملها مع السياسي في المجالين العام والخاص وعلاقتها بالتعدديَّة والاعتراف بالآخر. ويَرى الباحث أن أقرب أنماط التديُّن إلى ممارسة الديمقراطيَّة هو نمط “ما بعد الإسلامي” الذي تمثله حركة النهضة في تونس، حيث يُؤمن هذا النمط بخطاب تعددي مُسلَّح بعقل عملي غير استبدادي ويتواجد في المجال العام.
[3]
أمَّا الدراسة الثالثة فهي بعنوان: “كيف تولِّد النظرة المبتورة إلى الآخر العنفَ”، وهي لـ”عبدالناصر الجابي”، وموضوعها الرئيس هو العنف السياسي الذي عاشته الجزائر خلال أكثر مِن عقد، في محاولةٍ لتفسير السيرورة التي أنتجت هذا العنف الذي حدث في مجتمع متجانس دينيًّا واجتماعيًّا بقدر كبير، وفي دولة وطنيَّة بَدَت عليها علامات الضعف في مواجهة مظاهر العنف الأولى، ثم سرعان ما تحوَّلت إلى دولة قويَّة في تصديها لأشكال العنف اللاحقة، وهي مفارقة لافتة للنظر.
بدأ الباحث بالخصائص الرئيسة للجماعات الفاعلة التي أنتجت هذا العنف ومارسته، وهي تنظيمات اتسمت بكثرة الصراعات الداخليَّة العنيفة والانشقاقات فيما بينها، وتبني مدارس الإسلام السياسي الجذري، بتياراته السلفيَّة، وغلبة الطابع الجهوي والمحلي، والوقوع تحت قيادة عناصر مِن أصول شعبيَّة لا تتمتع بتأهيل علمي، ما جعلها تقع تحت هيمنة الفتاوى الخارجيَّة لشيوخ لا يَعرفون الواقع الجزائري.
ولفهم ما حصل مِن عنفٍ في نهاية الثمانينيَّات وبداية التسيعنيَّات، استعرض الباحث أهم المتغيِّرات والخلفيَّات التي دفعت في اتجاه العنف، وهي:
1 – الانطلاق في عمليَّة انتقال سياسي واقتصادي غير توافقيَّة وغير شفافة، اختلفت عليها مراكز اتخاذ القرار في الدولة، الأمر الذي أظهر تفكُّك النظام. وخرج الصراع إلى الشارع الذي سَيطرت عليه حركات اجتماعيَّة وسياسيَّة جديدة في ظِلِّ تدني شرعيَّة النظام الذي فشلت مشاريعه في إخراج الدولة مِن أزماتها المتراكمة منذ الاستقلال. وأدَّى نفور المواطن مِن العمل الحزبي إلى جعل الساحة حكرًا على الصراع بين النظام والتيَّار الإسلامي.
2 – التزامن بين أزمة النظام وظهور العنف وسقوط المعسكر الاشتراكي الذي كانت الجزائر تُعدُّ جزءًا منه. فقد كان لخروج الاتحاد السوفيتي مِن أفغانستان وعودة العديد مِن الجهاديِّين مِن أصحاب التجربة العسكريَّة والفكر الديني المتطرِّف إلى الجزائر أثرٌ كبيرٌ على بروز العنف في الحالة الجزائريَّة، وذلك بعد أن حصل تزاوج بين القاعدة الشعبيَّة للإسلام السياسي وهذه النخبة المسلَّحة القادمة مِن أفغانستان. ولم تجد هذه “النخبة” صعوبة في التعبير عن حضورها في جَوٍّ سياسيٍّ غابت فيه مظاهر السلطة، وتحوَّل فيه احتلال الشوارع إلى ممارسة شبه يوميَّة، ما زاد مِن اقتناع المواطن بضعف الدولة ومؤسَّسَاتها.
3 – التعامل بين التيَّار الإسلامي السياسي وهو في حالة صعود قوي والطرف الرسمي الممثل في مؤسَّسَات النظام السياسي المتصارعة والتي تآكلت شرعيتها في عين المواطن. وقد توصَّلت قيادات هذا التيَّار إلى قناعةٍ بقرب سقوط النظام، ما جعلها تتبنَّى فكرة الإضراب العام للضغط على الحكومة. وتمخض هذا الإضراب عن زيادة في حالة الضبابيَّة لدى الطرفين الفاعلين، مِمَّا زاد بالتالي مِن احتماليَّة زيادة العنف. وكان مِن تداعيات الإضراب أن تمَّ القبض على بعض قيادات الجبهة الإسلاميَّة للإنقاذ، وأعقب ذلك دخول التيَّار الإسلامي في مرحلة تخبُّط في مسيرته وتحديد أهدافه، بعد أن تحوَّل الإضراب عمليًّا إلى عصيان مدني، وهو مجال خلاف بين قيادات الجبهة. وزادت حالة التشرذم هذه مِن فرص إنتاج العنف بعد أن تعمَّق الصراع بين النخب الرسميَّة السياسيَّة والعسكريَّة المتصارعة، لتبرز جماعات الإسلام السياسي المسلَّح التي استغلت الأحداث كفاعل أساسي. وحظيت هذه الجماعات بقوَّة أكبر وصدقيَّة في التحليل بعد إلغاء نتيجة الدور الأوَّل مِن الانتخابات البرلمانيَّة. ومنحت هذه السيرورة التي أخذتها الأحداث شرعيَّة كبيرة للتيَّارات والجماعات المتطرِّفة داخل الجبهة الإسلاميِّة للإنقاذ، وهي التي كانت تريد الاستيلاء على السلطة بالسلاح ضد “الطاغوت”.
4 – الانقسامات ذات البُعد الثقافي والقِيَمي التي تعرفها النخبة السياسيَّة في الجزائر، فصعوبات التوافق بين النخب التي مَيَّزت مرحلة تسيير الانتقال السياسي في الجزائر يُمكِن أن تكون عاملًا آخر لاندلاع العنف، فقد تعاملت النخبة العسكريَّة والسياسيَّة “المفرنسة” مع القيادة السياسيَّة للتيَّار الإسلامي كجزء مِن النخب “المعرَّبة الدينيَّة وشبه الدينيَّة” التي لا يَحِق لها التدخل في الشأن السياسي الذي لا تعرفه ولا تُحسِن التعامل معه. وكانت النخب الإسلاميَّة بدورها ترى أن قيادات الجيش هم “حزب فرنسا”. هذا الانقسام يُمكِن أن يكون جزءًا مِن أسباب ظهور العنف بهذه الشراسة في مجتمع الجزائر المتجانس دينيًّا ومذهبيًّا، فالدولة الوطنيَّة لم تنتج مؤسَّسَات ثقافيَّة وسياسيَّة مشتركة تتعارف داخلها النخب وتتصارع فيما بينها كمنتوج ثقافي واحد، مِمَّا خلق حواجز نفسيَّة عديدة بين مكونات النخبة، وصولًا إلى العداء فيما بينها.
5 – اكتساب الصراع طابعًا عسكريًّا واضحًا بعد أن توغلت الجماعات المسلَّحة في المناطق الصحراويَّة والغابات. وبانفصال مركز الصراع، واجهت قوَّات الجيش صعوبات كبيرة في ملاحقة هذه الجماعات بهدف منعها مِن القيام بعمليَّات داخل المدن. ولم تكن هذه العمليَّات مُمكِنة بدون التأييد والمساعدة مِن جانب أبناء المدن الذين التحقوا بهذه الجماعات وبقوا تحت تصرفها قبل أن يُغيِّر الكثير مواقفهم مِن هذه العمليَّات التي لم تعد تستهدف قوَّات الأمن فقط، وإنما مَسَّت فئات واسعة مِن المواطنين.
6 – لجوء الدولة إلى زعامات العمل المسلَّح التابع للجبهة الإسلاميَّة للدخول في تفاوض بعد أن فشلت المفاوضات مع قياداتها السياسيَّة المسجونة، وامتناع بعض المسلحين عن التخلي عن مواقعهم بعد الاتفاق مع الجيش الإسلامي للإنقاذ ومثله “مدني مرزوق”، وهو الاتفاق الذي لم تقبل به الجماعات الأخرى التي استمرت في عملها المسلَّح، وزادت ضراوتها ضد بعضها البعض وضد المواطنين الذين زاد ابتعادهم عن هذه الجماعات المنغلقة على أنفسِها، والتي اندمجت في بُعدٍ دولي واضح بعد خروجها مِن المدن والْتحاقها بالمناطق الجبليَّة والصحراويَّة وتواصلها مع الجانب الليبي ودول الصحراء بعد ذلك.
[4]
يَسعى “خليل العناني” في الدراسة الرابعة، والتي تحمل عنوان: “مأزق الدولة القويَّة: ميكانيزمات إنتاج العنف والعنف المضاد في مصر”، إلى تفكيك العلاقة المطردة بين العنف والعنف المضاد في مصر بعد انقلاب 2013م، وفهم كيفيَّة إنتاج سياسات الدولة العنيفة تجاه المعارضين والمُخالِفين لها سياسيًّا موجات مِن العنف المضاد تجاه مؤسَّسَاتها وأجهزتها وأفرادها.
يبدأ الباحث بتقديم خلفيَّة نظريَّة عن العنف المنظم أو “إرهاب الدولة”، وهو وقوع الخوف السياسي مِن خلال العنف أو التهديد عن طريق الدولة ووكلائها وحلفائها. وهذا النوع هو الأكثر انتشارًا بسبب دعم الدول العظمى للدول التي تستخدم التعذيب، فهي تغض الطرف عن ممارساتها العنفيَّة لأنها تخدم مصالحها القوميَّة. ويُمكِن تفسير إرهاب الدولة وفق نظريتين، تقول أولاهما إن هذا الإرهاب يَنبع مِن الدولة التي تعاني ضعفًا بنيويًّا كدولة حديثة، وهو ما يَدفع الدولة إلى استخدام القوَّة مِن أجل الحفاظ على النظام وتبديد مخاوف التفكُّك. وترى النظريَّة الثانية أن هذا الإرهاب يتولَّد مِن شعور الدولة بالقوَّة وتركُّز السلطة في يَد نخبةٍ تشعر بأنها لن تُحاسَب على عنفها ضد المعارضين. وتميل الدراسة إلى النظريَّة الثانية في تحليل مأزق الدولة في مصر.
ثم ينتقل الباحث بعد ذلك إلى الحديث عن العلاقة بين القمع والعنف في مصر، وهي علاقة يَغلُب عليها طابع الطرديَّة أو السببيَّة، فقد ساهمت السياسات القمعيَّة التي انتهجها النظام بعد 2013م في تفشي ظاهرة العنف، ودفعت إلى ظهور العديد مِن التنظيمات والجماعات الراديكاليَّة.
وثمَّة ميكانيزمات تساهم بها الدولة في إنتاج العنف، وهي الاعتقالات التعسفيَّة التي طالت عشرات الآلاف أغلبهم مِن الإخوان المسلمين، مِمَّا اضطر الدولة إلى إنشاء 14 سجنًا جديدًا لاستيعاب الأعداد المتزايدة. وسياسات التعذيب الممنهج التي أدَّت إلى مقتل العشرات مِن المعتقلين. والاختفاء القسري الذي صار نمطًا متكررًا، حيث يَتِم إخفاء الفرد في مكان احتجاز غير رسمي، وقد يَتِم التخلُّص منه بالقتل أحيانًا. والتصفيَّة الجسديَّة، والقتل خارج إطار القانون، سواء كان قتلًا مباشرًا أثناء الحملات الأمنيَّة أو قتلًا بطيئًا بالإهمال الطبي المتعمَّد داخل السجون.
ومع تولِّي السيسي للحكم وارتفاع مستوى القمع والتدخل العنيف للسلطة في المجال العام، ظهرت مجموعة كبيرة مِن الحركات والشبكات والخلايا الراديكاليَّة التي تنتهج العنف، وتتبنَّى أجندة سياسيَّة وإيديولوجيَّة تستهدف إسقاط النظام مِن خلال استهداف قوَّات الجيش والشرطة، ويَتهم النظام أكثرها بالانتماء إلى الإخوان المسلمين، وهو ما يَنفيه أفرادها. وأهمها “حركة المقاومة الشعبيَّة”، و”حركة العقاب الثوري”، و”حركة سواعد مصر – حسم”. وهي حركات تأسَّسَت كرد فعل على الانحراف عن المسار الثوري والانقلاب على التجربة الديمقراطيَّة واستبداد العسكر، وتؤكِّد على سعيها لتحقيق العدالة والقصاص للشهداء ومعاقبة مَن أجرموا في حق المتظاهرين السلميِّين، وتنفي عن نفسِها تهمة الإرهاب.
[5]
تدور الدراسة الخامسة، وهي بعنوان: “تفشي العنف السياسي في ليبيا: التجربة المميِّزة لدولة زعاميَّة فاشلة في سياق العولمة السياسيَّة”، حول دور الدولة الزعاميَّة في إنتاج العنف في ليبيا، ويَعتمد فيها الباحث “مولدي الأحمر” على 3 أفكار رئيسة، وهي:
- أن العلاقات الاجتماعيَّة تتضمَّن علاقات سلطويَّة منتجة للعنف.
- أن الدولة الزعاميَّة لا تنتج أدوات احتكار وتشريع للعنف كما في دولة المواطنين.
- أن العولمة السياسيَّة تسمح في حالات الدول الفاشلة باستخدام العلاقات السلطويَّة بهدف إنتاج واستخدام العنف السياسي.
يبدأ الباحث بمناقشة احتكار العنف السياسي في ليبيا في سياق “الربيع العربي”، وهي معادلة تتفاعل فيها 3 عناصر: أوَّلها هو نسيج العلاقات الاجتماعيَّة التي تطغى على التمثلات والمعايير الجماعويَّة للسلطة. وثانيها هو “الدولة الزعاميَّة” التي يكون محور ديناميكيتها زعيم وأتباعه. وثالثها هو العولمة السياسيَّة التي تعني فقدان الاستقلال المحلي باسم “الشرعيَّة الدوليَّة”. ونتيجة هذا التفاعل هي ما نراه مِن عنف متأصِّل في نسيج مِن العلاقات الاجتماعيَّة المحليَّة، تطغى عليه التمثلات الجماعويَّة، وعنف تمارسه دول ومؤسَّسَات خارجيَّة، لا تشمل سيادتها المجال الترابي والقانوني الذي تتدخل فيه، لكنها تمارس فيه هذا العنف.
ثم يحاول الباحث عرض المكونات السابقة في حالتها الديناميكيَّة النشطة والمترابطة، مستهدفًا تفسير هذه الظاهرة التي شكَّلت في ليبيا تجربة مميَّزة لدولة زعاميَّة فاشلة في سياق عولمة سياسيَّة مِن نوع جديد.
يبدأ الباحث بتعريف الدولة الزعاميَّة في ليبيا، وهي دولة تلبَّسَت بزعامة القذافي، واحتكرت إنتاج الزعامة السياسيَّة ومواردها بالكامل على رقعة سياديَّة مُحدَّدة، ولم تنتج هذه الديناميكيَّة الزعاميَّة مشروع دولة بالمفهوم القانوني- السياسي الحديث.
ومِن هذا المنظور فإن ما يثير في الحالة الليبيَّة هو أن احتكار ممارسة العنف – السياسي تحديدًا – وأدواته مِن طرف الدولة الزعاميَّة كان بيد الزعيم وأتباعه أكثر مِنه بيد مؤسَّسَات الدولة.
والمهم في بنية هذه الدولة الزعاميَّة هو أنها لا تحتكر ممارسة العنف السياسي ولا أدواته وفق شرعيَّة قانونيَّة متفق عليها ومستقلة عن الأفراد، ما يَجعل العنف غير الشرعي ضدها شيء مناقض لجوهرها، بل إن الذي يَحتكِر ذلك هو المؤسَّسَة الزعاميَّة (الأتباع ممثلون في اللجان الثوريَّة والقائد) الملتبسة بالدولة. ومِن ثمَّ فإن أيَّ عنف مضاد لهذه الدولة هو عنف ضد الزعيم، وهو ما يَستدعي ويُنشِّط مرجعيَّات الروابط الاجتماعيَّة والثقافيَّة التي يستمد منها الزعيم شرعيته.
لقد مارست الدولة الزعاميَّة الليبيَّة العنف بطريقة تختلف عن العنف الذي تمارسه الدولة البيروقراطيَّة، حيث يَسحَب الزعيم مِن الجهاز البيروقراطي صلاحياته لنفسِه، ثم يمنحها لأتباعه المبثوثين في كلِّ مفاصل الدولة، حيث ينتشرون في كلِّ ثنايا ليبيا، جغرافيًّا واجتماعيًّا.
وبما أن الزعيم يَحكم بأتباعه المبثوثين في كلِّ مكان فإن الولاءات المحليَّة واستخداماتها تجري مِن منظور ثقافة سياسيَّة ليس لديها لتتمثل الآخر وتبني علاقات تبادليَّة معه غير روابط القرابة والجيرة، وهذا بشحن علاقات السلطة على المستوى المحلي بعنف أفقي كامن يَسري بين مجموعات الأتباع، وهو عنف قابل للانفجار بحسب حِدَّة الصراعات على الموارد والاعتبارات الاجتماعيَّة.
أمَّا عن العولمة السياسيَّة وعلاقتها بالعنف فيَرى الباحث أن الدول الكبرى تدبر لهذا العنف على المستوى الكوني حسب مصالحها، ولهذا فإنها لا تتدخل إلَّا إذا أدَّى عنف الدولة الزعاميَّة إلى توليد مقاومة أو عنف داخلي مضاد هدفه نزع الشرعيَّة عن الدولة برمتها، بما يُهدِّد مصالح الدول المستفيدة. وفي غير هذه الحالة، لا يُثير عنف الدولة الزعاميَّة مشكلة أخلاقيَّة بالنسبة لهذه الدول.
وإذا نظرنا إلى الحالة الليبيَّة، فسَنجد أن البنية السياسيَّة للنظام الزعامي كانت تتآكل بسبب تحوُّله إلى مشروع خاص وفردي للاستئثار بالحكم لا يَتعدَّى دائرة الأتباع، ومُعَادٍ لنشأة أيَّة قوَّة اجتماعيَّة واقتصاديَّة وثقافيَّة أو نقابيَّة أو غيرها منتجة لزعامة منافسة. وفي عصر العولمة السياسيَّة، استجلب تهاوي النظام التدخل لدعم مجموعة مِن المواطنين ضد مجموعة أخرى منهم باسم الدفاع عن حقوق الإنسان. ولم يكن هذا التدخل ليتحقق باستقلال عن عناصر العنف الكامنة في البُعد السلطوي للعلاقات الاجتماعيَّة المحليَّة.
وقد أظهرت الأحداث في ليبيا أن الأطراف المتحاربة لا تشكل كتلًا متجانسة مِن أيِّ نوع، سوى أنها مجموعات زعاميَّة محليَّة تغذيها موارد خارجيَّة تستخدمها في تحقيق مصالح كبرى، تتجاوز بكثير المعاني والأهداف المحليَّة التي يُعطيها المتقاتلون لحربهم.
وينتهي الباحث ببعض النتائج، منها أن فكرة تلازم الدولة ككيان سياسي – اجتماعي على مجال ترابي محدَّد واحتكار ممارسة العنف الشرعي داخله قد أصابها التلف بسبب العولمة السياسيَّة واستخداماتها للعنف على نطاق يتجاوز سيادة الدول المستقلة. وأن العنف يكمن في العلاقات السلطويَّة التي تتضمنها العلاقات الاجتماعيَّة غير المتكافئة، وهو ما يستخدمه التدخل الخارجي ويوجهه لتحقيق أهدافه الخاصَّة، ما يجعله طرفًا في إنتاج الصراعات الداخليَّة.
[6]
تحاول الدراسة السادسة لـ”مروان قبلان”، وتحمل عنوان: “الدولة السوريَّة بين حَدَّي القوَّة والفشل وإنتاج العنف”، البحث في حالة الدولة السوريَّة وتحديد ما إذا كان العنف الذي انتشر فيها بعد ثورات الربيع العربي قد نشأ نتيجة قوَّة الدولة في علاقتها بمجتمعها واستعدادها لاستخدام العنف المفرط، ما أدَّى إلى رَدِّ فعل مجتمعي أكثر عنفًا وتطرفًا في مواجهتها، أم أنه عنف ناتج عن ضعف الدولة وهشاشتها، ما أغرى قوى وشرائح اجتماعيَّة مختلفة بالتمرُّد عليها ورفع السلاح في وجهها.
ويؤكِّد الباحث قبل أيِّ شيءٍ على أن سوريا مِن أكبر الدول العربيَّة المتغولة أمنيًّا والمتوغلة اجتماعيًّا، فهي تمارس نوعًا متطرفًا مِن “سيادة الدولة”، ومستعدة للتضحية بشرائح واسعة مِن المجتمع في سبيل الحفاظ على الحكم والاحتفاظ بامتياز احتكار العنف وأدواته.
وللإجابة على التساؤل المطروح، يبدأ المؤلف باستعراض المفاهيم والتعريفات والمصطلحات حول الدول القويَّة والضعيفة والهشَّة والفاشلة والمنهارة، وموقف كلٍّ منها مِن العنف ودورها في إنتاجه.
وبإسقاط التعريفات والمفاهيم النظريَّة على الحالة السوريَّة يتوصَّل الباحث إلى نتيجةٍ مفادها أن سوريا مِن أكثر دول المنطقة قمعًا وتغوُّلًا مِن الناحية الأمنيَّة، وأكثرها استعدادًا لاستخدام العنف الموجَّه ضد خصومها، وهي مِن هذا الباب يُمكِن اعتبارها دولة قويَّة في علاقتها بالمجتمع. لكن مفهوم القوَّة في الحالة السورية خال مِن أيِّ اعتبارات حقوقيَّة أو ديمقراطيَّة. والملاحظ فيها أن النظام ضاعف مِن استخدام القوَّة لشعوره بالضعف، وذلك تعويضًا عن غياب الشرعيَّة والسلطة القانونيَّة والأخلاقيَّة التي تتمتَّع بها الدولة عندما تكون قويَّة. أمَّا إذا نظرنا إلى الدولة السوريَّة وفق قدرتها على آداء مهامها الثلاث الرئيسة، وهي: توفير الأمن، وتقديم الخدمات الأساسيَّة، وحماية الحقوق المدنيَّة الرئيسة لمواطنيها، فسوف تُعدُّ الدولة السوريَّة ضعيفة. كما أنها برفضها لأيِّ نوع مِن أنواع المشاركة السياسيَّة، إلى جانب انعدام المساءلة وضعف الثقافة القانونيَّة، وغياب سلطة القانون، قد ساهمت في انتشار ممارسات داخليَّة سلبيَّة كالفساد والترهل الإداري وتدهور أخلاقيَّات العمل وانتشار المظالم وضعف الشعور بالانتماء إلى الدولة والاستعداد للخروج عليها مع تآكل شرعيتها في فئات واسعة مِن المجتمع. وقد أدَّى ذلك إلى استغلال قوى المجتمع لأوَّل فرصة للانقضاض على الدولة باعتبارها خصمًا وعدوًّا، ورفع السلاح في وجهها، رَدَّا على العنف المفرط الذي استخدمته في مواجهة الاحتجاج على ممارساتها وسياساتها. وقد أدَّى هذا الأمر إلى إنتاج مقدار هائل مِن العنف والدخول في حالة احتراب أهلي أدَّت إلى الانتقال بالدولة مِن طور الدولة القويَّة (قمعيًّا) والضعيفة (حقوقيًّا) إلى طور الدول الفاشلة مع عجزها عن تأدية مهامها، وعدم قدرتها على احتواء العنف والاستمرار في احتكار أدواته، وخروج أجزاء كبيرة مِن أراضيها عن سلطتها، ووقوعها تحت حكم جهاتٍ خاصَّةٍ مِن ميليشيات وفصائل محليَّة ذات ارتباطات خارجيَّة. وما لم يَتِم وضع عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع تؤدِّي بموجبه الدولة المهام السياسيَّة المنوطة بها كاملة في مقابل احتكارها لأدوات العنف وشرعيَّة استخدامه، ستبقى الدولة السوريَّة دولة فاشلة.
[7]
أدَّى الاحتلال الأمريكي إلى إطلاق سياسات الهويَّة وما نتج عنها مِن سَرديَّات صراعيَّة أفضت إلى دولة عاجزة عن القبول بالتعدُّد ومُصِرَّة على تغليب منهج “تغالب الهويَّات”، ما أدَّى إلى تقويض شرعيَّة الدولة وتقليص قدرتها على الضبط الاجتماعي، وانشطار المجتمع على قاعدة هويَّات دينيَّة طائفيَّة، وانتشار تسييس الهويَّات المذهبيَّة، وشيوع الفوضى والخوف، واندلاع العنف.
وقد حاول الباحث “فارس كمال نظمي” مِن خلال الدراسة السابعة التي تحمل عنوان: “التطرُّف الديني العنفي: ديناميَّات الإنتاج والإدامة والشرعنة”، الإجابة على السؤال التالي: ما الشروط السوسيوثقافيَّة والاقتصادسياسيَّة والسيكوسياسيَّة المتضافرة جدليًّا لإنتاج التطرُّف الديني العنفي وإدامته وشرعنته في العراق بعد الاحتلال الأمريكي سنة 2003م؟
بدأ الباحث بتمهيد مفاهيمي، عرَّف فيه مصطلح “التطرُّف الديني العنفي”، ويشمل الجماعات الدينيَّة التي تتبنَّى العنف المتعمَّد وتمارسه وتبرِّره لتحقيق أهداف دينيَّة، وهو ما يَعنِي وجود تطرُّف ديني غير عنفي. ويُستخدَم هذا المصطلح للحالة العراقيَّة بدلًا مِن مصطلح “الإرهاب”، لأن الأخير يتسع ليشمل العنف الصادر عن جماعات سياسيَّة غير دينيَّة. وتزداد إمكانيَّة اندلاع العنف في المجتمع عندما تقوم الدولة بتفضيل طائفة على حساب الطوائف الأخرى، إذ قد يُخاطِر أتباعها لاسترجاع نفوذهم السياسي ومنافعهم الاقتصاديَّة، فتزداد رغبتهم بالنيل مِن الطائفة السائدة والسيطرة على ممتلكات الدولة.
ثم قدَّم الباحث ثلاث فرضيَّات تتضافر لإنتاج “التطرُّف الديني العنفي” وإدامته وشرعنته، وهي:
- أن إنتاج العنف تحفزه سرديَّات تاريخيَّة ذات خلفيَّة سياسيَّة ودينيَّة، وهو ما يُعبَّر عنه بصراع الشرعيَّات. حيث وظفت كلُّ طائفةٍ في النظام الطائفي سرديَّات الذاكرة التاريخيَّة في إقصاء الآخر لكونه يَفتقِر إلى الأحقيَّة الدينيَّة ويَتحمَّل الجناية التي تسبَّبت في “مظلوميَّته”، وبهذا تستمد شرعيتها مِن تمثيلها للحَقيْن الإلهي والسياسي معًا.
- أن العنف يَستمر بوصفه اقتصادًا سياسيًّا، وهو ما يُعبَّر عنه بـ”أسواق العنف”. حيث أدَّت إساءة إدارة موارد العراق النفطيَّة الضخمة إلى إنتاج العنف واستمراره مِن أجل إعادة توزيع الهيمنة على الثروة، وبذلك تصبح الحرب اقتصاديَّة مِن وراء ستار سياسي.
- أن العنف تتم شرعنته بوصفه أداة أخلاقيَّة، وهو ما يقع في إطار “الغاية تبرِّر الوسيلة”. حيث يَحظى العنف بمبررات الاستمرار (الشرعنة) مِن خلال التأطير السيكوأخلاقي للسرديَّات التاريخيَّة التي تمأسَسَت بواسطة الاقتصاد الريعي العراقي، ويُصبح أمرًا وَسِيليًّا مقبولًا لدى الجماعات المتطرِّفة لتحقيق غايات إيديولوجيَّة متخيَّلة.
ومِن تفاعل الفرضيَّات الثلاث يتوصَّل الباحث إلى أن كلًّا مِن الذاكرة التاريخيَّة التي جَرى استحداثها اليوم في العراق باستثمار سرديَّات تأويليَّة ومتخيَّلة ومتصادمة لأحداث ماضويَّة، وغزارة الفساد الناتج عن الريع النفطي الضخم، باتا يؤلفان اليوم المصنع السوسيوسياسي الأكثر تأثيرًا لإنتاج التطرُّف الديني العنفي على نحو استيلادي، إذ يُتوقع ما أن يتراجع جزءٌ مِن هذا العنف في حيِّز معيَّن حتى يشتد أو يظهر عنفٌ جديدٌ في حيِّز آخر مِن الخريطة السياسيَّة، ضمن أوضاع تُقدِّم مبررات سيكو – أخلاقيَّة لشرعنته. وفي الوقت نفسِه يَعمل هذا العنف “المشرعَن” في حركته الراجعة على تغذية مشاعر الإحباط والكراهية، وإنعاش السرديَّات المتصارعة وأسواق العنف المرتبطة بها، ضمن دائرة متينة مِن التأثيرات الديناميكيَّة المتبادلة.