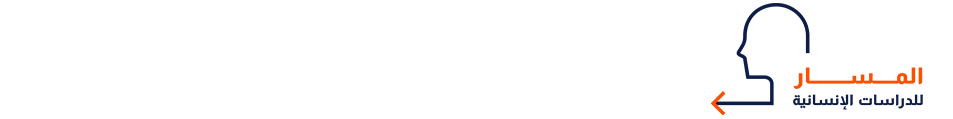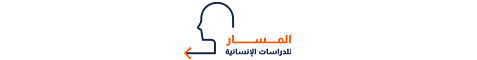| المحتويات |
|---|
| مقدمة المترجم |
| 5 عوامل تؤكد ضعف الأنظمة العربية |
| محاولات جزئية لاحتواء الأزمات |
مقدمة المترجم
قبل نحو 12 عامًا، انطلقت ثورات الربيع العربي، التي حملت آمال التغيير ووضع حلول للمشكلات المزمنة التي عانت منها الشعوب. لكن مع موجة الثورات المضادة التي قادتها بعض دول الإقليم، بدا الأمر وكأن المنطقة قد عادت إلى سابق عهدها، وربما بظروف أقسى.
لكن الحقيقة الماثلة هي أن الأسباب والمشكلات التي قادت الشعوب للثورة على المستبدين ما زالت قائمة، بل وتتفاقم. وبالتالي، فإن البذور التي قد تدفع الشعوب مرة أخرى للثورة ما زالت موجودة، وقد تثمر في لحظة مفاجئة، كما حال الثورات عبر التاريخ.
وفي هذا السياق، نشر “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” بواشنطن، مقالين لمدير برنامج الشرق الأوسط، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقًا، جون ألترمان، قد يكون من المهم للباحثين والمراقبين المهتمين بقضايا التغيير والديمقراطية في المنطقة العربية الاطلاع عليهما.
الأول حول الأسباب التي تؤكد أن الأنظمة الحاكمة حاليًا في الشرق الأوسط أضعف مما كانت عليه إبان اندلاع ثورات الربيع العربي. وقد حصرها “ألترمان” في خمسة أسباب. والثاني حول جهود الأنظمة لاحتواء المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وإذا ما كانت هذه الجهود كافية لحل هذه المشكلات أم لا.
وفي هذه الأسطر ندمج ترجمة المقالين المرتبطين ببعضهما بعضًا، على أمل أن يساهم ذلك في فهم أعمق للوضع الحالي للأنظمة العربية، ونقاط الضعف التي تعتريها، والمشكلات التي تواجهها.
5 عوامل تؤكد ضعف الأنظمة العربية
كانت العودة المظفرة التي حظي بها، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى جامعة الدول العربية علامة أخرى على عودة المنطقة إلى وضعها السابق. فقبل 12 عامًا، سيطر على الرأي العام العالمي فكرة أن السياسات والمجتمعات في الشرق الأوسط ستتغير تمامًا في المستقبل القريب. غير أننا الآن، نجد الأنظمة العربية مستعدة للتخلي عن سياستها في نبذ بشار الأسد، الذي تسبب في تهجير نصف مواطنيه، ومقتل نصف مليون منهم، وتعذيب الكثيرين.
لكن استمرار هذه الأنظمة العربية أربك المحللين الغربيين، الذين لطالما حاججوا بأن هذه الأنظمة ليس لديها القدرة على الاستمرار. ومع ذلك، فإن أداء الأنظمة العربية لا يضمن لها هذه النتيجة مستقبلًا- أي القدرة على الاستمرار. إذ أن إحجام الحكومات الإقليمية، أو عجزها عن حل المعضلات ونقاط الضعف والأمراض التي ساهمت في اندلاع “ثورات الربيع العربي” عام 2011، يجعلها عرضة للضغوط والصدمات التي تعصف بها من خارج المنطقة. فالعديد من هذه الدول في حالة ضعف بالفعل، ومن المرجح أن تتسبب الضربة الشديدة التالية في سقوط نظام أو نظامين منهم.
لكن التنبؤ بسقوط حكومات الدول العربية أمر محفوف بالمخاطر، ذلك أن الحكومات الاستبدادية نادرًا ما تسقط، ولا يوجد ارتباط قوي بين الأداء السيئ للحكومات وسقوطها. وبالنسبة لبعض القادة العرب، كان القمع المحض هو المفتاح للبقاء في السلطة ردح من الزمن، بينما استخدم آخرون الثروة النفطية لشراء تأييد شعوبهم، وبذلك كانوا أقدر من غيرهم على البقاء في السلطة. وهناك أيضًا مَن جمع الطريقتين معًا، كالرئيسين الليبي والعراقي الراحلين، معمر القذافي وصدام حسين.
والجدير بالذكر أن وجود قيادة ضعيفة، أو عدم وجودها أصلًا – كما يحدث في لبنان من حين لآخر- قد لا يؤدي إلى انهيار الأنظمة. فالحقيقة هي أن تعبئة الجماهير أمر صعب، ولا تستطيع معظم الحركات التعامل مع هذا التحدي. كما يمكن أن يزيد البعض حجة إضافية وهي أن فشل ثورات الربيع العربي في عام 2011 جعل من التعبئة الجماهيرية والحشد أمرًا أكثر صعوبة.
نعم، هناك حكومات سقطت، لكن في المقابل، لم تظهر ديمقراطية مستقرة في أي مكان. وعند النظر إلى تلك الأحداث، يمكن لأحدهم أن يقدم حجاجًا منطقيًا مفاده أن الخيارات المتاحة أمام الشعوب العربية هي إعادة تشكيل النظم الحاكمة، أو استعار حرب أهلية متواصلة. ومع ذلك، تشير مجموعة متزايدة من العوامل إلى أن المنطقة على وشك تغيير عميق في مسارها.
وإزاء ذلك، فإن هناك خمسة عوامل رئيسية -على الأقل- تجتمع لتدلل على أن العديد من حكومات الشرق الأوسط أصبحت في عام 2023 أضعف مما كانت عليه في عام 2011، ومن المرجح أن تزداد ضعفًا خلال الفترة المقبلة. كما يُلاحَظ أن أربعة من هذه العوامل تقع خارج نطاق سيطرة الحكومات الإقليمية -بشكل جزئي على الأقل- ولكنها ما زالت تتطلب تركيزًا متجددًا من تلك الحكومات.
العامل الأول: ضعف المجتمع المدني
في حين أن وجود مجتمع مدني قوي لا يوفر حلًا واضحًا لمشكلات البلاد، إلا أنه يوفر طريقة تساعد الحكومات الإقليمية على التصدي للتحديات التي تواجهها.
ذلك أن ضعف المجتمع المدني يجبر الحكومات وحدها على فعل المزيد والمزيد، ويولد حالة من السلبية بين المواطنين، كما أنه يعيق طرح الحلول وتجريبها، ويعزل الحكومة عن رعاياها.
وحول ذلك، كتب الفيلسوف السياسي الفرنسي، ألكسيس دي توكفيل، منذ ما يقرب من 200 عام أن الديمقراطية تحقق ما “لا تستطيع حتى أكثر الحكومات مهارة تحقيقه. فهي تنشر في جميع أنحاء المجتمع نشاطًا لا يعرف الكلل، وقوة وفيرة، وطاقة لا تنبعث إلا بها، ويمكن للديمقراطية تحقيق المعجزات إذا ما توافر لها الشيء اليسير من الظروف المواتية”.
ورغم ذلك، تتصرف الحكومات في المنطقة وكأنها مقتنعة بأن تخفيف القيود على المجتمع المدني سيطلق العنان للفوضى. ولذلك، من الصعب تخيل أن عملية التغيير الذي تقودها الحكومة بمفردها ستكون كافية لإدارة المشكلات المتصاعدة في المنطقة. بل يمكن القول إن ضعف المجتمع المدني سبب لاستمرار وجود المشكلات الأربع الآتي ذكرها تباعًا.
ومن المؤكد، أن إدارة عملية نمو مجتمع مدني ذي قدرة متزايدة، هو بلا شك خيار أقل مخاطرة من تحمل الحكومات المسؤولية وحدها، إلا أن قليلين هم مَن يهتمون باستكشاف والسماح بهذا الخيار.
ولا يهدف أي من ذلك إلى الدعوة إلى تعزيز اعتماد الشرق الأوسط على القواعد الغربية في تنظيم المجتمع والسياسة، أو إلى أن هناك طريقة واحدة فقط لمعالجة التحديات التي ستواجهها المنطقة في السنوات القادمة.
ومع ذلك، يشير الحديث هنا إلى أن أصعب أوقات الشرق الأوسط لم تأتِ بعد، وأن هناك ضغطًا متزايدًا على الحكومات للاستجابة بسرعة وفعالية للظواهر المتفاقمة. وفي الوقت نفسه، فمن المرجح أن تكون الموارد المتاحة للحكومات لمعالجة هذه الظواهر محدودة.
العامل الثاني: بيئة اقتصادية غير مواتية
أدت جائحة كورونا إلى دفع العديد من حكومات الشرق الأوسط إلى زيادة الإنفاق لدعم سكانها خلال ذروة الجائحة، مما زاد من ديون تلك الدول. ونجد الآن، أن الأسواق المالية أصبحت أكثر تشككًا في قدرة الأسواق الناشئة على سداد الديون، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل حاد.
كذلك، فإن رغبة صندوق النقد الدولي -ويمكن القول قدرته- على التدخل في جميع أنحاء المنطقة باتت مقيدة أكثر مما كانت عليه منذ في فترات مضت. ومن المرجح أن تشكّل قيود التمويل عاملًا مثبطًا للاستثمارات الحكومية الكبرى لفترة طويلة قادمة، على الرغم من حاجة الحكومات لتعزيز اقتصاداتها.
العامل الثالث: تحولات أسواق الطاقة
ساعدت دول الشرق الأوسط المصدرة للطاقة في تعزيز اقتصاد المنطقة بأكملها، سواء من خلال المساعدات الحكومية التي تقدمها الدول العربية النفطية لنظيرتها غير النفطية، أو استيراد العمالة منها.
لكن احتمالية حدوث تحول في أسواق الطاقة العالمية دفعت العديد من مصدري الطاقة اليوم إلى التركيز على الداخل، والاستثمار في تنويع اقتصاداتهم، وتعزيز القوى العاملة الوطنية كجزء من استعدادهم لمستقبل ما بعد الهيدروكربونات.
وهذا يعني أن الأموال التي توفرها الدول المصدرة للطاقة، سواء للحكومات الأخرى أم للعمالة التي تهاجر إليها، ستقل كثيرًا عن السابق، وستظهر آثار ذلك في كل من الميزانية الحكومية والتحويلات المالية من العاملين بالخارج.
العامل الرابع: التغير التكنولوجي السريع
في حين أن التكنولوجيا ليست عاملًا سلبيًا في حد ذاتها، إلا أنها ستسرع وتعزز التغيير في مجال التجارة، وأنماط الاتصالات، وأسواق العمل، والعديد من الجوانب الأخرى.
وحيال ذلك، ستحتاج الحكومات العربية إلى قدر كبير من المرونة والإبداع، ووضع الاستثمارات المناسبة في البنية التحتية، واعتماد الإطار التنظيمي المناسب لضمان أن تسهم التطورات التكنولوجية في تعزيز الأمن والازدهار. وبدون هذه الروح المطلوبة من المرونة والإبداع والاستثمارات والتنظيم، فيمكن للتكنولوجيا أن تعيد دول المنطقة إلى الوراء.
العامل الخامس: المياه وتغير المناخ
تتفاقم مشكلة ندرة المياه في العديد من دول الشرق الأوسط. ويرجع ذلك إلى زيادة استخدام المياه، سواء للزراعة، أو لرفد عدد متزايد من السكان بما يلزمهم من مياه، أو للهدر في استخدامها. علاوة على ذلك، يؤثر تشييد السدود الجديدة على تدفق المياه عبر الحدود، مما يؤدي باضطراد إلى بوار الرقعة الزراعية. كما أن الجفاف الناجم عن تغير المناخ واستنفاد المياه الجوفية أحد أسباب ندرة المياه في عدة بلدان شرق أوسطية.
ومن ناحية المناخ، هناك ازدياد في معدل درجات الحرارة غير الصالحة للحياة في منطقة الشرق الأوسط، كما تنتشر العواصف الترابية التي تصيب حركة التنقل بالشلل، ويدفع التصحر المزارعين اليائسين للانتقال من الريف إلى المدن، والعيش فيها حياة مهمشة. كل هذه الظروف تؤثر على حياة الشعوب العربية وسبل عيشها، ولا يلوح في الأفق أي أمل للتخفيف منها.
وعلى هذا، يمكننا القول بخطأ الفرضية التي تدعي أن الشرق الأوسط يعود إلى سابق عهده، بل على العكس من ذلك، إنه على وشك تحول جديد. والأمر متروك لشعوب وحكومات هذه المنطقة لتحديد الشكل الذي سيبدو عليه هذا التحول.
محاولات جزئية لاحتواء الأزمات
وإذ نقول إن من الخطأ تجاوز حقيقة أن العالم العربي مرة أخرى يمر بنقطة تحول حاسمة، فإننا نرى قادة دول المنطقة يتوجهون لأخذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي سيكون لها ما بعدها، تمامًا كما فعل أسلافهم في فترات تاريخية مضت.
كذلك، فإن المنطقة لديها فرصة لاتخاذ خيارات استراتيجية أفضل بكثير مما كانت عليه في الماضي، وهناك دلائل على أنها بدأت في القيام بذلك بالفعل، ولكن ليس في كل المناحي.
فمن الناحية الاقتصادية، ابتعدت الحكومات عن الاقتصادات الموجهة، وأصبحت تفكر أكثر بشأن الصناعات المملوكة للدولة. فقد استولت حكومات الشرق الأوسط (وجيوشها) لفترة طويلة على وصولها السهل إلى رأس المال لمنافسة القطاع الخاص. فزادت بذلك حالة من انعدام التوازن؛ بسبب الأنظمة المصرفية الضعيفة، التي جعلت من الصعب الحصول على رؤوس أموال خاصة.
علاوة على ذلك، فقد أصبح النظام الاقتصادي المتبع يحابي مجموعة صغيرة من المواطنين على كافة الشعب، وهذا شكل من أشكال الفساد، لكنه ضمن استقرار الحكام والقادة السياسيين حتى الآن، غير أنه في المقابل خنق الاستثمار. ويبدو أن هناك إدراكًا متزايدًا في المنطقة بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون محركًا للتوظيف والنمو الاقتصادي، حيث تصاعد اهتمام الحكومات بخلق بيئات تمنح مساحة لمثل هذه الأنشطة.
وبالتأكيد، فإن إدارة عملية التحول هذه ستكون صعبة للغاية، إذ تتسم الاقتصادات العربية بوجود قدر كبير من الدعم المالي الذي تقدمه لمواطنيها. فعلى سبيل المثال، يستحق حوالي 70 بالمئة من المصريين الحصول على خبز مدعوم. وفي الدول الأكثر فقرًا، يمنع هذا الدعم بالكاد وقوع الطبقة المتوسطة في براثن الفقر.
صحيح أن صندوق النقد الدولي يركز على توفير شبكة أمان دائمة للفقراء، وهو محق في ذلك، ولكن الطبقة المتوسطة تعاني من الهشاشة، ونسبتها في المجتمع ليست هينة في كثير من دول المنطقة، كما أن احتمالية انخراط أفراد هذه الطبقة في النشاط السياسي أكبر بكثير من هؤلاء الذين يعانون من فقر مدقع.
والواقع، هو أن هذه الطبقة الوسطى ستزداد عزلة بشكل عميق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تلك الأنظمة العربية -التي ليس لديها رسالة أيديولوجية أو سياسية- تقدم مكافآت ضخمة لطبقة الأثرياء بشكل خاص.
وكما نرى، فليست كل الحكومات تتقبل فكرة أن من الواجب عليها التجاوب مع مطالب مواطنيها، بل تميل العديد من الحكومات للنظر إلى المطالبة بمساءلتها على أنها تهديد وجودي. ومن المقلق -في هذا الصدد- رؤية الحكومات العربية تنفق مواردها ببذخ لمراقبة الرأي العام واحتوائه.
ولا تزال محطات البث الحكومية موجودة منذ 50 عامًا، لكن أهميتها تتضاءل بمرور الوقت. وكبديل لذلك، تركز الحكومات جهودها على شن حملات منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمراقبة الشاملة للتواصل الإلكتروني.
ومما لا شك فيه أنه من الصعب على أي حكومة أن تصل لدرجة التميز في أدائها إذا ما نظرت إلى كل اقتراح على أنه تحريض، أو اعتبرت النقد دليلًا شكلًا من أشكال الخيانة.
وبالتالي، فإن اللجوء إلى مراقبة الشعوب ليس مجرد دليل على عدم ثقة الحكومات في ذاتها فحسب، بل يُفضي أيضًا إلى تكوين ثقة خطيرة بالنفس من جانب الحكومات، وبث الخوف في نفوس المواطنين. ومن المتوقع أن تتراكم التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاستراتيجية مع مرور الوقت.
وخلال الفترة المقبلة، سيتعين على المنطقة أن تواجه التفاوت المتزايد بين الأثرياء والفقراء، سواء داخل البلدان، أو فيما بينها، حيث إن تقبل فكرة أن الأغنياء يزدادون ثراءً بينما الفقراء يزدادون فقرًا بات من الصعب أن يستمر. فالواقع أن أولئك الذين يشعرون أنهم يزدادون فقرًا هم من حاملي الشهادات العلمية، كما أن بإمكانهم الاطلاع على ظروف بعضهم بعضًا، وتكوين روابط فيما بينهم، ويجمعهم شعور مشترك بالظلم الواقع عليهم.
ومن ناحية أخرى، تستكشف دول الخليج الأكثر ثراءً من جيرانها وضع استثمارات أكبر في بلاد الشام وشمال إفريقيا. وهذا توجه إيجابي، لكن من المهم أن يستشعر كثيرون مزايا هذه الاستثمارات على نطاق أوسع.
ومن الصعب معرفة ما إذا كانت المنطقة ستكون قادرة على الابتعاد عن موروثها من العنف. فمع استمرار اندلاع الحروب الأهلية وحركات التمرد، ووجود مجموعة من الوكلاء بدعم من داخل المنطقة وخارجها، وشعور دائم بالحرمان، يبدو أن مصادر العنف دائمة في هذه المنطقة.
وغالبًا ما ندرك المنعطفات التاريخية بعد انقضائها، حيث تنشأ الأنماط من التفاصيل الصغيرة، وتتجمع تلك الأنماط لتكوّن اتجاهات، ولكنها صعبة الملاحظة في لحظة تشكلها. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أننا نعيش بالفعل نقطة تحول تاريخية في هذه الحقبة.
وها نحن نجد ثوار الربيع العربي لعام 2011 لم يروا رؤاهم تتحقق على أرض الواقع بعد تجريدهم من السلطة، لكن على هؤلاء الثوار أن يفكروا في خطواتهم التالية، وفي شكل بلادهم التي سيتركونها للأجيال اللاحقة.