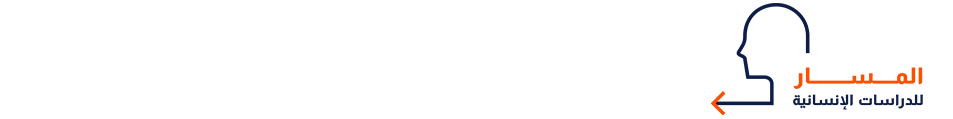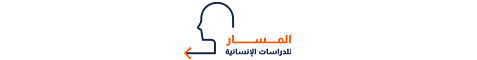المحتويات
- مقدمة المحرر
- مقدمة الكتاب
- الفصل الأول: دور القوات المسلحة المصرية ومكانتها في السياسة المصرية
- الفصل الثاني: تقييم العلاقات العسكرية الثنائية
- الفصل الثالث: علاقة انتقالية منذ الربيع العربي
- الفصل الرابع: نهج أمريكي جديد للعلاقات العسكرية الثنائية
- الفصل الخامس: استنتاجات الكاتب وتوصياته للإدارة الأمريكية
مقدمة المحرر
تمثل العلاقات الأمريكية المصرية قضية شائكة بالنسبة لكلا البلدين، ولعل بؤرة هذه العلاقات ومركزها الرئيسي يتمثل في العلاقات العسكرية بينهما. ومن المعلوم أن مصر تعد ثاني دول العالم تلقيًا للمساعدة الأمريكية العسكرية، بعد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويتجدد النقاش بين الفينة والأخرى داخل الأوساط الأمريكية حول جدوى هذه المساعدات وأهدافها، وفعاليتها في تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى مدى أخلاقيتها، لا سيما وأن السياسة المصرية على مدار العقود الخمسة الماضية تخالف كثيرًا من القيم الأمريكية، وعلى رأسها الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي مصر يتصاعد الحديث بين آن وآخر عن علاقة نظام الحكم مع الإدارة الأمريكية، وتبعية الأول للأخير، ودعم الأخير للنظم العسكرية المستبدة التي تحكم البلاد، ومدى قدرته على تغيير مجريات الأمور حسب رؤيته أو وفق ما تقتضيه مصالحه. وتعد هذه الرؤية هي الأكثر شيوعًا لدى غالب الأحزاب والنخب السياسية، لا سيما المعارضين، كما تلقى هذه الرواية رواجًا لدى كثير من الطبقات الشعبية.
في المقابل، يُصعّد مؤيدو السلطة وأذرعها الإعلامية من هجماتهم وانتقاداتهم لسياسات الولايات المتحدة تجاه مصر، ويتهمونها بدعم جماعة الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي في مصر، فضلًا عن سعيها لزرع بذور الفوضى والفتنة داخل البلاد.
وفي هذا السياق، يأتي كتاب “العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية: التعقيدات والخلافات والتحديات”، الذي أصدره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (The Washington Institute for Near East Policy)، في مايو/ أيار 2022.
ويعتبر المعهد مؤسسة فكر أمريكية داعمة لإسرائيل[1]، ينصب تركيزها على السياسة الأمريكية الخارجية في الشرق الأوسط. كما يوجه سياسةَ المعهد مجلسٌ يضم مستشارين بارزين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ومؤلف الكتاب هو ديفيد ويتي (David M. Witty)، أستاذ العلوم الأمنية بجامعة نورويتش الأمريكية.
وبالأساس، فإن “ويتي” عقيد متقاعد بوحدة القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، عمل وعاش في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 12 عامًا، كما أنه يتحدث العربية بطلاقة. وقد توزعت مهامه الأمنية بين الأردن ومصر والعراق والبحرين. وتركز أغلب أبحاثه على السياسات الأمريكية العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط.
وبخصوص خبرته المهنية في مصر، عمل “ويتي” كضابط تابع للقوات الأجنبية المتواجدة في مصر، خلال العامين 1995 و1996. كما أنه ترأس قسم المبيعات العسكرية الخارجية في مكتب التعاون العسكري بالسفارة الأمريكية في القاهرة خلال عامي 2010 و2011. ومنذ 2011 حتى 2013، شغل منصب نائب رئيس مكتب التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، التابع للسفارة الأمريكية في القاهرة.
كما عاون المؤلفَ عددٌ من الخبراء بالعلاقات الأمريكية المصرية، من العاملين في السفارة الأمريكية بالقاهرة، ومكتب التنسيق الأمني والعسكري، إضافة إلى خبراء آخرين في وزارة الدفاع الأمريكية.
وعلى هذا، فإن الاطلاع على هذا الكتاب من الأهمية بمكان، نظرًا للموضوع الذي يتناوله، وكذلك بسبب خبرة مؤلفه وعلاقاته المتشعبة في مصر والمنطقة، إضافة إلى المعهد الذي أصدره. ولذا، عني مركز المسار للدراسات الإنسانية بعرض هذا الكتاب المهم، وذكر أبرز ما جاء فيه، أملًا في أن تفيد خلاصاته القارئ العربي.
ويوفر الكتاب، في فصله الأول، نظرة معمقة عن القوات المسلحة المصرية ودورها المتعاظم في الحياة السياسية المصرية. وفي الفصلين الثاني والثالث، يتطرق إلى الأسباب الكامنة وراء سياسة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، في مراحل ما قبل الثورة، وما بعدها، مرورًا بالانقلاب العسكري وحتى الآن. وإضافة لذلك، يقدم الكاتب، في الفصل الرابع، نقدًا واضحًا للسياسات الأمريكية المتعلقة بالمعونات العسكرية المقدمة لمصر، كما يطرح مقاربة نقدية جديدة، يركز فيها على حاجة الولايات المتحدة إلى تعديل هذه السياسات، وتطوير توقعاتها بخصوص علاقاتها مع مصر.
مقدمة الكتاب
أكد المؤلف في مقدمة كتابه عددًا من الخلاصات؛ منها أن “العلاقة العسكرية الثنائية” هي الركيزة الأقوى في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر منذ اتفاقية كامب ديفيد 1978، وأن الجيش المصري هو أبرز وأقوى المؤسسات في مصر، وبالتالي ستكون علاقة الولايات المتحدة مع هذه المؤسسة محورية بغض النظر عن الحكومة الموجودة في مصر.
كذلك أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت مصدر السلاح الأول بالنسبة لمصر في الفترة ما بين (1978 – 2014). لكن تغير هذا الحال عقب الثورة المصرية عام 2011 وما تبعها من أحداث، حتى إزاحة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في البلاد عام 2013. ومن ثم أعقب ذلك فرض واشنطن قيودًا على المعونات العسكرية لمصر، وتعليق تسليم الأسلحة، وهو ما أدى إلى تحول مصر تجاه بلدان أخرى للحصول على احتياجاتها العسكرية. وعليه، برزت روسيا وفرنسا كأكبر جهتين لتوريد الأسلحة لمصر منذ عام 2014.
وقد أثارت تجربة الولايات المتحدة في تقديم المعونة العسكرية لمصر على مدى العقود الأربعة الماضية عددًا من القضايا المتعلقة باستخدامات تلك المساعدة وفعاليتها والغرض منها، وكذلك مدى تحقيقها للقيم الأمريكية.
من بين هذه القضايا الشائكة، حدد الكاتب 5 قضايا رئيسة:
- كيف توازن الولايات المتحدة بين مصالحها الأمنية وقيمها المتمثلة في إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، عند التعامل مع الحكومات الاستبدادية؟
- مدى نجاح الولايات المتحدة في تحقيق مصالحها الأساسية في المنطقة، مثل الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر و”إسرائيل”، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتسهيل عبور ترساناتها العسكرية عبر الأراضي والأجواء المصرية.
- مدى قدرة الولايات المتحدة على إعادة هيكلة القوات المسلحة المصرية بشكل يعزز من قدرتها على التصدي للتهديدات الأمنية الحالية.
- نجاح العلاقة العسكرية في دعم المصالح الأمريكية الرئيسية مثل الحفاظ على السلام مع “إسرائيل”، رغم المشاعر الشعبية المعادية لها في مصر.
- فشل العلاقات العسكرية إلى حد كبير في بعض المجالات عندما فرضت واشنطن بعض الشروط وقيّدت عمليات نقل الأسلحة لمصر، ما جعل الأخيرة تتحول في نهاية المطاف إلى دول أخرى ليكونوا رعاة عسكريين رئيسيين لها يمدونها بالسلاح اللازم، وفي الوقت نفسه، يغضون الطرف عن الانتهاكات الحقوقية في مصر.
وبسبب هذا الإخفاق الذي مُنيت به الولايات المتحدة، وأيضا لأهمية موقع مصر الاستراتيجي ودورها المتزايد في المنطقة، يرى الكاتب أنه بدلًا من استخدام المعونة والعلاقات العسكرية للضغط على مصر لتعزيز الديمقراطية، يجب على الإدارة الأمريكية القيام بما يلي:
- أن تقبل الولايات المتحدة حدود نفوذها، مع الإقرار بأن الإجراءات المصرية لن تتماشى أبدًا مع القيم الأمريكية.
- النظر للمعونة العسكرية على أنها نفقات تشغيلية للمساعدة في ضمان تلبية المصالح الأساسية للولايات المتحدة في المنطقة، مثل تعزيز السلام المصري الإسرائيلي، وتوسيع التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، والحفاظ على العلاقات مع القوات المسلحة المصرية.
- التوقف عن استخدام المعونات لإعادة هيكلة الجيش المصري، حيث إن مصر ستلجأ حينها لأطراف أخرى.
- بيع مصر أعدادًا معقولة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، التي تطلبها منذ سنوات ولم تحصل عليها، رغم أن دولا عربية أخرى حصلت على تلك الأسلحة بالفعل.
- تقَبُّل حقيقة أن مصر ستكون دومًا مصدرًا لقدر معين من الخطابات المعادية والمناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.
الفصل الأول: دور القوات المسلحة المصرية ومكانتها في السياسة المصرية
حوى الفصل الأول من الكتاب إشارات سريعة حول شعور المصريين بنوع من الفوقية تجاه العالم العربي، حيث يعتقد المصريون – كما يزعم الكاتب- أن لهم أحقية قيادة العرب. كذلك لفت المؤلف إلى مكانة القوات المسلحة في الحس القومي والوطني للشعب المصري، باعتبارها رمزًا لاستقلال البلاد ومصدرًا لهيبتها.
كما لعب الجيش المصري دورًا مهمًا في كافة مناحي الحياة المصرية العامة خلال تاريخ البلاد برمته، لكن تضخم هذا الدور منذ إطاحة الضباط الأحرار بالنظام الملكي عام 1952. ومنذ ذلك الحين، تحكم القوات المسلحة مصر بشكل مباشر أو غير مباشر.
إلا أن هذا الدور قد استفحل إلى حد كبير بعد الإطاحة، عام 2013، بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، الرئيس محمد مرسي. وبالرغم من الانتقادات التي طالت الجيش المصري ودوره منذ 2013، إلا أن الكتاب يذكر أن ثقة المصريين في الجيش المصري لا تزال مرتفعة حتى الآن، مع الإدراك بأنها انخفضت نسبيًا في السنوات الأخيرة.
وعرج الكاتب على ما وصفه بالدور الأكثر إثارة للجدل، وهو الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية، الموجود منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن هذا الدور توسع بشكل كبير منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. ودلالة على استشراء دورها في الحياة المصرية، يوجد 5 ملايين موظف مصري -أي نحو 18 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في مصر البالغ عددها 29 مليون مصري- يعملون لدى الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري.
كما أوضح المؤلف سيطرة مؤسسات الجيش الاقتصادية على القطاعات الحيوية في مصر، مشيرًا إلى وجود انتقادات متصاعدة -خلال السنوات الأخيرة- بخصوص هذا الدور. لكنه يؤكد أن القوات المسلحة ستحمي مصالحها الاقتصادية والتجارية وأدوارها المجتمعية، بغض النظر عن النظام الحاكم في مصر.
وألمح الكاتب إلى وجود امتعاض لدى بعض الأوساط داخل المؤسسة العسكرية، نابع عن بعض سياسات السيسي وحكومته، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل في قضية سد النهضة الإثيوبي، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، إضافة إلى حملات مكافحة الإرهاب في سيناء، وغيرها من السياسات الداخلية.
لكن الكاتب يستبعد -بشكل كبير- تضاؤل دور القوات المسلحة المصرية في الساحة المصرية خلال السنوات القادمة.
حيث أكد عدة مرات أن الجيش المصري قد يُقدم على فعل ذات الدور الذي قام به مع الرئيسين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي. فكما ساهم الجيش في الإطاحة بهما، قد يفعل الشيء نفسه مع السيسي، ليضمن الجيش أن يكون له القول الفصل في مرحلة ما بعد السيسي، حيث إن القوات المسلحة ستفعل كل ما هو ضروري لحماية مصالحها.
المخاوف الأمنية
انطلق الكتاب في هذا المحور من حقيقة وجود معاناة تاريخية طويلة للمصريين من الاحتلال الأجنبي. حيث يعتقدون أن موقعهم الجيوستراتيجي يجعلهم مطمعًا للقوى الأجنبية وعرضةً للهجوم المستمر.
وبسبب ذلك، يتحسس المصريون بشدة من التأثيرات والتدخلات الخارجية، وقد يتحول هذا التحسس أو الحذر إلى نظرة عامة تصبغ علاقات مصر مع الآخرين، وهو ما يمكن أن يفسر الاهتمام البالغ للحكومات المصرية بتأكيد التزامهم بالحفاظ على سيادة مصر وسلامتها كدولة مستقرة ومستقلة عن التأثيرات الخارجية.
وقد يكون أحد المؤشرات على هذا الحذر، هو إصرار الإدارات المصرية المتعاقبة على عدم استضافة البلاد لأي قواعد عسكرية أجنبية دائمة على أراضيها.
وفي هذا الإطار تضع القوات المسلحة المصرية أولوياتها الأمنية، التي قسمها الكتاب إلى 3 أنواع، كما يلي:
- التهديدات التقليدية
وهي المتعلقة بالأخطار الطبيعية التقليدية التي تأتي من خارج البلاد، مثل الاحتلال الأجنبي أو التدخل العسكري المباشر.
ووفقًا للكاتب، فإن التهديد التقليدي الاستراتيجي الوحيد بالنسبة للمؤسسة العسكرية المصرية هو دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ذات الوقت، يستبعد المؤلف احتمالية حدوث أي تصادم عسكري بين الطرفين في الوقت الحالي.
فمنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، حرص الجانبان على المحافظة عليها، وعدم الانخراط في أي نزاع مسلح. لكن كليهما -في ذات الوقت- لا يستبعدان حدوث أي تطورات سياسية قد تضع الجانبين في مواجهة بعضهما بعضًا. وكلاهما يدرك أن الآخر هو المهدد الاستراتيجي التقليدي الأكثر خطورة -بل قد يكون الوحيد- بالنسبة له.
وبالرغم من مرور 4 عقود منذ إبرام الاتفاقية، وكذا بالرغم من سعي السيسي لتعزيز علاقاته الاقتصادية والاستخباراتية والأمنية والدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، يبرز الكتاب شكوى الإسرائيليين المستمرة من أن السلام مصر يتسم بالفتور والبرود. حيث يرون أن السلام مع مصر كان مع حكومتها فقط، لكنه لم يكن أبدًا مع الشعب المصري. وفي هذا السياق، يستبعد الكتاب احتمالية حدوث أي تقارب إسرائيلي مع الشعب المصري على المدى المنظور.
كما أكد الكاتب غير مرة أن مصر لا تسعى لحرب، ولا يتصور بالأساس حدوث حرب مع الكيان المحتل، إلا أنها ستحاول دائمًا الحفاظ على التكافؤ
المتصور مع إسرائيل، بسبب صراع غير محتمل، لكنه -حال حدوثه- سيكون كارثي النتائج.
ولعل من أبرز ما أشار إليه الكتاب مرارًا، هو أن المسؤولين المصريين ينظرون إلى العلاقات مع إسرائيل باعتبارها أفضل كثيرًا من علاقاتهم مع الولايات المتحدة.
- التهديدات غير التقليدية
وهي التهديدات المتعلقة بالتهديدات الأمنية والجيوستراتيجية وانتشار الإرهاب والتمرد الداخلي المسلح وتهريب السلاح عبر الحدود وتجارة المخدرات والبشر، وغير ذلك من تحديات غير تقليدية بالنسبة للجيوش.
وهو ما استخدمته السلطة المصرية لترويج رسائل لتخويف الشعب من أن يؤول مصيره إلى مصير شعوب سوريا والعراق وليبيا واليمن.
وأورد الكاتب مؤشرات تفيد أن شريحة معتبرة من المصريين تفضل الاستقرار على الديمقراطية. وهو ما تستغله السلطة لإحكام سيطرتها على البلاد، بناء على فرضية أن الشعب يخشى عدم الاستقرار، ومستعد للتخلي عن الحريات المدنية مقابل أمن البلاد واستقرارها.
وفي هذا السياق، يعتبر النظام أن جماعة الإخوان هي المصدر الرئيس للإرهاب، ويستبعد تمامًا إمكانية التوافق معها. حيث تزعم السلطات المصرية وجود ارتباط بين جماعة الإخوان وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سيناء، وهو ما تنفيه الجماعة بشكل قطعي. وهنا لفت الكاتب إلى أن وجهة النظر الأمريكية تؤمن أيضًا بعدم وجود أي علاقة بين تنظيم داعش والإخوان المسلمين.
وبنبرة تعجب وسخرية، ذكر الكاتب أن الحكومة المصرية تلقي باللوم على الإخوان عند حدوث أي مشكلة، مثل حوادث تصادم القطارات المريعة، والتي تروج السلطة أنها ناتجة عن تسلل عناصر الإخوان إلى قطاع السكك الحديدية.
ولذا، تمارس مصر حملات قمع مستمرة ضد الإخوان، لكن هذه الحملات توسعت لتشمل أي معارضة سياسية. ولا يستبعد الكاتب احتمالية أن السيسي يدرك -في قرارة نفسه- أن جماعة الإخوان ليست تهديدًا كبيرًا كما يدعي هو وحكومته ومؤيدوه، لكنه لن يصرح بذلك علنًا حتى يتمكن من مواصلة تشويه سمعة الجماعة وإرباكها وتقويض نشاطها.
ويعتبر الكتاب أن شبه جزيرة سيناء هي المصدر الرئيسي للإرهاب والتمرد المسلح في مصر. ويعزو ذلك إلى إهمال الحكومات المصرية المتعاقبة لسيناء وتجاهل تنميتها، والنظر لسكانها بازدراء، إضافة إلى حرمانهم من حقوق المواطنة الكاملة.
كذلك فإن الحدود البرية المصرية مع كل من السودان وليبيا تمثل مشكلة بالنسبة للجيش المصري.
وإضافة لذلك، سرد الكاتب عددًا آخر من التهديدات غير التقليدية، مثل النزاع مع السودان على مثلث حلايب وشلاتين، والأمن المائي الذي يواجه خطرًا بسبب سد النهضة الإثيوبي، وكذلك النزاع على ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، علاوة على شعور مصر بقلق إزاء التهديدات الأمنية في خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وذلك بسبب تورط إيران في اليمن وتهديدات وكلائها المسلحين. كذلك فإن أحد التهديدات الأمنية غير التقليدية بالنسبة لمصر هو العلاقات مع تركيا، حسب الكاتب.
متطلبات إظهار القوة في المنطقة
لدى المسؤولين المصريين -وفقًا للكتاب- قناعة بأن الدبلوماسية لا يمكن لها النجاح ما لم تكن مصحوبة بقوة عسكرية. ولذا يمارس الجيش نوعًا مختلفًا من الدبلوماسية، أسماها الكتاب “الدبلوماسية العسكرية”، وذلك بهدف تحقيق الردع واحتواء التهديدات.
ونظرًا لافتقار مصر للموارد الاقتصادية التي تؤهلها للانخراط فيما يمكن تسميته بــ “دبلوماسية الشيكات”، يعد الدور الدبلوماسي للجيش المصري حيويًا ورئيسيًا من وجهة نظر قادته، بالرغم من امتلاك مصر بعض جوانب القوة الناعمة، من خلال ثقافتها وفنها وتاريخها ووسائل إعلامها.
ورغم امتناع مصر على مدار عقود متتالية من استخدام قوتها خارجيًا، وتركيزها بدلًا من ذلك على التهديدات المباشرة لحدودها، إلا أنها طورت قدراتها خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أشار الكاتب إلى تصريح السيسي بأن البلاد يجب أن تكون قادرة على إرسال قوات لمساعدة دولة عربية أخرى، مؤكدًا أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري.
ويعزو الكاتب التطورات الأخيرة التي طرأت على القوات المسلحة المصرية إلى استهداف قادتها تعزيز مكانتها الإقليمية ودبلوماسيتها العسكرية، أكثر من كونها تهدف لحماية مصر من التدخلات الأجنبية.
وجدير بالذكر أن مصر تحاول إبراز دبلوماسيتها العسكرية في عدد من مناطق الإقليم، لا سيما في حوض النيل والقرن الإفريقي، حيث تحاول مواجهة التحركات التركية ومواجهة إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو التهديد الأمني الأكثر إلحاحًا لمصر، وفق المؤلف.
وقد أسفرت هذه الجهود الدبلوماسية عن مواقف عسكرية مشتركة وسلسلة من الاتفاقيات الأمنية للتعاون والتنسيق العسكري مع دول حوض النيل، مثل بوروندي وكينيا والسودان وأوغندا، فضلًا عن اتفاقيات أخرى لتبادل المعلومات الاستخباراتية أو ضمان الحياد في حالة نشوب حرب مع إثيوبيا.
ولذا، يتضح -وفقًا للكاتب- أن العلاقات المصرية بحوض النيل باتت أقرب مما كانت عليه منذ عقود.
وحول احتمالية استخدام مصر خيارًا عسكريًا للتعامل مع سد النهضة الإثيوبي، ذكر الكتاب أنه بالرغم من قدرة الجيش المصري -نظريًا- على توجيه ضربة أحادية الجانب للسد من خلال قواتها الجوية أو عبر قوة سودانية مصرية مشتركة، إلا أنه استبعد قدرة الجيش على تنسيق وتنفيذ مثل هذا الهجوم.
كما استبعد أن يخاطر النظام المصري بذلك، لاحتمال حدوث انتكاسة عسكرية -حال مواجهة السد عسكريًا- تكون خطرًا على القيادة السياسية المصرية، التي استندت إلى حد كبير في شرعيتها المحلية والإقليمية إلى صورتها المتمثلة في امتلاك جيش قوي.
ويمكن النظر إلى المناورات والاستعراضات والتدريبات التي تنفذها القوات المصرية بالاشتراك مع دول أخرى على الأصعدة المختلفة، شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا، في إطار إبراز القوة المذكور أعلاه.
وقد سرد الكتاب بعض التفاصيل حول قدرات الجيش المصري، سواء من حيث نوعية الأسلحة المتوفرة لديه وعدده وإمكانياته وجهوزيته، أو من
حيث التدريبات التي يخضع لها، والتكتيكات التي يمارسها في مناوراته العسكرية.
ومن ثم يؤكد الكاتب أن مصر استخدمت هذه القدرات من أجل تعزيز دبلوماسيتها العسكرية، وهو ما أدى إلى شراكات أمنية مع اليونان وقبرص في البحر المتوسط، وكذلك تحالفها مع السعودية في البحر الأحمر. لكنه يستدرك فيصف هذه الشراكات بأنها -في الغالب- “أوهام عسكرية”، مؤكدًا عدم استعداد مصر لاستخدام القوة الفعلية إلا بشكل محدود للغاية.
الفصل الثاني: تقييم العلاقات العسكرية الثنائية
اهتم هذا الفصل بذكر تفاصيل العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر، منذ اتفاقية كامب ديفيد، وحتى قبيل ثورة 2011. تاركًا الحقب الزمنية اللاحقة للفصلين الثالث والرابع.
يذكر الكاتب أن مصر أصبحت شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة بعد اتفاقية كامب ديفيد. وتستند هذه الشراكة -من وجهة النظر الأمريكية- على المصالح المشتركة، المتمثلة في تعزيز الاستقرار في مصر والمنطقة، إضافة إلى الحفاظ على السلام مع إسرائيل، ومواجهة الإرهاب والتطرف الإقليمي.
وتولي الولايات المتحدة أهمية للاستقرار في مصر، حيث ترى أن عدم استقرارها قد يهدد السلام مع إسرائيل، أو يؤدي إلى موجات هجرة غير شرعية إلى أوروبا، فضلًا عن أنه قد يهدد حياة ما يزيد عن 82 ألف مواطن أمريكي يعيشون على الأراضي المصرية.
وبالرغم من أن مصر لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها حين وُقعت الاتفاقية، إلا أنها لا تزال بوابة مهمة لإفريقيا وآسيا وأوروبا، نظرًا لتاريخها وحجمها وموقعها الاستراتيجي.
وحول مكاسب الولايات المتحدة من علاقاتها مع مصر، أشار الكاتب إلى أن أولوية المتحدة أثناء عقد اتفاقية كامب ديفيد، كانت إخراج مصر من تبعات تحالفاتها مع الاتحاد السوفيتي خلال حقبة الباردة، فضلًا عن إنهاء الحرب بين مصر وإسرائيل.
ومن الممكن القول إن السلام مع إسرائيل يعد النتيجة الأساسية الأبرز والأكثر ديمومة للعلاقات الأمريكية المصرية، حسب وصف المؤلف.
كما أن السماح للمركبات العسكرية الأمريكية باجتياز الأراضي والمجالات الجوية المصرية يعد أحد المكاسب الرئيسة الناتجة عن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر. حيث إن حرمان الولايات المتحدة من هذه الميزة كان سيضطرها إلى المرور عبر طرق ومسالك أكثر طولًا وكلفة زمنية ومادية ولوجستية.
ومن المهم الإشارة إلى تحذير الكتاب من الاستخفاف بعمل الجيش الأمريكي مع مصر. فمصر ليست بعيدة عن قطع الطريق على أسطول الولايات المتحدة من المرور عبر قناة السويس، التي تخدم 12 بالمئة من التجارة العالمية، مذكرًا بما حدث في خمسينيات القرن الماضي، حين رفضت مرور السفن التي تحمل شحنات إسرائيلية عبر القناة.
كذلك أورد الكتاب إحصاءات حول العدد الكبير للأساطيل العسكرية البحرية والطائرات العسكرية الأمريكية التي سهلت لها مصر مهماتها في المنطقة، والتي ما كانت لتكون على هذا الحال لولا العلاقة الجيدة مع الحكومة المصرية.
وفيما يتعلق بالتطرف الإقليمي، يرى الكتاب أن مصر تعمل على مواجهة التدخل الإيراني في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز علاقاتها مع الدول ذات العلاقات الوطيدة مع إيران، مثل لبنان والعراق. لكنها -مع ذلك- تدعم بقوة خفض التوتر الإقليمي مع طهران، وتعارض أي توجه من شأنه تصعيد التوتر معها.
كما لفت منوهًا غير مرة إلى أن المصالح المصرية لا تتماشى مع المصالح الأمريكية بشكل مستمر. فعلى سبيل المثال، كان الموقف المصري تجاه
الأزمة الليبية مخالفًا للموقف الأمريكي. وبالرغم من دعم مصر للجنرال خليفة حفتر، إلا أنها سعت في نفس الوقت إلى حل سياسي للصراع، ولذا تعتقد الولايات المتحدة أن لمصر دورًا إيجابيًا في تحقيق وقف إطلاق النار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، حسب الكاتب.
العلاقات العسكرية والمعونة الأمريكية
لطالما كانت العلاقات العسكرية الثنائية هي الشق الأقوى من العلاقة الشاملة بين الولايات المتحدة ومصر. وقد بدأ توسع هذه العلاقة منذ كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وهو ما استفادت منه أمريكا من خلال استتباب حالة السلام بين مصر وإسرائيل، وتحجيم النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط.
ولعل العمود الرئيس للعلاقات العسكرية الثنائية بين الجانبين هو المعونة الأمريكية لمصر، والتي حددت بمبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا منذ عام 1978. وتعد مصر ثانى أكبر متلق للمعونة الأمريكية بعد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى عكس الاعتقاد الشائع في مصر، لا تعد المعونة العسكرية جزءًا من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، حيث تخضع هذه المعونة سنويًا لتقييم وموافقة الكونغرس الأمريكي. كما أنه لا يوجد اتفاق رسمي ينص على أن الولايات المتحدة ستزود مصر بمبلغ معين خلال فترة محددة، بالرغم من وجود اتفاقات أمريكية رسمية مع كل من إسرائيل والأردن بهذا الصدد.
كما أشار الكاتب إلى حقيقة أن مصر لا تستلم هذه المعونة نقدًا، لكنها تستلمها في شكل معونات ومنح ومعدات عسكرية.
موضحًا استياء الولايات المتحدة من اكتفاء مصر بما تقدمه لها الحكومة الأمريكية من معدات وأسلحة، وعدم شراء أي معدات أمريكية أخرى بأموالها الخاصة، لكنها -في ذات الوقت- تستخدم تلك الأموال لشراء معدات عسكرية من الدول الأخرى.
وفي سياق بعض التسهيلات التي منحتها الحكومة الأمريكية لمصر، تمكنت الأخيرة من الحصول أسلحة من الشركات الدفاعية الأمريكية بقيم تفوق قيمة المعونة الأمريكية، لكن تلك الشركات وافقت على ذلك، بافتراض أن الكونغرس سيواصل تخصيص المعونة السنوية لمصر.
ووفق الكاتب، فإن ذلك سيسبب خطرًا كبيرًا على الحكومة الأمريكية إذا قرر الكونغرس رفض تخصيص 1.3 مليار دولار لمصر (قيمة المعونة). حيث تنص العقود بين الشركات الأمريكية ومصر على وجوب دفع الأخيرة تكلفة هذه الأسلحة، حتى لو توقفت المعونة الأمريكية. كما نصت العقود أيضًا على أنه إذا لم تتمكن مصر من دفع التكلفة، أو حتى امتنعت عن الدفع ردًا على وقف المعونة، ستضطر حينها الحكومة الأمريكية لدفع مستحقات الشركات الأمريكية. وهذه البنود بدورها، أعطت لمصر قدرًا معينًا من النفوذ على الولايات المتحدة، حسب مؤلف الكتاب.
القيود المفروضة
تعد أحد القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على نفسها، وهي تورد معدات وأسلحة لمصر، هو الالتزام بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. حيث تسعى أمريكا إلى ضمان قدرة الكيان المحتل على هزيمة
أي تحالف من الدول العربية لديه فرصة التشكل لمواجهة إسرائيل، والذي سيكون -وفقًا للتاريخ- عبارة عن دولتين إلى ثلاث دول متاخمة للحدود الإسرائيلية حال تشكُّله.
ولذا تلتزم الإدارة الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير مفصل عن سياستها في هذا الصدد للكونغرس الأمريكي، لضمان عدم تأثير مبيعات الأسلحة الأمريكية لدول الشرق الأوسط على التفوق النوعي العسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويوضح الكاتب أنه بالرغم من أن مصر وإسرائيل تجمعهما معاهدة سلام، لكن لطالما رفضت واشنطن أو تباطأت عمدًا عن منح مصر أسلحة أو معدات حديثة، في الوقت الذي سمحت فيه بمنح ذات المعدات لدول عربية أخرى لا يجمعها سلام مع إسرائيل.
ومن القيود التي ذكرها الكاتب أيضًا على المعونة الأمريكية ومشتريات الأسلحة، هي اشتراطات الكونغرس على الحكومة المصرية في بعض الأحيان لإحداث إصلاحات سياسات أو أمنية، مثل تعزيز حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية، وبذل جهود إضافية للحد من عمليات التهريب العابرة للحدود، عبر إحكام السيطرة على الحدود.
لكن الكاتب يقدم هنا مقاربة نقدية لهذه السياسة، حيث أوضح أنه بالرغم من الاشتراطات المتعددة التي قدمها المسؤولون الأمريكيون لنظرائهم المصريين، والتي تذكر الإجراءات التي يجب على مصر فعلها نظير حصولها على المعونة، إلا أن القوات المسلحة المصرية عادة ما سارت وفقًا لنظمها وطرقها الخاصة، وحسب ما تراه يحقق أهدافها ويضمن مصالحها. كما أن المسؤولين المصريين أبدوا -في كثير من الأحيان- استياءهم من التوجيهات أو النصائح الأمريكية، معتبرين ذلك انتهاكًا للسيادة المصرية، وفق الكاتب.
ولفت الكاتب إلى أن المعونة الأمريكية العسكرية ليست الوجه الوحيد للتعاون مع مصر، بالرغم من أن المعونة هي أشهر أداة للتعاون بين الطرفين.
حيث يوجد عدد من البرامج العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر، منها عدد من برامج الإنتاج المشترك التي تساهم في إنتاج معدات عسكرية في مصر.
إضافة إلى إجراء مجموعة متنوعة من التدريبات والمناورات المشتركة على مدار سنوات، ولعل أكثرها شهرة مناورات “النجم الساطع” التي تُقام كل عامين، ولا تزال جزءًا أساسيًا في العلاقة بين الجانبين.
وفي ذات السياق يأتي برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، والذي يعد منحة أخرى تقدمها الولايات المتحدة سنويًا لمصر. حيث يستخدم هذا التمويل لإرسال ضباط مصريين إلى الدورات العسكرية الأمريكية لتحسين قدراتهم العسكرية وتطوير علاقاتهم المهنية والشخصية، فضلًا عن تعريضهم للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية في الحملات العسكرية، وشؤون الحكم.
لكن الكاتب ذكر أن فعالية هذا البرنامج -في غرس القيم الديمقراطية وإقامة الروابط الاجتماعية- محدودة للغاية.
موضحًا أن السبب هو حظر وزارة الدفاع المصرية للاتصالات الاجتماعية بين الضباط الأمريكيين ونظرائهم المصريين عقب عودتهم إلى ديارهم، خوفًا من حصول الضباط الأمريكيين على معلومات استخبارية تتعلق بأعمال القوات المسلحة، أو محاولة تلقين المصريين بالأفكار والقيم الأمريكية.
هذا إضافة إلى منع الضباط المصريين -المنوط بهم إدارة العلاقات مع البنتاغون- من إجراء اتصالات ودية اجتماعية مع نظرائهم الأمريكيين خارج العمل الرسمي.
وفوق ذلك، تمثل المنحة -من وجهة نظر الضباط المصريين- فرصة للسفر والتنزه وقضاء العطلات، والتسوق وشراء الهدايا لأصدقائهم وعائلاتهم من الولايات المتحدة.
وجهات النظر الأمريكية والمصرية للعلاقة
وأوضح الكاتب أن لكل من مصر والولايات المتحدة وجهة نظر خاصة حول العلاقات الأمريكية المصرية في المجال العسكري بشكل عام، والمعونة بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هذه الآراء تكون متباينة في كثير من الأحيان.
حيث تنظر مصر إلى المعونة على أنها مدفوعات مستحقة مقابل خدمات تقدمها للإدارة الأمريكية، وبالتالي فإن لديها شعور داخلي بالاستحقاق، وأن هذه المعونة تُدفع نظير اتخاذها قرارًا بمخالفة الإجماع العربي وعقد السلام مع إسرائيل.
وبناء على هذا الشعور، افترضت مصر أن واشنطن لن تطلب أكثر من مجرد السلام مع إسرائيل مقابل المعونة، بل واعتقدت أنه ليس من حقها فعل ذلك بالأساس. ولذا تتجنب القيادة العسكرية المصرية دائمًا المناقشات المتعلقة بمواضيع لا تروق لهم، مثل إعادة الهيكلة العسكرية أو الإصلاح السياسي.
وذكر الكاتب مفارقة سببت استياءً لدى الأمريكيين. وهي أن المعونة أفادت مصرَ، من خلال منحها ما تحتاجه لتحديث معداتها وأسلحتها، وسعت جاهدة للحصول على أقصى ما يمكن الحصول عليه من المعونة. لكن في المقابل، استخدمت مصر -بعد ذلك- أموالها الخاصة لشراء معدات وأسلحة من بلدان أخرى.
ولفت المؤلف إلي أن مصر قبلت المعونات نظرًا للمصالح التي تتحصل عليها، بالرغم من وجود تشكك لديها وانعدام ثقة تجاه الولايات المتحدة.
أما بالنسبة لوجهات النظر الأمريكية، فإن هناك وجهات نظر متضاربة ومتعارضة حول الهدف من المعونات العسكرية بالأساس.
حيث كان هناك هدفان رئيسيان من المعونات العسكرية – وفق الكاتب- أولهما توطيد السلام المصري الإسرائيلي وتعزيز العلاقات الأمريكية المصرية لا سيما العلاقات العسكرية، وثانيهما إبقاء مصر خارج المدار السوفيتي. وعلاوة على ذلك، توقعت الولايات المتحدة أن تدعم مصر المصالحَ الأمريكية في المنطقة، أو على الأقل لا تعارضها.
وكميزة إضافية، منحت المعونة الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى صناع القرار المصريين وفرصة لتقديم المشورة، والتي وصفها الكاتب بأنها لم تكن مقبولة دائمًا بالنسبة للمصريين. كذلك أعطت الولايات المتحدة قدرًا صغيرًا من النفوذ والتأثير على الجيش، المؤسسة المصرية الأكثر أهمية، لكنها في الوقت ذاته الأقل تفهمًا ومرونة.
لكن بمرور الوقت تطورت وجهات نظر أخرى حول المكاسب التي ينبغي أن تجلبها المعونة لصالح الولايات المتحدة. ففي الثمانينيات، كان الحفاظ على السلام مع الجيش المصري التقليدي الضخم مهمًا؛ لأن مصر كانت آنذاك خارج المدار السوفيتي، ويمكن أن تكون جزءًا من تحالف أمريكي ضد السوفييت.
لكن مع فترة السلام الطويلة مع إسرائيل، ونهاية الحرب الباردة، ومجيء الحرب على الإرهاب، أراد بعض صانعي السياسة الأمريكيين من مصر أكثر من مجرد الحفاظ على السلام مع إسرائيل، مثل إعادة هيكلة القوات المسلحة المصرية، لتصبح أكثر قدرة على مواجهة التهديدات غير التقليدية، وكذلك تحقيق الإصلاح السياسي في مصر.
كذلك طفت على السطح -حسب الكاتب- أسئلة شائكة تتعلق بكيفية توافق المصالح الأمنية الأمريكية مع مصر، مع القيم الأمريكية المتمثلة في نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وإثر ذلك، نشأ عدد من المدارس الفكرية حول الغرض من المعونة:
- تعتقد المدرسة الأولى أن المساعدات كانت تهدف للحفاظ على العلاقة مع مصر، وبالتالي القدرة على الوصول إلى القادة المصريين في أوقات الأزمات، ومساعدة مصر على تطوير قوتها.
وقد فضلت هذه المدرسة تقليل القيود والمشروطيات على المعونات الأمريكية، والسماح بحصول مصر على ما تريد، وذلك لصالح كسب ولاء القادة المصريين.
- تعتقد المدرسة الثانية ضرورة استخدام المساعدات لتحويل القوات المسلحة المصرية إلى قوة يمكنها مواجهة التهديدات غير النظامية، مثل التهريب والإرهاب.
وقد سعت هذه المدرسة إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة، ومنع مصر من التركيز بشكل مفرط على إسرائيل باعتبارها التهديد الرئيسي لها.
- تؤمن المدرسة الثالثة بضرورة استخدام المساعدات كوسيلة ضغط لتحقيق الإصلاح السياسي والأمني في مصر.
وذلك من خلال وضع قيود واشتراطات فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات بما يتماشى مع القيم الأمريكية. وحال لم تحقق مصر معايير معينة تتعلق بكل منها، فسيتم حجب المساعدات.
تعاملت المدرستان الفكريتان الأخيرتان مع مصر باعتبارها دولة من شأنها الانحناء بشكل كامل لإرادة الولايات المتحدة، سواء من خلال إعادة تشكيل القوات المسلحة، أو الإصلاح السياسي الشامل وتعزيز الديمقراطية.
لكن الواقع -وفقًا لما ذكره الكتاب- يفيد أن مصر تدعم مواقف الولايات المتحدة وتقف في صفها حين يكون ذلك في صالحها فقط. مشيرًا إلى أن مصر ستواصل مقاومة أي محاولة لتكييف أو استخدام المعونة لفرض أجندات أو سياسات لا تريدها، حيث إنها -كما ذكر سابقًا- ترى أن المعونة مدفوعات مستحقة مقابل خدماتها.
وفي ذات السياق، عدّد الكاتب بعض الإحباطات التي واجهت الأمريكيين في تعاملهم مع القوات المسلحة المصرية. منها ضعف الأداء المصري، قبل ثورة 2011، في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
إضافة إلى غضب الضباط الأمريكيين -الذين عملوا عن كثب مع الضباط المصريين- من شعور القادة المصريين باستحقاق المعونة، ورفضهم أخذ المشورة الأمريكية. كما كان يُنظر -في المؤسسات الأمريكية- إلى القوات المسلحة المصرية باعتبار أنها في تراجع ومتصلبة ومقاومة لأي تغييرات.
هذا علاوة على انتهاكات مصر المتكررة -وفق وجهة النظر الأمريكية- فيما يتعلق باستخداماتها للمعونة، وهو ما أثار استياء الأمريكيين. فعندما تبيع الولايات المتحدة معدات دفاعية، ينبغي أن يلتزم المشترون بشروط استخدام هذه المعدات لأغراض معينة فقط.
فعلى سبيل المثال، لا ينبغي أن تَعرض مصرُ الأسلحةَ الأمريكيةَ على عناصر ثالثة نظرًا لما تحتويه من تكنولوجيا حساسة. لكن يعتقد الأمريكيون أن مصر انتهكت هذه القاعدة 6 مرات في غضون 3 سنوات قبل عام 2009. كما وردت أنباء تفيد أن الجيش المصري سمح لمسؤولين عسكريين صينيين بفحص طائرات إف – 16 أمريكية الصنع في إحدى القواعد الجوية المصرية، وفق الكاتب.
وأخيرًا، كان هناك إحباطان آخران بالنسبة لواشنطن، متعلقان باستخدام الحكومة المصرية لأموالها لشراء الأسلحة من بلدان أخرى، فضلًا عن دور القوات المسلحة في الاقتصاد المحلي.
وقد أشار الكتاب إلى أن الولايات المتحدة أساءت تقدير دور القوات المسلحة في المجتمع المصري، كما أنها أخفقت في تقدير مدى القدرة الأمريكية على الضغط من أجل إحداث إصلاحات سياسية داخل مصر.
الفصل الثالث: علاقة انتقالية منذ الربيع العربي
الثورة المصرية عام 2011 وما بعدها
لم تتوقع مصر ولا الولايات المتحدة حدوث تغيير كبير جراء دعوات التظاهر المناهضة للحكومة في 25 يناير 2011، حسبما ذكر الكتاب.
لكن بعد العنف الذي استخدمته أجهزة الشرطة بداية أيام التظاهر، وعدم استجابة الجيش لإطلاق النار على المتظاهرين، من الممكن القول -حسب الكاتب- إن عدم رغبة الجيش في دعم الحكومة كان السبب الرئيس في نجاح الثورة.
ورغم تأكيد الكتاب بأن الولايات المتحدة شجعت الجيش للضغط على مبارك للتنحي عن السلطة، لكنه ينفي -في ذات الوقت- الاعتقاد بأن واشنطن هي من أثرت على تصرفات القوات المسلحة. حيث كان الهدف النهائي للجيش هو حماية دوره والحفاظ على امتيازاته ومصالحه الاقتصادية.
وفي بداية الفترة الانتقالية، أُشيد بالقوات المسلحة لعدم انحيازها إلى جانب مبارك. لكنها فقدت بعد ذلك شعبيتها نسبيًا جراء قمعها للمتظاهرين، وتباطئها في تنفيذ الإصلاحات وتسليم السلطة، حسب الكاتب.
وأفاد الكتاب من ملاحظاته، أثناء اجتماع لجنة التنسيق الإداري بين القوات المسلحة الأمريكية ونظيرتها المصرية إبان حكم الأخيرة بعد الثورة، أنه كان لدى المسؤولين الأمريكيين أمل في دفع القوات المسلحة المصرية للاستجابة للطلبات الأمريكية بإعادة هيكلتها بطريقة تبعدها عن الحرب التقليدية، وتجعلها أكثر قدرة على مواجهة التهديدات غير النظامية، إضافة إلى التأكيد على السيطرة المدنية على الجيش. لكنه عاد مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمسؤولين الأمريكيين حينها كان الحفاظ على العلاقة التقليدية بين الجانبين.
وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، ومع تأكد نجاح مرشح الإخوان المسلمين الرئيس محمد مرسي، أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا يمنح فيه نفسه سلطات واسعة.
وهو ما اعتبره الكاتب محاولة من الجيش للحفاظ على السلطة والحد من سلطات جماعة الإخوان المسلمين. لافتًا إلى أنه بالرغم من تعهد القوات المسلحة بالولاء لمرسي، إلا أنه عندما أتيحت الفرصة، تحرك الرئيس لمجابهة سلطة الجيش.
وكرر الكاتب إيضاح الخطأ الذي وقع فيه الأمريكيون، حين اعتبروا أن العلاقة العسكرية الطويلة مع مصر منحتهم نفوذًا شجع الجيش المصري على تجنب إطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة، إضافة إلى اعتقادهم أنهم أثروا على قيادتها إلى حد ما لإجبار مبارك على التنحي.
لكن كل هذه الاعتقادات غير صحيحة، فالقوات المسلحة لم تستمع لنصائح الولايات المتحدة، لكنها تحركت فقط وفقًا لما تقتضيه مصالحها الخاصة.
وأكد الكتاب أن القوات المسلحة أعلنت ظاهريًا تجاوبها مع مطالب الشعب وتصرفها وفقًا لذلك، لكن الحقيقة هي أنها فعلت الأفضل بالنسبة لها لتحافظ على مكانتها ودورها.
وبعد الثورة ووصول مرسي للسلطة، حاولت الولايات المتحدة الحفاظ على التعاون العسكري مع مصر. وعلى الجانب الدبلوماسي، تواصل المسؤولون الأمريكيون مع من كان في السلطة، سواء كان المجلس العسكري أو الرئيس مرسي.
وبعد انتخاب مرسي، ركزت واشنطن -حسب الكتاب- بشكل أكبر على تعزيز الديمقراطية في مصر، ما أدى إلى تجدد النقاش الأمريكي الداخلي حول الغرض من المساعدات العسكرية، وتحقيق التوازن بين المصالح الأمنية الأمريكية والقيم الإنسانية الديمقراطية.
لكن ذلك أدى -في المقابل- إلى هجمات إعلامية على الولايات المتحدة من خلال الأطراف المناهضة للحكومة المصرية المنتخبة، وأشيع أن الولايات المتحدة تدعم صعود جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كما اعتبر البعض توجهات الولايات المتحدة تدخلات في الشأن الداخلي المصري.
وبعد أوامر السيسي باعتقال الرئيس مرسي وتعليق العمل بالدستور، كان الجدل الرئيس حينها هو ما إن كان ما حدث انقلاب عسكري، أو ثورة شعبية استجابت لها القوات المسلحة، على غرار عام 2011.
وتبع ذلك اشتباكات بين مؤيدي مرسي وأنصار السيسي، بلغت ذروتها حين هاجمت القوات المسلحة والشرطة المصرية اعتصامين مؤيدين لشرعية الرئيس مرسي في القاهرة، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 1150 مصريًا. وقد اعتُبرت هذه الحادثة أسوأ عملية قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث، أعقبها حملات قمع جماعية للإخوان وأنصارهم.
وفي ظل الانسداد السياسي، حسب وصف الكاتب، فاز السيسي بنسبة 97 بالمئة في الانتخابات الرئاسية عام 2014، ولم يشارك من المصريين في هذه الانتخابات سوى 35-47 بالمئة ممن لهم حق المشاركة.
واعتبر الكاتب أن الحكومة المدنية التي عينها السيسي بعد وصوله للحكم لم تكن إلا مجرد واجهة لسلطة القوات المسلحة المصرية. وقد زادت هذه
الحكومة إجراءات إغلاق الفضاء العام، وحظر حرية التعبير وحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما أنها أضعفت فعالية المجتمع المدني.
مضيفا أن حكومة السيسي أقسى من حكومة مبارك. لكنه استدرك مؤكدًا أن العديد من المصريين يفضلون ما يحدث حاليًا على ما يحدث في دول أخرى حولهم.
العلاقة ما بعد مرسي
وبعد عزل مرسي، في 3 يوليو 2013، أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بيانًا أعرب فيه عن قلقه إزاء تصرفات القوات المسلحة وتعليق العمل بالدستور، ودعا الجيش إلى إعادة السلطة بسرعة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًا، والامتناع عن اعتقال مؤيدي مرسي.
لكن الولايات المتحدة لم تحدد في بياناتها ما إن كان ما حدث انقلابًا عسكريًا أم لا.
وقد عزا الكاتب ذلك إلى أنه حال التحديد بأنه انقلاب، ستُلزَم الحكومة الأمريكية وفقًا للقانون بحظر المساعدات العسكرية لمصر، باستثناء دفع تكاليف إنهاء العقود التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الشركات الأمريكية، كما ذكر أعلاه.
كما علقت إدارة أوباما تسليم 4 طائرات من طراز إف-16 لمصر. وقد كثفت هذه الأحداث النقاش الأمريكي الداخلي حول المعونات الأمريكية لمصر.
وبعد فض رابعة والنهضة بيوم، أدان أوباما العنف في مصر، ودعا الحكومة المؤقتة إلى احترام حقوق الإنسان، كما ألغى تدريبات النجم الساطع، وقال إنه من غير الممكن مواصلة التعاون التقليدي مع مصر. كذلك أجلت الإدارة اجتماعات لجنة التنسيق الإداري، التي كان مقررًا عقدها في أكتوبر/ تشرين الأول 2013.
وفي 9 أكتوبر 2013، أعلنت الإدارة الأمريكية نتيجة مراجعاتها للمعونة المقدمة، وقالت إنها ستركز على المصالح المشتركة فقط، المتمثلة في أمن الحدود والأمن البحري والأنشطة المتعلقة بتأمين سيناء.
كما علقت تسليم بعض الأسلحة التي لا تدخل في نطاق المصالح المشتركة، وكذلك جعلت تسليم المعونة أو أجزاء منها في المستقبل مشروطًا بتقدم مصر نحو الديمقراطية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار بتعليق تسليم أسلحة لمصر عبر الإدارة التنفيذية الأمريكية، وليس عبر الكونغرس كما جرت العادة.
وبحلول ربيع عام 2014، وبالتزامن مع تدهور الوضع في سيناء، طلبت مصر مرارًا وتكرارًا أن تُمكنها الولايات المتحدة من استخدام طائرات أباتشي لمحاربة الإرهابيين، وكان الضغط قويًا في هذا الصدد بشكل خاص من إسرائيل، لكن الأباتشي لم تصل إلى مصر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، كونها مطلوبة لمكافحة الإرهاب، لكن استمر تعليق عناصر المعونة الأخرى.
وكرر الكتاب تأكيده أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارًا علنيًا بشأن ما إن كانت أحداث مصر انقلابًا أم لا. لكنها -بالرغم من ذلك- قررت تعديل المعونة المقدمة إلى مصر، كما لو أنها قد حددت أنه انقلاب.
وقد تسببت هذه الإجراءات التنفيذية والتشريعية من قبل السلطات الأمريكية في إحداث صدمة لدى قيادات القوات المسلحة المصرية، الذين اعتبروا ذلك تغييرًا في الأسس الحاكمة للمعونة الأمريكية. فبعد أن كانت المعونة -من وجهة النظر المصرية- ثمنًا تدفعه أمريكا مقابل السلام مع إسرائيل فقط، بات المقابل هو السلام مع إسرائيل وتحقيق الديمقراطية، وهو ما سبب استياء لدى القادة المصريين، حسب الكاتب.
وبعد ذلك، لم يحصل المصريون على تمويل لأسلحة جديدة، فضلًا عن قطع الغيار والدعم والصيانة، ولم يبق لهم سوى الحفاظ على أنظمة الأسلحة القديمة. وقد أثر ذلك سلبًا على المعدات العسكرية لدى الجيش المصري، وهو ما أدى إلى غضب كبار قادته، حسب الكاتب.
وقد تزامن ذلك مع تصعيد وتنامي الخطاب المناهض للولايات المتحدة داخل مصر، والترويج بأن تعليق الأسلحة ووضع القيود على القوات المسلحة المصرية سببه سياسة أوباما وإدارته الداعمة لجماعة الإخوان، حسب هذه المزاعم.
ووفقًا للكتاب، لم تؤد كل هذه الإجراءات الأمريكية -بغض النظر عن الهدف من اتخاذها- إلى تعزيز الديمقراطية في مصر، بل ازداد الوضع سوءًا، وارتفعت مستويات القمع، وتدهورت الأوضاع الأمنية في سيناء.
لكن في المقابل، كان الوضع في مصر آنذاك -من وجهة نظر بعض صانعي السياسة الأمريكيين- أفضل من أوضاع دول أخرى في المنطقة، في إشارة إلى سوريا والعراق واليمن وليبيا.
وأكد الكاتب إلى أن إسرائيل أرادت مصر المستقرة أكثر من مصر الديمقراطية، كما ضغط الاحتلال على الولايات المتحدة، باعتبار أن السلام مع مصر قائم على الدعم العسكري الأمريكي، وأعرب المسؤولون الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا للكونغرس والإدارة الأمريكية عن مخاوفهم بشأن الحد من التعاون العسكري الأمريكي المصري.
بدورهم، أكد القادة المصريون أن المسؤولين الأمريكيين لا يفهمون الوضع مصر، معتبرين أن الأمريكان لديهم فهمًا محدودًا فيما يتعلق بمفهوم الإرهاب، كما طالبوا بأن تتوسع الحرب الأمريكية ضد الإرهاب لتشمل جماعة الإخوان المسلمين. كما اعتبروا أن حربهم ضد الجماعة –
التي روجوا أنها داعمة لكافة أشكال الإرهاب الإسلامي- معركة وجودية من أجل البقاء.
وفي هذه الظروف، وبغض النظر عما تريده الولايات المتحدة، يعتقد الكتاب أن ذلك لن يغير أبدًا السلوك المصري.
وبالرغم من القيود الأمريكية، لعبت مصر دورًا مهمًا في العلاقات بين إسرائيل وحماس في حرب غزة عام 2014، كما أيدت التحالف الأمريكي ضد تنظيم داعش عام 2015. كذلك واصلت القاهرة تقديم دعمها التقليدي للولايات المتحدة، من خلال السماح بمرور السفن عبر قناة السويس، وفتح الأجواء الجوية للقوات الأمريكية، لكن القاهرة ألمحت غير مرة إلى أنه إذا استمر الوضع الذي كان قائمًا حينها، فقد تتوقف هذه المكاسب، حسب الكتاب.
مصر تتحول إلى شركاء جدد
وبعد سنوات من الرفض الأمريكي للسماح بشراء أسلحة متقدمة، إضافة إلى الموقف الأمريكي عقب يوليو/ تموز 2013، خلصت مصر إلى أنه لم يعد بإمكانها السماح لدولة واحدة باحتكار أمنها القومي، وقررت إعادة التوازن إلى علاقاتها الدولية.
وبالرغم من تفضيلها للأسلحة الأمريكية، يرى الكاتب أنه لم يكن لدى مصر خيار آخر سوى اللجوء للآخرين وتنويع مصادرها، وذلك بسبب شعور القادة المصريين أن الولايات المتحدة شريك غير موثوق به.
ومع أن الدول الأخرى لن تقدم نفس مستوى السلاح الأمريكي، لكنها أيضًا لن تطبق نفس المستوى الذي تطبقه واشنطن فيما يتعلق بالتدقيق المتكرر على سجلات حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.
وبذلك، أرسلت مصر -حسب الكتاب- رسالة مفادها أن خضوعها للولايات المتحدة قد انتهى، وأنها لن تخضع بعد الآن للضغوط الأمريكية.
ولبيان الدلالة الرقمية على ما حدث، أوضح الكاتب أن الولايات المتحدة كانت مصدر السلاح الأول لمصر، بين عامي 1980 و2014. لكن تبدل الحال بعد هذا الوقت، ففي الفترة من 2016-2020، شكلت الأسلحة الروسية 41 بالمئة من واردات مصر، والأسلحة الفرنسية 28 بالمئة من واردات مصر، في حين لم تتجاوز الأسلحة الأمريكية 8.7 بالمئة من إجمالي الواردات.
ومن زاوية أخرى كانت التفاصيل الدقيقة لكيفية دفع مصر ثمن الأسلحة الجديدة من هذه الدول غير معلومة.
ويرجح الكتاب أن القوات المسلحة المصرية استخدمت في ذلك المنح الخليجية لمصر، المقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار بين عامي 2013 و2016. إضافة إلى القروض الفرنسية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.
ووقف الكتاب على العلاقة بين مصر ودول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات. وقد عارضت دول الخليج حكم مرسي، ودعمت السيسي، لكن شابت العلاقة توترات في بعض الأحيان بين السعودية والنظام المصري الحالي، حيث أرادت الأولى دورًا أكبر للأخيرة في اليمن، ونهجًا أكثر تشددًا مع إيران.
لكن وفقًا لتقييم الكتاب، تمكن السيسي من الحفاظ على بعض الاستقلال عن السعوديين. حيث رفض المشاركة البرية مع السعودية والإمارات في حرب اليمن، كذلك دعم بقاء رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في السلطة بالمخالفة لرأي شركائه الخليجيين آنذاك، كما اتبع سياسة منهجها تخفيف حدة التوترات مع إيران، فضلًا عن أنه بات ينظر للمساعدات الخليجية نظرة استحقاق، وهو ما ساهم في زيادة الخلافات.
وبغض النظر عن هذه التوترات، يقرر الكتاب أن الدعم الخليجي السخي لمصر قلل بشكل أكبر من النفوذ الأمريكي في مصر، حيث اتخذ السيسي
نهجًا مستقلًا عن واشنطن في سياسته الخارجية. وفي عام 2016، حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، ما سمح لها كذلك بتقليل اعتمادها على الخليج.
وبالنسبة للعلاقات المصرية مع روسيا، كان قرار التحول إليها سهلًا. وقد عزا الكاتب هذه السهولة إلى عدة عوامل؛ أولها أن روسيا كانت الراعي الرسمي للأسلحة المصرية بين عامي 1955 و1973. وثانيها أن روسيا -المنافس الرئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط- لم تفوت فرصة تعزيز مصالحها في المنطقة. هذا بالإضافة إلى أن السيسي يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه فهم حقيقي للشرق الأوسط ومسألة الإرهاب. كما أتت المساعدة الروسية خالية من أي شروط أو قيود، إلى جانب أن الأسلحة الروسية كانت أقل كلفة من نظيرتها الأمريكية. كذلك فإن مواعيد استلامها أسرع بكثير من مقابلتها الأمريكية. وقد توصل البلدان إلى اتفاق يسمح لكل منهما باستخدام قواعد الآخر ومجاله الجوي.
لكن يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 تسبب في تعقيد كبير للعلاقات العسكرية بين موسكو والقاهرة. فمع حدوث تحولات جيوسياسية عالمية غير واضحة النتائج، تحاول القاهرة السير على حبل دقيق مشدود بين موسكو والغرب. ونظرًا للعقوبات الغربية على موسكو، يُعتقد الآن أن مصر تعيد النظر تمامًا في صفقات الأسلحة مع روسيا، لا سيما صفقة مقاتلات الدفاع الجوي سو-35.
أما بالنسبة للعلاقات مع باريس، فقد صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوضوح أنه لن يضع شروطًا على المبيعات إلى مصر على أساس سجلها في مجال حقوق الإنسان، حيث إن هذه الشروط ستجبر مصر على اللجوء إلى روسيا والصين. كذلك طورت مصر علاقاتها العسكرية بدرجة أقل مع كل من الصين وألمانيا وإيطاليا.
في نهاية الأمر، من المهم -حسب الكتاب- إدراك أن مشتريات الأسلحة المصرية بوضعها الراهن تسببت في تغيير موازين القوى في المنطقة، وقد تؤثر على السلام (في المنطقة)، كما أنها كسرت احتكار الولايات المتحدة لتسليح الجيش المصري، الذي دام أكثر من 30 عامًا.
الفصل الرابع: نهج أمريكي جديد للعلاقات العسكرية الثنائية
في ربيع عام 2015، أعادت الولايات المتحدة المعونة العسكرية إلى مصر، لكن ببعض الشروط. أهمها أنه إذا لم يتمكن وزير الخارجية الأمريكي من الحصول على ما يشير إلى تقدم الديمقراطية في مصر، فستبقى المساعدات متاحة بالمعدل اللازم للحفاظ على العقود الحالية مع الشركات الأمريكية، والحيلولة دون إنهائها.
هذا بالإضافة إلى وجوب تشاور الوزير مع الكونغرس بشأن إعادة هيكلة المعونة العسكرية في المستقبل. لكن الشق الأهم، هو أن الوضع الجديد منح للوزير سلطة التغاضي عن متطلبات الديمقراطية، التي كانت مفروضة عامي 2014 و2015، ومنح المعونة لمصر، إن كان ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
وقد احتفت وسائل الإعلام المصرية الموالية الحكومة بعودة المساعدات، معتمدين رواية مفادها أن استئناف المعونة يعد انتصارا لمصر في جهودها للتغلب على الخضوع لأمريكا.
حيث اعتقد البعض من مؤيدي السيسي أن الولايات المتحدة دعمت في البداية جماعة الإخوان والإسلام السياسي في مصر، ولما فشلت، اضطرت إلى العمل مع السيسي.
وفي المقابل، شعر منتقدو حقوق الإنسان في مصر بالخيانة -حسب وصف الكتاب- بسبب تحول توجه الإدارة الأمريكية، التي قررت استئناف المعونة دون ربطها بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لكن السياق الحقيقي لقرار الإدارة الأمريكية مرتبط بعدة اعتبارات؛ منها قلق الولايات المتحدة آنذاك بشأن تدهور الأوضاع في المنطقة بشكل عام، وفي سيناء بشكل خاص. إضافة إلى إعلان مصر مشاركتها في العمليات التي قادتها المملكة السعودية في اليمن، إلى جانب أن العمليات الإيرانية كانت توسعت في المنطقة حينها، خصوصا في سوريا واليمن. كذلك فإن تحول مصر إلى شركاء آخرين كفرنسا وروسيا كان عاملًا مهمًا في القرار الأمريكي.
وقد جدد هذا القرار أيضًا النقاش الداخلي الأمريكي حول هذه المعونة وجدواها وأخلاقيتها.
ويجدر الذكر هنا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي حينها، جون كيري -حين حضر جلسة الحوار الاستراتيجي مع نظيره المصري، في أغسطس/ آب 2015، أي بعد استئناف المعونة- صرح بأن “العلاقة مع مصر لا تقوم على التوافق التام، ولكن على المصالح المشتركة مثل الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب”، كما أشار في ذات الوقت إلى أن “مصر لا يمكنها هزيمة الإرهاب ما لم تظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان”.
ووفقًا للكتاب، كان الهدف من هذا الحوار إعادة بناء العلاقة مع مصر. لكن بالرغم من الحوار واستئناف المعونة، فشلت تلك الجهود الأمريكية في تغيير وجهة نظر مصر حول السياسة الأمريكية. والحقيقة أن إجراءات الإدارة الأمريكية آنذاك أخفقت في نيل رضا كافة الأطراف، لا الكونغرس ولا القوات المسلحة المصرية، ولا أصدقاء أمريكا في المنطقة.
العلاقات المصرية خلال عهد ترامب
وبالرغم مما سبق، لا تزال مصر تنظر للولايات المتحدة باعتبارها الشريك الأهم بالنسبة لها، حتى مع تنويع مصادر أسلحتها.
وفي عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصفت العلاقات المصرية الأمريكية بأنها الأفضل على الإطلاق. حيث عملت إدارته على تحسين العلاقة مع مصر، وتكونت علاقة جيدة بين ترامب والسيسي. حيث اتصل الأول بالثاني خلال الأيام الثلاثة الأولى لتوليه منصبه، ودعاه إلى زيارة البيت الأبيض مرتين، بينما لم يفعلها سلفه أوباما على الإطلاق. كما أشاد ترامب عدة مرات بالسيسي، وتغاضى بشكل كبير عن انتهاكات حقوق الإنسان. وبالفعل، زادت شعبية الولايات المتحدة، وتحديدًا ترامب، في مصر أثناء هذه الفترة، وفقًا لاستطلاعات رأي أوردها الكتاب.
لكن بالرغم من ذلك، لم يتخذ ترامب خطوات فعلية في تغيير سياسات المعونة السابقة. وقد شعرت مصر -حسب الكتاب- بخيبة أمل، لأن العلاقات لم تتحسن بالقدر المتوقع في عهد ترامب.
وفي أي توتر شاب العلاقة آنذاك، ألقى المسؤولون المصريون وأذرعهم الإعلامية اللوم على الإدارة الأمريكية والكونغرس، وأعفوا ترامب نفسه من اللوم. وفي هذا السياق، سارع ترامب إلى إخبار السيسي بأن انقطاع المعونة وتخفيضها ووضع الشروط عليها كان تصرفًا خاطئًا.
وحتى على الصعيد الدولي، يؤكد الكتاب أنه لم تتطابق المصالح الأمريكية والمصرية دائمًا في هذه الحقبة بالرغم من تحسن العلاقات. وقد برز ذلك في تعزيز العلاقات مع روسيا، وعدم التوافق في الحرب الأهلية في ليبيا، ودعم السيسي لبشار الأسد، وتجاهل الطلب الأمريكي من مصر للمساهمة بقوات تحل محل القوات الأمريكية في سوريا. كما لم يقبل السيسي أيضًا المشاركة في جهود ترامب وإدارته لتشكيل تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط يناهض إيران، لأنه لا يريد تصعيد التوتر مع إيران. كما حافظت مصر على علاقات معززة مع كوريا الشمالية.
وأخيرًا، أكد الكتاب تمكن السيسي وترامب من المحافظة على علاقاتهما وثيقة، بالرغم من هذه المواقف المتضاربة بشأن بعض القضايا الدولية.
مصر السيسي
على الصعيد المحلي، وسع السيسي سيطرته بشكل كبير على مفاصل الدولة ومجتمعها المدني، وهو ما اعتبره الكتاب انجرافًا واضحًا نحو قدر أكبر من الاستبداد.
وتدليلًا على ذلك، أشار الكتاب إلى انتخابات عام 2018، حيث انتُخب السيسي لولاية ثانية في انتخابات كان خصمه الوحيد فيها مؤيدًا له، وتعرض آخرون سعوا للترشح للاعتقال والمضايقة. كما أجريت تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في منصبه حتى 2030، إضافة إلى تعديلات أخرى أدت إلى تآكل استقلال السلطة القضائية، والتضييق المشدد على منظمات المجتمع المدني وحرية التعبير والتجمع السلمي. فضلًا عن استخدام تعريفات فضفاضة للإرهاب، تمكن الدولة من استخدامها لاستهداف
المعارضين السياسيين والصحفيين والحقوقيين. كما أشار الكاتب إلى الأعداد الكبيرة للمعتقلين السياسيين والمختفين قسريًا في مصر.
وبهذه الصلاحيات الواسعة والإجراءات القاسية، بنى السيسي -وفق وصف الكتاب- الحكومة الأكثر وحشية في التاريخ المصري الحديث.
وتحت ضغط الانتقادات الدولية المتكررة بشأن حقوق الإنسان، أورد الكاتب أن نظام السيسي يحاول اتخاذ بعض الإجراءات، مثل إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان ورفع حالة الطوارئ، إلا أنها جميعا مجرد إجراءات تجميلية لا طائل حقيقي منها. وإن كان هناك تغيير، فهو أن حالة حقوق الإنسان ازدادت سوءًا منذ الإعلان عن هذين الإجراءين. ومن غير المرجح -وفق الكتاب- حدوث تغيير حقيقي فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، باستثناء الإفراج عن عدد قليل للغاية من المعتقلين قد تقدمه الحكومة لاسترضاء المجتمع الدولي.
مصر وإدارة بايدن حتى الآن (مايو/ أيار 2022)
أوضح الكتاب أن النظام المصري كان قلقًا من الإدارة الديمقراطية الحالية برئاسة جو بايدن، الذي انتخب نهاية عام 2020.
حيث واجهت مصر دومًا علاقة معقدة مع الإدارات الديمقراطية، في حين أن الجمهوريين عادة ما يدعمون مصر بسبب علاقتها مع إسرائيل. وبالفعل، بدت العلاقة في بداية عهد بايدن متوترة في أحيان، وفاترة في أحيان أخرى.
وفي المقابل، حاول السيسي آنذاك اتخاذ خطوات استباقية، حيث كان أول حاكم عربي يهنئ بايدن على فوزه في الانتخابات، واستأجرت القاهرة شركة علاقات عامة أمريكية للدفاع عن المصالح المصرية خلال إدارة بايدن مقابل 56 ألف دولار شهريًا. ومع ذلك، أدركت مصر أن الوضع لن يكون بهذه السهولة، وأن حقوق الإنسان ستكون أكثر أهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة.
وفي مقابل ذلك، تعاملت مصر بنوع من الإقدام والجرأة في هذا الإطار، حيث نظر مسؤولوها إلى أنهم قادرون على التعامل مع أي إدارة أمريكية.
ووفقًا للكتاب، لم تتحرك حالة التوتر أو الفتور هذه سوى في مايو/ أيار 2021، حين اندلعت حرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وحين سعت واشنطن للتفاوض، وجدت أن كل الطرق تؤدي إلى القاهرة، التي تملك علاقات متوازنة مع كل من حماس وإسرائيل. وقد تمكنت مصر بالفعل من الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار.
وحينها شكر بايدن السيسي علنًا، واتصل به مرتين خلال أقل من أسبوع. وقد أكد السيسي آنذاك على حاجة مصر إلى شراكة مثمرة مع الولايات المتحدة، وناقش ملف سد النهضة الإثيوبي والتوتر في ليبيا. في المقابل، شدد بايدن على أهمية إجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان.
وبعدها سافر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى القاهرة والتقى بالسيسي، وأشاد بدور مصر في وقف إطلاق النار، كما أكد أيضًا على ضرورة تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. كذلك ناقش المشرعون الأمريكيون دعوات خفض المعونة ووضع مشروطيات عليها، في حين كان أمل القاهرة آنذاك أن يساهم دورها في وقف إطلاق النار في غزة في تغيير وجهة النظر الأمريكية.
وقدمت واشنطن بالفعل عددًا من الخطوات الداعمة لمصر فيما يتعلق بمخاوفها الإقليمية الأكثر إلحاحًا.
حيث دعمت الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة، إضافة إلى الإشادة بموقفها في تمكين العملية السياسية الليبية، والتنديد بالتحركات التركية في شرق البحر المتوسط.
لكن بالرغم من ذلك، أكد الكاتب أن سجل القاهرة في حقوق الإنسان ظل قضية مركزية بالنسبة لواشنطن، لدرجة أن تل أبيب حذرت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا من أن الانتقاد المفرط للوضع في مصر قد يدفعها بشكل أكبر تجاه موسكو أو بكين، أو حتى طهران. حتى أن تل أبيب بدت مستعدة أيضًا إلى التنازل عن شروطها القديمة فيما يتعلق بتسليم الأسلحة لمصر، فمن الأفضل بالنسبة لها أن تمتلك مصر أسلحة أمريكية، بدلًا من الصينية أو الروسية.
لكن وبالرغم من هذه الضغوط، أعلنت الإدارة الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول 2021، حجب 130 مليون دولار من المعونة الأمريكية على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. إضافة إلى فرض شروط تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان على مبلغ 225 مليون دولار من المعونة.
وفي هذا السياق، عقد حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، برئاسة بلينكن ووزير خارجية النظام المصري، سامح شكري. وكانت الأولوية الأمريكية من اللقاء هي حقوق الإنسان، بينما كان تركيز مصر على القضايا الإقليمية الأخرى، مثل سد النهضة، والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والوضع في ليبيا. وبشكل عام، بدت هذه الجولة كسابقاتها، رمزية شكلية، لم تحقق شيئًا يذكر.
وجهات النظر الأمريكية حول مشروطية المعونة وأثرها
يحاجج البعض بأن المشروطية كانت ناجحة جزئيًا في التأثير على السلوك المصري، مدللين على ذلك ببعض الإجراءات خلال السنوات السابقة، مثل الإفراج عن عدد من الشخصيات، أو إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان وغيرها.
لكن الحقيقة -وفقًا لتقييم الكاتب- هي أن المشروطية لم ولن تكون -على الأرجح- سببًا في إحداث تغييرات كبيرة أو جذرية، فلا تزال مصر السيسي الأكثر قمعًا في التاريخ المصري الحديث. حيث لم تغير الشروط أو الضغوط الأمريكية في مصر سوى عدد قليل من الأمور التجميلية الشكلية وفقط.
وحتى بعد هذه الإجراءات التجميلية، شُرّعت قوانين استبدادية أخرى، وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان في مصر. والواقع هو أن مصر – وفق الكاتب- دولة ديكتاتورية نظامها مدعوم من الجيش، ومحكومة بصوت واحد هو صوت السيسي. ومن وجهة نظر المسؤولين المصريين، من شأن إجراء تغييرات كبيرة في مجال حقوق الإنسان تهديد حكم السيسي ودور القوات المسلحة المصرية في المجتمع، حيث ستكون التغييرات الكبيرة تهديدًا وجوديًا للنظام.
ويعتقد مسؤولون في السفارة الأمريكية أن الحوارات والمباحثات بعيدًا عن أعين الجمهور، والتي تركز على كيفية نظرة الآخرين لسجل مصر في حقوق الإنسان، وتأثير ذلك على العلاقات المصرية الأمريكية، تكون أكثر تأثيرًا في تغيير تصرفات القاهرة أكثر من المشروطية المعلنة.
وقد أفاد موظفو الخارجية والدفاع العاملون في القاهرة أن المناقشة العلنية لهذه الموضوعات تؤدي إلى توترات مع المسؤولين المصريين، الذين يعتبرون ذلك انتهاكًا للسيادة، ويجادلون بأن المعونة العسكرية هي حق لهم مقابل السلام مع إسرائيل، كما يسلطون الضوء على خدماتهم المقدمة للجيش الأمريكي.
بينما لا يزال المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس يخالفون هذا التوجه، حيث يعارضون الافتراض القائل بأن المساعدات ضرورية للحفاظ على السلام المصري الإسرائيلي، إذ أن إسرائيل وسعت علاقاتها مع العالم العربي بشكل كبير. كما يرى أعضاء الكونغرس الديمقراطيون أن هذه المساعدات أحد مخلفات حقبة الحرب الباردة. لكن من الناحية الأخرى، يعارض جزء من إدارة بايدن ومعظم المشرعين الجمهوريين هذا الموقف.
وجهة النظر المصرية للعلاقات مع الولايات المتحدة
حاول الكاتب في هذا المحور بيان وجهات نظر المصريين حول علاقاتهم مع الولايات المتحدة، وتقييمهم للسياسة الأمريكية تجاه مصر.
فيرى الكتاب أن المسؤولين المصريين لا يزالون يعتبرون واشنطن شريكًا غير موثوق، بسبب ما حدث بعد إزاحة مرسي من السلطة عام 2013.
كما تعترض القوات المسلحة على وضع شروط أمريكية بأي شكل من الأشكال.
مشيرًا إلى أن قادة القوات المسلحة المصريين يعلمون أحيانًا عن المشروطيات الجديدة التي تفرضها واشنطن من خلال الصحافة ووسائل الإعلام، وليس من خلال المناقشات السابقة مع المسؤولين الأمريكيين، وهو ما يسبب غضبًا واستياءً كبيرًا لدى القاهرة.
كما أكد أن المسؤولين المصريين ينظرون إلى الكونغرس وأعضائه باعتبارهم غير مدركين لحقيقة الأوضاع في مصر، حيث الأولوية -من وجهة نظر المصريين- هي الحفاظ على أمن البلاد وتماسكها ومنع انهيارها.
وبخصوص الأفراد الذين وصفتهم مؤسسات أمريكية بأنهم معتقلون سياسيون، وتعتبرهم القاهرة في المقابل إرهابيين، يشدد الكتاب على أن المسؤولين المصريين لا يقبلون المساومة بشأنهم على الإطلاق. لافتًا إلى أن القاهرة ترى ضرورة مناقشة مسائل حقوق الإنسان بعيدًا عن وسائل الإعلام.
كما يعتقد المصريون -حسب الكتاب- أن واشنطن تنظر لعلاقتها الثنائية مع القاهرة من خلال منظور مصلحة إسرائيل وحقوق الإنسان، بدلًا من التركيز بشكل أكبر على المصالح المصرية.
ويعتقد الكاتب أن مصر لا تستبعد احتمالية الاستغناء -إذا لزم الأمر- عن المساعدات الأمريكية بشكل كامل.
لكن بالرغم من ذلك، كان لدى القاهرة أمل في تهدئة التوترات عقب وساطتها لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في مايو/ أيار 2021، باعتبار أن ذلك سيزيد من تقدير الولايات المتحدة لدور مصر في المنطقة، لكن تبددت هذه الآمال حين أعلنت إدارة بايدن حجب 130 مليون دولار من المعونة، ووضع شروط حول 225 مليون دولار.
وبشكل عام، الرأي السائد في القاهرة هو أن بعض النخب في واشنطن تتأثر بشكل مفرط بدعاية الإخوان المسلمين، وتعتقد خطأً أن الإسلاميين يدعمون الديمقراطية بشكل فعلي، حسب الكتاب.
الفصل الخامس: استنتاجات وتوصيات
حوى الفصل الخامس والأخير على سرد موجز لأبرز مواطن النجاح والإخفاق للسياسة الأمريكية العسكرية تجاه مصر، مشفوعة بتنبؤات لمستقبل العلاقة، وختامًا بتوصيات الكاتب لمتخذي القرار الأمريكي، نفصلها على شكل نقاط مركزة مختصرة.
مواطن نجاح أمريكا في علاقتها مع مصر:
- المساعدة في الحفاظ على السلام المصري الإسرائيلي بالرغم من الازدراء الشعبي العميق والمستمر تجاه إسرائيل.
- إبعاد مصر إبان الحرب الباردة عن الاتحاد السوفيتي، وضمان كون مصر أحد شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين في المنطقة.
- تعزيز قدرة الجيش الأمريكي على استخدام قناة السويس والمجال الجوي المصري.
- استخدام التمويل لشراء المعدات المصنعة في الولايات المتحدة، مما ساهم في دعم قاعدة الصناعات الدفاعية الأمريكية.
- القدرة على الوصول للمسؤولين المصريين الفاعلين في كافة الأوقات.
- استمرار العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين البلدين، حتى في أحلك فترات العلاقة.
- إبقاء سياسة مصر الخارجية -نظريا- متوافقة مع المصالح الأمريكية، مثل توسيع السلام الإقليمي مع إسرائيل، ومحاربة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.
مواطن الإخفاق:
- استمرار اعتبار الجيش المصري أن إسرائيل هي التهديد الاستراتيجي الأكبر بالنسبة له، رغم معاهدة السلام.
- عدم تحقيق قابلية التشغيل البيني بين أنظمة عمل الجيش المصري ونظيرتها الأمريكية (العمل المشترك بكفاءة وفعالية).
- عدم قدرة أمريكا على جعل القوات المسلحة المصرية تتحول إلى قوة أكثر قدرة على مواجهة التهديدات غير التقليدية والحروب غير النظامية، مثل الإرهاب والتمرد.
- استياء القاهرة من شعورها أن واشنطن تملي عليها مفردات الأمن القومي المصري، وعدم استجابتها للنصائح الأمريكية بتقليص حجم قواتها المسلحة لخوض الحرب التقليدية بفاعلية أكبر.
- تقييم الجيش المصري وفقًا للنظرة الأمريكية، مع عدم اعتبار أن الجيش المصري مختلف تمامًا عن الأمريكي، فدور الجيش المصري في الدولة والمجتمع أكبر بكثير من مجرد قوة عسكرية كما هو الحال مع نظيره الأمريكي.
- عدم بناء علاقات شخصية قوية بين القادة العسكريين الرئيسيين في الجيشين الأمريكي والمصري، ولا حتى الرتب الأقل، لأن القوات المصرية سعت إلى الحد من هذه النوعية من الاتصالات.
- عدم فعالية المساعدات في غرس القيم الديمقراطية وأهمية حقوق الإنسان في الجيش المصري، كما اتضح من أفعاله بعد ثورة 2011، وإقالته للرئيس مرسي، وحملته الوحشية في سيناء، وانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان.
- عدم نجاح المعونات في تحقيق إصلاح سياسي داخل مصر، وحين عُلقت، أصبحت الحكومة المصرية أكثر وحشية واستبدادًا.
- تحول مصر من الولايات المتحدة إلى دول أخرى للحصول على الأسلحة يقوض النفوذ الأمريكي.
تضارب المصالح والقيم
يرى الكاتب أن المعونة الأمريكية قد حققت معظم أغراضها الأساسية، المتمثلة في الحفاظ على السلام مع إسرائيل، وتعزيز قدرة القوات الأمريكية على عبور الأراضي المصرية، والحفاظ على تماشي مصر في الغالب مع المصالح الأمنية الأمريكية في المنطقة.
لكنها في المقابل، أخفقت في تحقيق أغراض أخرى، لا سيما خلال السنوات الأخيرة.
بدورها، كافحت الولايات المتحدة للتوفيق دائمًا بين مصالحها الأمنية من جهة، والقيم والأفكار والمعتقدات الأمريكية فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي أحايين كثيرة، وُضعت الولايات المتحدة في اختبارات صعبة، سيما مع إصرار مصر على إعطاء الأولوية للاستقرار على الديمقراطية، وميلها
إلى ربط جميع المعارضين السياسيين بالإخوان، ومن ثم اتهام هؤلاء جميعًا بالإرهاب.
وفي فترة سقوط الحكومة المنتخبة وصعود حكم السيسي، باتت مصر أكثر استبدادًا، مما شكك في مدى أخلاقية المعونة الأمريكية، وجدد النقاش حول كيفية المواءمة بين المصالح الأمريكية والقيم الأمريكية.
ولذلك، يشير الكتاب إلى وجوب التمييز بين ما هو ضروري، وما هو مندوب أو مستحسن.
والضروري -من وجهة نظر الكتاب- مثل الحفاظ على السلام المصري الإسرائيلي، وإنهاء الصراعات بين إسرائيل والفلسطينيين، والسماح للقوات الأمريكية باجتياز الأجواء المصرية، إضافة إلى ضمان استقرار ليبيا.
في حين أن المندوب أو المستحسن هو وجود مصر ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
كذلك لفت الكتاب إلى ضرورة تقدير بأنه إذا حاولت الولايات المتحدة فرض تغيير في طبيعة القيادة المصرية، فمن المرجح أن تكون الحكومة -في المقابل- قمعية بنفس قدر هذا الضغط الأمريكي، وفي ذات الوقت ستكون أقل دعمًا للمصالح الأمريكية الضرورية.
كما أن مشروطية المعونة لن تساهم في إحداث تغييرات جوهرية على الحكم في مصر، وقد جُربت هذه الاستراتيجية بالفعل ولم تنجح. ووصف الكتاب أولئك الذين يدعون إلى فرض شروط على مصر، بأنهم يبالغون في تقدير قدرة الولايات المتحدة على فرض تغيير في مصر، مؤكدًا أن تجديد المحاولة في هذا الإطار لن يؤدي إلا إلى زيادة نفور قيادات القوات المسلحة والحكومة المصرية من الولايات المتحدة.
ويرى الكاتب – باختصار- أن خسائر الولايات المتحدة من إصرارها على المواءمة بين مصالحها الأمنية الأساسية وقيمها الديمقراطية، أكبر بكثير من مكاسبها.
مستقبل العلاقة
يرجح الكتاب أن العلاقة المصرية الأمريكية ستستمر في هذا النمط المتوتر، فلن تزيد الولايات المتحدة معونتها، كما سيواصل المشرعون الأمريكيون محاولات تكييف المعونة، وسيزيدون من مقدار المساعدات التي تتطلب موافقة الكونغرس عليها، مما يمنع وزير الخارجية الأمريكية من منح أجزاء منها للقاهرة حتى لو رأت الإدارة أنها حيوية للمصالح الأمريكية.
كما وضع الكتاب احتمالًا بتخفيض قيمة المعونة عن 1.3 مليار دولار. وقد يستمر رفض واشنطن بيع أسلحة من الدرجة الأولى لمصر، بينما تسمح ببيعها لآخرين في المنطقة.
مؤكدًا أن كل هذه الخطوات إن تمت ستغضب القاهرة، ولن تؤدي إلى أي تغييرات جوهرية حقيقية على طريقة الحكم أو أوضاع حقوق الإنسان.
وما إن قررت مصر الاستحواذ على طائرات سو-35 الروسية، ستكون هذه أحد أكبر المشاكل الشائكة، حيث سيؤدي ذلك إلى فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة. والمشكلة الحقيقية هي أن الولايات المتحدة ترفض تقديم أسلحة مماثلة لما تبيعه روسيا، نظرًا لمحاولتها الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل، وعدم رغبتها في مشاركة التكنولوجيا العسكرية الحساسة.
توصيات الكتاب للإدارة الأمريكية:
- ضرورة الوصول إلى توافق عام بين الإدارة والمشرعين الأمريكيين حول أهداف العلاقة العسكرية مع مصر، سواء كانت الأهداف المصالح الأمنية وحدها، أو تحقيق التوازن بين المصالح والقيم، أو محاولة إجبار مصر على إحداث تغييرات.
- التركيز على ما حقق نجاحات جزئية في الماضي، مع استبعاد ما ثبت فشله وأدى إلى نتائج معاكسة لأهدافه، مثل تلك الإجراءات التي دفعت مصر إلى اللجوء إلى دول أخرى كمصادر رئيسية للأسلحة، في الوقت الذي ازدادت فيه انتهاكات حقوق الإنسان سوءًا.
- التركيز على النهج العملي الواقعي الذي يركز على الحقائق في مصر والمنطقة بشكل أفضل، حتى لو لم يُتَح دائمًا التوفيق بين هذا النهج والقيم الأمريكية.
- وجوب بناء علاقة واشنطن مع القاهرة على أساس المصالح الأمنية المشتركة، مثل الحفاظ على معاهدة السلام، وحرية الحركة في الأجواء المصرية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وفي هذه الحالة، تتماشى جميع مصالح مصر تقريبًا مع مصالح الولايات المتحدة.
- ضرورة إدراك أن الولايات المتحدة في حاجة إلى تحالف مصر معها، لا سيما في ظل استراتيجية تقليل التواجد في المنطقة وزيادة الاعتماد على الشركاء، كذلك تحتاج أمريكا إلى دعم مصر في منافستها مع روسيا والصين.
- وجوب عدم تخفيض الولايات المتحدة قيمة المعونة الأمريكية السنوية البالغ مقدارها 1.3 مليار دولار.
- عدم إنهاء دور الولايات المتحدة في القوات متعددة الجنسيات في سيناء.
- ضرورة إدارك الساسة الأمريكيين بأن النقد المتكرر لانتهاكات حقوق الإنسان لن يكون له تأثير يذكر، سوى في عدد قليل من الحالات المحدودة التي تتعلق بمواطنين أمريكيين.
- أهمية إقرار الساسة الأمريكيين بأن القيم الأمريكية لن تتماشى دائمًا مع السياسات المصرية، وأن محاولاتهم للتغيير لن تؤدي إلا لمزيد من التوترات وتسليط الضوء على حدود قوة الولايات المتحدة ونفوذها.
- إمكانية استمرار المناقشات الخاصة بين الجانبين حول حقوق الإنسان، ومن المرجح أن تؤتي ثمارها عند التركيز على قضايا محددة، بدلًا من التركيز على الإدانات والانتقادات العامة الشاملة.
- تقبل الساسة الأمريكيين وإدراكهم بأنه سيصدر من مصر دومًا قدرًا ما من الخطاب المعادي للولايات المتحدة وإسرائيل، وينبغي الاستعداد لتجاهله.
- اعتبار المعونة الأمريكية نفقات تشغيلية، وعدم التعامل معها بمنطق الهبة أو المساعدة.
- ينبغي عدم تقييم القوات المسلحة المصرية من خلال مقارنتها مع الجيش الأمريكي، ويجب نسيان تغيير الطبيعة الأساسية للقوات المسلحة المصرية. حيث ستنفصل مصر تمامًا عن الولايات المتحدة قبل حدوث ذلك.
- وجوب إنهاء الجهود الأمريكية الرامية لإعادة هيكلة الجيش المصري وتحويله إلى قوة أصغر تركز فقط على الحروب غير النظامية.
- إنهاء السياسة القائلة بأن المساعدات يجب أن تقتصر على الحرب غير النظامية والحفاظ على المعدات الأمريكية الحالية.
- إدراك الولايات المتحدة أن القوات المسلحة المصرية التوصل إلى قراراتها بمفردها، وفقًا لتقديراتها وأسبابها الخاصة.
- يجب أن تصبح الولايات المتحدة أكثر مرونة فيما يتعلق بالمعدات المقدمة إلى مصر.
- حال حصول مصر على سو-35 الروسية، يجب أن تكون العقوبات محدودة ورمزية ولا تلحق أضرارًا كبيرة بالعلاقات العسكرية.
ففي حال فرض عقوبات مشددة، ستكون التداعيات شديدة على الولايات المتحدة، وينبغي الإدراك أن الولايات المتحدة هي من خلقت هذه المشكلة لنفسها، لأنها رفضت إعطاء مصر أسلحة تطلبها منذ عدة سنوات. - يجب على الولايات المتحدة السعي دائمًا للحفاظ على علاقة قوية مع القوات المسلحة المصرية. فبالرغم من عدم سهولة العمل معها، إلا أنها سيكون لها القول الفصل في مصر حتى في حال حدوث مستجدات مستقبلية.
المصادر
[1] The Washington Institute for Near East Policy, Access Date: 7th Feb. 2023.