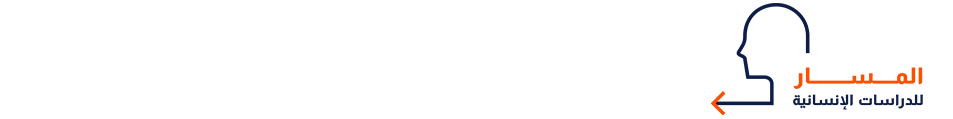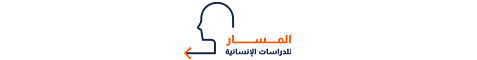قراءة في توجهات السياسة الخارجية في عهد الرئيس محمد مرسي
جهاد حسنين (باحثة في العلوم السياسية)
تتفق أغلب التحليلات التي تناولت السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي “رحمه الله” على أنه على الرغم من المخاوف التي ساورت المجتمع الدولي من اعتلاء رئيس ينتمي للإسلام السياسي سدة الحكم، فقد حافظت سياسته الخارجية بقدر كبير على نهج من سبقوه من الرؤساء، مع بعض التغييرات الرمزية في الخطاب، تلك التي لم تؤثر على جوهر السياسة الخارجية.
تدفع هذه الورقة باتجاه أن هذه الاستنتاجات هي نِتاج الاتجاهات السائدة في تحليل السياسة الخارجية، والعلاقات الدولية، والمناهج الغالبة عليها، التي لا تعكس طبيعة السياسة الخارجية لدول الجنوب – أي تلك الدول التي كان يشير إليها مصطلح “العالم الثالث” في أثناء الحرب الباردة – والدول المستعمَرة سابقا. فالتحليلات السائدة للسياسة الخارجية شأنها شأن دراسات العالم الثالث و”دراسات المناطق” التي نشأت في الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، كانت تنطلق في دراستها لدول الجنوب والشرق الأوسط خصيصا من مقولات اختزالية عن الظواهر المختلفة في تلك الدول.
على النقيض من ذلك، تنطلق هذه الدراسة من حقل وليد يعيد قراءة العلاقات الدولية من منظور “مابعد استعماري”، أي أنه يعيد قراءة هياكل النظام الدولي ونظمه من منظور الدول المستعمَرة سابقأ، ويحلّل آثار الاستعمار الأوروبي الذي لم تتحرر منه غالبية دول العالم حتى منتصف القرن العشرين، على الأداء الدولي والإقليمي لتلك الدول. ينتقد هذا المنظور الاتجاهات السائدة في تحليل العلاقات الدولية التي لا تأخذ في الاعتبار سوى مصالح النظام الدولي، الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، ورسخ الهيمنة الغربية على الدول المستعمَرة سابقا على كافة الأصعدة – الاستراتيجية- العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية-الفكرية.
تحديدا يعطي هذا المنظور وزنا كبيرا في التحليل لهيمنة الخطاب الغربي، الذي حافظ على التصور الأوروبي الاستعماري القديم عن التفوق الحضاري للغرب، وبالتالي عن أحقيته في إرساء القواعد والنظم وقيادة باقي الدول نحو الحرية والديمقراطية والتحضر. فبحسب هذا المنظور، لا يعود تفاوت القوى في النظام الدولي إلى ضعف القدرة على استثمار الموارد، أو ضعف سلطة الدولة مقابل مجتمعات ذات ثقافة سياسية تقليدية، أوغياب الديمقراطية الذي يؤدي إلى فساد القيادة السياسية، بل إن هذه العوامل كلها هي نِتاج عمليات الاستعمار وبناء الدول الحديثة، ثم نتاج الآليات التي استقلّت بها تلك الدول عن الإمبراطوريات الأوروبية، والتي تمت كلها تحت إشراف الغرب، الذي افترض في نفسه معرفة النموذج الأصلح الوحيد لسكان الدول المستعمَرة. لكنه في الحقيقة، كان ينطلق من تصور عن تلك الجماعات كجماعات متخلفة غير قادرة على حكم نفسها. وقد انعكس ذلك أول ما انعكس على ربط الاستقلال التام في النظام الدولي الجديد بـ”مستوى التحضر”، والسماح للدول الأقوى بخرق مبدأ عدم التدخل، من أجل “مساعدة” الدول “المتدنية في سلم الحضارة” من تطوير مؤسساتها السياسية، ورفع جاهزيتها للديمقراطية. وهو ما نظمته قواعد عصبة الأمم تحت بند “الحماية الدولية”، ثم من بعدها نظام الأمم المتحدة للوصاية الدولية الذي أُنهِي العمل به عام 1994.[1]
وقد حال هذا التوجه دون الوصول لفهم حقيقي للظواهر المتعلقة بالمستعمَرات السابقة، وبالأخص في حقل العلاقات الدولية، الذي كانت هيمنة الاعتبارات الأمنية عليه أقوى. ولعل ذلك انعكس في مواقف الساسة الغربيين، مما سمّي بـ”الشارع العربي”، حيث المواطنون غير عقلانيين، وتنتشر بينهم القناعات المتطرفة، وغير قادرين على حكم أنفسهم. وبالطبع، فقد عززت الحكومات الديكتاتورية المتعاقبة من تلك الرؤية، بتلويحها للغرب بخطر صعود قوى راديكالية إذا ما سُمح بالإصلاحات الديمقراطية في البلاد[2].
وهذا بدوره يلقي الضوء على الفرضيات التي انطلقت منها “المخاوف” الدولية، بشأن صعود من يسمّون بـ”الإسلاميين” للحكم، وهي الفرضيات ذاتها التي كانت تثير حفيظة ذلك التيار، حتى وإن كان على إدراك كامل لكافة أبعادها. ففي خلفية تلك المواقف، كانت هناك تعريفات اختزالية عن الثقافة السياسية العربية والإسلامية، وعن هوية الحركات الإسلامية والاختلافات بينها وبعضها بعضًا، وكذلك كانت هناك “أمنَنة” (securitization) لمظاهر التدين وللمفردات الإسلامية كـ”الجهاد”[3]، فكان يغلب على التعامل معها منطق الخطر الأمني لا الاختلاف الثقافي والديني – وكل ذلك بالإضافة لفرض سردية واحدة مشروعة عن القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، واعتبار كل من يسائل تلك السردية مصدر خطر محتَمل. وهي العوامل التي انتهت إلى الدعم المستمرّ للديكتاتوريات العربية، إعلاءً لقيمة استقرار النظام الإقليمي والهيمنة الأميريكية على قيمة المساواة بين الدول، وإفساح المجال للشعوب لحكم ذاتها.
إن الانطلاق في التحليل من منظور يأخذ في الحسبان استمرارية مثل هذه التوجهات الاستعمارية في النظام الدولي – مهم؛ لأنه يُبرز دلالة بعض أفعال السياسة الخارجية التي قد تغفلها الاتجاهات السائدة. فالمنظور مابعد الاستعماري يبحث الإرث الاستعماري واستمراريته في العلاقات بين دول الجنوب ودول الشمال، ويبحث الأدوار الإقليمية والدولية التي أُنيطَت بدول الجنوب بعد الاستقلال، ويبحث الكيفية التي تُقاوم بها هذه الدول هذه الأدوار أو تستديمها. يتناول هذا المنظور كذلك الأطر الأممية والدولية، التي تحكم العلاقات بين الدول، ومساعي دول الجنوب إلى تغيير المنطق التسلّطي والتنافسي- الصفري، الحاكم للتفاعلات الدولية في ظل الهيمنة الغربية، وإمكانيات الانتقال نحو نظام دولي جديد قائم على المساواة والحرية والمسؤولية المتبادلة[4]. في هذا الإطار، يمكن من جديد قراءة “التغييرات الرمزية في الخطاب” التي تَعزوها التحليلات إلى السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس مرسي، والبحث فيما وراءها؛ هل كانت مجرد ترجمة جامدة لهوية الحركات الإسلامية وما تعتنقه من ثوابت دينية؟ أم كان وراءها مساعٍ لإرساء أسس جديدة للعلاقات الإقليمية والدولية، مدفوعة برؤية جماعة الإخوان المسلمين عن النظام الدولي الذي طالما اتهمته لعقود بالانحياز وازدواجية المعايير والوصاية على الشعوب؟ وهذا – قطعا – دون إغفال النتائج التي توصّلت إليها تحليلات السياسة الخارجية التقليدية، وذلك من أجل التوصل لتصور أكثر شمولية عن أداء الرئيس الراحل محمد مرسي على الصعيد الدولي.
منهج الدراسة
ستنطلق هذه الدراسة من تعريف “ديفيد كامبيل” للسياسة الخارجية كأداء سياسي، يستقي من “التقاليد” المتاحة، ليعيد إنتاج “الشخصية الاعتبارية” للدولة، وللأمة التي تمثّلها تلك الدولة. فهذا الإطار يتيح الجمع بين القيود المفروضة على الدولة من قبل النظام الدولي والإقليمي من جهة، وفاعلية الدولة في اختيار الالتزام بتلك القيود (وبالتالي إعادة إنتاج النظام الذي تفرزه) أوالمناورة وفق الحدود المتاحة، لإضفاء معانٍ جديدة على الخطاب الخارجي وأفعال السياسة الخارجية من جهة أخرى[5]. والسياسة الخارجية في حركتها تلك، محكومة – أولا- بمبدأ السيادة الذي يُفرض على الدول، في نظام دولي أناركي، يفتقر لسلطة عليا، تفصل بين الدول الأعضاء، ومن ثَمَّ يجعل المنطق الحاكم للعلاقات بينها هو: “منطق الدولة” (raison d’etat)، والمنافسة (الصفرية) على البقاء. وثانيا – فإن السياسة الخارجية لهذه الدولة يحكمها -بدرجة أقل من الأهمية- مبدأ “الانحياز الجغرافي والثقافي، ” أو “المخيال القومي”[6] للدولة والأمة، ودورهما.
في هذا الإطار ستحلل الدراسة بعض التحركات الخارجية البارزة للرئيس محمد مرسي، لترى كيف بنيت على تقاليد مؤسسة السياسة الخارجية المصرية والأدوار التقليدية المنوطة بها، وكيف تفاعلت معها. مستوى التحليل هنا سيكون: تحركات الرئيس مرسي ذاته؛ ولذلك لن تتناول هذه الدراسة تلك الملفات الروتينية التي تولّتها وزارة الخارجية. بهذا الشكل، تكون الدراسة قد أفسحت المجال للضغوط الداخلية والإقليمية والدولية على السياسة الخارجية، وفي ذات الوقت نظرت فيما إذا كان وراء “التغييرات الرمزية” في الخطاب مساعٍ جادة تستهدف تغيير نمط علاقاتها الخارجية والأدوار المرسومة لها في ظل النظام الدولي مابعد الاستعماري.
تقاليد مؤسسة السياسة الخارجية في مصر
كانت السياسة الخارجية التي ورثها الرئيس الراحل مرسي عن نظام مبارك مزيجا من التوجهات التي أرساها الرئيسان السابقان: عبد الناصر، والسادات. فمن ناحية كانت مصر عبد الناصر تتبنى مشروعا ورؤية لموقع الإقليم العربي في النظام الدولي، ربطته بهويتها الداخلية والخارجية، وبذلت له الموارد والطاقات. أما في عهد السادات، فقد تبلورت هويّة مصرية فصلت بين المصالح القومية المصرية، ومصالح الدول العربية. وبعد اغتيال السادات والتدخل المصري ضد العراق في حرب الخليج، استعادت السياسة الإقليمية المصرية شيئا من التوازن بين الاتجاهين السابقين؛ فعلى الرغم من تضاؤل النفوذ المصري في المنطقة لحساب دول أخرى، فقد حافظت مصر على مكانتها كـ”مرجع إقليمي”[7]، لا بد لأية دولة تطمح للنفوذ في منطقة الشرق الأوسط من التحالف معها، لكن دون أن تتمكن من لعب الدور الإقليمي القيادي السابق، نظرا للضغوط الاقتصادية والمالية التي تراكمت عليها.
وقد دارت السياسة الخارجية المصرية طيلة الثلاثين عاما التي حكمها مبارك حول مسائل أساسية، هي: الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب (والأمن في سيناء خِصِّيصَى)، والاستقرار الاقتصادي، والعلاقات مع الولايات المتحدة، والعلاقات مع المنطقة العربية (وفي القلب منها دول الخليج في مواجهة إيران) [8]، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي وُكل إلى مصر في التوسط بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، والتحكم في معبر رفح ومسألة الأنفاق بين سيناء وغزة.
وقد حكمت تلك السياسة الخارجية قيود داخلية، كان أهمها الاحتياج المصري للدعم المالي والاقتصادي من الولايات المتحدة، ودول الخليج (وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية)، والاعتماد العسكري على الولايات المتحدة في ظل رئاسة المشير حسين طنطاوي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والوضع الأمني في سيناء، وبنسبة أقل كثيرا الرأي العام المصري في القضية الفلسطينية. كما هيمن جهاز المخابرات، والدائرة المحيطة بالرئيس على صناعة السياسة على حساب وزارة الخارجية، وإن احتفظت الأخيرة بدور لا يُستهان به؛ حيث تمأسست فيها وفي جهاز العاملين بها هذه التقاليد.
تتفق غالبية التحليلات على أن حركة الرئيس محمد مرسي لم تمثل قطيعة مع تقاليد السياسة الخارجية المصرية ولا بروتوكولات العلاقات الدولية بشكل عام، بل استمرّ على ذلك التوازن بين القيادة عن بعد، دون السماح بتحميل مصر المزيد من التكاليف. فمنذ نشأة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كان هناك تأكيد على أن أحد أهدافه استعادة الدور القيادي لمصر. وقد حرص الرئيس مرسي في خطاباته على تسكين تحركاته الخارجية، في إطار التوجهات التاريخية للسياسة الخارجية المصرية، فصور مشاركته في قمة عدم الانحياز بطهران، جاء امتدادا للدور المحوري الذي لعبه جمال عبد الناصر فيها، “معبرا عن إرادة الشعب في كسر الهيمنة الخارجية”[9]. كذلك فقد كانت السياسة الخارجية المصرية تؤكد – مرارا- التزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، بما فيها معاهدة كامب ديفيد، وحافظت على نمط علاقاتها العربية، على الرغم من الصعوبات المتولدة عن معارضة تلك الدول لثورات الربيع العربي.
ولا شك أن هذه الاستمرارية تعود (ولو جزئيا) إلى الضغوط الاقتصادية الداخلية التي واجهتها حكومة الرئيس مرسي، وأحوجتها للدعم المادي الخليجي، ولاستثمار موقعها من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وكذلك رؤية الجماعة التي انتمى إليها الرئيس محمد مرسي، حيث كانت في بعدها الخارجي سائلة ومفتوحة على احتمالات كثيرة، أساسها السيادة الشعبية، واحترام الخصوصية الثقافية، ورفض الهيمنة والوصاية الغربية على مصر والعالم الإسلامي. أما حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين – وإن ارتبط عضويا بالجماعة[10] – فإنه بلا شك كان له دور في إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية للرئيس، وتقديمها في صياغة جديدة، متقيدة بما يجب أن تكون عليه هذه السياسة الخارجية؛ ولذلك لم يكُن منتَظرا أصلًا إتيانه بانقلاب على صعيد تلك السياسة الخارجية، على غرار ما حدث- مثلا – بعد الثورة الإيرانية عام 1979، التي كان التيار الذي تزعمه آية الله الخميني فيها متبنيا لنظرية سياسية متكاملة الأركان، حددت معالم واضحة للنظام داخلية، أما خارجيا، فقد قسمت مجالات حركته الخارجية مع العالم على محوري مقاومة وممانعة. لكن من خلال العمل في إطار هذه التقاليد المؤسسية، يمكن القول بأن الرئيس مرسي كان يسعى كذلك إلى إضفاء معانٍ جديدة على سياسة مصر الخارجية، وحلحلة الأدوار الجامدة التي ظلت عليها مصر طيلة ثلاثين عاما تحت حكم مبارك.
توجهات سياسة الرئيس مرسي الخارجية
انتهى القسم السابق إلى أنه لم تسفر سياسة الرئيس الخارجية عن قطيعة كاملة مع التقاليد المؤسسية المصرية، وكذلك لم تحمل مشروعا يسعى للتغيير الجذري في النظام الإقليمي أو الدولي. في هذا القسم تحليل لمدى سعي الرئيس محمد مرسي لبلورة شخصية مصرية جديدة، مستقلة عن هيمنة النظام الدولي (والمنطق الاستعماري الذي يحركه) من خلال تحركاته الخارجية؛ من حيث التزامه بالأدوار التقليدية المفروضة على مصر من قبل النظام الدولي أو محاولة الخروج عنها، ومن حيث موازنته بين “منطق الدولة”، والانحيازات الجغرافية والثقافية التي تحرك بها.
- على صعيد الدولة المصرية
أولا- لا بد من الأخذ في الاعتبار أن الدولة المصرية منذ معاهدة كامب ديفيد وما تبعها من تغييرات مسّت السياسة الخارجية المصرية، وكذلك تنظيم الجيش المصري وعقيدته العسكرية، صار منوطا بها بالإضافة إلى حفظ الاستقرار في المنطقة “دور” إضافي هو: الحفاظ على التيارات التي قد تهدد ذلك الاستقرار، بعيدة عن أروقة الحكم. وهذا – ربما- لم يكن “دورا” رسميا، لكن كانت الحكومات الغربية والإسرائيلية تعوّل على أدائه من قبل نظام مبارك. وقد أطّر ذلك الخطاب الخارجي للرئيس مرسي، الذي كان حريصا على تكرار التزامه بالتوازن والاستقرار الإقليمي الذي حفظته مصر، وعلى سلمية الثورة التي أتت به إلى سدة الحكم، والتزامه وحكومته بإقامة “دولة وطنية، ديمقراطية، دستورية، قانونية، حديثة .. إلخ، تستوعب روح العصر”[11]، إدراكا لحاجته إلى إرسال رسائل “طمأنة” للمجتمع الدولي، حيال موقفه من الدولة الحديثة، وإدراكه لترسُّخ المخاوف من النموذج الإيراني.
ثانيا- عند تحليل نمط الزيارات الخارجية للرئيس، يمكن القول بأنه كان يسعى من خلال النشاط على الصعيد الخارجي إلى أن يستعيد صورة الشخصية الفاعلة للدولة المصرية، والتي كان اضمحلالها في عهد مبارك محلّ انتقاد من كافة التيارات السياسية المصرية في الداخل. فإلى جانب قيامه في الأشهر الأولى من انتخابه بزيارات عديدة؛ أخذت زياراته الأولى كذلك وجهات جديدة، كانت قد أهملتها السياسة الخارجية في عهد مبارك؛ كإثيوبيا، وإيران، والهند، وباكستان، والبرازيل[12]، في محاولة لإبراز استقلال أولويات السياسة الخارجية ومساعي التنمية الاقتصادية عن الولايات المتحدة، وأوروبا.
ثالثا- حرص الرئيس على إبراز تشعّب الاهتمامات الخارجية لـ”مصر الجديدة”، وتبنيها رؤية التغيير على أصعدة متعددة، ولو لم تمتلك السبل للسعي فيها جميعا، وأكثر ما تجلّى ذلك في خطاب الرئيس مرسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2012، حيث تعرّض لعشرة مسائل رئيسية قائلا: إنها رؤيته عما يجول في عقول أبناء مصر؛ من العدالة لجميع الشعوب، والأمن والاستقرار، والمساواة للجميع، وقد ذكرها على الترتيب الآتي:
- أهمية التسوية العادلة للقضية الفلسطينية؛ منتقدا بقاء كافة القرارات الأممية معلّقة وغير مفعّلة، وإحباط مساعي الفلسطينيين، على الرغم من استعمالهم كافة الأساليب المشروعة، للحصول على حقهم في دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية. وأدان التغاضي عن قيام “طرف في المجتمع الدولي” (قاصدا إسرائيل) إنكار حقوق الأمة الفلسطينية، واستمرار الاستيطان، وتغيير معالم القدس.
- أهمية حل الأزمة السورية ديمقراطيا دون تدخل عسكري خارجي، وبمشاركة كافة الأطياف الوطنية السورية وتوحيد صفوف المعارضة.
- أهمية مؤازرة السودان، وتسوية الخلافات مع دولة جنوب السودان، ومركزية البلدين للتعاون بين العالم وامتداده الأفريقي.
- دعم الصومال للخروج بسلام من المرحلة الانتقالية.
- أكد التزامه بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدار الشامل، وحق الجميع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
- النقد المبطن للمجتمع الدولي، لإقامته الاستقرار على القمع والطغيان، وانتقاد مجلس الأمن، والأطر الحاكمة للعلاقات الدولية، التي لا تمثّل دول الجنوب تمثيلا عادلا، وفي مقدمتها القارة الأفريقية. كما تعرض لمسألة الثروات المنهوبة من أفريقيا، وأهمية التعاون لردها.
- أهمية تجديد الشرعية التي يقوم عليها النظام الدولي، وتعزيز مصداقيته من أجل “صياغة عالم جديد”. ونقد ازدواجية المعايير، وفرض المفاهيم على دول تتمتع بخصوصية ثقافية، ومرجعية دينية معينة.
- اقترح مبادرة بإنشاء جهاز تابع للأمم المتحدة، يخدم الشباب والمرأة، ويشرف على التعليم والتشغيل وتفعيل المشاركة السياسية.
- التعرض لما تلقاه الجاليات المسلمة في العالم الغربي من تمييز ديني وعرقي، وانتقاد انتشار النيل من مقدسات المسلمين، والدفع بتعارضه مع مبادئ الأمم المتحدة، ووقوف ذلك حائلا أمام إمكانيات التعاون والسلم الدولي والحوار بين الحضارات، ودعوة الأمم المتحدة للتصدي للكراهية على أساس العرق أو الدين، وتعريف حرية التعبير بما يبتعد بها عن الإساءة للآخر.
- مراجعة آليات اتخاذ القرارات المالية، والانتقال لحوكمة اقتصادية دولية جديدة، محورها الشعوب، وأساسها التعاون، من أجل المنفعة المشتركة، بحيث تشارك فيها كافة الشعوب التي تمس شؤونها، وإنهاء الممارسات المجحفة في التجارة الدولية، والخفض من تكاليف نقل التكنولوجيا، والحصول على التمويل من أجل التنمية.
رابعا- بدأ الرئيس بالتحية الإسلامية التقليدية، ثم بالصلاة على النبي محمد ﷺ ، معقبًا: “الذي نحترم من يحترمُه،” كما تلا الآية الكريمة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، وذلك قبل أن يتوجه بالتحية الرسمية للحضور. وقد اتخذ السفير المصري السابق لواشنطن – نبيل فهمي – من هذا التأكيد على “الشكليات” الدينية دليلا على أن الرئيس “لا يزال ينظر إلى العالم من منظور ممثل عن الحركة الإسلامية المصرية، وليس من منظور الرئيس المصري الممثل عن كل المصريين”[13]. ولعل هذا كان مأخذ الكثير من التيارات السياسية المصرية. وعلى ذات المنوال، لجأ الرئيس إلى مفردات إسلامية مشابهة في زيارته لتركيا، التي هنأها على نجاحها في الحفاظ على الهوية والمعاصرة، مؤكِّدا أهمية التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين، قائلا : “لا ننفصم عنه بل نفخر به” . ولعلَّ ذلك كان مثالا آخر على التوكيد على الامتداد الإسلامي للهوية المصرية – والذي كانت ولا تزال طوائف من النخب المصرية المختلفة تُشير إليه بالاحتلال، وينفون تركيا خارج إطار العمق الثقافي المصري.
لكن في إطار ما سبق ذكره في المقدمة عن دور السياسة الخارجية في بلورة شخصية الدولة والأمة التي تمثّلها، وما انتقده تيار الإسلام السياسي لعقود من هيمنة الخطاب الأوروبي على السياسة، تتبدى قراءة مغايرة لهذا السلوك الذي اتبعه مرسي في كافة زياراته الخارجية. إن أحد المقولات الأساسية لتيار الإسلام السياسي كانت: براءة الإسلام من “افتراءات الغرب” – أي تلك المقولات التي ترسخت بفعل الاستشراق أحيانا، وبفعل النظم الديكتاتورية أحيانا، وبفعل سلوكيات الحركات الإسلامية في الأقطار المختلفة أحيانا أخرى- عن عدم تواؤم الإسلام مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدم قابلية المسلمين للتعاون المثمر مع الغير. وهي المقولات التي اتخذت ذريعة لاستبعاد الدين كأحد محددات السياسة الخارجية، وفصله عن الكثير من المجالات الداخلية؛ وهو ما اعتبرته الحركات الإسلامية فرضا للرؤية العلمانية على مجتمعات متدينة، وهو أحد المظالم التاريخية لدى الحركات الإسلامية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين التي جاء منها الرئيس محمد مرسي.
ولذلك فإن حرصه على “الزج” بهذه المصطلحات والتعابير الدينية في تلك الساحة الدولية التي كانت لها منذ عقود قواعد وبروتوكولات تنظم إعطاء وأخذ الكلمة، لا يُقرأ بالضرورة على أنه “جهل” بقواعد العمل في المحافل الدولية، أو عجزٌ عن الخروج من أسر الانتماء للحركة الإسلامية، بل يمكن القول بأن ذلك كان متعمدا كنوعٍ من “ممارسة المساواة”، وتحدٍ للصورة النمطية التي اختزلت المصطلحات والرموز الإسلامية في خانة “التقليد” الذي همشته الدولة المصرية بعيدا عن أروقة الحكم، وبعيدا عن الشاشات الإعلامية، وكذلك عن الجامعة – في فترة ما – ، وعن كل مراكز التأثير في المجتمع، لصالح كل ما يبدو “حديثا”، والذي كان معياره بالطبع ما هو منبثق عن الثقافة والتقاليد الأوروبية. وهو توتر يعود لعصور التغريب، حتى قبل قيام الجمهورية المصرية، لكن حافظت الحكومات المصرية المتعاقبة على تلك الثنائية، وأبقت “التقليدي” دوما في مرتبة أدنى من “الحديث” .
وليست العبرة هنا بما إذا كان الحديث حقا يفضل “التقليدي الإسلامي،” ولا ما إذا كان الدين محله “المجال الخاص” أو “المجال العام،” ولا مناقشة المنطلقات التي دفعت الحكومات المصرية المتعاقبة لتهميش مظاهر الدين عن مراكز السلطة. بل العبرة هي بأن هذه الثنائية كانت نتاج عمليات تغريب، وجهت أصابع الاتهام إلى أشكال التدين السائدة، و نعتتها بالرجعية والتخلف ومعاداة العلم، وفرضت ثنائيات العام والخاص والمدني والديني على سياقات مجتمعية مغايرة للتجربة الأوروبية، ولم يُفسَح المجال لمتبنِي أشكال التدين تلك للوصول إلى مواقع السلطة ونفي الاتهامات عن أنفسهم، حتى حين ترك لهم الرئيس السادات المجال للحركة في المجتمع. وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن الرئيس كان من خلال التوكيد على الرموز الدينية الإسلامية يتحدى فرض النظم الأوروبية رؤيتها للعالم ومفردات خطابها على الغير، ويتحدى الربط بين تلك الرموز والمصطلحات وبين الإرهاب والرجعية.
وبالطبع، فما من سبيل لتقييم ما إذا كان المسلك الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي هو المسلك الأصح لتحقيق ذلك الهدف أم لا. فلم يستمر الرئيس في الحكم أكثر من عام، وما لبثت المنطقة أن تراجعت التحركات الثورية والشعبية فيها، وعلى الصعيد الدولي، اتجهت الولايات المتحدة وأوروبا نحو المزيد من التمركز حول الذات، وضرب الحائط بكل من هو مخالف، بل ازدادت حدة الاستعلاء الذي تخاطَب به دول الجنوب. لكن تظلّ مساعيه علامة على طموحه لشرعنة “التقليد الخطابي” الإسلامي على الساحة الدولية، وإبراز الجانب الديني في الهوية المصرية الذي قمعته مراكز النفوذ المختلفة في مصر لعقود.
وكانت الإشكالية في اتخاذ ذلك الاتجاه بالطبع هي طبيعة المجتمع المصري في أعقاب ثورة 25 يناير. والذي كان قد تعرض لعوامل تفتت واهتزاز الأطر المرجعية الحاكمة للخطاب بين التيارات المختلفة، وخاصة مع صعود جيل جديد من الشباب اطلع على التيارات الفكرية العالمية المختلفة، وورث تصورا عن الدين مغايرا عن ذاك الذي ورثته الحركات الإسلامية. فقد أوضح الخطاب العام في مصر عقب الثورة عمق الانقسام المجتمعي، وانعدام الثقة، والتوجس السائد بين التيارات المختلفة – وذلك بداية من الجدل حول ما إذا كان “الإخوان” قد شاركوا يوم 25 يناير أم يوم 28 يناير، أو ما إذا كانت التيارات الليبرالية ستسعى لفرض العلمانية و”خلع الحجاب” على الناس، أو المطالبات للإخوان بأن لا يتقدموا بمرشح للانتخابات الرئاسية، وغيرها من الجدالات التي تدل – حين يخرج المرء عن المشهد ليتفكر فيه عن بعد – على أنه لم يكن يجمع بين كل هذه التيارات من جهة، وبينها وبين المجتمع المصري من جهة أخرى، “عقد اجتماعي” واحد يمكن الاتفاق عليه. ولذا، كان التربص بمن سينجح في النفاذ للدولة، وتشكيل المجتمع كما يحلو له. وقد كان المجتمع المصري حاضرا غائبا في كل تلك المناقشات، كتلك الكتلة البشرية الهائلة التي سينجح هذا الطرف أو ذاك في التلاعب بها واستمالتها وتشكيلها من أعلى. وهذا بالطبع بعيدا عن إعادة إنتاج التعميمات الفاسدة – والتي شابها الجهل أو سوء النية أو كلاهما – عن عمل الإسلاميين على استعادة أسواق النخاسة من جديد، أو عمالة الليبراليين للغرب، أو عمل اليسار المصري على نشر المثلية في المجتمع، إلى آخر ذلك من ممارسات لم تكن تستهدف خلق خطاب عقلاني عن شكل الدولة وسبل العيش المشترك، بقدر ما استهدفت تخويف الجماهير وإبعادها عن صف الخصم. أي أن الجميع كان قد أخذ من “مقولة عدم جاهزية الشعب للديمقراطية” نقطة للحركة – وهي المقولة التي كانت غطاء لشرعنة الاستعمار، وإضعاف ثقة الناس بما لديهم من مقدرات بشرية وفكرية واجتماعية.
لقد كان للرئيس محمد مرسي الحق في استعمال مفردات ومصطلحات إسلامية في خطابه في المحافل الدولية، وفي تحديه لهيمنة الخطاب الذي تُدار به العلاقات بين الدول، وتقديم نموذج لخطاب أصلح من الخطاب الحالي، ولعل ذلك كان من الممكن أن يؤتي أُكله لو كان وراءه بيئة داخلية متماسكة تقرّه على ذلك وعلى المنطلقات التي دفعت به إليه، وفي إطار تصور وطني مشترك عن الكيفية المثلى لاستعادة ذاتية الخطاب، خاصة وأن الزمن كان قد تجاوز نموذج الدولة حديثة الاستقلال التي كان من المعقول التفاف كافة أبنائها وراء الزعماء في صكّهم لشخصية جديدة مقاومة للهيمنة.
- الشخصية الإقليمية للدولة المصرية والعمق الإسلامي
لقياس الأداء المصري الهادف إلى إرساء أسس جديدة للعلاقات الدولية – كما أشار الرئيس في خطاباته مرارا – فلا بد من قياس ذلك أول الأمر على صعيد المحيط الجغرافي والثقافي للدولة، وما إذا كانت حافظت على العلاقات الإقليمية ذاتها، أم أنها سعت إلى إعادة صياغتها على صورة تعكس الشخصية الجمعية لذلك المحيط.
لا يختلف أحد على الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط، لاستقرار النظام العالمي، وللهيمنة الأميركية عليه. وقد كان ما يُفعل بالشرق الأوسط من نهب للثروات وزعزعة للاستقرار كذلك أحد أركان النقد الذي وجهته الحركات الإسلامية للنظام الدولي، ولدول الشرق الأوسط ذاتها، باستدامة تلك التبعية. وعندما اندلعت ثورات الربيع العربي في 2011، فإن ذلك أعاد ترتيب التحالفات التاريخية في المنطقة تلقائيا، ما بين محور “محافظ” ثقله في الخليج، ومحور التحول الديمقراطي الذي حاولت السياسة المصرية قيادته بصفتها “النموذج الأمثل للديمقراطية العربية الإسلامية السنية”[14] ، والذي كان قد تقارب مع تركيا بفعل طرحها من قبل النظام الدولي – حينها – كنموذج التوفيق الناجح بين الإسلام والديمقراطية. خاصة وأنها لم تكن قد انخرطت بعد في الصراعات المعقدة الدائرة الآن. وقد عقَّد من ذلك الخصومة التاريخية بين الجمهورية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج. وهي الخصومة التي فرضت على مصر المناورة، لجلب منافع اقتصادية واستراتيجية كانت تمثلها إيران حينها، من دون إرسال رسائل توحي بأن مصر قد أدارت ظهرها للمحور السني. وقد عقَّد من العلاقة مع إيران كذلك، الحرص المصري على أن لا تجرُّها إيران إلى محور تحالفاتها وخطابها العدائي التصادمي مع الولايات المتحدة، وعلى أن تبرز مصر موقفها جليا حيال الأزمة السورية؛ وهو عدم قبول مصر بأي دور للنظام السوري في مستقبل سوريا.
كان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أول رئيس يزور محمد مرسي الرئيس في قصر الاتحادية بعد توليه الرئاسة، وقد أكدا في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء، عمق الارتباط السياسي بينهما وأولويات التعاون ضد الاستبداد، وتعزيز الانتماء الأفريقي لكليهما، والسعي نحو التنسيق العربي الاقتصادي، كما أعربا عن رغبة في انضمام ليبيا الفعال إلى ذلك التحالف، من أجل وصل الإرادة الشعبية “ووصل الخطوط البرية والبحرية.” كذلك كان الرئيس التركي عبد الله غول، ورئيس الوزراء حينئذ رجب طيب أردوغان أول من هاتفا الرئيس مرسي مهنئينه على تولي المنصب.
ورغم أن هذا التقارب الثنائي، و”الانحياز الثقافي” (على المستوى الرسمي) مع تونس وتركيا[15] كان اتجاها جديدا في السياسة الخارجية، فإن السياسة الخارجية المصرية حافظت على استمرارية التحالف التاريخي بينها وبين المملكة العربية السعودية، كإطار حاكم لأي حراك إقليمي. وكان التحرك الإقليمي الأبرز المبادرة الرباعية التي طرحها الرئيس، لتضم السعودية وتركيا وإيران.
وعلى الرغم من غلبة مسائل التعاون التقني على العلاقات الثنائية للدول الثلاث (مصر، وتركيا، وتونس) واتجاهها نحو صيغ تعاونية وتكافلية لعلاقاتهم الإقليمية، فإن ذلك لم يترجم إلى آليات مشتركة، تعيد صياغة القواعد الحاكمة للعلاقات الإقليمية، والعلاقات مع العالم الإسلامي. ففي قمة مؤتمر التعاون الإسلامي في فبراير 2013، لم يتجاوز التغيير مستواه الرمزي في خطاب الرئيس مرسي، وفي هذا الإطار أيضا سعى مرسي لربط رؤيته للدور المصري بدور مصر التاريخي بالنسبة للعالم الإسلامي، والمرتكز على الأزهر الشريف.
صور الرئيس الثورة المصرية بحجر الزاوية في انطلاق الأمة نحو العدل، وقدم تصورا شاملا (مصريا) عن الملفّات التي يجب على المنظمة كتحالف إسلامي التعامل معها، وكان أبرزها البحث العلمي والابتكار، والسياحة الثقافية والعلمية بين الدول الإسلامية، وتراجع قدرة المجتمعات على التنشئة الدينية السليمة اللازمة لمواجهة التطرف والعنف، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الإسلامية، وتعزيز دور المرأة في كافة نواحي الحياة إعمالا للشريعة، وحماية الجماعات المسلمة المضطهدة. والمقترحات الوحيدة بشأن آليات جديدة لإدارة العلاقات الإسلامية، كانت بعض الآليات المقترحة لتطوير منظومة الإغاثة الإسلامية وإعادة هيكلتها ماليا لزيادة فاعليتها، وتطوير آليات للإنذار المبكر، والتنسيق بين الجمعيات الإغاثية والمجتمع المدني؛ وكذلك إنشاء مركز للحوار بين المذاهب. وكما كان الأمر في خطاب الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد كان الرئيس يطرح رؤية شاملة حول الإشكاليات التي تواجه الأمة، ومظاهر ضعفها كـ”أمة إسلامية” ذات شخصية اعتبارية وفاعلية ذاتية، وقد ذهب في ذلك إلى أبعد من مجرد “التعاون حول مسائل مشتركة”؛ حيث أشار إلى مسؤوليةٍ جَمْعيةٍ “أمام الله”، عن تواضع الإنتاج المحلي، وعن سلبية ردود الفعل الإسلامية تجاه الإسلاموفوبيا، والتكاتف من أجل إعادة إعمار الصومال، وحماية التراث الثقافي في دولة مالي، وإيجاد آلية ذاتية لفض النزاعات سلميا، إلى غير ذلك من القضايا.
أخيرا، كانت المسألتان الفلسطينية والسورية هما “المسألة الإقليمية” التي حضرت في كافة زيارات الرئيس مرسي في الخارج. فبخصوص المسألة الفلسطينية، كان المشهد الأبرز فيها هو موقف الرئيس أثناء العدوان على غزة في ديسمبر 2012، والذي كان في “إخراجِه” وظهور الرئيس، وإرسال رئيس الوزراء إلى قطاع غزة محاولة أخرى، لإعادة تصوير الشخصية المصرية الجديدة، وإن كانت الظروف الموضوعية والمصلحة القومية قد اضطرت مصر للحد من الساعات التي فُتح فيها معبر رفح، وتدمير الأنفاق المؤدية إلى غزة. ولعل حركة مرسي الخارجية، والتوكيد على أهمية المسائل الفلسطينية؛ كالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والأسرى الفلسطينيين، والهوية الثقافية للقدس، كانت سعيا لإكسابها زخما أمميا، ولتأكيد الاتساق التام بين الأهداف الفلسطينية، و “مصر الجديدة”.
وكان الأمر ذاته قائما بالنسبة لسوريا، الذي أكد الرئيس مرارا على اعتباره إياها “الرئة الثانية” لمصر وشريكتها التاريخية في المنطقة. والبارز أن الرئيس في طرحه للقضيتين، كان يحرص على تأطيرهما بمعايير الشرعية الدولية؛ من احترام السيادة، وسلامة الأرضي، ورفض التدخل الأجنبي، وتدخل الميليشيات.
خاتمة
كان الغرض من هذه الدراسة قراءة السياسة الخارجية في عام حكم الرئيس محمد مرسي “رحمه الله”، من منظور قد يفسّر التحركات الخارجية للرئيس القادم من خلفية حركية إسلامية تبنت لعقود خطابا ناقما على مساوئ الاستعمار، والتهميش الذي فرضه على العالم الإسلامي في الداخل والخارج، وعلى قيام النظام الدولي الحديث على أساس القمع والاستغلال، بدلا من العدل والتعاون. وبتحليل المحطات الرئيسية في سياسة مرسي الخارجية، يمكن القول بأن مصر كانت تسعى بالاستناد على تحالفها الإقليمي وعمقها الإسلامي الجديد إلى أن تعكس تصوراتها المثلى عن إطار تعاوني يحكم العلاقات الدولية، في ظل مسؤولية متبادلة بين الدول، وفي استقلالية عن الهيمنة الغربية على مفردات الخطاب وأدوات الحركة. ولو لم تتمكن مصر خلال عام حكم الرئيس محمد مرسي من بلورة آليات ملموسة لمأسسة ذلك الإطار التعاوني. على أنه يظهر أن مصر في تحركاتها الملموسة كانت تعمل على ربط تلك “الشخصية الجديدة” بتقاليد مؤسسة السياسة الخارجية المصرية، وربط التحالفات القديمة بالجديدة.
وقد حاولت مصر تمثّل الشخصية ذاتها في علاقاتها مع دول الجنوب من خارج العالم الإسلامي، وأكدت حرصها على التكامل مع الدول “الصديقة للتنمية، والعدالة الاجتماعية، والانطلاق الاقتصادي”[16] والتعاون في شتى المجالات الفنية. ولكن لا يجب إغفال أن الإطار التعاوني الذي سعت مصر على ربط شخصيتها الدولية الجديدة به تعثر (على مستوى الخطاب) عند “الاختبار الأول” في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، والتي كان الإطار الحاكم للتعامل معها هو بالطبع منطق المصلحة القومية والتأكيد على “الحقوق التاريخية” لمصر في مياه النيل، على الرغم من أن مصر قد اكتسبت تلك الحقوق بموجب اتفاقيات أبرمت مع الاستعمار البريطاني، ولم تشارك فيها كل دول حوض النيل – وذلك الأساس الذي تسوقه إثيوبيا لرفض تشبث الموقف المصري بحقوق تاريخية اكتسبها في الحقبة الاستعمارية.
ولعل ذلك يبرز أهمية انبثاق التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية – ولو كانت تسعى للتوكيد على سيادتها وندية تعاملاتها على الصعيد الدولي – عن إجماع بين قطاعات شعبية عريضة، تسمح ببلورة أوضح لحدود ذلك التوجه الجديد وأهدافه، كما توفر منافذ غير رسمية لممارسة “الدبلوماسية الشعبية” بين منظمات المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية، والجماعات الدينية. وهو النمط الذي قد أثبت فاعليته بالفعل، في ربط قطاعات كبيرة من أبناء الدول الإسلامية بالنموذج الخارجي الذي طرحته مصر في عام حكم الرئيس محمد مرسي (والذي بالطبع كان أكثر تماسكا من الأداء الداخلي). وهذه الأواصر المجتمعية العابرة للحدود ضرورية إذا كانت الدول ” مابعد الاستعمارية ” تسعى لتحصيل الدعم الشعبي والزخم اللازم، لتحقيق نتائج ملموسة على صعيد إعادة تأطير العلاقات الدولية على أساس من الندية والمساواة والعدل.
[1] Matz, Nele. “Civilization and the Mandate System Under the League of Nations as Origin of Trusteeship,” Max Planck Yearbook of United Nations Law Vol 9, 2005, p48.
[2] Fawaz Gerges, “What changes have taken place in US foreign policy towards Islamists?” Contemporary Arab Affairs Vol 6, No. 2, 2013, p190.
[3] Ewan Stein, “Jihad Discourse in Egypt Under Mohammed Morsi,” December 2014, p176.
[4] Siba Grovogu, “A Revolution Nonetheless: The Global South in International Relations,” The Global South Vol 5, No. 1, 2011, pp178-181.
[5] Mark Laffey, “Locating Identity: Performativity, Foreign Policy, and State Action,” Review of International Studies 26, 2000, pp431-432.
[6] Ibid, p433.
[7] Mustafa El-Labbad, “Egypt: A Regional Reference in the Middle East,” in Henner Furtig (ed), Regional Powers in the Middle East, New York: Palgrave Macmillan, 2014, pp81-82.
[8] Khawaja, “Egypt’s Foreign Policy Analysis: From Nasser to Morsi,” Pakistan Horizon 66, No. 1-2, p43.
[9] الرئيس محمد مرسي في خطاب قمة عدم الانحياز في طهران، 30 أغسطس 2012.
[10] وليست الإشارة إلى الارتباط بين الحزب والجماعة من باب الطعن في استقلالية الحزب. بل إن التصوير السلبي لهذه العلاقة والطعن في حزب الحرية والعدالة بصفته “حزبا دينيا” منبثقا عن جماعة دينية كان أحد تجليات هيمنة المركزية الأوروبية على تعريف الظواهر السياسية والاجتماعية المحلية وعجز أدوات ومناهج التحليل التقليدية عن الإحاطة بأبعاد الظواهر محل الدراسة في العالم الإسلامي والشرق الأوسط. وهذه التفرقة لا تحمل تقييما سلبيا أو إيجابيا للأداء السياسي للحزب، بل تشير فقط إلى أن ثنائية المدني-الديني التي فُرض على خطاب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الدوران في فلكها منذ الأيام الأولى لثورة 25 يناير كانت أداة استقطابية وإقصائية – وهو ما يحمل دلالات كثيرة عن طبيعة التضامن الاجتماعي بين التيارات السياسية المختلفة في مصر منذ قيام الثورة.
[11] من خطاب الرئيس محمد مرسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 14 سبتمبر 2012.
[12] إدارة الرصد والتوثيق، “عندما حكم مرسي: الزيارات الخارجية،” المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، 20 يونيو 2019، .
[13] Nabil Fahmy, “Egypt’s Morsi Gets Marks for Speed, Not Style, in Foreign Policy,” Al-Monitor, https://www.al-monitor.com/pulse/fa/politics/2012/10/morsis-foreign-policy-grading-could-do-better.html.
[14] Yasmine Farouk, “More Than Money: Post-Mubarak Egypt, Saudi Arabia, and the Gulf,” Gulf Research Center 2014, p6.
[15] Gamal Hassan, “A Revolution Without a Revolutionary Foreign Policy,” Adelphi Series 55, p152.
[16] من المؤتمر الصحفي للرئيس مرسي مع نظيرته البرازيلية ديلما روسيف.