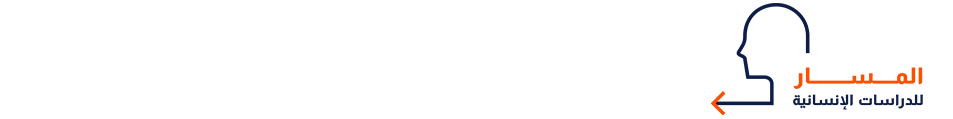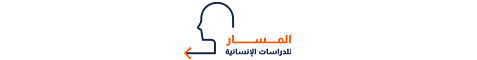لماذا نقدم المساعدة للآخرين؟
قراءة في نظريات علم النفس الأخلاقي
عمر عابدين
باحث في قضايا السياسة والمجتمع
يُعد مفهوم “المساعدة”، أحد أهم مفاهيم مجال علم النفس الأخلاقى المتفرع من علم النفس الاجتماعى، وعلم النفس، لدراسة “السلوك الاجتماعى الإيجابى” و لتفسير دوافع البشر نحو المساعدة وما شابهها من صفات، مثل: التعاون، والإيثار، وحب الخير للآخرين، ..إلخ.
هناك دافعان للبشر نحو مساعدة الآخرين، إما لأن الذى يساعد يؤمن بالخير وبقيمة العمل التعاونى، (النظرية القيمية)، أو لأنه يقدم مساعدة مقابل توقعات من الطرف الآخر على المدى القريب والبعيد (نظرية التبادل الاجتماعى). هذان النوعان من البشر ينظران إلى حالة الطبيعة وطبيعة البشر من منطلق إيجابى، بمعنى: أنهم يرون الخير فى الإنسان، لا الخطئية ولا العداوة؛ فالمساعدة واجبة، إما لأن المساعدة تنبع من طبيعة العمل الخير، أو لأن الخير هو قيمة غير متجزئة يرثها الأجيال، فمن المتوقع أن المساعدة ستُرد إما بشكل وقتى، أو فيما بعد، فى فعاليات مشابهة أو غير مشابهة، فالخير هو نتيجة حتمية.
تفسر النظرية القيمية سلوك “المساعدة” بمنطلق عاطفى، مشاعرى، وقيمى. تضع النظرية القيمية “الإيثارية العاطفية” والقيمية، و”الإيثارية الجذرية”، فى مركز تحليلها لسلوك المساعدة. فالناس يعاون بعضهم البعض لإيمانهم بقيم “الإيثار”، وحب الآخرين بقدر حبهم لأنفسهم، لا لحب النفس. فالمتغير المستقل هنا،هو: “العاطفة الإيثارية نحو المساعدة”، في حين كان المتغير التابع هو: “سلوك المساعدة” نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تنفى المدرسة القيمية، وجود “المصلحة الذاتية” فى أى مرحلة من مراحل التعاون. ينظر بعض المنظرين إلى النظرية القيمية على أنها لا تخاطب العقل، بل هى فى حالة مخاطبة جزئيات لاعقلانية.
بينما تفسر نظرية “التبادل الإجتماعى”، سلوك المساعدة طبقاً للرغبة فى تعظيم المكاسب، والحد من الخسائر، عن طريق اتباع أفعال وردود أفعال قائمة على مبدأ “الرد بالمثل”.
يرى منظرو علم النفس الاجتماعى، أن “الأعراف الاجتماعية” والثقافية يمكن أيضا أن تفسر دوافع البشر نحو المساعدة. فمن المرجح هنا أن البشر يساعد بعضهم بعضا، ليس بناء على “قيم نقية” “عاطفية”، أو “تبادلية”، ولكن المحفز هنا يكمن فى التعاليم المجتمعية. فالتعاليم المجتمعية المتعارف عليها، والمقبولة من قبل أفراد المجتمع، والتى تخضع لمبدأ “مأسسة الأعراف” تحت هيكل اجتماعى وفاعلين مجتمعيين مؤثرين- هى التى تزرع مبدأ حب الخير والمساعدة كقيمة أولاً ، ومن ثم أصبحت “عُرفا”. وبتعبير آخر، هناك “عقد اجتماعى”، بين مؤسسات المجتمع والفاعلين المؤثرين وأفراد المجتمع، هذا العقد مربوط بكمٍّ من التعاليم التى “تُطبَع” مع الوقت لتصبح عرفاً، على الجميع قبوله، وعدم الخروج من فلكه. فمثلا؛ يفسر منظرو هذه النظرية، مساعدة صغار السن لكبارالسن فى المرافق العامة على أنها عرف مجتمعى سنَّته الأسرة، والمسجد (أو الكنيسة)، والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، أو الأفراد الفاعلين (مثل رب الأسرة، إمام المسجد، كبار القبائل، رئيس الدولة فى محل السلطة التقليدية الويبارية، إلخ)، ليس لأن صغار السن يرجون مكسباً مقابل تلك المساعدة، وليس لأن مصدر المساعدة ينبع من واجب أخلاقى قيمى.
هناك بعض العوامل الأخرى التى تفسر جوانب أخرى لسلوك المساعدة، فى سياق اجتماعى ونفسى، مثل”العامل الجندرى”، و”الشكل الثقافى”، و “المزاج النفسى والاجتماعى”. فمثلا؛ العامل الجندرى يفسر مواطن مساعدة الذكور والإناث، فيرى أن الرجال يقدمون المساعدات فى الظروف الصعبة، والخطيرة، في حين يقدم النساء مساعدات فى أوقات أقل خطورة، وهذا يتعلق بالقدرة “العقلية” و”الجسدية” لكلاهما. وإذا نظرنا إلى عامل “الشكل الثقافى”، فإن المجتمعات ذات الثقافات “الفردانية” يميل أفرادها إلى تقديم مساعدات خارج سياق المجموع، فى سياقات فردانية، بغض النظر عن الدافع “قيمى” أو “تبادلى”. فى حين أن المجتمعات ذات الثقافة “الجماعية” تميل إلى اتخاذ سلوكيات تميل أكثر إلى أخذ قرارات داخل إطار المجتمع والأعراف المجتمعية، بما يخدم الصالح العام. أضف إلى ذلك، عامل “المزاج”، الذى من خلاله يمكننا فهم أن الناس يقدمون مساعدات فى أوقات السعادة، والرضاء المجتمعى، والوظيفى والنفسى. فى حين أنهم لا يميلون إلى تقديم مساعدات فى أوقات الأزمات النفسية والضغط، وعدم الرضاء عن أدائهم بما يخدم تحقيق أهدافهم المجتمعية والنفسية؛ فمثلا، هؤلاء الذين لا يشعرون بـ “احترام وتقدير للذات” لا يميلون لتقديم مساعدات، وينكمشون فى بقع ومساحات ضيقة، على حين نجد الآخرين الذين يثقون فى أنفسهم ويقدرون ذاتهم، محققين”الذات الاجتماعية”، يرجح لديهم تقديم مساعدات للآخرين.
علاوة على ذلك، هناك عوامل “ظرفية وسياقية”، مثل الموقع الجغرافى:”الريف والمدينة”، والطقس الحار والبارد، و”عدد المارة”. فمثلا، القرى والمناطق ذات الطابع الريفى تحتفظ أكثر بالأعراف الاجتماعية المهيمنة بدلا من القوانين الجبرية، مما يجعل أفراد “القوة التعاونية” تأخذ مكاناً أفضل فى القرى أكثر من الريف.
وإذا أخذنا عامل “الكم” أو “العدد” فى الاعتبار، فإنه يحمل أهمية كبيرة عند علماء علم النفس الاجتماعى فى تفسير صعود وهبوط منحنى المساعدة. فترى ما يسمى بنظرية “تأثير المارة”، أي إنه “كلما زاد عدد المارة قلَّ حس البشر نحو المساعدة”، ففى تجربة أُجريت، لتوضيح أثر المارة، قام شرطى بتمثيله لضرب طفل صغير فى الطريق العام، حيث يتواجد عدد أكثر من 30 فردا، فكان رد الفعل هو “المشاهدة” و”الصمت”، وعندما كُررت نفس الواقعة، فى مكان يضم عدد أقل، كانت النتائج تعاونية أكثر، وحدث تدخل بالفعل لمعاونة الطفل المضروب. يفسر منظرو نظرية “تأثير المارة” أنه كلما زاد عدد المارة، زاد حس اللامبالاة، و”توزيع المهام”، و “تجاهل الأغلبية”، فيصف منظرو علم النفس الاجتماعى تجاهل الأغلبية بأنه الوعى الخاطىء وبأنه ثمة تجاهل يحدث، وهذا التجاهل سببه أن الجميع يعتقد فى أمرين، الأول هو أن الآخرين سيقومون يتقديم المساعدة، أما الثانى، فهو أن “الجميع يعتقد بصحة ما يحدث بالرغم من عدم صحته”، فمثلا فى تجربة الولد، الجميع ينتظرأن يقدم أحدهم المساعدة للطفل، أو أن الطفل قد قام بشىء خاطىء يستحق عليه العقاب، على الرغم من وجود احتمال وقوع ظلم على الطفل.
يشير علماء علم النفس إلى أهمية عامل “السن”، فالأعمار حتى 5 سنوات، والأعمار من الـ 65 فما فوق تميل أكثر إلى فعل الخير وتقديم المساعدة للآخرين؛ لأنهم يؤمنون بالخير فى نفسه أكثر من كونهم يقدمون المساعدة لأجل علاقات تبادلية، فيما تفضل الأعمار التي تقع بين 5 سنوات و 65 سنة ، فعلَ الخير بناء على إيمانهم بمبدأ “الرد بالمثل”؛ فالخير يُرد بالخير، والشر يُرد بشر مثله أو مشابه له. وقد يُفسر التفاوت في رد الفعل لدى الأعمار المشار إليها، إلى نشاط القوى العقلية والإدراكية، واسترخاء الذهن؛ فكلما زاد الوعى، ونشط المخ زاد حس “الكسب” والمصلحة. فمثلا إذا طلبت من طفل صغير أى طلب صغير كان أو كبير، فسيلبيه على الفور، أو أنه سيحاول قدر المستطاع أن يقوم به، ولكنك إذا طلبت مساعدة من شاب فى الثلاثينيات من عمره، فمن المرجح أن يقوم بالعمل، لإيمانه به، أو إنه سيطلب مقابلا بشكل وقتى ومباشر، أو إنه سينتظر منك شيئا ما فى المستقبل المنظور والبعيد.
ومن التفسيرات المساعدة القائمة على العلاقات التبادلية، هى أنها تعتمد أيضا على “الحسابات العقلانية”. وبعبارة أخرى، تفسر هذه النظرية: أن البشر يقدمون المساعدة بناء على “التكلفة” و “الفائدة”، وهنا التكلفة هى “الفعل”، أما الفائدة فهى ما ينتظره المُعاون من الطرف الآخر، أو ماذا أُقدم فى مقابل ماذا؟
وأيضا، فى دراسة توضح العلاقات التبادلية، كإحدى النظريات التفسيرية لدوافع الناس نحو المساعدة، أُجريت الدراسة على عدد من العلاقات الزوجية، واستخلصت التجربة أن العلاقات الزوجية التى تتسم بالتعاون وحسِّ المساعدة هى علاقات ذات طابع تبادلى ومنفعى، وحسابات عقلانية، أكثر من كونها قيمية، بمعنى أن الطرفين عناصر فعالة فى العلاقة، فمثلا (وليس نموذجا) الزوج يعمل والمرأة تربى الأولاد، أو الرجل والمرأة يعملان، الرجل يعطى القوة، في حين تعطى المرأة العاطفة والحنان. ومن هنا يكون الرجل والمرأة شريكان “متعاونان” ليس من أجل حب المساعدة كقيمة فى ذاتها، ولكن لأن كلاهما ينتظر وظيفة من الآخر، فالقوة تُرد بعواطف، والأموال تُرد بسكينة منزلية، وهكذا. وفى أكثر (وليس كل) الأسر التى أجريت عليها الدراسة، لم يكن لأحد الطرفين دور سلبى فى العلاقة، ولكنه لوحظ توزيع للمهام بين الزوجين، وهذا ما زاد من “القوة التعاونية” بين الطرفين، وهو ما يربطه العلماء أيضا بسعادتهم فى معظم فترات حياتهم، خاصة بعد مرور خمس سنوات من الزواج. فالتعاون وحس المساعدة المتبادل يزيد من عُمر العلاقة الزوجية، أكثر من بناء العلاقات على كم من المشاعر التى قد تكون هشة فى أوقات عدة.
وهناك أمثلة عدة على ذلك؛ فمثلا العلاقة بين المعلم والتلميذ، قد تتسم بالتعاون: فالمعلم يبذل قصارى جهده أو ما يزيد عن المطلوب منه فى مقابل نيل الاحترام والوقار من الطلاب، أو لأجل المقابل المادى، ومن الممكن أيضا لأنه يؤمن بقيمة العلم، وبقيمة المعلم ودوره فى تربية الأجيال. والعلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ فمن الممكن أن نرى دولا تقدم دعما حكوميا لعدد من البضائع الاستهلاكية، ودولا تهتم بالمهمشين والفقراء، ودولا تسير فى طريق توفير الرفاه، فهنا يمكن أيضا أن تُقرأ هذه السياسات الداعمة للمواطن بمنظور قيمى أو تبادلى، وذي طابع حسابات عقلانية، بمعنى أن الدولة تساعد الفقراء لإيمانها بأن الفقراء هم جزء من المجتمع، ودعمهم واجب أخلاقى وقيمى ، أو لأن الحكومات الداعمة تنتظر شىيئا ما من هؤلاء المدعومين من الفقراء وغيرهم، مثل عدم الخروج على حكمهم، وتوفير الاستقرار للبلاد، وتطويل مدتهم فى الحكم، لا لأن يثوروا عليهم. فكل مساعدة قد تكون مبنية على دوافع “قيمية”، أو دوافع “تبادلية”.
هنالك قسم آخر يقدم مساعدة بدون قيمة وبدون مقابل (علاقات تبادلية)، هؤلاء إما أنهم يجهلون أو لا يدركون ، أو يتغاضون عن فهم (بقصد أو بغير قصد) “قيمة” “وعواقب” ما يقومون به (أوإحداها)، أو لأنهم غالبا ما يقدمون المساعدات لأغراض غير نبيلة (مثل المساعدة فى الشرور، والقتل.. إلخ)، هؤلاء الناس يفعلون الشر، لأنهم لايؤمنون بوجود الخير فى البشر، وبالتالى فهم يرون أن “حالة الطبيعة” تنبع من الشر لا الخير، وأن الجميع فى صراع، وأن الإنسان عدو لأخيه الإنسان، لذلك فإنه لا مكان للخير، وبالتالى فمصطلح المساعدة عندهم لا يحمل معانى إيجابية، ولكنه يحمل معانى سلبية، مثل البغضاء والكراهية وحب النفس وغيرها.
هناك أيضا مدرستان من خلالهما تُفهم دوافع البشر، نحو الخير والشر، المدرسة العواقبية، ومدرسة الأخلاق الواجبة. الأولى تؤمن أن العمل تنبع أهميته فى نتيجته، وعواقبه ومن هنا جاءت المقولة الميكيافيلية الشهيرة:” الغاية تبرر الوسيلة”؛ فمن الممكن أن يكون العمل جيدا، ولكن نتائجه سيئة، ومن الممكن أن يكون العمل سيئا، ولكن نتائجه جيدة، فالقيمة ليست فى العمل نفسه، ولكن في ما بعد العمل، أى النتيجة. فإذا طبقنا هذا على مفهوم المساعدة، فإذا كانت المساعدة وما شابهها من صفات مثل الإيثار، قد تفرز “نتائج” إيجابية فهى واجبة إذن. من هنا فهى خيًرةَ. وإذا كانت الأفعال غير الخيرة، مثل الأنانية وحب النفس، أو مثل العنف، قد تفرز إفرازات للصالح العام أو لصالح الأفراد، فهى مباحة وواجبة فى وجهة نظر من يؤمنون بنتيجة الأفعال وليس بقيمتها. فمثلا، إذا كان عقاب الأب للابن، أو ضربه، أو حرمانه، أو دفعه نحو تحمل مسؤليات وأعباء شاقة، قد يفرز إنسانًا مسؤولا فى المستقبل، فهذا جيد، ليس لأن العمل جيد (الضرب مثلا)، ولكن لأن النتيجة وعواقب العمل جيدة. ومن هنا يمكن أيضا أن تُبرر أفعال العنف والقتل مثل حرب العراق، على أنها تحمل خطوات عنيفة ودموية، ولكن هذا لعواقب نبيلة وهى القضاء على القواعد الإرهابية، وجلب الديموقراطيات للدول غير الديموقراطية. هناك من ينتقد منظرو هذه المدرسة لكونهم لا يضعون شروطا ولا قواعد للخير والشر، ولهذا، فمن السهل التلاعب بما هو خير وبما هو شر فى سبيل الوصول إلى نتائج بعينها، بالإضافة إلى ضبابيتها. يمكن أن تُقرأ هذه المدرسة على أنها غير متوقعة فى أفعالها، لأنها لا تعترف بجوهر الخير والشر، ولكن السلوكيات متغيرة بتغير الظروف والمواقف، والسياق، فالمحتوى متغير بتغير المواقف، فلا شىء يمكن توقعه، سوى أن هناك شيئا ما يحدث.
على عكس ما سبق، ترى المدرسة الكانطية، أن العمل (الفعل) يستمد من قيمته، وليس من نتيجته وعواقبه. فالعمل خير لأنه الخير فى قيمته وفى أصله، ليس لأنه سيفرز نتائج جيدة فحسب. يؤمن تابعى هذه النظرية بمعايير أخلاقية ثابته؛ فالفعل الجيد يؤدى إلى عمل جيد، والفعل الذى يحمل صفات سئية يؤدى إلى عواقب وخيمة. فإذا طبقنا هذه النظرية على مفهوم المساعدة، والتعاون، فإن المساعدة يُنظر إليها على أنها مبدأ خير فى نفسه. فمثلا معاونة المارة أو كبار السن، أو الضعفاء، أو ذوى الاحتياجات الخاصة، كل هذه أفعال تأتى أهميتها فى الإيمان بالخير نفسه، ليس لأن المارة بتقديمهم المساعدة سينجون من عواقب الطريق، وليس لأن كبار السن يحتاجون مساعدة الباقين، أوليس لأن هناك أعرافا وتقاليد اجتماعية مُتفق عليها تأمرنا باحترام الكبار وتقديم المساعدة لهم كواجب اجتماعى. وعلى نفس النمط، فدوافع كبار رجال الأعمال والجمعيات الخيرية، لا تنبع من أنهم يفعلون الخير لأن الضعفاء سيكونون أكثر سعادة وأقل عناء بتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم، ولكن لأن الدعم المادى والمعنوى خير فى قيمته بغض النظر عن عواقبه.
ختاما:
فى هذا المقال، تم عرض للنظريات والعوامل المختلفة لفهم لماذا يساعد البشر بعضهم بعضا؟ مع عدم تفضيل بعض هذه النظريات على بعض. بالإضافة إلى ذلك، فإن قيم الخير والشر لا تخضع للنسبية، فهى قيم مطلقة، فالمساعدة أو الشروع فى الكراهية كلاهما سلوكان مختلفان لا يمكن التلاعب بتعريفاتهما بتأطيرات نسبية مختلفة.