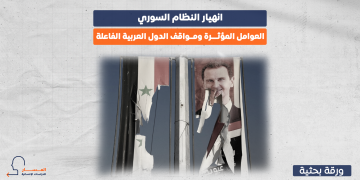ملاحظات حول مسارات الانتقال إلى الديمقراطية في الدول العربية
د. عبدالفتاح ماضي
أستاذ العلوم السياسية
https://www.abdelfattahmady.net
تستهدف هذه المقالة التي أعدت لتقديمها في ندوة “مستقبل الديمقراطية في الدول العربية”- التي ينظمها مركز المسار للدراسات الإنسانية في 27 حزيران/ يونيو 2020 – أمرين:
الأول: فهم ماذا حدث في الجولة الأولى من الثورات العربية التي اندلعت في أواخر العام 2010 في تونس، وامتدت إلى مصر وليبيا وسوريا والمغرب والبحرين.
والثاني: كيف يمكن استعادة مسارات الانتقال إلى الديمقراطية، في ظل الأوضاع الحالية، ولا سيما في ظل الموجة الثانية التي بدأت في السودان في أواخر 2018 ، ثم امتدت إلى الجزائر والعراق ولبنان في 2019.
سأتحدث عن موضوعين، الأول يتعلق بفهم ما حدث في الموجة الأولى من الثورات العربية، أي سؤال لماذا تعثرت هذه الموجة؟ أما الثاني فيرتبط بالمستقبل، وسؤال ما العمل؟ وسأستخدم أداة المقارنة، لربط الحالات العربية ببعض التجارب الأخرى، بهدف إظهار أوجه الشبه والاختلاف، واستخلاص بعض الدروس.
لكن من الأهمية التمهيد لهذين الموضوعين بنبذة مقتضبة عن سؤال كيف تتغير نظم الحكم؟. فأنواع نظم الحكم المعاصرة متعددة، فهناك نظم حكم شمولية، وفردية، وتسلطية، وديمقراطية، وبوليسية، وعسكرية، وهناك نظم هجينة، وغير ذلك. ويكون تغير نظم الحكم في كل الاتجاهات تقريبا، أي “من” و”إلى” أي نظام من هذه النظم.
ومن هنا، فالانتقال إلى النظم الديمقراطية – تحديدا – يمثل نمطًا واحدًا من أنماط التغيير، وهو وإنْ شكّل ظاهرة وهدفًا مرغوبًا فيه في العقود الأخيرة، بيْد إنّ نجاحه ليس بالأمر اليسير، نظرًا لأنه يتوقف على عوامل متعددة، بعضها يتعلق بالسياقات والعوامل الهيكلية، وبعضها الآخر يتصل بالفاعلين ومواقفهم واختياراتهم، بل وهناك أيضا عوامل عرضية قد تساهم في النجاح أو الفشل. وبالإجمال، فإن ثلث الحالات تقريبا هي التي تنجح في الانتقال إلى الديمقراطية، في حين أن بقية الحالات تفشل بشكل أو بآخر. وبالتالي ما حصل عندنا في الدول العربية هو للأسف الأكثر شيوعا.
كما يشهد العالم منذ أكثر من عشر سنوات ردة عن الديمقراطية، ونزعات معادية لها، بما في ذلك الدول الديمقراطية الغربية، وذلك مع تصاعد الشعبوية، واليمين المتطرف، وتغول الرأسمالية، وضعف الأحزاب السياسية، وسيطرة المال السياسي والشركات الكبرى.
قدّمت أدبيات السياسة المقارنة المعنية بدراسة الديمقراطية – السابقة على موجة التحول الديمقراطي التي بدأت في سبعينيات القرن العشرين – مدخلا يفسر نجاح الانتقال إلى الديمقراطية أو فشله، يستند إلى نظرة تحليلية كلية، وإلى افتراضات نظرية التحديث، التي ترى أن الانتقال ينجح عندما تحقق الدولة حدًا أدنى من مؤشرات التحديث في الاقتصاد والمجتمع، وهو ما عُرف لاحقا بالمدخل الهيكلي، أو مدخل الشروط المسبقة.
ثم تحول الاهتمام في العقدين الأخيرين من القرن العشرين إلى ما أطلق عليه مدخل الانتقال إلى الديمقراطية، أي التركيز على سلوك الفاعلين؛ حيث يكون مفتاح التحول الديمقراطي الناجح هو إجماع النخب فيما يتعلق بشرعية قواعد النظام الديمقراطي البديل، وقدرتها على التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقيات تقدم لكل طرف جزءًا مما يريده. وعادت دراسات أخرى إلى الاهتمام بالسياقات الهيكلية، كالأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية والتاريخ، والثقافة، وغير ذلك. وبرغم بعض التشابهات أو الاختلافات بين الحالات المختلفة، فليس هناك نظرية عامة أو نموذج تفسيري واحد لنجاح الانتقال إلى الديمقراطية.
يوضح الشكل التالي العوامل المؤثرة في تغيير نظم الحكم في العصر الحديث، حيث هناك عاملان محوريان، هما:
– اتفاق القوى الوطنية الرئيسة على نظام حكم بديل؛
– ودعم – أو على الأقل عدم معارضة- الخارج للانتقال إلى هذا النظام البديل.
وهناك عوامل أخرى وتفاصيل كثيرة في هذا الموضوع لا تتسع مساحة هذا المقال لها.

شكل توضيحي: أبرز عوامل الانتقال إلى الديمقراطية في العقود الأربعة الأخيرة
أولا: لماذا أخفقت الموجة الأولى من الثورات العربية؟
لا تقدم أدبيات ما يسمى بالانتقال الديمقراطي أجوبة كثيرة عن سؤال: لماذا أخفقت الموجة الأولى من الثورات العربية، برغم أنها تقدم بعض التفسيرات الجزئية، مثل أهمية التوافقات الكبرى كما حدث في الحالة التونسية، أو فشل الانتقال في ضوء الانقسامات الحزبية أو تدخل العسكريين في الحالة المصرية، أو صعوبة تغيير نمط الحكم العربي الذي اتسم بدرجة عالية من الإقصاء. وحسب أكثر من دراسة كتبتها في السنوات الماضية (انظر أرشيف الكاتب)، يمكنني أن أقف عند ثلاث ملاحظات كبرى لم تحظ بالكثير من الاهتمام من الباحثين، أولها تتصل بطبيعة عملية التغيير ذاتها، وثانيها تتعلق بطبيعة الفاعلين الرئيسيين وإدارتهم للمراحل الانتقالية، أما الملاحظة الثالثة فتهتم بإشكاليات متصلة بالعوامل الخارجية.
1- طبيعة عملية التغيير
من المهم هنا التوقف عند الكيفية التي أثرت من خلالها طبيعة الأنظمة العربية في شكل عملية التغيير. هنا أدبيات الانتقال الديمقراطي مفيدة، فبشكل عام كلما كان النظام عنيفًا، كان الصراع داخله صراعًا صفريًا بين نخبته أو طبقته الحاكمة من جهة، وبين خصوم هذه الطبقة (وليس المعارضة) من جهة أخرى، وكلما كانت أيضا هذه الأنظمة أقرب إلى التغيير بطرق عنيفة من أسفل، كالانقلابات والثورات والعصيان المسلح.
وتصاحب هذه الإشكالية إشكالية أخرى هي أن طريقة التغيير الثورية تؤثر بالسلب على محاولات تشكيل النظام السياسي البديل، فمن الصعوبة بناء نظام ديمقراطي بديل في الدول التي تتغير نظمها السياسية عن طريق العنف، وبرغم أن الثورات تُمثّل فرصةً للتغيير الشامل، فإنها تضع صعوباتٍ جمّة أمام عملية الانتقال الديمقراطي.
عربيا، نشأت “الدولة” نشأةً مشوهةً منذ البداية، فلم تستند أنظمتها السياسية إلى مرجعية سياسية (political frame of reference) متسقة مع ثقافة مجتمعاتها العربية وتراثها، كما أنها أقامت سلطةً مستبدةً تعمل لمصالح ضيقة ومرتهنة في بقائها على تحالفات مع قوى داخلية وخارجية معادية لتمكين الشعوب وثقافتها. فضلا عن أنها رسّخت التقسيم الذي خلفه المستعمر في تناقض تام مع منطق وكيان الدولة الحديثة ومبدأ القوميات الذي يهتم أساسا بوحدة الشعوب.
إن طبيعة هذه الأنظمة العربية قريبة الشبه بنظم الحكم الفردي في أفريقيا ومناطق أخرى بما كان يعرف بالعالم الثالث. فالانقسام الأبرز داخلها لم يكن بين النظام والمعارضة، وإنما بين من هم ضمن دائرة الحكم – بمنافعها المادية والمعنوية وبين من هم خارج تلك الدائرة (من استبعدتهم السلطة). وكلما ارتفعت حدة الصراع حول الامتيازات، ارتفعت دوافع المستبعدين للخروج على النظام، ليس لإصلاحه أو إقامة نظام ديمقراطي، وإنما لتقلد السلطة للحصول على امتيازاتها ومنافعها.
جعلت هذه الطبيعة الأنظمة العربية غير قابلة للإصلاح من الداخل، ومن ثم اندلعت الثورات. وقد فهم عدد من مثقفي العالم العربي هذا الأمر مبكرًا، من هؤلاء طارق البشري الذي دعا المصريين، في مقال شهير عام 2004 إلى العصيان المدني على اعتبار أن الأنظمة العربية لن تتغير بالطرق التدريجية، كما كتب المنصف المرزوقي مُشبّها الأنظمة العربية بالاحتلال. هذا، مع الإقرار بقدر من التفاوت بين هذه النظم الإقصائية، فتونس ومصر كانتا أقل سوءًا من سوريا وليبيا، لكن في النهاية كل هذه النظم تعرضت لثورات شعبية، واختلفت مسارات الانتقال فيها باختلاف اختيارات الفاعلين الرئيسيين وتباين تأثير السياقات الإقليمية والدولية.
كان الفاعل الرئيس في تغيير هذه الأنظمة هو الشعوب، عبر تعبئة شعبية قامت بها حركات شبابية واحتجاجية. وهذا الفاعل كان يُنظر له في كتابات بحثية غربية وعربية، على أنه أحد الأسباب الرئيسة في بقاء أنظمة الحكم الاستبدادية، لأنه يحمل ثقافة لا تتلاءم مع الحداثة والديمقراطية. جاءت ثورات 2011 لتثبت بجلاء عدم دقة هذه الافتراضات. وهذا ينقلنا إلى الملاحظة الثانية.
2- طبيعة الفاعلين السياسيين وإدارة المراحل الانتقالية
ترتيبًا على الملاحظة الأولى، ظهرت فجوة بين الفاعل الشعبي، والفاعل النخبوي، والفاعل الاحتجاجي الشبابي.
نعم ساهمت نخب الأحزاب والقوى المعارضة التقليدية في خلق المناخ الفكري والسياسي العام الذي جَعَلَ الثورات ممكنة. كما أن تقارب التيارات الإسلامية والليبرالية واليسارية والقومية في عدة مبادرات عابرة للأيديولوجيات (كحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير في مصر، ومبادرة 18 أكتوبر في تونس، واللقاء المشترك في اليمن) ساهم في هذا، لكن عملية التعبئة الشعبية عامي 2010-2011 تمت على يد حركات احتجاجية شبابية لم تكن جزءًا من المعارضة التقليدية، بل كان ذلك بغير رغبتها في بعض الحالات.
إن الجماهير سبقت النخب في الفعل المؤثر، في حين فشلت النخب في تحويل مطالب الجماهير إلى مشاريع وطنية وبرامج سياسية، وأخفقت في إدارة اختلافاتها، بل راحت تصدر هذه الاختلافات إلى الشارع.
لكن ومن جهة أخرى أثبتت الحالات العربية، والمصرية تحديدا، أن حركات الاحتجاج الشبابية أخفقت في تغيير ميزان القوة بين أنصار الثورة وخصومها، إذ إنها اكتفت بدور هدم النظام القديم، ولم تشترك في عملية إدارة المرحلة الانتقالية وبناء البديل. لقد انتظرت من – بل طالبت – الآخرين القيام بتلبية مطالب الثورات، وتركت الساحة السياسية للقوى التقليدية التي ضمّت قوى محسوبة على الثورة من أحزاب المعارضة القديمة (قبل 2011) ومن بعض القوى المحسوبة على الأنظمة القديمة أيضا.
لم تمتلك القوى الاحتجاجية الثورية القدرات الفكرية والتنظيمية التي تُمكّنها من المساهمة في الاتفاق على النظام الديمقراطي البديل وخارطة الطريق للوصول إليه. لم تتفق على الديمقراطية ذاتها كمصلحة مشتركة تضمن التعايش والتنافس السلمي للوصول للسلطة، ليس كغاية في حد ذاتها، وإنما كوسيلة لتحقيق سياسات وبرامج عامة تحقق المصلحة العامة للجميع.
وكانت تونس الاستثناء الوحيد حتى الآن، أمّا في مصر، فكان خطاب الكثير من الحركات الاحتجاجية الشبابية منصبًا على نواتج النظام السياسي المرغوب، وليس على كيفية بناء النظام ذاته (المؤسسات والآليات والضمانات) الذي يمكن من خلاله الوصول إلى تلك الغايات، عبر صنع السياسات وبرامج العمل.
وللأسف لا تزال بعض الحركات الاحتجاجية الحالية في الجزائر والعراق ولبنان تكرر أخطاء الموجة الأولى، إذ – في ظل حالة التصحر التي يعاني منها العمل السياسي بشكل عام – يقتصر نشاط هذه الحركات على المطالبة بتحقيق أهداف مشروعة، لكن دون أن تتشكل قوى أو تنظيمات تؤطر هذه الأهداف في مشاريع وبرامج سياسية.
تختلف هذه الأوضاع عن حالات انتقال أخرى في أمريكا اللاتينية وجنوب وشرق أوروبا، حيث وصل الفاعلون الذين قادوا التغيير، إلى السلطة أو شاركوا فيها عبر أحزاب أو ائتلافات أو حركات مجتمع مدني ذات برامج سياسية تتنافس في الانتخابات، وحيث فضّل رجال الأعمال الديمقراطية على الحكم الفردي، عندما أدركوا أنها ستحمي حقوق الملكية ومصالحهم التجارية، وتقلل من عنصر اللايقين عبر قنوات سلمية، يمكن التوقع بشأنها.
وفي الحالات العربية، مثّلت القوى القديمة مصدر التهديد الأول للديمقراطية، نتيجة خوفها من أن تتضرر مصالحها الاقتصادية، ونتيجة فشل قوى التغيير في جعل الديمقراطية مصلحة لها. هذا فضلا عن تلقيها دعمًا خارجيًا مؤثرا.
كما أسهمت طريقة وتوقيت تعامل الفاعلين السياسيين مع إرث الأنظمة القديمة والملفات الكبرى الأخرى (قوانين العزل مثلا) في تعزيز الاستقطاب، وهو ما ساهم في تحالف المتضررين في الداخل، ومن ثم تحويل المسألة إلى صراع صفري عنيف بين جبهتين متصارعتين.
وهناك إشكاليات عدة أخرى، أهمها اللجوء إلى آلية الانتخابات في ظل استقطاب حاد وقبل تحقيق الحد الأدنى من التوافق. فالحالات العربية تقترب هنا مما اصطلح على تسميته “الثورات الانتخابية”، التي تشير إلى حصر الديمقراطية ومطالب التغيير في الانتخابات واختيار الحكام، بدلا من الاهتمام بكل أركان الديمقراطية المتعارف عليها.
أي أن المشكلة ليست في الانتخابات ذاتها، وإنما في التسرع في إجرائها على أسس دستورية وقانونية مرتبكة، أو لم تحظ بقدر كاف من التوافق والمشاركة. وقد حدث هذا في مصر وتونس وليبيا.
ويزداد اللجوء إلى الانتخابات قبل التوافق صعوبة مع الشكوك المتبادلة بين القوى السياسية واللايقين أو الخوف من نتائج الانتخابات، وأيضا مع غياب التوازن بين القوى السياسية الإسلامية التي تمتلك قدرات تنظيمية وتعبوية ورمزية قوية وبين القوى الأخرى الليبرالية واليسارية والقومية.
لقد كان بالإمكان معالجة هذه الأمور تدريجيا بجملة من الاستراتيجيات تقوم على التوافقات والحوارات والترتيبات المؤسسية والدستورية، وكان يمكن اللجوء إلى آلية الحكومات الانتقالية (interim governments) بأشكالها وآلياتها المختلفة. وقد أثبتت الحالة التونسية إمكانية تحقق هذا عندما توفرت متطلبات ذلك داخليًا وخارجيًا.
تشهد المراحل الانتقالية عادة قدرًا من الاستقطاب، إلا أن الحالات العربية أظهرت أهمية عدم تجاوز الحد الذي يؤدي إلى قلب الطاولة على الجميع. وقد نجحت تونس في هذا عندما نجحت في إضافة “شرعية التوافق” إلى “شرعية الانتخابات”، وتوفرت قيادات قوية وخاصة من التيار الإسلامي. أما استقطاب الحالة المصرية فقد ساهم في نقض فكرة الديمقراطية ذاتها، فهناك قوى من كافة التيارات كانت تتحدث عن الديمقراطية، لكنها لم تكن مؤمنة فعلا بها. كما تفاوتت أدوار القوى المحسوبة على التيار الإسلامي، والأخطر من هذا أن الساحة المصرية شهدت وجود فاعلين مؤثرين غير مرئيين يحركون القوى السياسية التي كانت تمارس الفعل السياسي العلني، وهنا يمكننا الإشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، والمجلس العسكري والحكومة التابعة له، والقوى الإقليمية وحلفائها في الداخل.
وفي الإجمال أثبت الاستقطاب أن حجم العداء المتبادل بين التيارات السياسية أقوى من الديمقراطية كمصلحة مشتركة وهدف يتحدث الجميع عنه. كما أن شرعية الانتخابات المرتبكة أو المتسرعة – وقبل الوصول إلى توافقات حقيقية – ساهمت في تحول الثورة المصرية -في مرحلة أولى- إلى “ثورة انتخابية”، ثم في تحول هذه الأخيرة إلى “ثورة مضادة” في 2013.
3- إشكالية الخارج المعادي للديمقراطية العربية
أظهرت الحالات العربية أهمية السياقات الإقليمية والدولية في عرقلة مسارات الانتقال إلى الديمقراطية في الدول العربية من عدة وجوه. فعنصر اللايقين الناتج من أي انتخابات ديمقراطية حقيقية ليس عنصرًا محليًا في الحالات العربية، وهناك ضوء أحمر ترفعه القوى الغربية الكبرى أمام الديمقراطية في الدول العربية منذ الاستقلال تقريبا، إذ تتخوف هذه القوى من أن تفرز الديمقراطية حكومات وطنية تُعيد ترتيب المعادلة السياسية، وتهدد أمن الدولة الإسرائيلية والهيمنة الغربية على المنطقة. كما تتخوف من ظهور تكتل عربي يهدد المصالح الغربية، وقد عبّر هنري كيسنجر عن هذا الأمر بكل وضوح في 2012 عندما كتب عن الثورات العربية مشيرًا إلى أهمية منع ظهور أيّة قوة إقليمية تستطيع أن تجمع دول المنطقة حولها (The International Herald Tribune, April 2, 2012).
وهناك الإقليم المعادي للديمقراطية. فعلى عكس ما حدث في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، حيث كانت الديمقراطية مصلحة إقليمية، ففي الدول العربية قام تحالف إقليمي ضد الديمقراطية التي اُعتبرت خطرًا وجوديًا على بقاء العروش في بعض الدول الخليجية، وعلى الأمن الإسرائيلي أيضا. هذا فضلا عن أن هذا الخطر يعتبر محددًا أساسيًّا للأميركيين والأوربيين في علاقتهم بالعرب و”إسرائيل”.
لم تحصل قوى التغيير العربية من أجل الديمقراطية على دعم خارجي صريح كما كانت الحال في جنوب وشرق أوروبا مثلا. بل على العكس لم يحرك الغرب ساكنًا أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا واليمن ومصر، وهذا ما أسميته سابقا الضوء الغربي الأخضر المرفوع منذ عقود أمام منتهكي الحريات والحقوق من الأنظمة العربية. لقد أثبتت ثورات 2011 أن المواقف الغربية من الديمقراطية العربية هي مواقف بلاغية فقط وتستند إلى نظرة ضيقة، لا ترى ضمان مصالحها إلا من منظور تجاري ضيق، وعبر دعم الحكومات المستبدة في المنطقة.
كما يمثل استخدام خطاب “الحرب على الإرهاب” إحدى استراتيجيات الفاعلين الداخليين والخارجيين لإجهاض مسارات الانتقال السلمي إلى الديمقراطية المعادية لمصالحهم. فالمنطقة دخلت ثلاث مرات على الأقل في “حرب على الإرهاب” خلال العقود الثلاثة الماضية تقريبا، حيث تم في كل مرة تجيير المنطقة، في حرب ضد عدو داخلي في حين يتم أيضا اتباع سياسة تكميم الأفواه، وغلق الحياة السياسية، ووضع كل الإسلاميين في سلة واحدة.
وقد استخدم بنيامين نتانياهو فزاعة الإسلاميين مبكرا؛ فتحت عنوان “خطة نتانياهو لوقف الإسلام”، نشرت جريدة معاريف في 3 أغسطس 2011 تصريحاته الداعية إلى إنشاء صندوق دولي لدعم خصوم الإسلاميين بالعالم العربي على غرار خطة مارشال في أوروبا، وذلك لتشجيع ما أسماه التحرك نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادي، ولمنع الإسلام من السيطرة على الشرق الأوسط. ودعا داني أيالون، نائب وزير الخارجية آنذاك، الدول العربية الثرية إلى تمويل هذا الصندوق.
وتشهد المنطقة العربية أيضا إعادة انتاج افتراضات المدخل الثقافي في تفسير بقاء الاستبداد بالقول إن صراعات المنطقة صراعات أبدية ولها جذور ثقافية وتاريخية تخص المنطقة وتركيبها المذهبي، ما ساهم في تعميق صراعات المنطقة. فَعَلَ ذلك بارك أوباما، عندما قال: إن ما يدور بالمنطقة متأصل في الصراعات التي تعود إلى آلاف السنين (خطاب حالة الاتحاد الأخير في 12 يناير 2016)، ويفعله الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي أقام سياساته منذ حملته الانتخابية على أن الإرهاب سببه هو ما يسميه “الإرهاب الإسلامي المتطرف” (خطاب التنصيب، 20 يناير 2017).
كما أن الثورات العربية جاءت في وقت تتصاعد فيه التسلطية وتتراجع الديمقراطية، حيث تدعم الصين وروسيا الدعم كثير من السلطويات حول العالم. ويضاعف انتشار جائحة كورونا هذا الأثر في ظل قوانين الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وتصاعد طرق الرقابة الإلكترونية.
وأخيرا هناك الترويج للديمقراطية الاجرائية باعتبارها وصفة جاهزة للجميع، ومنتجا غربيا فقط، بل وتم أحيانا الربط بينها وبين الليبرالية كمرجعية عليا للنظام الديمقراطي المنشود واستبعاد أي منظومات قيمية غير غربية. وفي حالات كثيرة يتم الترويج لعمليات الإصلاح الهيكلي على النمط النيوليبرالي على أنها شرط لا مفر منه للانتقال الديمقراطي.
أحدث هذا الأمر توترات جمة بين مختلف التيارات، وأنتج شعورًا قويًا من التشكك – على مستوى النخب والجماهير – تجاه الديمقراطية وتجاه أي سُبلٍ لدعمها. بجانب أنه لا يوجد انبهار بالتجربة الغربية عند الكثير من العرب في الأساس، بالنظر إلى أن هذه الأمة لها إرث حضاري كبير، وذلك على عكس ما كان شائعًا إلى حد كبير في مناطق أخرى، مثل شرق أوروبا، حيث تم استنساخ بعض المؤسسات والممارسات الغربية.
ساهم ما سبق في إهدار فرصة النقاش والحوار حول المخاوف المتبادلة، وصولا إلى بناء نظم حكم ديمقراطية لا تعادي ثقافة المنطقة، وتقوم على حكم القانون والمواطنة الشاملة والكاملة، والتداول السلمي على السلطة بضماناتها المتعارف عليها.
ثانيا: سؤال المستقبل وما العمل؟
أود أن أشير هنا إلى أمرين: الأول متصل بأجندة التغيير عربيا، والثاني: متعلق بسؤال المستقبل أو ما العمل؟
أجندة التغيير
يمكن القول بداية إن الثورات المضادة وسّعت أجندة التغيير عربيا، وفتحت أمام الشعوب العربية الباب على مصراعيه، لتشمل مطالبه العديد من الأسباب الجوهرية للاستبداد العربي وقضاياه الكبرى. لم تكن من أهداف ثورات العام 2011 الانتقام من كل من عَمِلَ مع الأنظمة القديمة، وإنما فتحت الباب أمام الكثيرين لدعم الثورة، أو الاستقالة من العمل العام، كما لم تفتح الملفات المتعددة للسياسات الخارجية للأنظمة القديمة والتي قامت على التبعية للخارج.
لكن ما حَدَثَ هو أن القوى الدولية عادت إلى دعم مصالحها التجارية والعسكرية على حساب الديمقراطية، وتَكَتَّل خصوم الثورات في الداخل والخارج، ونجحوا في إجهاض الثورات وإدخال المنطقة إلى عهد جديد تسوده حالتان لا ثالث لهما. الأولى: الدولة البوليسية القمعية التي تسيطر فيها عصابة محدودة العدد على السلطة والثروة والإعلام، والتي لا مكان فيها حتى للصمت أو الوقوف على الحياد، فالمطلوب من الجميع، إمّا دعم الدولة البوليسية أو الذهاب إلى القبور أو المعتقلات أو المنافي. والثانية: الصراعات والحروب الأهلية، حيث هناك أيضا عصابات محدودة العدد تحتكر السلاح والمال، مع فتح المجال أمام تدخلات إقليمية ودولية سافرة.
وبالإجمال، أدت الثورات المضادة إلى اتساع مطالب الشعوب العربية، وصارت المعركة واضحة المعالم والأبعاد إلى حد كبير.
كما أن عمليات التغيير التي أشعلتها ثورات 2011 عمليات كبرى، تمس القضايا المؤجلة، منذ نشأة النظام العربي ودولة ما بعد الاستقلال وشعاراتها في الاستقلال والديمقراطية والتنمية والوحدة. وتمس أيضا ما استجد من إشكاليات وقضايا.
غير أن هذا الاتساع يمثل أيضا إشكالية في حد ذاته، إذ ليس بالإمكان معالجة كل الإشكاليات مرة واحدة، والتعامل مع هذه القضايا يقتضي عملا استراتيجيًا ينطلق من جوهر المشكلة ويرتب الأولويات حسب السياقات والقدرات المتوفرة. وهو ما ينقلنا إلى الملاحظة الأخيرة حول المستقبل.
سؤال ما العمل؟
إنّ أي موجات قادمة للثورات العربية أو حركات الإصلاح السياسي لا يمكن أن تتجاهل عددًا من الشروط الموضوعية التي بدونها لا يمكن تصور نجاح الانتقال إلى الديمقراطية في الدول العربية. وهنا أنتقل إلى ما يمكن تسميته الشروط الموضوعية لتحقيق انتقال ناجح صوب الديمقراطية، وهي أربعة، ترتيبها كما يلي:
1- الشرط الموضوعي الأول: تحقيق السلم الأهلي ومعالجة العلاقة بين الأمن والحرية وبين المدنيين والعسكريين
لم يحدث أن نجح انتقال ديمقراطي في ظل صراعات أهلية أو حروب، ووجود دولة موحدة تنعم بالسلم الأهلي كان دومًا شرطًا ضروريًا لحالات الانتقال الناجحة.
ولهذا، لا ديمقراطية – في دول مثل سوريا واليمن وليبيا أو غيرها – بدون دولة موحدة ، ويسودها السلم الأهلي.
كما لا ديمقراطية في الجزائر ومصر والسودان إلا بدولة تحكمها المؤسسات المدنية الديمقراطية المنتخبة، مع الحفاظ في ذات الوقت على وحدة الجيوش وقوتها ورفع مهنيتها وتقوية نظم تسليحها وتدريبها، ومع وضع ضمانات لعدم انقلابها على أي سلطة مدنية منتخبة أيضا.
أي لا ديمقراطية بلا دولة، ولا دولة بلا جيش.
2- الشرط الموضوعي الثاني: هو الهدف المشترك
فلا انتقال ديمقراطي ناجح دون الاتفاق أولا على هدف مشترك جامع هو الدولة الديمقراطية بأركانها المتعارف عليها (وأهمها: حكم القانون، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي على السلطة عبر آلية الانتخابات الديمقراطية التي تعكس الإرادة الشعبية وتفرز مؤسسات تمثيلية، وحكم الأغلبية مع ضمان حقوق الأقليات، والمواطنة الكاملة والشاملة، والحريات والحقوق المدنية والسياسية التي تضمن التعددية، وتمكين الفرد والمجتمع من المشاركة في العمل العام على كافة المستويات).
وهذا الهدف المشترك يتضمن أهدافًا أخرى، قد يكون من الحكمة تجنب التركيز عليها في بداية الطريق. بمعنى أن بناء نظام جديد يقوم على حكم القانون، ودولة المؤسسات المدنية المنتخبة، والمواطنة الشاملة، يتضمن حتمًا في بعض الحالات إخراج العسكريين من السلطة، كما يتضمن في حالات أخرى إنهاء حكم الأقلية الحاكمة.
وقد حدث هذا في حالات أخرى، إذ لم تُفتح كل الملفات مرة واحدة، وإنما تم التركيز على جوهر المشكلة. حيث كانت الأولوية في دول أمريكا اللاتينية هي إعادة الحكم المدني، كما كان إقرار المواطنة الكاملة الغاية الكبرى في جنوب افريقيا، أما في دول شرق أوروبا فكان الهدف هو إقرار التعددية وإنهاء احتكار الأحزاب الشيوعية للسلطة، وهكذا.
في الحالات العربية، الغاية الكبرى للثورات العربية منذ العام 2011 كانت – ولا تزال – غاية تحررية، وليست مجرد تحقيق المطالب الفئوية أو استبدال الأشخاص والحكومات. أي تحرر الإنسان والمجتمع ومؤسسات الدولة – وعلى رأسها المؤسسات العسكرية والأمنية – من قبضة الأقليات الحاكمة المستبدة، وإعادة هذه المؤسسات إلى مهامها الأساسية، وتمكين المواطن والمجتمع.
3- الشرط الموضوعي الثالث: العمل المشترك
فلا انتقال ديمقراطي ناجح إلا عبر تنظيمات وقوى قادرة، أو عبر تكتلات وطنية قوية ببرامجها وكوادرها. ففي كل الحالات الناجحة تقريبا، كان هناك تكتلات من نوع ما (كما حدث في بولندا، البرازيل، تشيلي، جنوب افريقيا، اسبانيا…).
ولهذا، فالمرحلة الراهنة في الدول العربية تُحتم على كل القوى الوطنية الحية ترتيب أولوياتها بطريقة يجري من خلالها تجاوز خلافاتها وصراعاتها العدمية، والارتقاء إلى حجم المسؤولية التاريخية، والتكتل في ما يطلق عليه أحيانا “تيار أساسي” (حسب ما كتب طارق البشري) أو “كتلة تاريخية ديمقراطية” (انظر: علي خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي، “مفهوم الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية في الدول العربية” في نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية، تحرير: علي خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010)).
إن إجماع القوى المجتمعية والسياسية الرئيسة على الحكم المدني الديمقراطي قادرٌ على تعديل ميزان القوة لمصلحة أنصار التغيير الديمقراطي السلمي، فالقوة لا يُوقفها إلا القوة، إلا أن وحدة الهدف تحتاج إلى عمل مشترك، أي ائتلاف القوى الديمقراطية أو تكتلها وراء ذلك الهدف المشترك.
ولا يعني التوافق حول المشترك الديمقراطي القضاء على التباينات بين الأطراف في البرامج، فوحدة الهدف لا تتناقض مع تمسك كل طرف بقناعاته، انطلاقا من أن بناء النظام الديمقراطي المنشود سيمكن كل طرف -لاحقا- من طرح برامجه في إطار تسوده قيم الحرية والتعددية والحوار.
ويتطلب الوصول إلى هذا التكتل بدوره إنجاز عدة أمور أهمها:
– نبذ استخدام كل صور العنف لتحقيق أهداف سياسية.
– التوقف عن الازدواجية – التي تمارسها كل التيارات تقريبا – في النظر إلى مسألة الحريات والديمقراطية.
– التوقف عن النظر المتجزئ للديمقراطية أو تجاهل ركن ركين من أركانها، وذلك عبر إيجاد فهم مشترك لمفهوم “الديمقراطية” ذاته، والاتفاق على أركان النظام الديمقراطي المنشود وآلياته ومؤسساته وضوابطه وضماناته.
– تصفية ما أمكن من نقاط التوتر في فهم هذه القوى للديمقراطية، وبخاصة علاقة الإسلاميين بالديمقراطية وإشكاليات تلك العلاقة، وقضايا العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة، وقضايا الحريات وسُبل حماية الأقليات.
– ممارسة الديمقراطية داخل التنظيمات المشكلة الداعية للديمقراطية، فلا يمكن المناداة بالديمقراطية على المستوى الوطني العام في حين تغيب الديمقراطية داخل الأحزاب والقوى السياسية وفيما بينها. وهذا يعني العمل على توفير الحد الأدنى من المعايير الديمقراطية في داخل هذه التنظيمات كوضوح معايير الإدارة الداخلية، وتأكيد عنصر التداول على الإدارة، واحترام الرأي والرأي الآخر، والشفافية والمصارحة، وظهور قادة ونخب منتخبة، وتعزيز التداخل الجيلي، وغير ذلك.
– عدم النظر إلى النظام الديمقراطي على أنه غاية في حد ذاته، وإنما المنطلق الذي يتم في سياقه لاحقا معالجة أي توترات أو اختلافات أخرى، بل تطوير النظام الديمقراطي ذاته وكافة الإشكاليات والعيوب التي أفرزتها الممارسة الغربية للديمقراطية أو التي قد تفرزها الممارسة العربية في المستقبل.
– العمل المستمر على توسيع قاعدة القوى السياسية التي ترى الديمقراطية بوصفها هدفًا مشتركا. ومن المهم إيضاح طبيعة الصراع بأنه بين الاستبداد والحرية، ومن ثم لا ينبغي استعداء المؤسسات التي تعتمد عليها الأنظمة المستبدة، وإنما يجب طمأنة المؤسسات القضائية، والعسكرية، والأمنية، ورجال الأعمال، والأقليات العرقية أو الدينية أو المذهبية إن وجدت، والعمل أيضا على كسب أنصار للديمقراطية من داخلها، وزعزعة جبهة الاستبداد. والتأكيد دوما وفعلا على أن العهد الجديد المنشود هو عهد المواطنة الكاملة والشاملة والمساواة أمام القانون والشفافية، وعهد العدالة الاجتماعية وإنصاف فئات المجتمع كافة، وتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة.
– وسيكون من أولويات أي ثورة شعبية أو حركة إصلاحية، تمكين المجتمع، وتبني القيم والمؤسسات والآليات الكفيلة بأن يكون الإنسان هو محور أي نظام اجتماعي وسياسي، وأن تكون المجتمعات المحلية وجماعاتها الوسيطة هي رافعة البرامج التنموية التي تستهدف إقامة وترسيخ المساواة والعدالة الجنائية والاجتماعية، وإقرار الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
– وسيكون من الأهمية القصوى أيضا وضع آليات تتضمن الحفاظ على الدين ودوره في المجتمع كمعين للقيم والمبادئ ومصدر للمرجعية العليا للمجتمعات، مع وضع ضمانات لاستقلاله عن السلطة التنفيذية، وضمانات لمنع استخدامه من أجل الحصول على مكاسب حزبية ضيقة أو في التمييز أو التحريض ضد الآخر. هذا بجانب وضع ضمانات لاستقلال الجامعات، ومؤسسات البحث، ومؤسسات الإعلام والثقافة، وإيجاد مؤسسات مستقلة تعمل على ترقية الوعي المجتمعي وتكوين الخبرات والكوادر السياسية.
4- الشرط الموضوعي الرابع: معالجة إشكالية الخارج المعادي للديمقراطية
فلا انتقال ديمقراطي ناجح دون معالجة مسألة ممانعة الخارج. وهذه إشكالية لها ملامح مختلفة تحتاج مساحات للتفكير، وبلورة الأفكار والرؤى بشأنها.
فهناك الإرث التاريخي للدول القُطْرية العربية والدور الخارجي في نشأتها، وأثر ذلك في طبيعة أنظمة الحكم وقابليتها للتغيير نحو الديمقراطية.
وهناك موضوع الهيمنة الغربية التي تؤطر العلاقات الغربية-العربية، فلم يعد من الممكن تجاوز حقيقة أن القوى الغربية تنظر للمنطقة كساحة مفتوحة لممارسة الهيمنة، على حين تقف أمام أي مطالب من أجل انتقال حكوماتها إلى الديمقراطية. ولم يعد ممكنا الاستمرار في استخدام فزاعة الحرب على الإرهاب من قبل الأنظمة العربية والغربية لقمع الحريات، والنظر إلى الحروب والصراعات وكأنها قدر محتوم.
وهناك الإقليم المعادي للديمقراطية. علينا التفكير في الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل الديمقراطية إلى مصلحة إقليمية، كما حدث بمناطق أخرى من العالم، وفي كيفية وضع هدف دولة المواطنة والمؤسسات الديمقراطية في أجندات المبعوثين الدوليين، وفي الحلول الإقليمية والدولية التي تُقترح للصراعات التي تشهدها المنطقة.
وهناك أيضا مسألة تتصل بهيمنة النموذج الغربي، ومحاولات دوائر سياسية وبحثية غربية تصدير نموذج محدد للديمقراطية، وما يرتبط بهذا من توترات داخل التيارات السياسية المختلفة. من الأهمية هنا فهم عملية بناء نظم حكم حديثة، باعتبارها عملية مركبة يتداخل فيها المحلي والأولويات الوطنية، ومعايير النظم والدساتير الديمقراطية التي صارت في جوانب كثيرة منها مشتركة، يجب الانطلاق والاستفادة منها.
إن معالجة ممانعة الخارج غير ممكنة إلا بتحقيق الشروط الثلاثة السابقة (وجود دولة موحدة – وحدة الهدف والمشترك الديمقراطي – والعمل المشترك من أجل إنجاز الانتقال الديمقراطي).
ومن هنا لا يجب أن تكتسب أي كتلة أو تحالف ديمقراطي عداء الخارج، بينما هي تناضل ضد المستبدين في الداخل. وهذا أمر لابد أن يتم بشكل استراتيجي واستنادا إلى رؤية مدروسة.
نعم لدينا عامل خارجي مناوئ للديمقراطية، لكنه ليس عاملا حتميًّا، ولم يكن كذلك في الحالات الناجحة للانتقال الديمقراطي، إذ أمكن تحييده عندما قامت قوى الداخل بدورها، أي : (1)عندما ظهرت معارضة متفقة على هدف استراتيجي جامع في الداخل هو الديمقراطية، و(2) عندما ظهرت تكتلات تناضل من أجل هذا، و(3) عندما امتلكت رؤية محددة وواقعية للتعامل مع هذه الإشكاليات الخارجية. وقد حدث هذا بأشكال مختلفة في دول عدة في شرق أوروبا، وكوريا، والفلبين، وجنوب أفريقيا، وفي الكثير من دول أميركا اللاتينية وغيرها.
إن السياسة عمل مرحلي، والحكومات الديمقراطية قادرة، حال قيامها، على التعامل مع تحديات الخارج أفضل بكثير من الحكومات المطلقة. وثمة شرط واحد هنا هو وضوح هذه الملفات الخارجية، والاستعداد لها جيدا من حيث الرؤى والسياسات والكوادر والخبرات.
وأخيرا، التغيير عادة يستغرق عقودًا، ويتطلب نفسًا طويلا، وهو عملية وصيرورة اجتماعية ممتدة. ولو قرأ السياسيون العرب تفاصيل – وليس الملخصات السريعة المنتشرة على المواقع الإلكترونية – الثورتين الفرنسية، والأمريكية، أو النضال من أجل الديمقراطية والحكم المدني في دولة مثل الأرجنتين، أو البرازيل، أو كوريا الجنوبية، أو تشيلي، أو إسبانيا، لأدركوا جيدا أنه بالإمكان أن تكون هناك ديمقراطية عربية، ولتوقفوا عن لوم الآخرين أو الشعوب أو السياقات والظروف. والله أعلم.