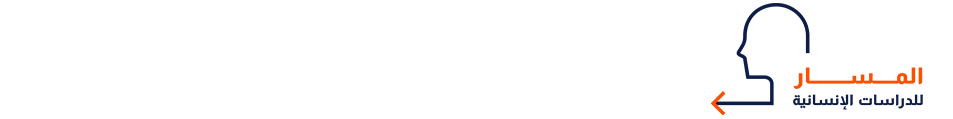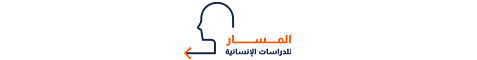أمننة الإخوان المسلمين
وشرعنة عنف الدولة وتجدُّد السلطوية في مصر ما بعد الربيع العربي¹
لم يجر متخصصو كل من الدراسات الأمنية النقدية وسياسة الشرق الأوسط ما يكفي من الأبحاث حول المستويات غير المسبوقة من عنف الدولة ضد الإخوان المسلمين في مصر في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ، وكذلك قبول المصريين الواسع لها؛ ما يعكس الافتراضات الضمنية بأن عنف الدولة أمر عادي ومألوف خارج أوروبا.
تبحث هذه المقالة في عملية الأمننة Securitization² التي مكنت من اللجوء لهذه المستويات من العنف، والتي نجح الجيش المصري من خلالها في استغلال المعارضة الشعبية لحكم الإخوان المسلمين، وتصوير الجماعة باعتبارها تهديدًا وجوديًا لمصر، وتبرير اتخاذ تدابير استثنائية ضدها. وتستند المقالة إلى الانتقادات الحالية للمركزية الأوروبية لنظرية الأمننة، إلى جانب كتابات أنطونيو غرامشي، لمزيد من تنقيحها لتناسب التطبيق على السياقات غير الديمقراطية.
كما تشير المقالة أيضا إلى دور”الأمننة” في إعادة إرساء الحكم السلطوي في أعقاب انتفاضات عام 2011، بالإضافة إلى كشفها عن استثنائية عنف الدولة ضد الإخوان المسلمين وتسليط الضوء على الدور الهام الذي لعبته الجهات غير الحكومية في تصوير جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تهديدًا لمصر.
ومن ثّمَّ، فإننا نرى أن الأمننة لا تشكّل حيادًا عن “السياسات الاعتيادية” وحسب، بل ربما تكون جزءًا لا يتجزأ من إعادة بناء “السياسات الاعتيادية” في أعقاب فترة انتقالية.
مقدمة
تستخدم هذه المقالة نظرية “الأمننة” لفهم المستويات غير المسبوقة من عنف الدولة في مصر بعد إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا، في يوليو/تموز 2013، وخاصة المذبحة التي ارتكبتها قوات الأمن، وراح ضحيتها أكثر من 800 مدني(بل ربما يصل العدد إلى 1000) وذلك ، في 14 أغسطس 2013 ، بأدنى قدر من الاحتجاج المحلي والمعارضة.
عارضت مدرسة “كوبنهاغن” المنظور الواقعي للأمن باعتبارها إياه”أكثر من مجرد استجابة طبيعية لتهديد واضح” وقدّمت مفهوم “الأمننة” باعتباره تصويرا خطابيا لقضية ما، أو كيان ما، على أنه تهديد وجودي، ما يُمكِّن من اتخاذ تدابير “استثنائية” بشأن هذا الكيان، أو تلك القضية خارج العملية السياسية العادية، إذا ما لقي هذا التصوير قبولا جماهيريا واسعا.
ومع ذلك، فإن تطبيق نظرية “الأمننة” خارج نطاقه الأوروبي التقليدي يثير تساؤلات هامة حول ماهية “السياسة الاعتيادية” مقابل “التدابير الاستثنائية” في السياقات غير الديمقراطية، وإلى أي درجة تتقيد النظرية بالسياق الأوروبي.
تفترض هذه المقالة، تمشيًّا مع مؤلفين آخرين، أن نظرية “الأمننة” قابلة للتطبيق في سياقات غير غربية، شريطة تنقيحها وتعديلها، وبالتحديد فيما يخص الآتي؛ تعريف مفهوم “السياسات الاستثنائية” لا باعتباره خروجًا عن السياسات الديمقراطية بل باعتباره خروجًا عن القواعد التي تعتمد عليها الأنظمة غير الديمقراطية لتحكم، وأيضًا رفض النموذج الأوروبي للعلاقات بين المجتمع والدولة ، الذي يفترض أن المجتمع المدني مستقل عن الدولة.
يبدأ المقال بمناقشة نظرية الأمننة ومدى انطباقها على السياق المصري. إذ يبحث أولًا في ما يُشكّل القواعد” بالتحديد في ظل نظام استبدادي”، معتمدًا على مفهوم الهيمنة لغرامشي لفهم الجذور المؤسسية والأيديولوجية والاجتماعية للسلطوية.
ويرى المقال بأن “الخروج عن القواعد” يحدث عندما يحيد الحكام عن “الصفقة السلطوية” ، مما يجعل عنف الدولة أمرًا غير مقبول في نظر كتلة حرجة من المجتمع، كما حدث في الفترة التي سبقت انتفاضة 25 يناير 2011 .
وثانيًا؛ بهدف توضيح الفاعلين ذوي الصلة، وأدوار كل منهم في عملية الأمننة؛ يستعرض المقال تعريف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في السياقات غير الغربية باستخدام مفهوم “غرامشي” الخاص بالمجتمع المدني لأجل وضع تصور حول الحدود الضبابية غير الواضحة بين هذه الفئات.
وبعد ذلك؛ يصف المقال عملية الأمننة التي بلغت ذروتها في مذبحة أغسطس 2013.
فأولاً ، يلفت الانتباه إلى الدور الهام الذي لعبته الجهات الفاعلة غير الحكومية في تصوير جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تهديدًا لمصر، الأمر الذي مهَّد الطريق لإعادة تقديم الجيش بوصفه فاعلًا مُؤَمنِنًا شرعيًا، بعد خسارته الفادحة لشعبيته في مرحلة مابعد مبارك، ثم مكَّن الجيش من شن انقلاب على الرئيس السابق مرسي في 3 يوليو.
وفي هذا الصدد، يُظهِر المقال الدور الفعال للمجتمع المدني في عملية الأمننة، إلى جانب تسليط الضوء على صعوبات التمييز بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، أو في الواقع، تلك المستقلة عن الدولة أو المُستَقطبَة من جانبها.
وثانيًا؛ يحلل الخطابين الرئيسين للجيش اللذَيْن نجحا في استغلال الخطاب المناهض للإخوان المسلمين الموجود فعلًا ، وكذلك بعض انتفاضة ثورة 25 يناير 2011، وهذه الخطابات يمكن تأطيرها مفاهيميًا باعتبارها “إجراءات مُؤمْنِنَة” سعت لتسويغ اتخاذ تدابير استثنائية ضد الرئيس المعزول مرسي ومؤيديه.
وبالتحديد، قدم خطاب الجنرال عبد الفتاح السيسي في 23 يوليو، الذي دعا المصريين فيه إلى “تفويض” الجيش “لمحاربة الإرهاب”، والحشد اللاحق للمصريين في 26 يوليو – غطاءً سياسيًا جوهريًا لمذابح رابعة والنهضة في 14 أغسطس.
ثم أخيرًا؛ يتناول المقال دور عملية الأمننة الناجحة هذه في تطبيع مستويات جديدة من القمع وعنف الدولة ومأسستها، والتي استُخدمَت بما يتجاوز نطاق الإخوان المسلمين مستهدفة نشطاء شباب ومنظمات مجتمع مدني و نقابيين و منتقدي نظام السيسي.
وفي هذا السياق، يمكن فهم الأمننة باعتبارها عنصرًا محوريًا في الجهود الرامية لإعادة إرساء ركائز الحكم السلطوي في أعقاب ثورات 2011. وعليه؛ يرى المقال بأن الأمننة لا تشكل خروجًا على “السياسات الاعتيادية” فقط، بل قد تكون أيضًا جزءًا لا يتجزأ من إعادة “السياسات الاعتيادية” بعد فترة انتقالية.
ثم نختتم بتأملات حول ما يمكن أن تسهم به الحالة المصرية في التنظير للأمننة في السياقات غير الغربية، وما يمكن أن تسهم به نظرية الأمننة في فهم إقامة النظم الاستبدادية وصونها.
الأمننة في السياقات غير الغربية/غير الديمقراطية
تطورت نظرية الأمننة بشكل رئيسي من خلال تطبيقها على دراسات حالة من أوروبا، لذا برز جدل واسع بشأن إمكانية تطبيقها على سياقات غير غربية وغير ديمقراطية، وكيفية ذلك. وتمثّل الاعتراض الرئيسي حول استخدام نظرية الأمننة في السياقات السلطوية في التفريق بين ماهو “عادي” وماهو “استثنائي”، إذ تفترض النظرية أن التدابير”الاستثنائية” تعني الخروج عن السياسة الديمقراطية الليبرالية التداولية السائدة، فإذا فُهِمت الأمننة على أنها “وسيلة لإخراج قضايا معينة عن نطاق العملية الديمقراطية للحكومة”؛ فكيف يمكن تطبيقها على دول ذات ديمقراطية واهية أو تخلو من العملية الديمقراطية أصلا؟
والسؤال الآخر ذو الصلة هنا هو ما إذا كانت الجهات الفاعلة في عملية الأمننة في السياقات غير الديمقراطية بحاجة للسعي إلى القبول المجتمعي لأفعالها، أم أنها – ببساطة – قد تعتمد على الإكراه؟.
يفترض التساؤل حول إمكانية تطبيق نظرية الأمننة في السياقات غير الديمقراطية أن الحكم السلطوي اعتباطي واستبدادي وتعسُّفي، مُجَسِّدًا نظرة استشراقية سائدة منذ عهد بعيد تجاه البلدان غير الأوروبية. فرغم تمتع دولة ما بعد الاستقلال في مصر، مثلها مثل دول عديدة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، بسلطات واسعة للتحكم والمراقبة فرضها جهاز قسري قوي، وكذلك أتاح قانون الطوارئ – الذي كان ساريا سريانًا مستمرا تقريبا فيما بين عامي 1967 و 2011- للدولة سلطات واسعة لاحتجاز المواطنين و مقاضاتهم³ ؛ فإن عنف الدولة لم يستخدم بصورة اعتباطية تعسفية – على الأقل ليس حتى آخر فترة من حكم مبارك، كما أنه، ومن ناحية أخرى؛ يصعب على المرء فهم طول عمر الأنظمة السلطوية مثل مصر من خلال منظور الإكراه وحده.
بالطبع ساهم جهاز الدولة القسري واستخدامه القمع في استمرار السلطوية لعقود، لكن الإكراه الممتد لفترات طويلة يكبّد الأنظمة تكاليف باهظة، لذا بدلًا منها اعتمدت الأنظمة المتعاقبة على عدد من الممارسات غير القسرية للحكم، منها الترتيبات المؤسسية، والمحفزات الاقتصادية، وكذلك الأيديولجيا.
وبناء على ماسبق؛ يذهب “جوها فوري Juha Vuori” إلى أنه يجب فهم “السياسات الاستثنائية” هنا باعتبارها خروجًا عن القواعد التي تعتمد عليها الأنظمة غير الديمقراطية لتحكم، بدلًا من اعتبارها خروجًا عن السياسات الديمقراطية، ومن ثم فإن “نزع الطابع السياسي” الذي تتضمنه الأمننة لنقل قضية ما من فئة السياسات الاعتيادية إلى فئة السياسات الاستثنائية ينبغي فهمه بصورة نسبية، وحينئذ يمكن رصده وتتبعه في كل من المجتمعات الديمقراطية وغير الديمقراطية.
تقترح الدراسة أن مفهوم “الهيمنة” لأنطونيو غرامشي يسمح لنا بمزيد من فهم القواعد التي تحكم من خلالها الأنظمة السلطوية بعيدًا عن أنماط المواطنة الديمقراطية الليبرالية. فوفقًا لغرامشي؛ تمارس أي طبقة مهيمنة السلطة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل غير القسرية بما فيها المؤسسات السياسية، والمنافع الاقتصادية أو المادية، والثقافة، لا من خلال آليات الإكراه مثل؛ الشرطة والجيش والنظام القانوني فقط، ولكي تنجح؛ ينبغي أن تظهر الهيمنة وكأنها في صالح المجتمع ككل لا الطبقة المهيمنة فقط.
وقد كانت أهم عناصر هيمنة النظام في مرحلة ما بعد الاستقلال في مصر ما يمكن تسميته بالمساومة أو” الصفقة السلطوية” بين الحكام والمحكومين، تخلّى المواطنون بمقتضاها عن حرياتهم المدنية والسياسية مقابل الرعاية الاجتماعية ومنافع اقتصادية أخرى، مثل؛ الأمان الوظيفي ودعم السلع والخدمات الأساسية. كما ساهمت المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية والانتخابات والبرلمانات في استيعاب المعارضين السياسيين. وأيديلوجيًا؛ نجحت أنظمة ما بعد الاستقلال في اكتساب الشرعية عبر تصوير نفسها باعتبارها ضامن السيادة المصرية والتقدّم الوطني ضد التهديدات الداخلية والخارجية.
تعتمد الأنظمة على كسب موافقة المواطنين أولا قبل كل شئ ، لتغدو قادرة على ممارسة القمع كما يرى” تيري إيجلتون” قائلًا “يجب أن تحصل المؤسسات القهرية في المجتمع على موافقة عامة من الناس إن أرادوا العمل بفعالية”.
إلى جانب ذلك، اعتمدت الأنظمة عمومًا القسر ضمن معايير الصفقة الاستبدادية، واستهدفت به المعارضين السياسيين الذين حاولوا تغيير شروط الصفقة من خلال تحدي السيادة السياسية والأيديولوجية للنظام. وبالطبع كان للحركة الإسلامية نصيب الأسد من عنف الدولة، إذ اعتبرتها الأنظمة المصرية التهديد الأكبر لها؛ فحُظِرَت جماعة الإخوان المسلمين وسُجِن المئات من أعضائها وتعرض بعضهم للتعذيب والإعدام في عهد نظام جمال عبد الناصر، وصورهم النظام باعتبارهم أذناب الإقطاعيين والمستعمرين الذين يهددون المكاسب القومية التقدمية لـ “ثورة” 1952 في مصر.
وعندما تولى أنور السادات الحكم في عام 1970 سمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين لموازنة الكفة ضد أنصار الرئيس السابق، لكن مع ذلك؛ اعتقلت السلطات أكثر من 1500 شخص بعد انتقادات حادة لعقد السادات معاهدة السلام مع إسرائيل، وكان جُلُّهم من الإسلاميين، ومنهم أيضا قوميون وعلمانيون يساريون، الأمر الذي استفز متشددًا إسلاميا لاغتيال الرئيس في عام 1981.
ثم تسامح النظام مع جماعة الإخوان المسلمين بعدها في ظل نظام حسني مبارك، رغم عدم تقنينها، فسُمِح لها بالعمل داخل النظام السياسي، وخوض الانتخابات البرلمانية، وكذلك الترشح لانتخابات مجالس النقابات المهنية.
لكن تحرك النظام بعدها لاحتواء التنظيم، تصدّيًا للنجاح الانتخابي الذي حققته جماعة الإخوان المسلمين وشعبيتها، واعتقل أعضائها بشكل دوري، بل حاكم بعضهم أمام المحاكم العسكرية. كما استهدف جماعة الإخوان ضمن حملة قمع واسعة شنتها الدولة ضد الجماعات الإسلامية العنيفة خلال التسعينيات.
إذًا تاريخيًا؛ لم يكن عنف الدولة في مصر ما بعد الاستقلال -لاسيما استخدام القوة المفرطة -عشوائيا ضمن معايير “الصفقة السلطوية”، رغم انتهاكه القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
ومع ذلك ، غدا قمع الشرطة أكثر اعتباطية وأوسع نطاقًا في الفترة التي سبقت ثورة 2011، وتزامن ذلك مع إدخال الإصلاحات الاقتصادية النيوليبرالية بعد عام 1990، مما قاد إلى سحب المنافع الاجتماعية والاقتصادية التي ترتكز عليها “الصفقة السلطوية” لمرحلة ما بعد الاستقلال، وثارت القلاقل الاجتماعية في أوساط العمال والمزارعين وحتى الطبقة الوسطى التي كانت ساكنة سابقًا.
وكان ثمة دليل على أن قطاعات متزايدة من السكان أضحت ترى عدم مشروعية هذا المستوى من القمع، إذ بدأ المدونون يسلطون الضوء على التعذيب والاعتداءات الجنسية في مراكز الشرطة وسرد كثير من الضحايا تجاربهم، وكانت الشرارة التي أشعلت الفتيل بلا شك هي مقتل شاب من الطبقة الوسطى اسمه “خالد سعيد” إثر ضربه حتى الموت على أيدي ضباط الشرطة في منتصف الشارع في يونيو 2010، ثم انتشرت صور وجهه المشوّه والمحطّم على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت غضبًا واسعًا. وبعدها أخذت مجموعة بعنوان “كلنا خالد سعيد” على موقع فيسبوك في تمهيد تعبئة إلكترونية غير مسبوقة، وخصوصًا من جانب شباب ناشطين إلكترونيًا، وهم الذين لعبوا دورًا محوريًا في تنظيم احتجاجات 25 يناير 2011
تشير انتفاضة عام 2011 واستعداد المصريين لمواجهة عنف الشرطة للمدى الذي تراجعت إليه هيمنة النظام بل انهارت، وإلى أن انتهاج الدولة للعنف لم يعد مشروعًا في أعين قطاعات كبيرة من الشعب.
ولذا، فإن الأنظمة الاستبدادية ، وإن كانت قادرة على كسر القواعد التي تحكم انتهاج الدولة للعنف، إلا أنه لابد من اعتبار هذه “السياسة الاستثنائية” مشروعة من جانب كتلة كبيرة داخل المجتمع لكي تستمر في الحكم.
وفي مقابل هذا التراجع، نفترض أن “نظرية الأمننة” تتيح استطلاعًا مفصلاً للعملية التي أعادت “شرعنة” عنف الدولة بعد يوليو 2013.
الحدود المبهمة بين الجهات الفاعلة الحكومية والأخرى المجتمعية في ظل الأنظمة الاستبدادية
يتعلق سؤال ثانٍ بشأن صلاحية تطبيق نظرية الأمننة على السياقات غير الغربية أو غير الديمقراطية بالافتراض الشائع بأن الجهات في عملية الأمننة هي النخب الحكومية، وأن ثمة تمييزا واضحا بين الفواعل الحكوميين وغير الحكوميين؛ هذه الافتراضات قد تُعزى إلى الفكر السياسي الغربي الذي يعتبر المجتمع المدني قطاعًا مستقلًا متمايزًا عن الدولة ومراقبًا لسلطتها.
لكن الباحثين أظهروا أن الحدود بين الدولة والمجتمع المدني عادة ماتكون مبهمة وغير واضحة في ظل الأنظمة الاستبدادية، وأن المجتمع المدني يفتقر لاستقلالية نظرائه الغربيين بسبب القوانين واللوائح المُقيِّدة وشبكات المصالح بين الحكومة والمجتمع المدني ، وخصخصة جماعات الضغط ، أي عملها لصالح شركات وأعمال تجارية خاصة، تلك التي قد تعززالأنظمة الاستبدادية .
وبالمثل، تبرز أدبيات المجتمع المدني في الشرق الأوسط افتقار القطاع إلى الاستقلالية، وتسييسه التاريخي، والتوجهات “غير المدنية”، بل الاستبدادية بين العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والواقع أن بعض الأدبيات الأحدث قدمت مفهوم “انقلابات المجتمع المدني” لوصف استعانة الحكومات بمجموعات غير حكومية لدعم تدخل عسكري.
ورغم أن المجتمع المدني في الشرق الأوسط (والسياقات الاستبدادية الأخرى) قد لا يشبه نظيره في الديمقراطيات الغربية، لكن من المهم ألا يعاد إنتاج الخطابات الاستشراقية التي تصور المجتمعات غير الغربية على أنها استبدادية بطبيعتها، وتلوم غياب المجتمع المدني ذي النمط الأوروبي.
فهناك العديد من الأمثلة التاريخية، على تحدّي مجموعات غير حكومية في الشرق الأوسط للقمع والاضطهاد ومطالبتهم بالعدالة والحقوق، منها؛ حركات دستورية ومنظمات لحقوق الإنسان، وأخرى نسوية وحتى المجموعات الدينية.
وقد مُكِّنَ لثورة 25 يناير بفضل وجود شبكة من نشطاء المجتمع المدني ظهرت بعد عقد متواصل من النشاط المناهض للنظام، كما أمدت انتفاضة 2011 المجتمع المدني بزخمٍ متنامٍ، إذ حافظت أعداد كبيرة من المصريين على مستوى مرتفع من الاستنفار والتعبئة على مدى أشهر عديدة لمساءلة حكام مصر بعد مبارك، لأجل توسيع نطاق الحريات المدنية.
يضم المجتمع المدني إذن طائفة متنوعة من المنظمات التي لا يمكن تصنيفها بسهولة إلى حكومية/غير حكومية ، أو مستقلة/موالية، لذا ربما يكون الأجدى نفعًا هو تصوّر المجتمع المدني باعتباره مساحة تنخرط فيها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية وتتفاعل، وفقًا لأنطونيو غرامشي.
فبالنسبة لغرامشي، لا يتألف المجتمع المدني من مؤسسات وفاعلين فحسب، بل يشكّل مجالًا تحاول الطبقات الحاكمة ترسيخ هيمنتها عبره لتحكم من خلال التوافق والرضاء.
ومن ثَمَّ، فإن المجتمع المدني مرتبط عضويًا بالدولة، لا مستقلًا بذاته، وينبغي النظر إليه كأنه ميدان رئيسي تخاض فيه معركة شرعية النظام الحاكم؛ بما في ذلك ممارساته الأمنية.
وفي مصر، شهدت فترة ما بعد 2011 معركة محتدمة داخل المجتمع المدني، بلغت ذروتها بانقلاب يوليو 2013 العسكري والإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، ويتعرض لذلك القسم التالي من الورقة.
أمننة جماعة الإخوان المسلمين 2012- 2013:
كيف لقي هذا المستوى المذهل من عنف الدولة بعد يوليو 2013 قبولًا واسعًا بين المصريين؟ يبحث هذا القسم في عملية “أمننة” الإخوان المسلمين ، تلك التي بلغت ذروتها في استخدام القوة المميتة ضد مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بما في ذلك مذابح الرابع عشر من أغسطس 2013.
نتعقب هذه الحلقة من سلسلة أحداث الأمننة بالعودة إلى الفوز المحدود الذي أحرزه محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر في 30 يونيو 2012.
وبينما تركّز مدرسة كوبنهاغن تركيزًا تقليديًا على دور النخب الأمنية في تحديد التهديد، فإننا نُظهِر هنا أن الفاعلين الأساسيين في تصوير جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تهديدًا لم يكونوا من النخب الرسمية ، بل كانوا مجموعة من الفاعلين غير الحكوميين في المجتمع المدني – منهم نشطاء شباب، ومدافعون عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وأحزاب سياسية معارضة، وفنانون، وصحفيون، وكتّاب، وشخصيات إعلامية- الذين جمعتهم حملة “تمرُّد” في نهاية المطاف.
كان بعض هؤلاء الفاعلين مؤيدًا للجيش، لكن كثيرًا منهم كان معارضًا للجيش ولمرسي على حد سواء، ورأوا في كلا الخيارين تهديدًا لأهداف ثورة 2011. كما سنناقش في القسم التالي.
سيوضح هذا القسم أيضًا أن مجموع خطابات هذه القطاعات المختلفة من المجتمع المدني- بغض النظر عن مستوى مشاركة كل منها – قد خلق فرصة للجيش ليسترد مكانته باعتباره ممثلًا شرعيًا للأمننة، الأمر الذي وفّر سياقًا مواتيًا لانقلاب الثالث من يوليو 2013 ومن ثم مذبحة أغسطس وغيرها من وقائع استخدام القوة الفتّاكة ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
اتسمت الفترة الواقعة ما بين انتخاب مرسي وعزله بالمعارضة والاحتجاجات المتواصلة، التي أضحت عنيفة مع مرور الوقت. مامن شك في أن كثير من الانتقادات لحكم مرسي كان لها مايبررها؛ فقد دفع باتجاه دستور وضعته جمعية تأسيسية مثيرة للجدل، وأخفق في التواصل مع المعارضة لمواجهة الاستقطاب المتنامي، واستخدم تكتيكات تنتمي لعهد مبارك لإخماد الانتقادات الإعلامية، وأشرف على الانتهاكات المستمرة من جانب أفراد الأمن؛ بما فيها من استخدام للقوة المفرطة وتعذيب للمعتقلين، كما أخفق في وقف خطاب الكراهية والهجمات الطائفية ضد الأقباط والأقليات الدينية الأخرى، وعجز عن تقديم رؤية متماسكة لمعالجة أزمة مصر الاقتصادية ومطالب العدالة الاجتماعية.
وعمومًا، أظهرت جماعة الإخوان المسلمين الانتهازية السياسية خلال المرحلة الانتقالية بعد مبارك ، وانحازت إلى جانب الجيش ضد المطالب الشعبية بتحولات سياسية أكثر جذرية، كما افترضوا أن بإمكانهم السيطرة على الدولة عبر استبدال الموظفين الحاليين، مستهينين بالشبكات الراسخة داخل مؤسسات الدولة وقوة عداوتها للإخوان المسلمين، وهي التي دعمتها السعودية والإمارات لخشيتهم من التداعيات الإقليمية إذا ماتولّى الإخوان السلطة.
ورغم ذلك، فإن الأساليب التي انتهجتها كثير من هذه الانتقادات عملت على “شيطنة” الإخوان المسلمين ومرسي باعتبارهم تهديدًا استثنائيًا لمصر. وفي هذا الصدد، استندت طائفة من الفاعلين إلى مجازات تاريخية قديمة العهد، تعود إلى أيام نظام الضباط الأحرار، تصوّر جماعة الإخوان المسلمين على أنها ليست أهلًا للثقة، وسرية، وعنيفة، وخائنة، و مناقضة للسياسات الحديثة.
على سبيل المثال؛ كان أحد أكثر منتقدي مرسي نفوذاً هو الساخر باسم يوسف، الذي حظي برنامجه “البرنامج” بأعلى نسب مشاهدة في تاريخ التلفزيون العربي، وفي إحدى حلقاته البارزة؛ شن يوسف هجومًا حادًا على الإسلاميين بوصفهم “تجار الدين”، ما يعني ضمنًا أن الجماعة تستغل الإسلام لمصالحها الضيقة. وازدهر عرضه عموما بسبب السخرية من الإخوان المسلمين، وكذا المصريين العاديين الذين أيدوا حكومة مرسي.
وعلى نطاق أوسع؛ كثيرًا مادُعيَ أنصار مرسي والإخوان المسلمين بـــ”الخراف” من قبل خصومهم، للإيحاء بأنهم أتباع غير مفكرين لايفعلون إلا ما تأمرهم به قيادة الإخوان المسلمين.
وثمة اتهام آخر وُصِم به الإخوان المسلمون، وهو سعيهم إلى “أخونة” الدولة، أي الهيمنة على مؤسساتها، ما يقضي ضمنًا بأنهم يهددون “حقيقة” الدولة المصرية وطابعها الأصيل.
ازدادت الانتقادات للرئاسة ازديادًا ملحوظًا بعدما أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا في 22 نوفمبر 2012، مانحًا نفسه ما اعتبرها كثيرون “سلطات مفرطة” بجعل القرارات الرئاسية محصنة ضد الرقابة القضائية. وفيما ادعى مرسي أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الثورة والانتقال إلى الديمقراطية الدستورية؛ اتهمه البعض بتعيين نفسه “فرعون مصر الجديد”، وفي هذا الصدد وصف عمرو حمزاوي، العضو الليبرالي في البرلمان المنحل والمثقف البارز، نظام مرسي بأنه”طغيان رئاسي مطلق” وادعى أن “مصر تواجه انقلابًا مروعًا ضد الشرعية وسيادة القانون واغتيال كامل للانتقال الديمقراطي”.
وفي 24 نوفمبر 2012، شكلت 35 جماعة سياسية جبهة الإنقاذ الوطني؛ وهي ائتلاف معارض قاده سياسيون بارزون مؤيدون للديمقراطية مثل؛ محمد البرادعي ، وحمدين صباحي، إلى جانب مؤيدي نظام مبارك السابق، مثل عمرو موسى، ودعوا الرئيس إلى إلغاء إعلانه وطالبوا بجمعية تأسيسية أكثر تمثيلا.
وقد عكس كل من اسم هذه الجبهة الجديدة والتحالف المفاجئ لمجموعات أخفقت في العمل بفعالية معًا لمنافسة القوة الانتخابية للإسلاميين في الماضي، عكس إلحاح وتهديد تلك اللحظة. وعلى مستوى الشارع. قاد إعلان مرسي إلى احتجاجات واسعة، واعتصام أمام القصر الرئاسي، هاجمه أنصار مرسي هجومًا عنيفًا.
واستجابة للاحتجاجات الواسعة، ألغى مرسي الإعلان، لكنه أصر على المضي قدمًا في استفتاء مفاجئ على الدستور الجديد، رغم فشل الجمعية التأسيسية في الوصول إلى توافق في الآراء بشأن عدد من القضايا الرئيسية، ما أدى إلى خروج أعضاء المعارضة والمستقلين من الجمعية.
لقي الدستور المقترح معارضة شديدة من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك أحزاب المعارضة السياسية والناشطين الشباب وجماعات حقوق المرأة و حقوق الإنسان والفنانين، وعبرّت 24 منظمة حقوق إنسان مصرية في بيان شديد اللهجة عن قلقها إزاء ما اعتبرته “محاولات من جانب الأحزاب المهيمنة داخل الجمعية التأسيسية لتقويض مفهوم الدولة الحديثة، واستيراد النموذج الإيراني للنظام الاستبدادي الثيوقراطي في “قالب سنيّ ” “.
لا شك أن الدستور، الذي أقره الاستفتاء الشعبي – كان بأغلبية 63% ، لكن بنسبة مشاركة منخفضة للناخبين بلغت 33% فقط- قد قصر عن ضمان حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، لكن ” الدستور المصري لعام 2012 لم يكن مخططًا لدولة إسلامية” كما ادعى أحد المراقبين، بل عانى من محاولات لإدخال تعديلات بسيطة على دستور 1971 ، بدلًا من إنشاء دستور جديد بسبب الاعتبارات السياسية لمن صاغوه.
غير أن النتاج الأهم لعملية صياغة الدستور هو تفاقم التوترات بين مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيها، وأضحت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أحداثًا معتادة ، وكثيرًا ما انتهت بالاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، وأيضا بين المحتجين ، وأنصار مرسي.
كذلك، اضطلعت وسائل الإعلام الخاصة، التي يمتلكها أساسًا متعاطفون مع النظام السابق، بحملة منظمة لشيطنة مرسي والإخوان المسلمين، متهمة إياهم ب”الاستيلاء على الدولة لخدمة مصالحهم الخاصة، ونشر ميليشيات ضد المحتجين المعارضين لمرسي، وتهديد الهوية المصرية بمواقفهم “الدخيلة” تجاه الدين، كما عُبّر عن مرسي باعتباره تهديدًا أيضًا فيما يتعلق بسياسته الخارجية إذ شُكِّك في علاقته الوثيقة مع دولة قطر، وانتشرت شائعات في وسائل الإعلام مفادها أن الدولة الخليجية الغنية تخطط “لشراء” قناة السويس، وهي أهم أصول مصر الاستراتيجية و رمز للفخر القومي منذ تأميمها في عام 1956.
مثلت الأزمة الدستورية نقطة تحوّل مهمة ، وأتاحت فرصة سانحة أمام الجيش ، ليعيد شرعيته تدريجيًا ، باعتباره فاعِلًا مُؤمنِنًا بعدما فقد شعبيته خلال توليه الحكم بين عامي 2011 و2012. ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا؛ أصدر الجيش عددًا من البيانات، لم يبلغ فيها حد شيطنة الإخوان المسلمين صراحةً، لكنه سعى لإعادة تقديم الجيش بوصفه الضامن الشرعي لأمن مصر.
فعلى سبيل المثال؛ شدد وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي” على خطر الاستقطاب، وحث على الحوار، في أعقاب الاشتباكات التي وقعت أمام القصر الرئاسي في ديسمبر 2012، مؤكدًا أن البديل هو “نفق مظلم سينجم عنه كارثة” ومحذرًا من أن “الأمة كلها ستدفع الثمن” مالم يؤخذ بهذه النصيحة.
وبعد الاستفتاء على الدستور، وصف السيسي الجيش بأنه “الضامن الحقيقي لأمن البلاد” و”جزء لا يتجزأ من هذا الشعب العظيم”.
وفي أعقاب المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في مدن القناة في يناير عام 2013، حيث قُتل أكثر من 50 شخصًا، حذر السيسي من أن الأزمة السياسية “قد تؤدي إلى انهيار الدولة”.
كما سُمع السيسي، في التسجيلات المسربة في مارس 2013، وهو يخبر طياري القوات الجوية أن “القوات المسلحة ملك للشعب وحده”، ما يعني ضمنًا النأي بالجيش عن الرئاسة.
وفي تلك الأثناء، أعلن رئيس الأركان “اللواء صدقي صبحي” أن الجيش ” يراقب مايجري في البلاد” مؤكدًا للعامة أنه “إذا احتاج الشعب المصري للقوات المسلحة، فسوف يكونون في الشوارع في أقل من ثانية” ، مشيرًا بوضوح إلى استعداد الجيش للتدخّل لإنهاء الأزمة السياسية.
في 28 أبريل 2013، أُطلقت حملة “تمرد” رسميًا بهدف جمع 15 مليون توقيع بحلول 30 يونيو (ذكرى فوز مرسي بالرئاسة) للدعوة إلى انتخابات مبكرة، وقُدِمت باعتبارها مبادرة شعبية، إذ جمع مؤيدوها التوقيعات من المواطنين العاديين في جميع أنحاء مصر، وسرعان ما أقرتها جبهة الإنقاذ الوطني.
وبحلول أوائل يونيو؛ زعمت جمعها عدد 15 مليون توقيع ، ودعت إلى احتجاجات جماهيرية في 30 يونيو، وبيّن “محمود بدر”، أحد مؤسسي الحملة و متحدثها الرسمي، في مقابلة أن تمرد أُنشئت لسد الفجوة بين الشعب والمعارضة؛ التي أخفقت في كسب قلوب وعقول ملايين المصريين بسبب افتقادها لمهارات بناء الدعم الشعبي،لاوأضاف “ببساطة، نحن القوة الشعبية لجماعات المعارضة”.
ومنذ ذلك الحين؛ ظهرت الأدلة على أن الحركة تعمل بموافقة ودعم من الأجهزة العسكرية والأمنية و مؤيدي نظام مبارك السابق أيضًا. كما كشفت التسجيلات المسربة للمحادثات بين شخصيات عسكرية مصرية أن المجموعة سحبت أموالًا من حساب بنكي تديره وزارة الدفاع ، وتعيد الإمارات إيداع الأموال فيه، مما يشير إلى المصالح الإقليمية القوية التي لعبت دورًا كذلك.
تلقت “تمرد” الدعم أيضًا من نخبة رجال الأعمال في عهد مبارك، وخاصة من الملياردير “نجيب ساويرس”، الذي لاحقته حكومة مرسي بسبب التهرب الضريبي. ومن ناحية أخرى، نشر الجيش قواته في الشوارع في الفترة السابقة لـ30 يونيو، مؤكدًا للمصريين أنهم تمركزوا لحماية المتظاهرين لا الحكومة.
إلا أن معظم هذه الروابط كانت مخفية، ودعم تمرد العديد من النشطاء الثوريين والمعادين للجيش مثل الاشتراكيين الثوريين وحركة 6 أبريل ، إذ اعتبروها وسيلة لإحياء العملية الثورية، وفي الواقع؛ كررت تمرّد أساليب تعبئة انتفاضة 25 يناير وجددت التأكيد على أهداف الثورة – بما فيها كرامة المصريين وتحقيق العدالة لمن قُتلوا على أيدي قوات الأمن منذ عام 2011- التي فشل نظام مرسي في تحقيقها وفقًا لرأيهم.
في 30 يونيو، استجاب ملايين المصريين لدعوة “تمرد” ونزلوا إلى الشوارع. وتناهت إلى المسامع أصوات المتظاهرين خارج القصر الرئاسي مطالبين الجيش بإزاحة مرسي وهاتفين “الشعب والجيش يد واحدة”، في استدعاء لشعار رئيسي في انتفاضة 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ثم استمرت الاحتجاجات على مدى الأيام القليلة التالية، وعلت النداءات المطالبة بتدخّل الجيش.
وفي حين خرجت مجموعات مثل حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين مطالبة ببديل ثالث للجيش وللإخوان المسلمين، فإن عدد الحشود التي هتفت لتدخّل الجيش قد فاقتهم عددًا.
بالطبع أتى بعض الدعم للجيش من الجهات الفاعلة التي استمالتها الدولة، كما تشير دراسة “والتر أرمبروست” لدور “توفيق عكاشة”، العضو السابق في الحزب الوطني الديمقراطي ومقدم البرنامج الشهير في قناة “الفراعين” الفضائية، وإلى الدور الجوهري لهذه الجهات الفاعلة المسماة شكليًا بـ”غير الحكومية”. ورغم ذلك فإن كثيرًا من الدعم بدا صادرًا عن “مواطنين عاديين” خيّب حكم مرسي آمالهم.
الجيش يتصدر واجهة المشهد
وهكذا، كانت الأجواء مهيأة لتدخل عسكري، ففي 1 يوليو منح الجنرال السيسي مهلة مدتها 48 ساعة لحل الأزمة السياسية، وإلا فرض الجيش خارطة الطريق الخاصة به. ثم في الثالث من يوليو، أعلن السيسي أن الجيش علّق العمل بالدستور، وعزل الرئيس من أجل “إنهاء حالة الصراع والانقسام” و”ضمان بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يُقصي أيًا من أفراده ولا من توجهاتهم”.
ادعى السيسي أن حكم الإخوان قاد إلى “انقسامات وتوترات اجتماعية” مثّلت “تحديات ومخاطر محورية تواجه الوطن”. ووفقًا للسيسي، فقد رفض الرئيس مرسي الدخول في “حوار وطني” و” ألحق الأذى بالمؤسسات القومية والدينية للدولة”، مما أخاف الشعب المصري وهدده.
وعلى النقيض من ذلك؛ أكد السيسي على ” الدور التاريخي والوطني” للجيش ، وشدد على أن الجيش “بذل جهودًا مضنية، مباشرة وغير مباشرة، لاحتواء الوضع المحلي وإجراء المصالحة الوطنية”، كما أومأ إلى مكانته المتميزة باعتباره مديرًا سابقًا للمخابرات العسكرية ، وذكر أنه “قدم في مناسبات عدّة تقييمًا إستراتيجيًا على المستويين المحلي والأجنبي، يتصدّى للتحديات والمخاطر الأكثر محورية التي تواجه الوطن على الأصعدة الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية”.
كما ذكر أنه عمل بالتعاون مع “شخصيات سياسية واجتماعية معينة”، في إشارة إلى تحالف الأحزاب السياسية المعارضة والحركات الشبابية وغيرها من الجماعات، وكذلك الكنيسة القبطية والأزهر، الذين وقفوا مع الجيش في عزله لمرسي، ما يعني ضمنًا أن الجيش لم يتحرك وفق مصالحه الخاصة، بل تحرك بدعم مجموعة متحدة من الفاعلين في سبيل الأمة المصرية.
وأعاد إلى الأذهان ذكرى وقوف الجيش مع الشعب ضد مبارك خلال الثمانية عشر يومًا من انتفاضة 25 يناير 2011 عندما أعلن أن الجيش “لم يستطع غض الطرف عن نداءات الاستغاثة من الشعب المصري” وكان مُلزَمًا بالاستجابة إلى ” مطالب الثورة…من جميع أنحاء مصر”.
وأسفر هذا الخطاب المتلفز عن احتفالات مبتهجة للمصريين المحتجين في ميدان التحرير برهنت على نجاحه -أي الخطاب- في إعادة شرعنة الجيش باعتباره فاعلًا مُؤمنِنًا.
وإزاء ذلك، واصل أنصار مرسي اعتصاماتهم واحتجاجاتهم في جميع أنحاء البلاد، وفي الأيام التالية، جرت عدة حوادث استخدمت فيها الأجهزة الأمنية القوةَ المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين لمرسي. وقد ساهم ممثلو المجتمع المدني في تبرير هذا العنف عبر شيطنتهم المستمرة للإخوان المسلمين، فمثلًا؛ قال “أحمد الهواري عضو حزب الدستور، الذي ترأسه محمد البرادعي “أتمنى لو استطعت إدانة قوات الأمن لاستخدامهم القوة المفرطة، لكن لا يمكنني ذلك، فهذه ليست مظاهرة سلمية ولا فعلًا سياسيًا. إن جماعة الإخوان المسلمين تعارض الشعب نفسه، لا السيسي ولا الحكومة، لا مكان للإخوان في مصر ما لم يطهروا أنفسهم”.
وحتى الشخصيات الإعلامية مثل ، باسم يوسف، الذي عارض الجيش لاحقًا، قد انضم إلى هذا العداء للإخوان المسلمين، وفي تغريدة نشرها في 5 يوليو اتهم الساخر “قيادة الإخوان المسلمين بإرسال شبابهم للموت أمام مقرات الجيش، ليظهروا أنفسهم بوصفهم ضحايا أمام العالم، وأن دماءهم التي أسيلت هدفها الدعاية الرخيصة، وأنه ليس انقلابًا”.
وكان الخطاب الرئيسي الثاني للسيسي، وهو ما ألقاه أثناء حفل تخرج الكلية العسكرية في 23 يوليو وبثه التلفزيون المصري مباشرة، تجليًا واضحًا لسياسات “العداوة، والقرار، والطوارئ” لكارل شميت. ويذكر أن الخطاب أتى بعد أيام من العنف بين المعارضين ومؤيدي مرسي أخفق الجيش والشرطة في التدخل تدخلًا فعالًا حينها.
إلى جانب ذلك؛ قتل مجند شرطة، وجرح 19 ضابطًا ومدنيًا في هجوم بالقنابل، في الليلة السابقة على الخطاب، خارج مبنى للشرطة في مدينة المنصورة الإقليمية، ووصفه متحدث باسم الحكومة بأنه “عمل إرهابي”. ثم في خطابه؛ طلب السيسي من “جميع المصريين الشرفاء أن يتجمعوا في الشوارع يوم الجمعة، ليعطوه ويعطوا الجيش والشرطة الأمر و”التفويض” بأن يواجه العنف والإرهاب المحتمل”.
وهنا أنشأ الجنرال صورة لمعسكرين متناقضين تمامًا؛ “المصريون الشرفاء”، وهم من يصطفون إلى جانب الجيش والشرطة، في مقابل مقترفي العنف والإرهاب، ويقصد بهم جماعة الإخوان المسلمين وأنصار مرسي.
وادعى السيسي أن المصريين بنزولهم إلى الشوارع يوم الجمعة سيظهرون “للعالم إرادتهم كما فعلوا من قبل” في إشارة إلى المظاهرات الجماهيرية التي أزاحت حسني مبارك من السلطة عام 2011 وتذكير للمحتجين بدعم الجيش خلال الـ18 يومًا.
ومن ثَم؛ قادت دعوة الناس للتظاهر في الشوارع من أجل “تفويض” الجيش لمواجهة “العنف السياسي والإرهاب” إلى تصوير التدابير الاستثنائية باعتبارها “إرادة الشعب” وتصرفات الجيش باعتبارها استجابة لما تمليه هذه الإرادة الشعبية.
وبالفعل، نجح خطاب السيسي، وفي 26 يوليو 2013، استجاب ملايين المصريين لطلبه وتجمعوا في ميدان التحرير، رمز انتفاضة 25 يناير 2011، وفي ميادين عامة أخرى في جميع أنحاء البلاد لدعم الجيش.
وكفل “يوم التفويض” الغطاء الشعبي والسياسي للنظام الجديد لقمع الإخوان المسلمين وأنصار مرسي. وفي 30 يوليو، انتدب مجلس الوزراء وزارةَ الداخلية ” لاتخاذ كافة التدابير القانونية لمواجهة أعمال الإرهاب وإغلاق الطرق” ، وقصد بها الاعتصامات الجارية لمؤيدي مرسي في ميداني رابعة والنهضة.
وفي فجر يوم 14 أغسطس، تحركت الشرطة لفض الاعتصام في عملية استغرقت ما يقرب من 12 ساعة ، وقتل فيها ما لا يقل عن 817 شخصًا، وربما يفوق العدد الألف شخص. وأعقب ذلك سلسلة من التدابير القمعية ضد جماعة الإخوان المسلمين صاحبتها إدانة واسعة وشاملة للمنظمة وأجنحتها السياسية في الأوساط الإعلامية. كما أُلقي القبض على عدد من أعضاء الجماعة البارزين وسُجنوا مثل مرسي، وحُكم على بعضهم بالإعدام.
أيّد قسم كبير من الشعب هذا القمع العنيف للإخوان، واعتُبِر الإخوان منبوذين وخارج حدود أية احتمالات لمصالحة سياسية ، أو إعادة دمج في الحياة السياسية والاجتماعية المصرية.
الأمننة وإعادة إحياء السلطوية بعد عام 2013
يذهب هذا القسم من الورقة إلى أن أمننة جماعة الإخوان المسلمين لم تُمَكِّن فقط من اتخّاذ التدابير الاستثنائية بشأنها ، بل قامت أيضًا بإعادة الحكم الاستبدادي في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وكما يرى “جوش ستاشر”؛ فإن عنف الدولة كان ضروريًا لإعادة تشكيل الأنظمة في مرحلة مابعد الربيع العربي.
كما يشرح هذا القسم أن هذه المستويات الهائلة من عنف الدولة لم تمثّل حيادًا عن “السياسات الاعتيادية” فحسب، بل كانت محورية كذلك لإعادة بناء “السياسات الاعتيادية” عقب فترة انتقالية.
والواقع أن استخدام عنف الدولة ضد الإخوان المسلمين مهّد الطريق لإنشاء “صفقة استبدادية” جديدة قايض فيها المصريون حرياتهم السياسية بالأمن، هذه المرة، بدلًا من المنافع الاجتماعية والاقتصادية سابقًا.
منذ يوليو 2013، وسّع نظام السيسي مجال القمع خارج نطاق جماعة الإخوان المسلمين ، ليشمل كل من ينتقد النظام، وبخاصة جماعات حقوق الإنسان والصحفيين والمشاركين في الاحتجاجات السلمية ، مثل؛ العمال والطلاب، بما فيهم من أيدّوا سابقًا عزل الجيش لمرسي- وفقًا لما ذكره عدد كبير من المراقبين.
أُتيح هذا القمع عبر جملة من القوانين الجديدة والتعديلات القانونية في أعقاب صيف 2013، فمثلًا؛ اعتقل عدد من النشطاء البارزين المرتبطين بثورة 25 يناير 2011 مثل: علاء عبد الفتاح ،وأحمد دومة، ومحمد عادل، وماهينور المصري ، إثر استحداث قانون في نوفمبر 2013 يحظر التظاهرات دون تصريح
وفي أعقاب مقتل النائب العام في أغسطس 2015؛ اعتمدت الحكومة قانونًا جديدًا للإرهاب يتضمن إجراءات غير مسبوقة لتكميم وسائل الإعلام، ويتيح لأفراد الجيش والشرطة الإفلات من العقاب في شن “حربهم على الإرهاب”. ونتيجة لذلك؛ سُجِن الصحفيون وحُظِر أكثر من 400 موقع على الإنترنت. وكانت ثمة أعداد استثنائية من المسجونين السياسيين وأحكام الإعدام الجماعية وزيادة مذهلة في حوادث الاختفاء القسري وحالات التعذيب، إذ وثقت اللجنة المصرية للحقوق والحريات ما لا يقل عن 1500 حالة اختفاء قسري بين عامي 2014 و 2018، كما شُيِّد سبعة عشر سجناً جديداً لاستيعاب الأعداد غير المسبوقة من السجناء.
وفي عام 2017؛ وقّع السيسي قانونًا يفرض قيودًا جديدة على المنظمات غير الحكومية تقوّض استقلاليتها وحريتها تقويضًا واضحًا، وتضم مصطلحات غامضة الصياغة تجرّم ضمنًا عمل منظمات حقوق الإنسان.
كما غادر العديد من النشطاء مصر خوفًا من استهدافهم، واستقال الأفراد من الأحزاب السياسية التي فشلت عمومًا في خلق أي معارضة حقيقية لسلطوية النظام المتصاعدة، وأضحت التظاهرات نادرة -رغم عدم إلغائها بالكامل-، وكانت هذه المستويات من مأسسة القمع، وعنف الدولة تنذر بأن أي معارضة عامة أضحت نشاطًا بالغ الخطورة.
بُرِّرت هذه الإجراءات الوحشية باسم “حماية الشعب” من الإرهاب المحتمل، وصيانة السلامة الإقليمية لمصر. ورغم حقيقة أن الجيش ومؤيديه صوّروا انقلاب 3 يوليو -آنذاك- باعتباره إنقاذًا لثورة 25 يناير 2011، فإن ثمة سردية برزت تعيد صياغة انتفاضة 2011 باعتبارها مؤامرة طويلة المدى لتدمير الدولة المصرية، وكان هناك خطاب إعلامي يروج النظام له باستمرار يصوّر مصر في حالة طوارئ دائمة، وأنها ضحية لمؤامرات شتّى يحيكها الإخوان المسلمون ، والمتمردون الإسلاميون والحكومات الأجنبية، تهدف إلى انهيار الدولة، واتُهمت جماعات حقوق الإنسان، خصوصًا، بالعمل لصالح قوى أجنبية لهدم البلاد.
وإلى جانب ذلك، دعم النظام ثقافة الإبلاغ التي يشجّع من خلالها المواطنين العاديين على إبلاغ الشرطة بشكوكهم، وفي يناير 2018، أصدرت وزارة الداخلية رسومًا متحركة تحرّض الأطفال المصريين على تجاوز آبائهم وإبلاغ الشرطة مباشرة بأي شبهات.
على الرغم من تأمين السيسي لفوزه بفترة ولاية ثانية بسهولة في عام 2018، فإنه يواجه استياء وسخطًا متزايدين من قطاعات مختلفة من المصريين بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، وكانت هناك إضرابات واحتجاجات عمالية مستمرة، وكذلك مظاهرات صغيرة -لكنها مهمة- ضد الزيادات الكبيرة في تكاليف المعيشة، فضلاً عن معارضة ملحوظة لسياسة السيسي بنقل السيادة على جزر البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، كما أثارت الهجمات المستمرة على المسيحيين الأقباط من جانب الجهاديين العنيفين المنتسبين لتنظيم الدولة غضبَ المجتمع القبطي.
لكن رغم مواجهة نظام السيسي لمستويات من السخط لم يسبق تخيلها في عامي 2013 و2014، فإن النظام الحالي و”الصفقة السلطوية” التي شُيِّد على أركانها يبقيان على حالهما في المستقبل القريب، تدعمهما المخاوف من الفوضى و/أو العودة لحكم الإخوان المسلمين.
خاتمة
سعت هذا المقالة إلى إعادة تهذيب نظرية “الأمننة” لتناسب السياقات غير الديموقراطية، وسلطت الضوء على أشكال جديدة من الفهم لاستخدام عنف الدولة في بلدان ما بعد الربيع العربي، عبر دراسة الحالة المصرية.
واستنادًا إلى دراسة “جوها فوري” التي تعرّف الأمننة بوصفها استخدام المنطق الأمني لخرق القواعد الجارية؛ تبرز المقالة جدوى استخدام مفهوم “الهيمنة” لدى غرامشي لتفسير هذه القواعد خارج سياق العملية الديمقراطية لتشمل الصفقات الراسخة اجتماعيًا والتراكبات الأيديولوجية بين الدولة والمواطنين.
كما رأى المقال أن أنظمة ما بعد الاستقلال استخدمت عنف الدولة لدعم صفقة استبدادية، تنازل المواطنون بموجبها عن الحقوق المدنية والسياسية في مقابل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وما إن أخذت تلك الصفقة في الانهيار نتيجة لإعادة الهيكلة الاقتصادية النيوليبرالية، لم يعد المواطنون يرون مشروعية عنف الدولة، مما مهّد الطريق لاندلاع انتفاضة 25 يناير 2011.
ومن هنا، ذهب هذا المقال إلى أنه ينبغي فهم القبول الواسع لعنف الدولة غير المسبوق ضد الإخوان المسلمين في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، على أنه مؤشر لنجاح عملية الأمننة.
إلى جانب ذلك، سلط المقال الضوء على الدور الحاسم للجهات الفاعلة غير الحكومية في عملية الأمننة، فقد كانت الجهات الفاعلة غير الحكومية هي من مهدّت الطريق لتصوير جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تهديدًا استثنائيًا لمصر، ومن ثَم إعادة تقديم الجيش باعتبارها فاعلًا مُؤَمنِنًا مشروعًا.
وبناءً عليه؛ يبين المقال أن الثنائية ذات المركزية الأوروبية للدولة في مقابل المجتمع تُبسّط ديناميات الأمننة في السياقات غير الأوروبية، ونحن نقترح أن مفهوم المجتمع المدني عند غرامشي يتيح لنا رؤية سيولة وضبابية الحدود الفاصلة بين الدولة والمجتمع والجهات الفاعلة المستقلة والمُستوعَبَة، و يصور المجتمع باعتباره مساحة هجينة أو مختلطة تعمل كل الفواعل الحكومية وغير الحكومية بداخلها.
وتُجسّد حملة تمرّد هذه الهُجنة تجسيدًا ملائمًا؛ فقد استمال الجيش قادتها، لكن الحملة نفسها دعمتها مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة تضم شخصيات إعلامية مؤثرة من توفيق عكاشة المؤيد للجيش إلى باسم يوسف الأكثر استقلالية، وحتى النشطاء المناهضون للجيش مثل حركة 6 أبريل.
وبصرف النظر عن مدى استقلال هذه الجهات الفاعلة من عدمه، فقد ساهمت خطاباتهم داخل المجتمع المدني مجتمعة في دعم الجيش لاتخاذ إجراءات حاسمة في يوليو 2013 ، وتبرير ممارساته القمعية، إذ كان الجمهور مُهيئين جيدًا.
أخيرًا؛ تبين الحالة المصرية فائدة استخدام نظرية الأمننة لتسليط ضوء جديد على عمليات الثورة المضادة وإحياء السلطوية في مرحلة ما بعد الربيع العربي. فقد يكشف التركيز على خطابات النخب الأمنية والسياسية ومجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية عن ديناميات جديدة تدعم هذا التزايد الهائل في استخدام عنف الدولة، وبالتالي تتمم التحليلات المؤسسية والمادية القائمة.
ويشير المقال، تحديدًا، إلى دور الأمننة في إعادة تأسيس السلطوية في أعقاب ثورات 2011 عبر إعادة صوغ “صفقة سلطوية جديدة”.
وعلى نطاق أوسع؛ يمكن لتطبيق نظرية الأمننة على غير الديمقراطيات أن يفتح آفاقًا جديدة من البحث في العمليات التي تستخدم المنطق الأمني لتمكين الأنظمة التسلطية وحمايتها، وهي مهمة ربما تكون أكثر إلحاحًا اليوم من أي وقت مضى.
الهوامش
____________________________________
(1) الورقة منشورة في ساج جورنال بتاريخ 8 إبريل 2019، للمؤلفين نيكول برات من جامعة ورواك ببريطانيا، ودينا رزق من جامعة ريدنج ببريطانيا، والورقة أيضا منشورة في منشورات جامعة ورواك البريطانية بتاريخ 20 ديسمبر 2018. قام بترجمتها : مركز المسار للدراسات الإنسانية.
Nicola Pratt, Dina Rezk,
Securitizing the Muslim Brotherhood: State violence and authoritarianism in Egypt after the Arab Spring, SAGE journals, 8 Apr.2019,
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0967010619830043?journalCode=sdib
(2) الأمننة :كمصطلح متداول في العلاقات الدولية، يعني قيام الفاعلين في الدولة بعملية تحويل المواضيع إلى مسائل أمنية بمعنى آخر ، هي نسخة معقدة من التسييس Politicisation تسمح باستخدام معاني استثنائية باسم الأمن. والقضايا التي تؤمنن لا تمثل بالضرورة قضايا أساسية لبقاء الدولة، بل ربما تمثل قضايا متعلقة %A