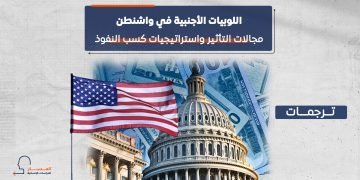المحتويات
مقدمة المترجم
الملخص التنفيذي
أولا: مقدمة الملف
أ. التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزاعات في الشرق الأوسط
ب. اقتصادات الشرق الأوسط قبل “طوفان الأقصى”
1. الدول المركزية
2. الدول المجاورة
3. الدول الهشة والمتأثرة بالنزاع
4. دول الخليج ودول المغرب العربي
ثانيا: التأثيرات الإقليمية لحرب غزة
أ. التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة
1. تدمير البنية التحتية
2. تأثير الحرب على النمو الاقتصادي
3. تأثير الحرب على القطاعات الاقتصادية
4. نقاط الضعف في الحساب الجاري
5. التأثير المالي
6. التأثير على استقرار القطاع المصرفي
7. التأثير على سوق العمل
ب. التكلفة الاجتماعية للحرب في غزة
ثالثا: التأثيرات العالمية لحرب غزة
أ. المخاطر الجيوسياسية وأسواق السلع
ب. المخاطر المالية العالمية
ج. الاضطرابات البحرية
رابعا: خاتمة الملف
مقدمة المترجم
بعد عام ونيف من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، تواصل الحرب تأثيراتها العميقة على المنطقة بأكملها، حيث طالت تبعاتها العديد من الدول بشكل مباشر وغير مباشر.
وإذ يحاول “مركز المسار” رصد التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لـ”طوفان الأقصى”، اطلع المركز على ملف مفصل صادر عن المجلس الأطلسي (Atlantic Council) حول تأثير الحرب على غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى تأثيراتها على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومصر، والأردن، وعدد من الدول الأخرى في المنطقة، مثل تونس، والجزائر، ودول الخليج، فضلا عن تأثيرها على الاقتصاد العالمي بشكل عام. حيث أثرت هذه الحرب بشكل كبير على التجارة، والاقتصاد، والاستقرار الاجتماعي في المنطقة، مما استدعى الاهتمام والدراسة العميقة لهذه التبعات.
وعلى هذا، آثر “مركز المسار” ترجمة هذا الملف -بتصرف بسيط- بهدف تقديم رؤية أشمل للدارسين والباحثين والمهتمين، حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بعد “طوفان الأقصى”.
ومن أبرز الخلاصات التي توصل إليها “المجلس الأطلسي”، أن قطاع غزة يواجه تحديات هائلة، حيث تشير التقديرات إلى أن إزالة 37.4 مليون طن من الأنقاض قد تستغرق 14 عاما. وتظل السياسات الإسرائيلية تجاه القطاع محورية؛ ففي حال رفع الحصار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 10 بالمئة سنويا، يمكن للاقتصاد الغزي أن يستعيد مستوياته ما قبل الحصار بحلول عام 2035. أما إذا استمر الحصار مع نمو سنوي محدود لا يتجاوز 0.4 بالمئة، فقد يتطلب الأمر سبعة عقود للعودة إلى مستوى النشاط الاقتصادي لعام 2022.
وفي “إسرائيل”، تأثرت الأسواق المالية بالحرب بشكل ملحوظ، حيث شهدت تراجعا في تصنيفاتها الائتمانية من وكالات مثل “موديز” و”فيتش”. وتستمر هذه الضغوط المالية مع احتمالية ارتفاع تكاليف الاقتراض ورفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. كما خلص الملف إلى أن مصر تأثرت توقعات نموها الاقتصادي نتيجة الحرب، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو السنوي بين 0.5 و0.6 نقطة مئوية بحلول عام 2025 إذا استمرت الحرب.
وإليكم ترجمة الملف الذي يبدأ بملخص تنفيذي.
الملخص التنفيذي[1]
لمنطقة الشرق الأوسط تاريخ طويل من الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التي ألقت بظلالها على اقتصادات المنطقة بشكل كبير. فإلى جانب الخسائر البشرية والمادية الفادحة، والنزوح واسع النطاق، والتكلفة الهائلة الناجمة عن تدمير البنى التحتية والممتلكات، فقد رسخت الحروب الفقر وعدم المساواة، ودمّرت ما تحقق من إنجازات تنموية على مدار عقود.
وتمثل الحرب الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة أحدث تطور لصراع هو الأطول في العالم: الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وأسفرت الحرب المستمرة عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف، وحركة نزوح في ثلاث دول، وتدمير بنى تحتية تقدر بمليارات الدولارات. وإذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم قريبا، فقد تتورط أطراف أخرى سريعا في حرب إقليمية شاملة، الأمر الذي يحمل تداعيات سلبية عديدة على المنطقة والعالم أجمع.
وحتى اللحظة، تسببت الحرب في أعباء اقتصادية ثقيلة على المستويين العالمي والإقليمي. فعلى الصعيد العالمي، تسببت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر في تعطيل طرق الملاحة البحرية، ما أسفر عن تداعيات اقتصادية ومناخية لا تزال مستمرة. ذلك أن طول مسارات النقل وزيادة استهلاك الوقود أسهم في رفع تكاليف الشحن، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، هذا فضلا عن أن زيادة الانبعاثات الناتجة عن زيادة حركة السفن حول رأس الرجاء الصالح تحمل تداعيات سلبية على البيئة.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد اضطرت اقتصادات الشرق الأوسط إلى التعامل مع تباطؤ النمو، وارتفاع المخاطر على الحساب الجاري، وارتفاع التكاليف المالية، وضعف الاستقرار في القطاع المالي، بالإضافة إلى تأثيرات متعددة على القطاعات الاقتصادية وأسواق العمل.
وتفرض الحرب في غزة تكاليف اجتماعية مرهقة على الأمن الغذائي في الدول الإقليمية الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث زادت الهشاشة الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، واليمن، ولبنان. وتواجه هذه الدول -التي تعتمد بالفعل على واردات الغذاء- تحديات جمة بسبب العقوبات وتقييد تدفقات المساعدات الإنسانية، التي تعد شريان الحياة الأساسي لبقاء السكان.
وإذا تصاعدت الحرب واستمرت، فإنها ستزيد من الهشاشة والضبابية في المنطقة، بما في ذلك اقتصاداتها الغنية بالنفط. كما سيتعرض الاستقرار السياسي للتهديد، مما يعزز حالة الضبابية في الشأن الاقتصادي، ويقود إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وتحويلها بعيدا عن المنطقة. علاوة على ذلك، قد تتسبب أسواق السلع -خاصة في ظل خفض الإنتاج الذي قررته دول “أوبك بلس”- في زيادة التضخم وتعميق الأزمة المالية العالمية.
ولذلك، فإن المضي نحو وقف دائم لإطلاق النار وتنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. فما من شك في أن جهود بناء السلام، بوساطة المجتمع الدولي، باتت ضرورة ملحة، يمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة. فإلى جانب الخسائر البشرية، قد يؤدي تصاعد الحرب في غزة وانتشارها إلى دول أخرى إلى اضطرابات في أسعار السلع، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف المالية، وهو ما قد يقوض التعافي الاقتصادي الهش الذي بدأ يتشكل بعد نجاح السياسات في كبح التضخم.
أولا: مقدمة الملف
تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة متنوعة وغير متجانسة، وغالبا ما تُوصف بأنها عبارة عن دول مُصدّرة للنفط وأخرى مستوردة له؛ ذلك أنها تضم خمسا من أكبر عشر دول منتجة للنفط عالميا: السعودية، العراق، الإمارات، إيران، والكويت، بالإضافة إلى ست دول من بين أكبر 20 منتجا للغاز.
مع ذلك، فإن هذا الوصف يبدو في غاية التبسيط، فالمنطقة تتميز بتباين مستويات الدخل بين دولها، حيث تضم دولا ذات دخل مرتفع، وأخرى فوق المتوسط، وأخرى أقل من المتوسط، إلى جانب دول ذات دخل منخفض. أضف إلى ذلك أنها تحتوي على ست دول تُعد من بين 39 دولة عالميا مصنفة على أنها هشة اقتصاديا ومؤسساتيا، ومتأثرة بالنزاعات. وعلى هذا، لا يمكن لنموذج واحد أو تصنيف واحد أن يعكس تعقيدات المنطقة بشكل كامل.
ولأغراض هذا الملف، فإننا سنصنف دول المنطقة إلى فئات لتوضيح التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة بشكل أفضل. تشمل هذه الفئات: دول المركز (“إسرائيل” والأراضي الفلسطينية)، والدول المجاورة (مصر، الأردن، ولبنان)، والدول ذات الدخل المتوسط والعالي غير المتأثرة مباشرة بالنزاع، والدول الهشة والمتضررة منه.
أ. التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزاعات في الشرق الأوسط
تحمل منطقة الشرق الأوسط إرثا من الاضطرابات الجيوسياسية، من ذلك الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وحرب تحرير الكويت وغزو العراق، والحرب الإيرانية-العراقية. وخلال الأعوام الأخيرة، زادت الديناميكيات الجيوسياسية والربيع العربي من هشاشة المنطقة وأثرت على اقتصاداتها.
وتتفاقم التحديات التي تتعرض لها المنطقة بفعل صدمات إقليمية وعالمية، كالتغيرات المناخية، وجائحة كوفيد-19، واضطرابات الإمداد، والحرب في أوكرانيا.
هذه العوامل أدت إلى بروز “حالات طوارئ معقدة” في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتفكك اقتصادي عالمي وتشديد السياسات المالية، مما أسهم في تراجع نمو منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في أماكن أخرى.
ولا يزال تصاعد النزاعات والعنف خلال العقد الماضي يخلف آثارا اجتماعية واقتصادية قاسية، من خسائر بشرية وتهجير وتدمير البنية التحتية، إلى خسائر اقتصادية أوسع تشمل تحويل الموارد للتسلح، وهروب رأس المال، وفقدان الفرص وتآكل رأس المال البشري. ففي عام 2018 وحده، تراوحت التكلفة الاقتصادية للعنف في المنطقة العربية بين 3 و67 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتؤدي النزاعات إلى خسائر اقتصادية مستدامة تشمل تراجع الاستهلاك والاستثمار، وضعف الإنتاجية، وتعطل الخدمات، وانخفاض التجارة. وتختلف تداعياتها بحسب نوع النزاع ومدته، حيث قد تستمر آثار الحروب الأهلية لأربع سنوات، بينما تقتصر تداعيات النزاعات الدولية على عام إلى عامين فقط.
وتشير التقديرات إلى أن النزاعات تتسبب في خفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة تصل إلى 28 بالمئة لمدة تصل إلى عشر سنوات من اندلاعها، كما تقلص التجارة الرسمية بشكل كبير، حيث تنخفض الصادرات بنسبة 58 بالمئة والواردات بنسبة 34 بالمئة بعد عقد من الزمن.
وتعتمد معظم دول المنطقة على استيراد الغذاء، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. وتفاقم النزاعات حالة انعدام الأمن الغذائي نتيجة تأثر أنظمة التوزيع والبنى التحتية. كما تعاني الدول من تحديات مالية متزايدة، كتدهور إدارة الدين العام والاضطرابات البحرية وانخفاض إنتاج النفط، مما يعمق حالة الضبابية في الإقليم.
وعلى هذا، يحاول هذا الملف تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب الإسرائيلية على غزة ضمن أربع فئات: الدول المركزية (إسرائيل وفلسطين)، والدول المجاورة (مصر، الأردن، ولبنان)، والدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط غير المتأثرة مباشرة، والدول الهشة والمتضررة. ويركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تأثيرات الحرب على الأمن الغذائي والتهجير، دون التطرق للتحليل السياسي أو الأمني.
ويستعرض الملف الآثار المحتملة للنزاع على المستوى العالمي، بما يشمل اضطرابات الملاحة البحرية والتجارة، والأوضاع المالية، والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بأسواق السلع. وفي الختام، يناقش السيناريوهات المحتملة إذا استمرت الحرب لعام 2025، أو إذا توسعت إقليميا.
ب. اقتصادات الشرق الأوسط قبل “طوفان الأقصى”
1- الدول المركزية
- “إسرائيل”
على عكس الاقتصادات الأخرى في المنطقة، تعافى الاقتصاد الإسرائيلي بشكل قوي بعد جائحة كوفيد-19، مدفوعا بقطاع التكنولوجيا العالية والصادرات. فبين عامي 2017 و2022، ساهم قطاع التكنولوجيا العالية بـ 32 بالمئة من نمو الناتج الاقتصادي، وفي عام 2022، نما الاقتصاد بنسبة 6.5 بالمئة، وكان من المتوقع أن ينمو بنسبة 9 بالمئة في 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وساهمت التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الجائحة في تخفيف زيادات تكاليف المعيشة، وبعد انتهائها نجحت السلطات في تقليص العجز المالي من 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى فائض قدره 0.6 بالمئة في 2022.
وكان من المتوقع أن ينخفض العجز إلى -0.9 بالمئة في 2023، مع استقرار النمو عند 3.8 بالمئة في 2028. كما ساعدت السياسات المالية الحذرة في بناء احتياطيات وتقليل الدين من أكثر من 70 بالمئة في 2020 إلى حوالي 61 بالمئة في 2022، مع توقع انخفاضه إلى 55 بالمئة على المدى المتوسط. كذلك، بدأ التضخم بالتراجع بعد ذروته في 2022. وبالعموم، كان الوضع الخارجي للاقتصاد الإسرائيلي قويا في 2022 وكان من المتوقع تحسنه في 2023.
وتجدر الإشارة إلى عدة نقاط، منها أن الحرب في أوكرانيا لم تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب التجارة المحدودة مع روسيا وأوكرانيا.
علاوة على ذلك، فإن اعتماد إسرائيل على الطاقة متوسط، حيث يغطي الإنتاج المحلي أكثر من نصف احتياجاتها. ورغم تجاوز الأنشطة الاقتصادية في قطاعي البناء والتكنولوجيا العالية مستويات ما قبل الجائحة، فإن تعافي سوق العمل ظل غير متوازن.
أضف إلى ذلك أن قطاع التكنولوجيا الفائقة يمثل 12 بالمئة من التوظيف و17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ونصف الصادرات، بينما يعاني من نقص العمالة الماهرة، مما أدى إلى زيادة الأجور بنسبة 7 بالمئة في 2019.
- الأراضي الفلسطينية
تأخرت التنمية الاقتصادية في غزة مقارنة بالضفة الغربية بسبب سنوات من العزلة والصراع المستمر، كما فرضت “إسرائيل” قيودا على الحركة والتجارة والاستثمار، أثرت على 61 بالمئة من الضفة الغربية (المنطقة “ج”) وكانت أشد قسوة على غزة. وخلال الخمسة عشر عاما الماضية، شهدت غزة تراجعا في قدرتها الإنتاجية وتدهورا في مؤشرات الحياة الاجتماعية، حيث اعتمد النمو الاقتصادي على الاستهلاك الحكومي في ظل ضعف الاستثمار والوساطة المالية، بالإضافة إلى عدم كفاية الأجور لتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء.
ومنذ انفصال غزة عن السلطة الفلسطينية عام 2007، ازداد التباين الاقتصادي بين غزة والضفة الغربية، فبين 2007 و2022، أدى الحصار الإسرائيلي، والحروب الأربع مع “إسرائيل” (2008-2009، 2012، 2014، 2021)، والخلافات السياسية إلى ركود اقتصادي طويل الأمد في غزة، مع معدل بطالة بلغ 45 بالمئة و53 بالمئة من السكان تحت خط الفقر. وأظهرت بيانات 2019-2020 أن 0.8 بالمئة من الأطفال دون الخامسة في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد. في المقابل، بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 13 بالمئة، وكان حوالي 14 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
ويعتمد اقتصاد غزة بشكل رئيسي على الاستهلاك الحكومي، بينما يعتمد اقتصاد الضفة الغربية على إنفاق الأُسَر، وأدى الحصار وقيود التجارة إلى تقليص وصول غزة إلى الاقتصاد الخارجي، حيث تعتمد بشكل كبير على الواردات والمساعدات الغذائية، مع 63 بالمئة من الواردات من “إسرائيل” والباقي من مصر.
وقبل الحرب الأخيرة، كان الاقتصاد الفلسطيني يتراجع بسبب تزايد العنف والخسائر البشرية، إلى جانب العمليات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما زاد من تدهور الاستقرار الاجتماعي والسياسي، في ظل ضغوط مالية ونقص تمويل الوكالات الإنسانية والتنموية، الذي أثر على تقديم الخدمات الحكومية.
وبالعموم، كان التوقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية قاتما، مع انخفاض الدخل للفرد على المدى المتوسط واستمرار الفجوة الكبيرة بين مستويات المعيشة في غزة والضفة الغربية. وقبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عانى أكثر من 63 بالمئة من سكان غزة من الفقر، واعتمد 80 بالمئة على المساعدات. وكانت الأزمة المالية وضغط السيولة يهددان الخدمات الحكومية والدعم الاجتماعي، حيث ظلت الأجور في غزة ثابتة منذ عام 2000، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية.
وبعد جائحة كوفيد-19، تفاقم الوضع الإنساني في غزة، حيث شكلت الحالات في القطاع ثلثي إجمالي الإصابات في الأراضي الفلسطينية. ومع ضعف القدرة على الفحص وصعوبة الوصول إلى اللقاحات، وعندما أصبح اللقاح متاحا من خلال برنامج كوفاكس الدولي (في مارس/آذار 2021)، كان 3 بالمئة فقط من الفلسطينيين قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
2- الدول المجاورة
- مصر
حققت مصر استقرارا اقتصاديا بعد الإصلاحات بين 2016 و2019 بدعم من صندوق النقد الدولي، مما جعلها من الاقتصادات الناشئة القليلة التي حققت نموا إيجابيا في 2020. وتضمنت الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وإلغاء معظم دعم الوقود، واتخاذ تدابير تقشفية.
وبين 2017-2018 والنصف الأول من 2019-2020، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5 بالمئة، وانخفضت البطالة إلى 8 بالمئة، وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 5 بالمئة في مارس/آذار 2020، مقارنة بـ 14 بالمئة في مايو/أيار من نفس العام.
وبحلول فبراير/شباط 2020، بلغ الاحتياطي الدولي في مصر 45 مليار دولار. ورغم تدهور الميزانية العامة، تحول الرصيد المالي الأساسي من عجز تجاوز 3 بالمئة إلى فائض يقارب 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما أظهر مسارا مستداما لانخفاض دين الحكومة.
وتحسنت أوضاع الأسواق المالية مع وصول منتظم إلى أسواق رأس المال الدولية، قبل أن يسحب المستثمرون أكثر من 15 مليار دولار خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020 بحثا عن ملاذات آمنة. وفي مايو/أيار 2020، حصلت مصر على 2.8 مليار دولار تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي كجزء من خطة لدعم استقرار الاقتصاد وتخفيف تأثيرات الجائحة.
وفي يونيو/حزيران 2020، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق تسهيل ممدد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، مع توقعات بعودة النمو لمستويات ما قبل الجائحة في 2021-2022 واستئناف الإصلاحات الاقتصادية. رغم ذلك، قوضت التحديات الهيكلية المتفاقمة، وتراجع التمويل الخارجي، وارتفاع تكاليف الاقتراض الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ورغم السيطرة النسبية على تداعيات الجائحة، باستثناء قطاع السياحة، اختبرت أزمات سلاسل الإمداد وحرب أوكرانيا صمود الاقتصاد؛ إذ أدت هذه الحرب إلى زيادة الضغوط الخارجية، الناجمة عن ضعف مرونة سعر الصرف وضعف القدرة على تحمل أعباء الدين العام.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج دعم لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واستعادة الاحتياطيات، وتحفيز نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.
وتجاوزت الاحتياجات التمويلية الإجمالية 14 مليار دولار، مع توقع تغطية الفجوة من شركاء دوليين وإقليميين عبر تصفية أصول مملوكة للدولة وتمويل تقليدي من مؤسسات مالية ودول أخرى.
وطلبت السلطات المصرية الوصول إلى صندوق “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF) بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي، فيما مول عجز الحساب الجاري بسحب الأصول الأجنبية الصافية للبنوك. وبحلول فبراير/شباط 2022، سجلت الأصول الأجنبية أدنى مستوى تاريخي عند -11.8 مليار دولار، بانخفاض يتجاوز 18 مليار دولار عن فبراير 2021.
واستمرت التحديات الاقتصادية مع انخفاض الواردات واضطراب سوق العملات وتشديد الظروف المالية العالمية، بينما ركزت السياسات النقدية وسعر الصرف على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأسعار.
- لبنان
أدت الأزمة المالية في لبنان عام 2019 إلى نشوب أزمة اجتماعية واقتصادية شديدة ومعقدة، فقد شهد الاقتصاد انكماشا بحوالي 40 بالمئة، وفقدت العملة المحلية 98 بالمئة من قيمتها، في حين بلغ التضخم مستويات ثلاثية الأرقام، كما فقد البنك المركزي ثلثي احتياطياته الأجنبية.
ولا تزال التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة حادة، حيث تدهور الدخل الفعلي وزادت معدلات البطالة والفقر بشكل كبير. ومع تراجع سعر الصرف في الربع الأول من 2023، تسارعت الدولرة وارتفعت معدلات التضخم إلى 270 بالمئة على أساس سنوي. ونتيجة لانهيار الإيرادات، كان من المتوقع أن يكون العجز المالي قد اتسع ليصل إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. وانهارت الخدمات العامة، مع مواجهة القطاع المصرفي صعوبات كبيرة، وزيادة العجز في الحساب الجاري ليصل إلى حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وللتخفيف من آثار الأزمة المالية، طلبت السلطات اللبنانية دعم صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022، وجرى التوصل إلى اتفاق يتضمن حزمة من السياسات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والهيكلية. وركزت الإصلاحات على ترشيد المالية العامة، وإصلاح القيود على رأس المال، وإعادة هيكلة النظام المصرفي. ومع ذلك، حالت التعقيدات السياسية الداخلية دون تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. ومنذ عام 2018، صنف لبنان من الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
والجدير بالذكر، أن لبنان يستضيف ثاني أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه، حيث يعيش واحد من كل سبعة لاجئين في البلاد، و9 من أصل 10 لاجئين يعانون من الفقر المدقع. ووفقا لدراسة حديثة للبنك الدولي، فإن الفقر في لبنان قد تضاعف ثلاث مرات، من 12 بالمئة في 2012 إلى 44 بالمئة في 2022، مع ارتفاع كبير في التفاوت في الدخل. وهذا يمثل اتجاها مقلقا، خصوصا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة، التي تفاقمت بسبب نقص التمويل العالمي لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.
- الأردن
ساهم التزام الأردن ببرنامج إصلاحي مدعوم من صندوق النقد الدولي في التخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 وأزمة تكاليف المعيشة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. وقبل الجائحة، تعرض الاقتصاد الأردني لصدمات إقليمية وعالمية، بما في ذلك إغلاق الحدود مع العراق وتعطيل إمدادات الغاز واستضافة اللاجئين السوريين الذين شكلوا 15 بالمئة من السكان.
وارتفعت معدلات البطالة إلى 19 بالمئة والدين العام إلى 78 بالمئة بحلول عام 2019. كما كانت الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة منخفضة، وأسفرت أزمة تكاليف المعيشة عن تكاليف مالية كبيرة، مما دفع الحكومة لتقديم دعم للوقود للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.
وبدعم من صندوق النقد، تمكنت السلطات من الاستفادة من 334 بالمئة من حصتها في الصندوق لتحقيق والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص الدين العام إلى مستويات مستدامة، والمضي قدما في مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مع تخفيف تأثير الأزمات على الفئات الضعيفة. ورغم ذلك، لا تزال تحديات -مثل البطالة المرتفعة، التي بلغت 22.3 بالمئة عام 2023، ونسبة الدين المرتفعة- قائمة.
وبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن 730 ألف اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم 89 بالمئة من السوريين، و8 بالمئة من العراقيين، والبقية من جنسيات أخرى كاليمنيين والسودانيين والصوماليين. بالإضافة إلى ذلك، يوجد 2.3 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن وفق وكالة الأونروا، حيث بدأ أقدمهم في الوصول منذ عام 1948.
ورغم تاريخ الأردن الطويل في استقبال اللاجئين، أظهرت البيانات أنه حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لم يتلق سوى خُمس التمويل المطلوب، مما أثر سلبا على تلبية احتياجات اللاجئين الأساسية وأمنهم الغذائي. وارتفعت معدلات الفقر بينهم بمقدار 10 نقاط مئوية، لتصل إلى 67 بالمئة في عام 2023 خلال عامين فقط.
3- الدول الهشة والمتأثرة بالنزاع
تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ست دول هشة ومتأثرة بالنزاعات، أربع منها في حالة حرب (العراق، سوريا، الأراضي الفلسطينية، واليمن)، واثنتان تواجهان هشاشة مؤسسية واجتماعية (لبنان وليبيا). هذه الدول تعاني من تآكل مؤسسي يعطل السياسات الفعالة ويحد من تقديم الخدمات العامة.
وقبل جائحة كورونا، واجهت الدول الهشة تحديات كبرى، تفاقمت بسبب الأزمات المتداخلة وتشديد الظروف المالية العالمية. ووفق توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2022، فلم يكن من المتوقع أن يعود الدخل الفردي في هذه الدول إلى مستويات 2019 قبل عام 2024.
وعلى سبيل المثال، أدى النزاع في اليمن إلى أزمة إنسانية حادة، حيث تقدر الأمم المتحدة أن 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، بينهم 14 مليون شخص بحاجة ماسة، و4.5 مليون نازح. وقبل الحرب في 2014، كان اليمن يسجل أدنى نصيب للفرد من الناتج المحلي في المنطقة.
وبين 2015 و2023، انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 54 بالمئة، مما فاقم الفقر المدقع. كما أثر حصار الحوثيين لصادرات النفط الحكومية على النمو الاقتصادي واستقرار القطاعين المالي والنقدي، وتدهور الوضع بسبب التغير المناخي والفجوة التمويلية الكبيرة.
ومع تشديد الظروف المالية العالمية، انخفض دعم الجهات المانحة للشركاء التنمويين، مما زاد تعقيد عمل المؤسسات، خاصة في ظل وجود حكومة منافسة أنشأها الحوثيون في الشمال، وتفاقمت التحديات الاقتصادية بسبب تباين أسعار الصرف وسيطرة الحوثيين على الموانئ، ما أدى إلى تعطيل الواردات الأساسية، خاصة الإمدادات الغذائية.
4- دول الخليج ودول المغرب العربي
بين عامي 2017 و2022، تأثرت أكبر اقتصادات الخليج، قطر والسعودية والإمارات، إضافة إلى الجزائر والمغرب وتونس، بالتغيرات الاقتصادية العالمية وجائحة كوفيد-19.
وسعت دول الخليج، عبر رؤى تنموية متوسطة وطويلة الأمد، إلى تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، مما ساهم في تعزيز التعافي بعد انهيار الطلب العالمي على النفط مع بداية الجائحة.
إذ حافظت قطر على قوة وضعها المالي بفضل صندوقها السيادي، ودعمت النشاط الاقتصادي بضخ السيولة في القطاع المالي، إلى جانب تنفيذ تدابير مالية للتخفيف من آثار الجائحة، واستمرار التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022.
أما الإمارات، فقد حافظت على وضع خارجي مرن بفضل تنويع اقتصادها، الذي يشمل استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة، إضافة إلى تنفيذ تدابير مالية وتنظيمية للتخفيف من آثار الجائحة.
وفي السعودية، أسهمت رؤية 2030 في وضع أسس اقتصاد أكثر تنوعا وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب تدابير دعم مالي خُصصت للتخفيف من تداعيات الجائحة.
أما الجزائر، فقد تأثر اقتصادها المعتمد على الهيدروكربونات بانهيار أسعار النفط والتعافي البطيء، ما دفع السلطات لتنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات تقشف مالي لمعالجة العجز.
وفي المغرب وتونس، رغم اعتمادهما على السياحة والصناعة، واجهتا اضطرابات اقتصادية حادة، لكنهما لجأتا إلى مساعدات مالية دولية وسياسات مالية مستهدفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ثانيا: التأثيرات الإقليمية لحرب غزة
أ. التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة
1- تدمير البنية التحتية
لا يمكن حتى الآن تقدير حجم الدمار في غزة بدقة، لكن تقييما أوليا أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2024 قدّر الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار، ما يعادل 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لغزة والضفة في 2022.
وتعكس الأرقام المأساوية الظروف الإنسانية القاسية التي يعانيها الناجون، مع انهيار المرافق العامة بالكامل. وتُقدّر إزالة 37.4 مليون طن من الأنقاض بأنها قد تستغرق 14 عاما، مما يجعل إعادة الإعمار تحديا ضخما.
ومن الضروري التفكير في المستقبل والتخطيط له، وهذا لا يقتصر على إعادة البناء المادي فقط، بل يتطلب أيضا توفير المساعدات الإنسانية لضمان استقرار الوضع وتمكين الناس من استئناف النشاط الاقتصادي. وستكون مسؤولية المجتمع الدولي تقديم الأموال اللازمة لهذا الغرض.
بالإضافة إلى ذلك، ستظل السياسات الإسرائيلية تجاه غزة، وخاصة ما إذا كانت ستنهي الحصار، محورية لنجاح جهود إعادة البناء. في أحد السيناريوهات، إذا أنهت إسرائيل الحصار وبدأت إعادة البناء بعد الحرب مع نمو اقتصادي مستدام قدره 10 بالمئة، قد يستعيد اقتصاد غزة نشاطه الذي كان عليه قبل الحصار (في 2006) بحلول عام 2035.
وفي سيناريو أكثر تحفظا، إذا استمر الحصار بعد الحرب وبدأت عملية إعادة البناء، مع نمو اقتصادي سنوي بنسبة 0.4 بالمئة، سيحتاج الاقتصاد الغزي إلى سبعة عقود للوصول إلى مستوى النشاط الاقتصادي لعام 2022.
مع ذلك، تظل السياسات وخطط التمويل الخاصة بـ “اليوم التالي” غير واضحة، حيث ما زالت القرارات المتعلقة بالسيطرة على غزة وشكل الحكم فيها قيد التغيير. حيث تتفاوت الدعوات بشأن مستقبل القطاع، بدءا من اقتراحات بتهجير الفلسطينيين من غزة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية، وصولا إلى دعوات لفرض سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع. علاوة على ذلك، يظل تمويل إعادة الإعمار بعد الحرب غير محدد، ولا توجد رؤية واضحة بشأن مصادره أو خططه التنفيذية.
وجرى ذكر بعض الدول الخليجية كممولين محتملين لإعادة الإعمار، حيث خصصت بعض الدول ميزانية مبدئية تبلغ 3 مليارات دولار على مدى عشر سنوات في أعقاب اجتماع الدول المانحة في أوسلو، النرويج، في ديسمبر/كانون الأول 2023، مع اعتبار الإمارات والسعودية وقطر من أكبر المانحين. كما يُتوقع أن يسهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا في التمويل، نظرا لدورهما البارز في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن تُطلب من الولايات المتحدة المساهمة في تمويل جهود إعادة الإعمار.
وتتزايد الدعوات لتحمل إسرائيل جزءا من التكاليف، بالنظر إلى مسؤوليتها عن الأضرار، مع اعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى بها كدولة احتلال. ومع ذلك، فإن غياب التوافق السياسي بشأن خطة “اليوم التالي” يعيق تحديد كيفية توفير الأموال، وهو أمر حاسم بالنظر إلى حجم الدمار الهائل في غزة. وقد يتردد بعض المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل إعادة بناء البنية التحتية دون حل نهائي للنزاع، خشية أن تعود جهود إعادة الإعمار إلى نقطة الصفر نتيجة للصراعات المستقبلية.
2- تأثير الحرب على النمو الاقتصادي
أدى اندلاع الحرب إلى صدمات في العرض والطلب، مما تسبب في انكماش النشاط الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 21 بالمئة في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. وتراجعت طلبات الاستثمار والاستهلاك الخاص في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 26 و8 بالمئة على التوالي. وبعد مرور سبعة أشهر على بدء الحرب، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن التأثير المباشر للصراع بلغ ذروته في نهاية عام 2023 ثم بدأ في التراجع.
من جانب الطلب، أظهرت البيانات أن استهلاك القطاع الخاص بدأ في التعافي، وأن الإسرائيليين الذين كانوا يعيشون في الجزء الشمالي بدأوا بالعودة إلى منازلهم. ولكن آثار صدمات العرض ستستمر لفترة أطول. وفي توقعاته لعام 2024، افترض “بنك إسرائيل” أن الحرب ستستمر طوال العام مع زيادة في حدتها، وأن التأثير المباشر على الاقتصاد سيبدأ في التراجع بحلول عام 2025. وكان هذا التوجه يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نموا بنسبة 2 بالمئة في 2024 و5 بالمئة في 2025.
وفي توقعات يوليو/تموز 2024، عدّل “بنك إسرائيل” تقديراته للنمو بانخفاض قدره 0.5 بالمئة في 2024 و0.8 بالمئة في 2025. كما عدّل توقعات التضخم، حيث ارتفعت من 2.7 بالمئة إلى 3 بالمئة في 2024، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 2.3 بالمئة في 2025، مع زيادة في معدلات الفائدة.
وتشير التوقعات بأن الحرب ستكون أطول وأكثر حدة إلى أن صدمات العرض والطلب ستستمر في التأثير على الاقتصاد بشكل كبير. ومن جانب الطلب، من المتوقع أن يتراجع الاستهلاك العام والخاص نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، بينما سيستمر القطاع السياحي في المعاناة، خاصة إذا تصاعدت الحرب على الحدود الشمالية. ومن جانب العرض، ستستمر صدمات العرض بسبب نقص العمالة المستمر وانخفاض الإنتاج في مناطق النزاع.
وفي الربع الأول من عام 2024، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية بنسبة 35 بالمئة، نتيجة لانكماش اقتصادي في غزة بنسبة 86 بالمئة خلال نفس الفترة. قبل ذلك، شهد نهاية الربع الرابع من عام 2023 تراجعا في النمو في الأراضي الفلسطينية بنحو 30 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، بسبب انكماش في غزة تراوح بين 81 و86 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة في العام الذي سبقه.
ويعد التراجع الكبير في نمو الربع الأول لعام 2024، الذي أورده مؤخرا البنك الدولي، أكبر بكثير من التوقعات السابقة. ففي تقرير سابق، كان البنك الدولي قد توقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة أكثر من 50 بالمئة في 2024، في حين يمكن أن تشهد الأراضي الفلسطينية – ككل – تراجعا بنسبة تتراوح بين 6.5 إلى 9.4 بالمئة في نفس العام.
ومع استمرار تطور تداعيات الحرب على غزة، كان التوقع للمستقبل في عام 2024 وما بعده غير مؤكد بتاتا. فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بنسبة 12 نقطة مئوية في 2023 مقارنة بعام 2022، وكان من المتوقع أن يتراجع أكثر في 2024.
وفي غزة، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28 نقطة مئوية في 2023 ليصل إلى 1,084 دولارا، وهو ما يعادل خمس الناتج المحلي للفرد في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، فإن المبالغ الكبيرة من إيرادات الضرائب، أو “إيرادات المقاصة”، التي تحتفظ بها “إسرائيل”، تزيد من تفاقم الاقتصاد الضعيف أصلا في الأراضي الفلسطينية.
وفي الدول المجاورة مثل مصر، تأثرت آفاق النمو بالفعل جراء الحرب، ولكن إذا استمرت الحرب في غزة وتفاقمت تداعياتها، فقد تترتب عليها آثار اقتصادية كبيرة وطويلة الأمد على المستوى الكلي. وبافتراض انتهاء النزاع بنهاية عام 2024، تراجعت التوقعات بشأن النمو في مصر. وتُظهر المقارنة بين التوقعات السابقة واللاحقة للحرب أن النمو السنوي قد ينخفض بين 0.5 و0.6 نقطة مئوية سنويا بحلول عام 2025.
كما انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 47 بالمئة في يناير/كانون الثاني 2024 مقارنة بالعام الماضي، وقد تؤدي الهجمات المستمرة في البحر الأحمر إلى تحويل دائم للتجارة البحرية بعيدا عن قناة السويس، مما يكبد مصر خسائر في تدفق العملة الأجنبية والإيرادات المالية.
وفي حال طال أمد الحرب أو ازدادت شدتها، قد يتغير اهتمام المستثمرين بعيدا عن مصر والمنطقة، مما يجعلها وجهة أقل جذبا للاستثمار. وبالتالي، يصبح من الضروري لمصر أن تتمكن من الصمود في هذا السيناريو من خلال اتباع سياسات تعيد الاستقرار الكلي للاقتصاد وتعزز التوازنات الهيكلية المستدامة.
3- تأثير الحرب على القطاعات الاقتصادية
تأثرت قطاعات السياحة والزراعة والبناء والتجارة في الدول المجاورة نتيجة الحرب في غزة، مع تداعيات سلبية على أسواق العمل.
ففي “إسرائيل”، تراجعت السياحة الواردة بنسبة 73 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وانخفضت بنسبة 89 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق. ومن المرجح أن تؤدي التصعيدات على الحدود الشمالية مع لبنان إلى تأجيل آفاق التعافي.
وفي مصر، تراجع قطاع السياحة الواردة في الربع الرابع من 2023، مما أنهى الانتعاش الذي عاد بأعداد السياح إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
أما الأردن، فقد فقدت إيرادات سياحية بحوالي 205 مليون دينار أردني بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ومارس/آذار 2024؛ بسبب إلغاء الرحلات من دول غير عربية.
علاوة على ذلك، تأثر قطاع المطاعم بشكل كبير جراء تراجع السياحة منذ بداية الحرب في غزة، بالإضافة إلى المقاطعة الوطنية لسلاسل الوجبات السريعة الشهيرة، حيث شهدت إيراداتها تراجعا بنسبة 85 بالمئة. كما انتشرت مقاطعات مشابهة في المنطقة، حيث أرجعت شركة ماكدونالدز تراجع الطلب في منطقة الشرق الأوسط وإندونيسيا وماليزيا في الربع الأخير من 2023 إلى انخفاض حاد في الطلب. ورغم أن بعض نشاطات المقاطعة قد تكون مؤقتة، فإن التحول إلى منتجات بديلة قد يستمر.
وفي لبنان، الذي كان قطاع السياحة فيه صامدا نسبيا خلال الأزمة المالية في 2018، تأثر القطاع بشكل سلبي بسبب الحرب في غزة. فقد تراجعت السياحة بنسبة 13.5 بالمئة في الربع الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق، مما أثر على حياة العاملين في هذا القطاع. كما تراجع نشاط قطاع المطاعم بنسبة 80 بالمئة في الربع الأخير من 2023، بينما انخفضت إشغالات الفنادق، التي شهدت زيادة معتدلة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى ما بين 0-7 بالمئة بنهاية العام.
حتى الدول البعيدة عن النزاع تأثرت، فقد أُلغيت حجوزات الفنادق للسياح الإسرائيليين في المغرب بنهاية 2023، وتراجعت حجوزات عطلة رأس السنة إلى مستويات أدنى مما قبل الجائحة. ورأى “بنك المغرب” في توقعاته متوسطة المدى أن تظل إيرادات السفر مستقرة في 2024 قبل أن تبدأ في الارتفاع في 2025.
أما قطاع البناء في “إسرائيل”، فقد تأثر بشكل كبير بعد منع العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة من عبور الحدود إلى “إسرائيل”. ومن 2018 إلى 2022، شكل الفلسطينيون ربع قوة العمل في قطاع البناء، وكان معظمهم يعيشون في الضفة الغربية ويعتمدون على هذا العمل كمصدر رئيسي لدخلهم. ورغم أن 65 بالمئة من وظائف القطاع يشغلها إسرائيليون، إلا أن قطاع البناء لا يعد مصدرا بارزا للوظائف بالنسبة للإسرائيليين، حيث يمتص القطاع في المتوسط 5 بالمئة فقط من قوة العمل الإسرائيلية.
نتيجة لذلك، انخفض النشاط الاقتصادي في قطاع البناء بنسبة تزيد عن 50 بالمئة منذ بداية الحرب. وفي الوقت نفسه، تعمل السلطات الإسرائيلية على استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب آخرين، من خلال اتفاقات مع الهند وسريلانكا لاستقدام حوالي 100 ألف عامل هندي لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2026، و20 ألف سريلانكي للعمل في الزراعة والبناء.
لكن استبدال العمال الفلسطينيين يواجه تحديات تشمل انخفاض الإنتاجية، وتكاليف الإسكان والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى مخاوف من تغيير النسيج الاجتماعي. وعلى هذا، قد يواجه قطاعا البناء والزراعة نقصا كبيرا في اليد العاملة على المدى القصير إلى المتوسط.
وفي الأراضي الفلسطينية، انهار النشاط الاقتصادي في غزة وتقلص بشكل كبير في الضفة الغربية، مع تأثيرات سلبية على الأمن الغذائي والفقر والبطالة.
ولم يكن قطاع التصنيع الزراعي في الأراضي الفلسطينية يساهم بنسبة 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل كان أيضا مصدرا بارزا للوظائف وتعزيزا للأمن الغذائي. ومنذ بداية الحرب، تقدر الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في غزة بـ 629 مليون دولار، مع تضرر 81-86 بالمئة من الأراضي الزراعية.
أما في لبنان، فقد أفاد نحو ثلاثة أرباع المزارعين بخسارة دخلهم. ودُمرت 1,240 هكتارا من الأراضي، وفقد 340 ألف من حيوانات المزارع، وتضررت 10 منشآت مائية، وأغلقت 72 مدرسة جزئيا أو كليا. وفي 2023، شهد قطاعا الزراعة والصناعة في لبنان نموا سلبيا بنسبة 3 و8 بالمئة على التوالي، ومن المتوقع أن ينكمش قطاع الزراعة بنسبة 10 بالمئة في 2024.
ويمكن القول إنه إذا تصاعدت الحرب بين “حزب الله” و”إسرائيل”، فمن المرجح أن يتعمق تأثيرها على الزراعة وسبل العيش في لبنان بشكل عام.
4- نقاط الضعف في الحساب الجاري
أدى انخفاض الإيرادات من السياحة نتيجة الحرب في غزة، إلى جانب تصعيد النزاع على الحدود الجنوبية للبنان، إلى الضغط على احتياطيات “مصرف لبنان” وقدرة البلاد على تمويل الواردات الأساسية. وتعتبر السياحة واحدة من المصادر القليلة المستدامة لتدفق العملة الأجنبية إلى لبنان، وقد اعتمدت الحكومة عليها كمحرك للنمو الاقتصادي، لكن تصعيد النزاع سيحرم الاقتصاد اللبناني من هذا المصدر.
وفي مصر، ساهمت الحرب في غزة في تعميق التحديات الاقتصادية الكلية المتزايدة. وتاريخيا، اعتمدت مصر على مصدرين رئيسيين لتدفقات العملة الأجنبية: التحويلات الخاصة وإيرادات قناة السويس. ومع ذلك، وفي ظل ارتفاع التضخم نتيجة حرب أوكرانيا وتراجع إيرادات العملة الأجنبية بسبب ضعف الصادرات، بدأ الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق من خلال برنامج الإصلاح المصري لعام 2017 في التراجع باستمرار.
ودفعت السياسات المصرية العشوائية -التي تهدف إلى تقليص الطلب على الاحتياطيات الأجنبية- التحويلات الخاصة نحو القنوات غير الرسمية، مما زاد الضغط على العملة الأجنبية. وانخفضت التحويلات بنسبة 21.2 بالمئة، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023-2024.
كما انخفض العجز في الحساب الجاري في السنة المالية 2022-2023 إلى 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.5 بالمئة في السنة السابقة، بفضل انخفاض الواردات غير النفطية وزيادة النشاط السياحي وارتفاع إيرادات قناة السويس. لكن مع بداية الحرب في غزة، تراجعت إيرادات السياحة في الربع الأخير من 2023، كما قلصت هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بـ “إسرائيل” إيرادات قناة السويس بشكل حاد، بما يقارب النصف.
وتأثرت بعض دول المغرب واليمن بتزايد تكاليف الطاقة، وانخفاض إيرادات السياحة، وضغوط العملة الأجنبية، مما أثر سلبا على أوضاعها الاقتصادية. وشعرت المغرب وتونس بضغط على موازين التجارة وزيادة الضغوط المالية بسبب ارتفاع تكاليف واردات الطاقة، مما أرهق المالية العامة. ورغم زيادة أسعار النفط بشكل معتدل، إلا أن تقلباتها أدت إلى غموض، مما صعب تخطيط المالية العامة واستراتيجيات الاستثمار.
أما اليمن، فقد زاد عجز الحساب الجاري بنسبة 1.5 بالمئة في 2023 مقارنة بـ 2022 ليصل إلى 19.3 بالمئة بسبب توقف صادرات النفط جراء الحصار الذي فرضه الحوثيون. ولذلك، ارتفع الضغط على الريال اليمني، مما أدى إلى انخفاض قيمته في عدن بنهاية 2023. ومع ذلك، ساعد انخفاض أسعار السلع العالمية وانخفاض الطلب المحلي في تقليص التضخم بشكل كبير.
5- التأثير المالي
تتباين التكاليف المالية الناتجة عن الحرب في غزة حسب خصائص كل دولة، وتزداد الأعباء المالية للدول المشاركة مباشرة في النزاع.
في الربع الأخير من 2023، قدرت تكلفة التسلح الفوري للاقتصاد الإسرائيلي بحوالي 600 مليون دولار أسبوعيا، أي ما يعادل 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي، بسبب تعبئة الاحتياطيات وإغلاق المدارس. واستُدعي نحو 360 ألف جندي احتياط، وهو ما يمثل 4 بالمئة من السكان و8 بالمئة من القوة العاملة. كما أسفر إخلاء سكان المناطق القريبة من حدود غزة والضفة الغربية وإغلاق المدارس عن نسبة تغيب كبيرة في أماكن العمل. وهناك تقديرات تشير إلى أن التكاليف البشرية المرتبطة بالحرب بلغت 41 مليون دولار يوميا في الأيام الأولى من القتال، قبل أن تبدأ في التراجع بعد سبعة أشهر من الحرب.
وقد يؤثر الإنفاق العسكري الضخم في “إسرائيل” سلبا على تخصيصات الإيرادات والنفقات الأخرى، مما يعرض جهود الحكومة لتقليص الديون للخطر. وقبل الحرب، كان من المتوقع أن يصل العجز إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان الدين في تراجع. ولكن بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، وافق الكنيست على قانون ميزانية معدلة رفع العجز إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. وفي الربع الأول من 2024، جاء نمو النفقات التراكمية أقل بقليل من 36 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023، بينما انخفض نمو الإيرادات التراكمية بنحو 2 بالمئة.
ولمواجهة الإنفاق الإضافي، قررت الحكومة زيادة ضريبة الصحة قليلا، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة، وتقليص النفقات التنموية للمجتمعات العربية بنسبة 15 بالمئة، وخفض الميزانيات عبر الوزارات بنسبة 5 بالمئة. ورغم هذه الإجراءات، دفعت الميزانية المعدلة خلال فترة الحرب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو الارتفاع على المدى المتوسط.
وبحلول أغسطس/آب 2024، بلغ العجز في الميزانية الإسرائيلية 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.6 بالمئة التي تم اعتمادها سابقا في القانون المعدل للميزانية في فبراير/شباط 2024. وتعود الزيادة في النفقات إلى الإنفاق العسكري وتمويل المدنيين الذين جرى إجلاؤهم وجنود الاحتياط، في ظل استمرار الحرب حتى نهاية 2024.
من جهة أخرى، تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية منذ اندلاع الحرب، حيث أدت العقوبات الإسرائيلية إلى تقليص الإيرادات بنسبة تزيد عن 50 بالمئة. كما أسهم الانكماش الاقتصادي والمساعدات الخارجية المنخفضة في زيادة فجوة التمويل لعام 2023 إلى 682 مليون دولار، أي ما يعادل 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويجري سد فجوة التمويل الفلسطينية من خلال الاقتراض من البنوك المحلية وزيادة المستحقات على القطاع الخاص والموظفين وصندوق التقاعد. ويتوقع أن تصل فجوة التمويل إلى 1.86 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ1.2 مليار دولار في مايو/أيار 2024. هذه الفجوة المتزايدة، إلى جانب القدرة المحدودة على تعبئة الموارد، تشير إلى اقتراب الوضع المالي للسلطة الفلسطينية من حالة كارثية. ورغم أن خدمة الديون غير مدرجة في الميزانية، من المتوقع أن يُحتوى العجز في 2024 ليصل إلى 1.8 بالمئة.
6- التأثير على استقرار القطاع المصرفي
لتخفيف تأثير الحرب، اتخذ بنك إسرائيل المركزي خطوات لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، شملت بيع العملات الأجنبية، ومعاملات المبادلة، وبرامج إعادة الشراء، وبرامج تخفيف الائتمان. وفي يناير/كانون الثاني 2024، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لدعم الاقتصاد. كما قدمت الحكومة الإسرائيلية تدابير لدعم العمال والشركات المتضررة، مثل تحويلات نقدية، وتأجيل المدفوعات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة، وشروط مرنة للقروض.
في المقابل، تواصل سلطة النقد الفلسطينية الإشراف على القطاع المصرفي، ورغم أن النظام المصرفي سائل، ومزود برأس مال قوي، ومتوافق مع متطلبات اتفاقية “بازل 3″، فإن التحديات السياسية والمؤسسية والاقتصادية الناتجة عن الحرب قد وضعت ضغطا شديدا على النظام المصرفي.
ومن جانبها، قدمت الحكومة الإسرائيلية إعفاءً سينتهي في نهاية يونيو/حزيران، يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية دون الخوف من العقوبات القانونية، مما يساهم في الحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة وتجنب أزمة مصرفية واقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وبعد اندلاع الحرب، هددت الحكومة الإسرائيلية بقطع العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وهي خطوة كانت ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد غزة والضفة الغربية.
ومن الضروري الحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية لمعالجة الفروق الاقتصادية في الضفة الغربية مقابل الخدمات والرواتب. هذه العلاقات حيوية لمعالجة نحو 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من “إسرائيل”، مثل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، بالإضافة إلى تسهيل حوالي 2 مليار دولار سنويا من الصادرات الفلسطينية.
7- التأثير على سوق العمل
قد تؤدي صدمات سوق العمل في مركز النزاع والدول المجاورة إلى آثار طويلة الأمد إذا استمرت الحرب أو تصاعدت الاشتباكات على الحدود الجنوبية للبنان.
ففي “إسرائيل”، أثر استدعاء 360 ألف من قوات الاحتياط، ما يعادل 4 بالمئة من السكان و8 بالمئة من القوى العاملة، بشكل كبير، ليكون ثاني أكبر استدعاء في تاريخ “إسرائيل”. كما أسهم تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين لعبور الحدود إلى “إسرائيل” في تفاقم نقص العمالة في بعض القطاعات، حيث كان نحو 170 ألف عامل فلسطيني يدخلون للعمل قبل 7 أكتوبر، لكن بعد ذلك جمدت التصاريح، مما أثر على قطاعي البناء والزراعة.
ورغم أن قطاع الزراعة في “إسرائيل” يساهم بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة بسيطة نوعا ما، فإنه يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية مثل الفلسطينيين والتايلانديين. وخلال موسم الحصاد، كان يعتمد على المتطوعين، بينما يواجه قطاع البناء نقصا كبيرا في العمالة رغم خطة السلطات لاستبدال العمال الفلسطينيين بعمال من جنوب آسيا.
وستستمر اختلالات العمالة والمشاكل الهيكلية في عرقلة تعافي الاقتصاد الفلسطيني على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار الحظر على العمال الفلسطينيين وعدم القدرة على استبدالهم بعمال ذوي مهارات مشابهة.
وفي “إسرائيل”، من المتوقع أن يؤدي تمديد الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي لتقليل مساهمة الأفراد في النشاط الاقتصادي المدني، بينما تستمر النقاشات السياسية حول تضمين السكان الحريديم في الخدمة العسكرية.
ومن الضروري معالجة التحديات الهيكلية الموروثة في الاقتصاد قبل حرب غزة، مثل انخفاض إنتاجية العمل، وانخفاض معدلات التوظيف بين السكان العرب والحريديم، لتحفيز النمو والتنمية. وأظهرت دراسة لبنك إسرائيل المركزي أنه بتكلفة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، يمكن زيادة إمكانات النمو بنسبة تربو على 20 بالمئة على المدى المتوسط والطويل. أما في الأراضي الفلسطينية، فصعوبة تقييم تأثير صدمة سوق العمل تعود إلى أن الاقتصاد كان ضعيفا بالفعل، حيث ارتفعت البطالة في غزة إلى 75 بالمئة في الربع الأخير من 2023 وفقد أكثر من 201 ألف وظيفة بنهاية يناير/كانون الثاني 2024.
وفي الضفة الغربية، ارتفعت معدلات البطالة في الربع الأخير من 2023 إلى 32 بالمئة، مقارنة بـ 13 بالمئة في الربع السابق، بسبب تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين إلى “إسرائيل” وفرض قيود على الحركة. أما في غزة، فقد انهار سوق العمل، حيث بلغت البطالة 79.1 بالمئة في غزة و32 بالمئة في الضفة الغربية. وفي الربع الأخير من 2023، أصبح 88 بالمئة من الفلسطينيين العاملين في “إسرائيل” عاطلين عن العمل، وفقد 72 بالمئة من العاملين في المستوطنات وظائفهم. وفي عموم الأراضي الفلسطينية، تجاوزت البطالة 50 بالمئة.
ب. التكلفة الاجتماعية للحرب في غزة
هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد: الطقس القاسي، والصدمات الاقتصادية، والنزاع/التهديدات الأمنية. وتشير تقارير برنامج الأغذية العالمي إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2023 قد تضاعف أكثر من مرتين مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا ليصل إلى 333 مليون شخص. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُعتبر النزاع والصدمات الاقتصادية العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث يؤدي النزاع إلى تعطيل أنظمة الغذاء وعمليات الإنتاج.
حتى وإن لم يُدمر رأس المال المادي، فإن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تتأثر سلبا، مما يستمر انعدام الأمن الغذائي. ويعتمد التأثير على نمو وتطور البلد المتأثر. وتظهر أسوأ النتائج عند تداخل الصدمات الاقتصادية مع النزاع، كما في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كان نحو ربع السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العالم يعيشون في هذه المنطقة في 2023.
ووفقا لتعريف قمة الغذاء العالمية لعام 1996، يتضمن الأمن الغذائي توفر الغذاء، وصوله جسديا، القدرة على تحمله ماليا، واستخدامه وفقا للتفضيلات. كما يتضمن استقرار الدولة الاقتصادي، وقدرتها على توليد العملة الأجنبية لتمويل واردات الغذاء. وقد طور الباحث براين بريزينغر وآخرون مؤشرا لقياس الأمن الغذائي، الذي يأخذ في اعتباره كون معظم البلدان مستوردة صافية للغذاء، ومصدرة أو مستوردة للعمالة.
بناءً على ذلك، تعتمد قدرة كل دولة على توليد العملة الأجنبية لاستيراد الغذاء جزئيا على الحوالات المالية من العمال، التي تعد مصدرا حيويا للتدفقات الصافية للعملة الأجنبية. وكلما زادت نسبة واردات الغذاء إلى إجمالي تدفقات العملة الأجنبية، زادت هشاشة أمن الغذاء تجاه الصدمات المرتبطة بقدرة كسب العملة الأجنبية.
وبحلول أواخر 2023، صُنفت الحالة في قطاع غزة كأشد أزمة غذائية في تاريخ مؤشري “IPC” و”GRFC”. وفي الربع الرابع من 2023، ارتفعت أسعار الغذاء في غزة بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالربع السابق، بينما زادت تكاليف النقل بنسبة 143 بالمئة بسبب توقف إمدادات الوقود. كما ساهمت حرب غزة في تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول المجاورة التي كانت تعاني أصلا من تحديات اقتصادية، وتأثرت الفئات الضعيفة خصوصا، بما في ذلك اللاجئون.
ففي لبنان، أسهم الانخفاض الحاد في قيمة العملة اللبنانية نتيجة للأزمة المالية في أكتوبر 2019 في تفاقم أزمة الأمن الغذائي، خصوصا أن لبنان يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته. كما فاقم تدمير صوامع الحبوب الرئيسية في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 من صعوبة الوصول إلى الغذاء.
وفي مارس/آذار 2023، أدى التراجع القياسي في قيمة العملة إلى ارتفاع التضخم الغذائي بنسبة 352 بالمئة، مما أثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا من اللبنانيين واللاجئين. ومع تصاعد القتال في غزة، أسفر النزاع عبر الحدود مع “حزب الله” بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومارس/آذار 2024 عن نزوح أكثر من 90 ألف شخص إلى شمال لبنان، مما زاد من صعوبة وصولهم إلى الغذاء وأثر على سبل عيشهم.
في حالة اليمن، حتى قبل حرب غزة، كان الصراع المستمر في اليمن لمدة عقد تقريبا وظروفه الاقتصادية والاجتماعية قد دمرت الفرص الاقتصادية وسبل العيش. كما زادت الاضطرابات الداخلية مؤخرا، مما أدى إلى نزوح محدود مقارنة بمستويات ما قبل الهدنة في 2022.
وبعد الحرب، فاقمت الهجمات الحوثية على الشحن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن الأوضاع الغذائية في اليمن. وتضررت سبل العيش المرتبطة بالصيد، وتوقفت مفاوضات السلام بسبب الصراع. كما بيع العديد من المواشي بسبب عجز الرعاة عن توفير الأعلاف، وتسبب تغير المناخ في فشل المحاصيل الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، أدت الهجمات الحوثية إلى تعليق المساعدات الإنسانية الغذائية.
والجدير بالذكر أن اليمن يعتمد على استيراد 90 بالمئة من حبوبه الأساسية وكل احتياجاته من الأرز والسكر عبر الموانئ التي تسيطر عليها سلطات صنعاء. ومع تراجع العملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، سيستمر معاناة ملايين الأشخاص من انعدام الأمن الغذائي.
وفي غزة، تراجعت تدفقات المساعدات الإنسانية وتوافر المياه الصالحة للشرب وإمدادات الوقود بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمئة منذ بداية الحرب، وتدهورت الظروف الإنسانية بعد إغلاق القوات الإسرائيلية المعابر الرئيسية. ومقارنة بفصول الصراع السابقة، تسببت هذه الحرب في الضرر الأكبر على الإطلاق، ومن المتوقع أن ترفع الحرب المستمرة معدل الفقر إلى 60.7 بالمئة في جميع الأراضي الفلسطينية، كما أن اقتصاد غزة وتنميتها قد عاد إلى الوراء أربعين سنة، وفقا لبعض التقديرات.
ثالثا: التأثيرات العالمية لحرب غزة
أ. المخاطر الجيوسياسية وأسواق السلع
منذ بداية الحرب في غزة والصراع على الحدود الجنوبية للبنان والهجمات في البحر الأحمر، ظلت إمدادات النفط صامدة، وبقي سعر الخام دون مستويات التصعيد الجيوسياسي السابقة. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار من حوالي 85 دولارا للبرميل إلى أكثر من 95 دولارا في أسابيع قليلة. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 10 إلى 15 بالمئة بسبب المخاوف من اتساع دائرة عدم الاستقرار الإقليمي. واستمرت تحركات معتدلة في أسعار النفط حتى بعد بدء “أوبك بلس” خفض الإنتاج طواعية في أواخر 2022.
ومن ناحية العرض، تجاوز إنتاج الدول غير المنضوية في “أوبك بلس” مثل الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا الطلب العالمي على النفط. وساهم التقدم التكنولوجي في زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى ثلاثة أرباع الإنتاج الأمريكي. كما ساعد العرض المتزايد من هذه الدول والطلب العالمي الأضعف، خاصة من الصين، في تقليل الضغوط السعرية رغم زيادة أسعار الشحن العالمي بنسبة 50 بالمئة. وقد تساعد معدلات الفائدة المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة في تنشيط الطلب العالمي على النفط ورفع الضغوط على الأسعار، خاصة إذا استمرت إعادة توجيه السفن بعيدا عن البحر الأحمر بسبب الهجمات.
وتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل معدل التضخم في المنطقة إلى 2 بالمئة بنهاية 2024، وخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو/حزيران، وهو أول خفض في خمس سنوات. ومع تقارب التضخم العالمي مع أهداف البنوك المركزية، قد يبدأ خفض الفائدة في الاقتصادات المتقدمة لتحفيز الطلب العالمي. وإذا استمرت الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر، فإن الطرق الأطول والأكثر تكلفة قد تؤثر على أسعار النفط، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن بنسبة 200 بالمئة من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى مارس/آذار 2024. قد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى قيود على تدفقات السلع، مما يهدد التضخم العالمي، وأمن الغذاء، وآفاق النمو.
ب. المخاطر المالية العالمية
شهد التضخم عالميا تقاربا نحو مستويات الأهداف، وتباطأت الزيادات في معدلات الفائدة، بل خُفض بعضها. نتيجة لذلك، ازدادت شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وعلى الرغم من انخفاض التضخم عالميا، تظل البنوك المركزية حذرة لضمان التقارب الآمن للتضخم مع مستويات الأهداف.
وبشكل عام، تخففت الظروف المالية العالمية، وتمكنت اقتصادات منخفضة الدخل من العودة إلى الأسواق الدولية. والجدير بالذكر، قد يساعد خفض معدلات الفائدة في الاقتصادات المتقدمة في تخفيف الضغوط المالية على الدول المثقلة بالديون. ومع ذلك، تظل معدلات الفائدة المرتفعة والعجز المرتفع تهديدا لتوقعات النمو إذا ارتفعت تكاليف إعادة التمويل.
ج. الاضطرابات البحرية
تسببت الهجمات في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في تعطيل 12 إلى 15 بالمئة من التجارة البحرية العالمية، واستمرت هذه الهجمات في تحويل طرق التجارة البحرية بعيدا عن قناة السويس نحو رأس الرجاء الصالح. وقبل الهجمات، كانت قناة السويس تتعامل مع 25 إلى 30 بالمئة من شحن الحاويات، و12 بالمئة من شحن النفط، و8 بالمئة من شحن الغاز الطبيعي المسال وتجارة الحبوب. أما بعد الهجمات، حوّلت 9 من كل 10 سفن حاويات كبيرة مسارها المعتاد بين آسيا وأوروبا، مما أدى إلى تحديات كبيرة للدول المتأثرة.
وعلى الرغم من أن تحويل الطرق البحرية لم يُسهم في ضغوط تضخمية عالمية، إلا أن التجارة بين آسيا وأوروبا تأثرت، حيث يعبر 40 بالمئة من التجارة و95 بالمئة من السفن عبر البحر الأحمر عادة. كما تأثرت موانئ إسرائيل كمراكز شحن، حيث انخفضت عمليات ميناء حيفا بنسبة 40 بالمئة منذ اندلاع الحرب. وتراجع تصنيف ميناء باي في حيفا وأشدود في تصنيف موانئ الحاويات لعامي 2022 و2023، وفقا لمؤشر أداء الموانئ الصادر عن البنك الدولي.
علاوة على ذلك، فإن تعطيل التجارة يقلص حركة الإمدادات الحيوية من الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى أفريقيا، ويؤثر على المناطق المتأثرة في المدى القصير والمتوسط. كما أن تحويل مسارات التجارة البحرية له تداعيات اقتصادية وبيئية. بعد 2021، أدى توسع الشحن مع ازدياد التجارة الإلكترونية إلى خفض أسعار الشحن إلى ثلث مستوياتها في 2021-2022. بالمقابل، رفع تحويل المسارات البحرية رسوم الشحن بنسبة 30 بالمئة، ومع ذلك، حافظ الطلب العالمي الضعيف على استقرار الأسعار رغم زيادة التكاليف.
وإذا استمر الوضع الراهن، فمن المحتمل أن تحدد أسعار الشحن على المدى الطويل اللوائح البيئية التي فرضها الاتحاد الأوروبي. من المتوقع زيادة انبعاثات الشحن البحري في 2024 بسبب المسارات الأطول والسرعات العالية المطلوبة.
ويشكل الشحن البحري نحو 3 بالمئة من الانبعاثات العالمية، وفي إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، قامت المفوضية الأوروبية بتطبيق تشريعات بحرية جديدة. ولكن إغلاق المرور عبر البحر الأحمر قد يعوق تحقيق هذه الأهداف، بسبب زيادة تكاليف الامتثال واستخدام سفن أقل كفاءة. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الطلب العالمي على السلع، خاصة إذا خفضت الولايات المتحدة أيضا معدلات الفائدة، قد تزداد الضغوط التضخمية عالميا، لا سيما مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
رابعا: خاتمة الملف
إن التطورات الجيوسياسية السلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تصاعد الصراع، ستزيد من الضعف والضبابية. وقد يؤدي استمرار التصعيد في غزة إلى إعادة تقييم المخاطر للدول في المنطقة. فقد اتسعت الفوارق الاقتصادية بعد هجمات 7 أكتوبر ولم تعُد إلى مستويات ما قبل هذا التاريخ.
وفي “إسرائيل”، تراجعت أسعار الأسهم بعد الهجمات لكنها بدأت في التعافي. ففي توقعاتها للربع الثاني من 2024، تتوقع بنك إسرائيل انخفاضا أقل في العلاوة على المخاطر السيادية مقارنة بتقديراته السابقة، ما قد يستدعي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. إلا أن استمرار الحرب وتصاعدها إلى دول أخرى سيؤثر سلبا على تصنيف “إسرائيل”، حيث خفضت وكالة “موديز” تصنيفها بمقدار درجتين في 27 سبتمبر/أيلول 2024، بينما خفضت وكالة “فيتش” تصنيفها بدرجة واحدة الشهر السابق. ومن المرجح أن تضغط هذه التخفيضات على تكلفة الاقتراض الإسرائيلي من الخارج.
شهدت الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان أيضا إعادة تقييم للمخاطر التي كانت تتعرض لها قبل الحرب. أما مصر، التي كانت تعاني بالفعل من التحديات الاقتصادية، فكانت أقل تأثرا بالحرب. وقد يؤدي تصعيد الصراع إلى تأثيرات سلبية على أسواق السلع، خاصة مع خفض الإنتاج النفطي من “أوبك بلس”، مما يرفع ضغوط التضخم ويشدد الظروف المالية العالمية.
في هذا السياق، ستواجه الاقتصادات المثقلة بالديون في المنطقة صعوبة في تحقيق استقرار اقتصادي كلي واستدامة الديون على المدى المتوسط. وإذا استمرت التوترات الجيوسياسية، قد تستمر أسعار الشحن والتأمين عبر البحر الأحمر في الارتفاع، مما يعرقل الإيرادات المالية للدول المستفيدة. كما ستتعرض واردات الوقود والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى إفريقيا للاضطراب، مما يزيد من معاناة المستهلكين الذين يعانون بالفعل من فقر مرتفع وقدرة محدودة على التكيف.
- حرب غزة.. التجزئة الجيواقتصادية، وتأثيراتها على النمو العالمي
رغم أن التكامل العالمي لم يحقق الفوائد الموعودة لجميع الاقتصادات، فإن التجزئة الجيواقتصادية الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، ستؤثر سلبا على آفاق النمو في العديد من الدول. ذلك أن تزايد القيود التجارية وعودة السياسات الحمائية والصناعية منذ 2019 سيتسبب في تراجع النمو على المدى المتوسط نتيجة لتغيير الروابط التجارية وفقدان الكفاءة.
وتقدّر دراسة حديثة أن تكاليف التجزئة التجارية على المدى الطويل قد تتراوح بين 0.2 بالمئة و7 بالمئة من الناتج العالمي، وقد يصل فقدان الإنتاج إلى 8 إلى 12 بالمئة في بعض الدول إذا تم تضمين فصل التكنولوجيا. ورغم اختلاف الحجم الدقيق للتأثير، ستؤثر التجزئة الجيواقتصادية سلبا على تدفقات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا على طول الخطوط الجيوسياسية. وقد تتفاقم هذه التجزئة بنهاية 2024 مع الانتخابات في 64 دولة، مما يزيد الفارق في النمو بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، حيث ستخسر الأخيرة أربعة أضعاف الخسارة المتوقعة في الناتج الاقتصادي العالمي نتيجة لتقسيم أسواق السلع بين الولايات المتحدة والصين.
- تجاوز آثار الحرب
إن الحرب في غزة تتطلب جهودا دولية منسقة لوقفها قبل أن تتحول إلى حرب إقليمية وتسبب مزيدا من الضحايا والفوضى. وتبرز الحرب دور المنظمات الدولية في التعامل مع الأزمات الإنسانية، لكن الدمار الكبير يوضح الحاجة إلى استراتيجيات أكثر فعالية لتقييم تأثير الأزمة وتطوير خطط إعادة إعمار فور التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. في الوقت نفسه، تعد المبادرات الدولية التعاونية أساسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة. يجب دمج التنمية المستدامة في خطط إعادة الإعمار على المستويين الإقليمي والمحلي، وتحديد الجهات الممولة بناءً على مبدأ التوزيع العادل للأعباء.
كذلك، أسفرت الحرب في غزة عن اضطرابات كبيرة في التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الحيوية، مما يفرض على الدول في المنطقة التي تعاني من اختلالات هيكلية تطبيق الإصلاحات اللازمة لمعالجة هذه التحديات. وتزداد أهمية بناء مرونة اقتصادية أكبر، خصوصا للدول التي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية مثل مصر والأردن ولبنان، التي تعاني أيضا من أعداد كبيرة من اللاجئين.
كما أدت الحرب إلى تفاقم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وخارجها، مما خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي تثني الاستثمارات الأجنبية. ومن المرجح أن يطلب المستثمرون علاوات مخاطر أعلى، مما يزيد تكلفة رأس المال للشركات. كذلك، فإن تدمير البنى التحتية وتحويل الأموال العامة للاحتياجات العسكرية والإنسانية سيبطئ النمو الاقتصادي.
وأرهقت الحرب ميزانيات الحكومات، التي زادت من الإنفاق الدفاعي على حساب البرامج الاجتماعية والتنموية، مما قد يؤثر على الحد من الفقر والتعليم والرعاية الصحية. لذا، من الضروري أن تتعاون الحكومات الإقليمية لتعزيز مرونة اقتصاداتها والعمل نحو حل سلمي يسهم في التنمية المستدامة.
[1] جدير بالذكر أن المجلس الأطلسي نشر هذا الملف في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أي قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. إلا أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة للهدنة تجعل احتمالية تحقق السيناريوهات الاقتصادية التي تناولها الملف، في حال تصاعدت الحرب بين “إسرائيل” و”حزب الله”، أمرا واردا.