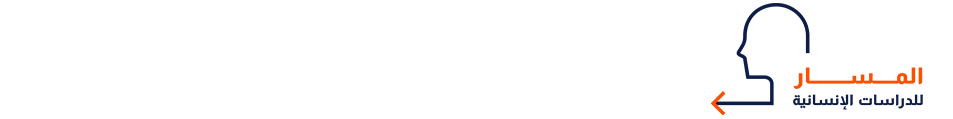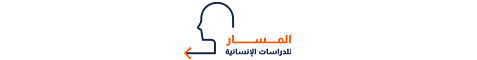المحتويات
- مقدمة المترجم
- ملخص تنفيذي
- مقدمة الملف
- الأردن قبل 7 أكتوبر
- على حافة الهاوية.. ضغوط سياسية واقتصادية
- احتمالية ضم الضفة الغربية
- خاتمة الملف
مقدمة المترجم
يتعرض الأردن ونظامه السياسي لمخاطر متصاعدة بدأت قبل “طوفان الأقصى”، لكنها تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وهناك احتمالية لتدهور الأوضاع في الأردن بعد عودة، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.
فبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت المخاطر التي يواجهها الأردن بشكل كبير نتيجة الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ولبنان. وعلى الرغم من أن الأردن كان يُعتبر سابقا لاعبا محوريا في المنطقة، إلا أنه يتعرض لتجاهل أمريكي منذ نحو عام، وفق بعض المراقبين.
يأتي هذا بينما تعيش المملكة حالة من عدم الاستقرار، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الحادة والتحديات الداخلية، مثل استضافتها لملايين اللاجئين وغياب الموارد الأساسية مثل المياه. كذلك، فإن احتمالية ضم دولة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية تضع عمّان في موقف صعب، إذ يخشى كثيرون من أن هذا الضم قد يعيد طرح فكرة “الأردن هو فلسطين” التي ترفضها المملكة قطعيا.
في هذا السياق، نشر معهد “كوينسي” الأمريكي ورقة للباحثة، أنيل شيلين، التي عملت سابقا كمسؤولة للشؤون الخارجية في “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، واختصت بشؤون الشرق الأدنى، قبل أن تستقيل في مارس/آذار 2024 احتجاجا على الدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارة، جو بايدن، للعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وتضمنت الورقة تحليلا للوضع السياسي والاقتصادي في الأردن، في ظل “طوفان الأقصى” وعودة ترامب؛ واستندت الباحثة إلى لقاءات أجرتها مع مسؤولين حكوميين وقادة سياسيين خلال زيارة أجرتها مؤخرا للأردن.
وقد آثر “مركز المسار” ترجمة هذه الورقة وتقديمها للباحثين والدارسين والمهتمين، بهدف تقديم فهم أعمق للمخاطر المتزايدة التي يواجهها الأردن، سواء على الصعيد الداخلي أو في سياق السياسة الإقليمية والدولية، واحتمالات ضم “إسرائيل” للضفة الغربية خلال إدارة ترامب المقبلة.
وإليكم نص الورقة التي تبدأ بـ”مخلص تنفيذي”.
ملخص تنفيذي
يتناول هذا الملف الحرب الإسرائيلية–الفلسطينية والإسرائيلية–اللبنانية وتداعياتها على المملكة الأردنية.
فرغم أن الأردن كان يُعتبر سابقا لاعبا محوريا فيما يعرف بـ”الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني”، إلا أنه لم يحظَ باهتمام كبير من دوائر السياسة الخارجية الأمريكية منذ هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. هذا الإهمال قد تكون له تداعيات خطيرة، إذ أن زعزعة استقرار الأردن ربما تؤدي إلى عواقب واسعة النطاق على المنطقة ككل.
ويستند الملف إلى مقابلات مباشرة أجرتها الباحثة الأمريكية، أنيل شيلين، مع مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى، وقادة إسلاميين، وصحفيين، وخبراء آخرين لتحليل الرؤية المستقبلية للأردن.
ومنذ توقيع الأردن اتفاقية سلام مع “إسرائيل” عام 1994، برزت المملكة كحليف مقرب من الولايات المتحدة. وقد تجسّد ذلك بتوقيع البلدين مذكرة تفاهم رابعة عام 2022، التزمت الولايات المتحدة بموجبها بتقديم مساعدات سنوية للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار. ومع ذلك، باتت العلاقة الأردنية–الأمريكية تواجه حالة من الضبابية المتزايدة، مع تقديم الولايات المتحدة دعما غير مشروط للحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان.
وقد أسهم هذا الموقف في توحيد الشارع الأردني ضد التحركات الإسرائيلية، مما انعكس في تصاعد المشاركة في حملات مقاطعة المنتجات الأمريكية والأوروبية، إلى جانب تزايد الدعم للحزب الإسلامي الرئيسي في المملكة.
وعلاوة على الحرب، فإن احتمالية قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية -وهي فكرة تتزايد مناقشتها داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- تشكل تهديدا خطيرا للأردن. ويزداد القلق بين الأردنيين من أن هدف إسرائيل قد لا يقتصر على منع قيام دولة فلسطينية، بل ربما يمتد إلى إحياء الفكرة القائلة بأن “الأردن هو فلسطين”، وهي فكرة ترفضها المملكة بشكل قاطع.
والمؤكد أن نزوحا واسع النطاق للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن قد يفضي إلى أزمة عميقة. فالمملكة التي تستضيف بالفعل أكثر من مليون لاجئ، والتي قد تشهد تدفق المزيد منهم إذا تصاعدت الاضطرابات في سوريا بعد أن سقط نظام بشار الأسد، كما أنها تواجه تحديات اقتصادية خانقة وتعاني من عجز في توفير المياه لشعبها. هذه الضغوط قد تهدد استقرار حكم الملك عبد الله الثاني واستمراريته.
وفي ظل غموض موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بشأن احتمال استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية، فإن من المؤكد أن زعزعة استقرار الأردن تتناقض مع المصالح الأمريكية. وفي نهاية المطاف، قد يواجه ترامب معضلة صعبة لتحقيق وعده الانتخابي بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، وسيتعين عليه الاختيار: إما كبح جماح التصرفات الإسرائيلية، أو المجازفة بإشعال صراعات أكبر في الأردن وخارجه.
مقدمة الملف
غاب الأردن بشكل لافت عن التغطية الإعلامية الأمريكية للأحداث الجارية الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم يحظَ بموقع بارز ضمن جهود الحكومة الأمريكية لمعالجة تداعيات التصعيد المستمر.
ويعد الأردن لاعبا محوريا في الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني منذ عقود، حيث يشكل الفلسطينيون أغلبية سكانه وتربطه أطول حدود مع “إسرائيل”. وخلال إدارات كلينتون وبوش الابن وأوباما، حظيت عمّان بعلاقات مميزة مع واشنطن، بفضل دورها الاستراتيجي في تعزيز أمن إسرائيل واستقرار المنطقة.
إلا أن هذا الدور تراجع خلال إدارة ترامب، التي أولت اهتمامها بمصالح تل أبيب والرياض وأبو ظبي، ما أدى إلى تهميش الأردن وملكه عبد الله الثاني. ومع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض عام 2021، سعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة بناء علاقتها مع المملكة، حيث كان الملك عبد الله أول زعيم أجنبي يُستقبل في البيت الأبيض. وشهدت العلاقات تطورا ملحوظا، مع زيارات متكررة للملك إلى واشنطن، بلغ عددها خمس زيارات، ما يعكس إدراك الإدارة الأمريكية لأهمية دور الأردن في مواجهة التحديات المتفاقمة في منطقة الشام.
لكن عودة ترامب إلى السلطة أثارت مخاوف واسعة بين الأردنيين بشأن التداعيات المحتملة على بلادهم وعلى عموم المنطقة. فقد أعرب مسؤولون إسرائيليون عن نيتهم ضم الضفة الغربية، وهو ما قد يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأردن، السيناريو الذي تعتبره عمّان تهديدا وجوديا.
فما الذي قد يعنيه عدم الاستقرار السياسي في الأردن؟ وهل يمكن أن تدفع الولايات المتحدة وإسرائيل الأردن إلى حرب إقليمية ضد إيران؟ وكيف ستؤثر تداعيات سقوط الأسد وعدم الاستقرار في سوريا على الأردن؟
إن انتخاب ترامب يعزز من موقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية، مما يستدعي من واشنطن إيلاء اهتمام أكبر بتأثير التدخلات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان على الأردن. كما يتوجب عليها النظر في الانعكاسات السلبية المحتملة على المصالح الأمريكية إذا استمرت دائرة العنف في التوسع.
ويستند هذا الملف إلى زيارة الباحثة لعمّان في أواخر سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الأول 2024، بهدف تقييم تأثير عام كامل من الحرب في “إسرائيل” وفلسطين على السياسة والاقتصاد في الأردن. ويعتمد الملف على بيانات مستمدة من مقابلات مع وزراء سابقين ومسؤولين حكوميين وأمميين، وقادة حركات إسلامية، وخبراء في السياسة الخارجية، وصحفيين.
شملت هذه المقابلات ردود فعل على أحداث مفصلية، من أبرزها إطلاق إيران صواريخ عبر الأجواء الأردنية نحو “إسرائيل”، في سياق ردها على الغزو الإسرائيلي للبنان. وقد أكدت هذه التطورات أن الأردن لا يمكنه تجنب تداعيات موقعه الجغرافي الحساس. ورغم جهود الحكومة الأردنية للحفاظ على الاستقرار، تلوح في الأفق مخاطر متزايدة قد تدفع الأردن والولايات المتحدة نحو الانخراط في حرب جديدة بالشرق الأوسط خلال العام المقبل 2025.
الأردن قبل 7 أكتوبر
واجه الأردن على مر العقود تحديات سياسية واقتصادية متواصلة، تفاقمت بسبب الأعباء الديموغرافية الناتجة عن موجات اللجوء المتكررة من المناطق المجاورة التي تشهد نزاعات. وفي الوقت نفسه، تجد الأسرة المالكة نفسها أمام تهديدات تطال شرعيتها، مع الأخذ في الاعتبار أصولها الهاشمية التي تعود إلى منطقة الحجاز، والتي تُعد اليوم جزءا من المملكة العربية السعودية.
وتشمل الضغوط المتزايدة دعوات شعبية أردنية تطالب الملك عبد الله باتخاذ مواقف أكثر فاعلية لدعم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب التصدي للتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحروب المستمرة في الإقليم، والتي تُلقي بظلالها على استقرار المملكة.
وهناك روابط تاريخية بين الأردن وفلسطين تعود إلى عام 1921، حينما أنشأت الإمبراطورية البريطانية “إمارة شرق الأردن” عبر اقتطاع الجزء الشرقي من أراضي الانتداب الفلسطيني، الذي شمل نهر الأردن، ومنحته لجد الملك الحالي، الأمير عبد الله. وكما يوضح أحد المصادر التاريخية، “ففي محاولة لتهدئة عبد الله والظهور بمظهر الملتزم بوعودها السابقة للعرب، اقتطعت بريطانيا الجزء الشرقي من أراضي الانتداب الفلسطيني، وأسمته “شرق الأردن”، ونصّبت عبد الله أميرا عليه”.
كانت المنطقة شبه محاطة باليابسة، وتفتقر إلى الموارد الطبيعية، وبخلاف لبنان وسوريا والعراق، لم تكن تضم مدينة ذات أهمية تاريخية لتكون عاصمة لها، ولا كان هناك شعور قوي بالهوية الوطنية. ورغم أن الأمير عبد الله، الذي أصبح لاحقا ملكا، استمتع بالسلطة الدينية التي منحها له نسبه من رسول الله محمد ﷺ، إلا أنه كان يُعتبر غريبا عن المنطقة، ويُنظر إليه من قبل كثيرين كدمية بريطانية.
وتعد المملكة بمثابة ملاذ فعلي لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، فقد أسفر قيام “إسرائيل” عام 1948 عن تهجير أكثر من 700 ألف شخص، نزح معظمهم إلى الأردن، مما أدى إلى مضاعفة عدد سكانها ثلاث مرات.
وبعد حرب 1967، استقبل الأردن 300 ألف فلسطيني آخرين عندما استولت إسرائيل على الضفة الغربية، التي كانت جزءا من الأراضي الأردنية. وكان مقر منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن حتى “أيلول الأسود”، عندما اندلعت اشتباكات بين المنظمة والجيش الأردني في عام 1970، مما دفع الملك حسين إلى طرد المنظمة، التي انتقلت إلى لبنان في عام 1971.
وحتى عام 1994، حافظ الأردن على حالة من “العداء النشط” تجاه “إسرائيل”، وشارك في حروب 1948 و1967 و1973. لكن بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية و”إسرائيل” على اتفاقيات أوسلو في 1993، ووعد الرئيس كلينتون بإلغاء ديون الأردن وتقديم الدعم الاقتصادي والعسكري، وافق الملك حسين على توقيع معاهدة سلام مع “إسرائيل”.
وفي عام 1993، تلقت عمّان مبلغا قدره 44 مليون دولار فقط من الولايات المتحدة، مقارنةً بمليار دولار في عام 2014. وفي عام 2022، وقّعت واشنطن مذكرة تفاهم رابعة مع عمان، التزمت فيها بتقديم 1.45 مليار دولار سنويا للأردن.
ورغم أن معاهدة السلام لم تكن تحظى بشعبية لدى الأردنيين مطلقا، وأصبحت أقل قبولا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يظل الأردن معتمدا على الدعم الأمريكي الذي قد يتوقف في حال إخلاله ببنود المعاهدة. وفي عدة مقابلات أجرتها الباحثة، أعرب أردنيون عن مخاوفهم من أن تُقدم “إسرائيل” على خطوات تصعيدية، كإلغاء وصاية الأردن على المواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس، أو تنفيذ عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين نحو الأردن، أو حتى شن اعتداء مباشر على المملكة.
والأكيد أنه إذا أقدمت إسرائيل على مثل هذه الإجراءات، سيجد الأردن نفسه مضطرا للرد، مما يعرض المعونات الأمريكية له للخطر.
ولقد تسببت جولات العنف المتتالية في الشرق الأوسط في تدفق موجات إضافية من اللاجئين إلى الأردن، بما في ذلك خلال حرب إيران–العراق في الثمانينيات، وبعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، ومع اندلاع الحرب السورية في 2011.
وحتى عام 2024، كان معظم اللاجئين في الأردن من سوريا، حيث بلغ عددهم 1.2 مليون من إجمالي سكان الأردن البالغ 11 مليون نسمة. ولا يُسجل جميع اللاجئين لدى “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، لكن من بين المسجلين، يشكل السوريون 90 بالمئة، في حين يأتي 7 بالمئة منهم من العراق، والبقية من دول مثل اليمن وليبيا والسودان والصومال.
إلى جانب لبنان الذي استقبل أيضا أعدادا كبيرة من اللاجئين، حرص الأردن على استيعاب من تشرّدوا جراء العنف الإقليمي، وهذا بدوره دفع الحكومات الأجنبية إلى إرسال أموال لدعم هذه الفئات. فبالإضافة إلى تلقيها مليارات الدولارات من الولايات المتحدة، حصلت المملكة على موارد كبيرة من دول الخليج، رغم أن هذه المساعدات كانت تتوقف بين الحين والآخر. فبعد انتهاء مذكرة التفاهم الأخيرة في 2017، امتنعت الدول الخليجية عن تجديدها، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإحباط من السياسة الخارجية للأردن، مثل دعمه لقيام دولة فلسطينية وعلاقاته المستمرة مع قطر، التي عارضت الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات على قطر من 2017 إلى 2020.
ويحكم الملك عبد الله الثاني الأردن منذ عام 1999، بعد وفاة والده حسين. وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 والتدخل العسكري الأمريكي في المنطقة، أصبح عبد الله شريكا مهما للولايات المتحدة فيما يسمى “الحرب على الإرهاب”، وفي غزو العراق، والتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش.
ومع ذلك، تجاهل ترامب خلال ولايته الأولى مصالح الأردن، بما في ذلك محاولته تقليص التمويل الأمريكي للمملكة بسبب معارضتها لأجندته الإقليمية. لكن الكونغرس ووزير الخارجية آنذاك، ريكس تيلرسون، تجاوزا ذلك، وفي النهاية حصلت الأردن على تمويل أمريكي أكثر مما كان تحت إدارة أوباما، وهو ما يعكس العلاقات التي بناها الملك عبد الله ومسؤولون أردنيون آخرون في الـ”كابيتول هيل”.
وفي خطوة أخرى جردت الأردن من دوره، تخلّى ترامب عن أي ادعاء بالحياد الأمريكي في القضية الفلسطينية. فقد كان نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس تعبيرا قويا عن التزام ترامب بتلبية رغبات “إسرائيل”. كما أظهر تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب أن بعض القادة العرب كانوا مستعدين للتطبيع دون أي شروط تتعلق بالقضية الفلسطينية، وبالرغم من معارضة شعوبهم.
هذا بدوره أفقد “مبادرة السلام العربية” لعام 2002 قوتها، والتي كانت تقوم على أن الدول العربية ستطبع علاقاتها مع “إسرائيل” مقابل الاعتراف بدولة فلسطينية. كذلك قلل من مصداقية الادعاء الأمريكي بدعم حل الدولتين، كما نصت عليه اتفاقيات أوسلو لعام 1993 التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من تعارض اتفاقات التطبيع مع الموقف الرسمي الأمريكي بشأن حل الدولتين، كان البيت الأبيض بقيادة بايدن يسعى للتفوق على إنجازات ترامب، عبر إقناع السعودية بتطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”، إلا أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول جعلت مثل هذا الاتفاق تحديا سياسيا ضخما حتى بالنسبة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
ومع عودة ترامب، يشعر الأردنيون بقلق من أن مصالحهم، بالإضافة إلى مصالح الفلسطينيين، قد تتعرض لمزيد من التهميش، وهو ما ستكون له تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة والمصالح الأمريكية الجوهرية في الشرق الأوسط.
على حافة الهاوية.. ضغوط سياسية واقتصادية
تزايد الضغط السياسي على الحكومة الأردنية بشكل ملحوظ بعد 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية في غزة. حيث شهدت المملكة احتجاجات واسعة من الأردنيين، سواء من أصل فلسطيني أو من أصول أردنية، ضد سياسات “إسرائيل”، وطالبوا الحكومة بتكثيف جهودها لدعم فلسطين.
وفي أعقاب أحداث 7 أكتوبر، دعا خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، الذي يقيم في الدوحة، الأردنيين إلى التحرك العلني، قائلا: “أخاطب دول الطوق أولا رسميا وشعبيا، واجبكم أكبر لأنكم الأقرب لفلسطين، وأخاطب في الأردن عشائرهم الكريمة، ومخيماتها، فالأردن الذي يريد (وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل) سموترتيش أن يلغيه، هذه لحظة الحقيقة، فالحدود قريبة، والكل يعرف مسؤوليته”.
ولقد استجاب العديد من الأردنيين لنداء مشعل، ففي 8 سبتمبر/أيلول 2024، فتح سائق شاحنة أردني النار بالقرب من جسر الملك حسين/جسر اللنبي، المعبر الحدودي بين الأردن والضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين. وأشار مراقبون إلى أن الرجل لم يكن من أصل فلسطيني، بل من قبيلة “الحويطات” القوية في جنوب الأردن، التي كانت تاريخيا معقلا داعما للملكية الأردنية.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عبر أردنيان الحدود جنوب البحر الميت وفتحا النار على جنود إسرائيليين، مما أسفر عن إصابة عدد منهم قبل أن يُقتل الأردنيان. وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، فتح مسلح النار على الشرطة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمّان، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد قبل أن يُطلق عليه النار ويُقتل.
وقد أشار العديد من المشاركين في المقابلات إلى أن المعارضة للحرب الإسرائيلية على غزة تجاوزت أحد الانقسامات الرئيسية في المجتمع الأردني، وهو الانقسام بين الأردنيين من أصول فلسطينية وأولئك الذين عاشوا تاريخيا في الأراضي الأردنية. ومع استمرار “إسرائيل” في الحرب على غزة وتصعيدها ضد الضفة الغربية، قد يرد الأردنيون بمزيد من الأعمال العنيفة ضد الأهداف الإسرائيلية.
سياسيا، فإن إقامة دولة فلسطينية تمثل هدفا طويل الأمد للحكومة الأردنية، إذ استندت معاهدة السلام الأردنية–الإسرائيلية على اتفاقية أوسلو والاعتقاد بأن الحل يكمن في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. ومع ذلك، في ظل سعي الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لسياسات تطهير عرقي ووقوع إبادة جماعية في غزة، وغزوها لبنان، وربما نيتها لضم الضفة الغربية، عبّر العديد من المشاركين في المقابلات عن شكوكهم في استمرار وجود شريك لعمّان في تل أبيب.
وأوضح زكي بني ارشيد، الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي — الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الأردن وأحد أبرز الأحزاب المعارضة في البلاد — أن إقرار الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز 2024 قانونا يحظر إقامة دولة فلسطينية أثار قلقا بالغا في الأردن. هذا القلق جاء نتيجة لأن الأردن كان قد أسس استعداداته للتعاون مع إسرائيل على احتمال قيام دولة فلسطينية. وأضاف “بني ارشيد” أن “نتنياهو قال إنه لا يريد لحماس أو فتح السيطرة على غزة، ولا يوجد شخص واحد في الجانب الإسرائيلي يسعى للسلام”.
وبينما كانت الحكومات الإسرائيلية السابقة تزعم أنها قد تفكر في إنشاء دولة فلسطينية في وقت لاحق غير محدد، فإن الحكومة اليمينية التي تولت السلطة في أواخر 2022، قد أغلقت الباب أمام هذا الاحتمال بشكل صريح، خاصة بعد 7 أكتوبر.
من جانب آخر، فاقمت الحرب الضغوط الاقتصادية على الأردن، ففي يونيو/حزيران 2024، بلغت نسبة دين الأردن 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت معدلات البطالة 22 بالمئة، بينما وصلت إلى 46 بالمئة بين فئة الشباب.
وبعد 7 أكتوبر، تضررت السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بشكل كبير بسبب العنف الإقليمي، خاصة في المناطق المحيطة بالبتراء والبحر الميت ووادي رم، التي تعتمد بشكل رئيسي على السياحة. وأشار وزير الخارجية الأردني الأسبق، ناصر جودة، إلى أن العنف الإقليمي كان دائما يؤثر سلبا على السياحة في الأردن، لافتا إلى أن السياح يتجنبون عادة المناطق القريبة من الحرب رغم أن المملكة تبقى آمنة. وقال مازحا: “في السبعينيات والثمانينيات، كانت إذا انفجرت قنبلة على بعد 2000 ميل، يتوقف السياح عن القدوم للأردن”.
كما أن العنف الإقليمي يؤثر بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أدى الصراع إلى توتر العلاقات الاقتصادية بين الأردن و”إسرائيل”، والتي كانت تهدف إلى معالجة النقص الحاد في المياه الذي يعاني منه الأردن. ويعد الأردن من أكثر الدول ندرة في المياه على مستوى العالم، حيث لا يتوفر سوى أقل من 100 متر مكعب للفرد سنويا، وهو رقم بعيد جدا عن عتبة ندرة المياه التي تُقدر بـ 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وتستحوذ إسرائيل على كميات من مياه نهر الأردن تفوق ما يستهلكه الأردن والضفة الغربية مجتمعين، رغم أن تعداد سكانها أقل بكثير. وكان من المخطط أن تصادق الحكومتان الإسرائيلية والأردنية على اتفاق تمنح بموجبه الأردن الماء المحلى الإسرائيلي، مقابل أن تعطي الأردن “إسرائيل” طاقة شمسية، إلا أن ذلك ألغي بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ندرة المياه هذه تسببت بأضرار كبيرة لقطاع الزراعة في وادي الأردن. ورغم أن الزراعة لا تمثل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تظل مصدرا حيويا للتوظيف في هذه المنطقة. وتاريخيا، كان الأردن يعتمد على الإنتاج المحلي للمحاصيل الأساسية، لكنه بات الآن يستورد ما يقارب 90 بالمئة من المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب.
وفي حال غياب الأبعاد السياسية، كان بإمكان موقع “إسرائيل” على البحر المتوسط وبنيتها التحتية لتحلية المياه أن يجعلا منها شريكا ذا قيمة في معالجة أزمة المياه في الأردن، لكن الحرب الجارية جعلت إبرام أي اتفاق جديد غير ممكن من الناحية السياسية.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، طلب رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، مراجعة جميع الاتفاقيات مع “إسرائيل” لجعلها مشروطة بوقف أعمالها العدائية؛ وحظي هذا التحرك بإجماع الأعضاء. ومع ذلك، وحتى وقت كتابة الملف، لا يزال 40 في المئة من طاقة الأردن تأتي من الغاز الطبيعي الإسرائيلي.
وبشأن قضايا التعاون في مجالي الطاقة والمياه، لا يوجد أمام الحكومة الأردنية بدائل كثيرة لإسرائيل، لكن توجد مقاومة محلية واسعة ضد هذا التعاون. إحدى الطرق التي تتبعها الحكومة للتعامل مع هذه المعارضة الشعبية هي التأكيد على أن تعاونها مع “إسرائيل” يسمح للأردن بأن يكون مركزا لإيصال المساعدات إلى غزة. وقد أشار “بني ارشيد” من جبهة العمل الإسلامي إلى ذلك، قائلا: “الجانب الرسمي”، أي الحكومة، “لا يستطيع قطع العلاقات مع إسرائيل، وهم يبررون ذلك بأن الأردن يساهم في تقديم المساعدات للفلسطينيين، خاصة في غزة”.
مع ذلك، ومع فرض “إسرائيل” المزيد من القيود على دخول المساعدات إلى غزة، أصبح من الصعب على الحكومة الأردنية أن تزعم أنها تلعب دورا حاسما في دعم الفلسطينيين هناك.
على الصعيد الشعبي، تجسدّت معارضة “إسرائيل” في مقاطعة شاملة للمطاعم الغربية مثل “ماكدونالدز” و”ستاربكس” و”كارفور”، إلى جانب المنتجات الأمريكية والأوروبية مثل “كوكاكولا” و”بيبسي” و”نستله”. وقد وصف الصحفي، داوود كتّاب، الضغط الاجتماعي كعنصر أساسي في دفع الناس للامتثال للمقاطعة، مشيرا إلى أنه أثناء مؤتمر، كان المشاركون يستنكرون شراء المياه التي تحمل علامة “نستله”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أظهرت تقييمات غير رسمية لحالة المقاطعة في عمّان أن فروع “ماكدونالدز” و”ستاربكس” كانت عادة فارغة. واستنكر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الأردن، زيد عيادات، الأثر الذي خلفه هذا الوضع، مشيرا إلى فقدان 17 ألف وظيفة في السوق الأردني.
من جهة أخرى، أشار “كتّاب” إلى أن المقاطعة قد وفرت فرصا غير متوقعة للبدائل غير الغربية، قائلا: “كان هناك شخص يملك شركة للمشروبات الغازية تُدعى “ماتريكس”، وكان على وشك إغلاقها في أكتوبر 2023، ثم قاطع الجميع بيبسي و”سڤن أب”، لكنه الآن أصبحت شركته الشركة الأولى في مجال المشروبات الغازية في الأردن، بينما تجد صعوبة في العثور على منتجات “بيبسي” أو “كوكاكولا.”
وفي الزيارات التي أجرتها الباحثة إلى الأكشاك والمحلات المحلية، لم تكن هناك أي منتجات من “كوكاكولا” أو “بيبسي” أو “نستله”، كما لم تكن هناك إعلانات للمنتجات التي قاطعها الأردنيون. وتشارك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط في مقاطعة المنتجات الغربية، إلا أن الامتثال للمقاطعة كان مرتفعا جدا في الأردن، حيث وصل إلى 94 بالمئة.
وأوضح عدة متحدثين أن المقاطعة تُعد تعبيرا عن استياء الأردنيين من حكومتهم؛ فرغم أنهم لا يستطيعون إجبار الحكومة الأردنية على إنهاء تعاونها مع “إسرائيل”، إلا أنهم يستطيعون التحكم في عاداتهم الاستهلاكية. حيث قال جواد العناني، الذي شغل منصب وزير الخارجية ووزارات أخرى تحت حكم الملك حسين وساهم في تسهيل معاهدة السلام عام 1994: “الناس غاضبون من تساهل قادتهم بشأن ما يحدث في غزة ولبنان”.
ولقد عكست نتائج الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول 2024 غضب الأردنيين تجاه الحكومة. إذ فازت جبهة العمل الإسلامي، أكبر حزب سياسي في البلاد، بأكبر عدد من المقاعد حيث حصلت على 31 مقعدا من أصل 138، على الرغم من محاولات الحكومة تشجيع الأحزاب الأخرى على التنافس.
وكانت جبهة العمل الإسلامي وغيرها من الجماعات الإسلامية من أبرز المنتقدين لرد فعل الحكومة الأردنية على الهجوم الإسرائيلي على غزة. ولذلك، لم يكن مفاجئا كثيرا نجاح الجبهة في الانتخابات، على الرغم من أن البعض أشار إلى أن الإسلاميين حققوا نتائج أفضل مما كان متوقعا؛ حيث قال “العناني” إنه سمع أشخاصا يتوقعون أن تحصل جبهة العمل الإسلامي على 11 أو 12 مقعدا، وهو ما يتماشى مع أدائهم في انتخابات 2020 عندما فازوا بـ 10 مقاعد من أصل 130. وأوضح “العناني” أن نجاحهم يعكس أيضا التصور بأن الإسلاميين أقل فسادا من السياسيين غير الإسلاميين.
لكن في العموم ظل الإقبال منخفضا، حيث وصل 32 بالمئة فقط، مما يعكس وعي الأردنيين بأن البرلمان يملك تأثيرا محدودا على القرارات السيادية، بما في ذلك رسم السياسات تجاه “إسرائيل”.
احتمالية ضم الضفة الغربية
نظرا لتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية بعد 7 أكتوبر، فقد وُضِعت قدرة الحكومة الأردنية على ضمان الاستقرار تحت الاختبار، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الضغوط في العام المقبل 2025، بدلا من أن تتراجع.
وفي ذاكرة الأردنيين، تبقى إدارة ترامب الأولى مثالا على تهميش مصالحهم ومصالح الفلسطينيين لصالح شركائها في الرياض وأبو ظبي. من ذلك ما قاله رامي عيسى، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، من أن “إضعاف دور الأردن في المواقع الإسلامية” في القدس كان أحد جوانب “صفقة القرن” التي طرحها ترامب.
وفي عام 2018، أفاد موقع “المونيتور” الأمريكي بأن مسؤولا كبيرا في السلطة الفلسطينية -لم يوضح هويته- أكد أن السعودية سعت إلى أن تكون بديلا للأردن كوصي على المواقع الإسلامية والمسيحية في القدس، مقابل دعم خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
وحاليا، تتمثل إحدى مصادر القلق الرئيسية لدى الأردن في رغبة “إسرائيل” ضم الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يبدو أكثر احتمالا بعد انتخاب ترامب. فقد صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني أنه يأمل أن تفرض إسرائيل “سيادتها” على الضفة الغربية في عام 2025، بمساعدة ترامب؛ وأضاف أنه “أمر السلطات الإسرائيلية المشرفة على المستوطنات في الضفة الغربية ببدء العمل المهني والشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة”.
وفي إدارته الثانية، يبدو أن تعيين ترامب لأنصار بارزين للاستيطان الإسرائيلي -مثل مايك هاكابي الذي عُين سفيرا للولايات المتحدة في “إسرائيل”، وستيف ويتكوف الذي عُين مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط- فضلا عن إشارة ترامب إلى إسرائيل باعتبارها “صغيرة”، كل ذلك يفاقم مخاوف الأردنيين.
وقد أعرب العديد من الذين أجريت معهم المقابلات عن قلقهم من احتمال ضم “إسرائيل” للضفة الغربية. من هؤلاء وزير الخارجية الأردني السابق ونائب رئيس الوزراء، مروان المعشر، الذي أوضح كيف أن أفعال إسرائيل غيرت بشكل جذري العلاقات بين “إسرائيل” والأردن. وقال إنه يجري الآن نقاش في الأردن حول ما إذا كان الهدف الحقيقي لإسرائيل ليس فقط منع إقامة دولة فلسطينية، بل إحياء فكرة أن الأردن هو فلسطين. وكان لـ”المعشر” -الذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي- دور أساسي في إبرام معاهدة السلام وقدم كأول سفير للأردن في إسرائيل.
من جانبه، أشار “العناني”، وزير الخارجية الأسبق، إلى أن “إسرائيل” قد حاولت مرارا جعل الحياة في الضفة الغربية لا تطاق للفلسطينيين، واستدرك قائلا: “لكنهم لم ينجحوا، فما الذي سيفعلونه بعد ذلك؟ هل سيضعونهم في شاحنات ويطردونهم؟”، مشددا على أن هذا سيكون جريمة حرب.
ومن المهم الإشارة إلى أن فكرة اعتبار الأردن “وطنا بديلا” للفلسطينيين كانت دائما خطا أحمر للحكومة الأردنية. ففي عام 1988، تنازلت الحكومة عن مطالبتها بالضفة الغربية لتؤكد أن الأردن ليس فلسطين ولا يجب أن يُعتبر مكانا لإعادة توطين الفلسطينيين. ولكن، وبناءً على تصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد انتخاب ترامب، يخشى البعض من أن “إسرائيل” قد تنتهك معاهدة السلام وتهجّر الفلسطينيين.
هناك أيضا سيناريو آخر يتمثل في محاولة “إسرائيل” جعل الحياة في الضفة الغربية لا تطاق لدرجة أن الفلسطينيين قد يحاولون الهرب. وفي هذا السياق، قدرت وزارة الخارجية الأمريكية أن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ حوالي 3 ملايين نسمة في عام 2022.
إن العديد من الفلسطينيين هناك لهم علاقات بالأردن وحتى لديهم جوازات سفر أردنية، بعضها يعود إلى فترة سيطرة الأردن على هذه الأراضي قبل عام 1967. ومع تصعيد المستوطنين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي جهودهم في إرهاب الفلسطينيين في الضفة الغربية، قد يفر البعض منهم إلى الأردن.
وترى تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية والاتصالات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن الضغط الإسرائيلي المتزايد على الفلسطينيين في الضفة الغربية قد يدفعهم إلى مغادرتها، وهو سيناريو أكثر احتمالا من أن تقوم “إسرائيل” بدفع الفلسطينيين جماعيا عبر الحدود، وهو ما سيشكل انتهاكا لمعاهدة السلام وقد يثير ردود فعل دولية واسعة. ومع ذلك، أكدت “الرفاعي” أن رد الفعل الدولي على الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة لم يسبب تغييرا في سياسات “إسرائيل” أو الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الانتقادات ليست رادعا كبيرا بالنسبة لهما.
إن الأردن يعتبر تدفق اللاجئين الفلسطينيين بأعداد كبيرة أزمة وجودية، سواء كانت “إسرائيل” هي التي هجّرتهم جميعا بالقوة دفعة واحدة، أو نتيجة لخروج أبطأ للهروب من العنف اليومي للاحتلال. ولمنع هذا، قد يفكر الأردن حتى في إلغاء الجنسيات للفلسطينيين أو غيرها من الأوضاع التي تسمح للفلسطينيين بعبور الحدود بشكل قانوني.
وعندما سُئل وزير الخارجية الأسبق “جوده” عن احتمال نقل الفلسطينيين على نطاق واسع إلى الأردن، أجاب: “هذا خط أحمر بالنسبة لنا، فلا يمكنك إفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من ديموغرافيتها، لن نقبل أو نسمح بأي إجراء من شأنه أن يتحدى أمننا الوطني، أو حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال على أراضيه، ويجب على المجتمع الدولي أن يتصدى لذلك”.
إن رده، مثل الموقف الرسمي للحكومة الأردنية، يعتمد على المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، التي أثبتت حتى الآن عجزها عن إيقاف العمليات الإسرائيلية في غزة بسبب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، مثل استخدامها حق النقض في مجلس الأمن.
وبالنسبة للبعض، يعد مشروع “إسرائيل الكبرى” مصدر قلق أكبر من تهجير الفلسطينيين إلى الأردن. فقد أكد رئيس تحرير ومؤسس موقع “سبيل” الإخباري، عاطف الجولاني، أن المخاوف الأردنية من التصعيد الإسرائيلي كانت أعلى من أي بلد آخر، قائلا إن “الخوف عميق بسبب طبيعة الحكومة الإسرائيلية، خاصة في ظل وجود اليمين المتطرف الذي يزداد نفوذه ويعزز أيديولوجيته التي تستهدف الأردن”.
ورغم أن غزو “إسرائيل” للأردن قد يبدو أمرا غير محتمل في ظل تحالف الأردن القوي مع الولايات المتحدة، فإن الدعم الأمريكي لإسرائيل ظل ثابتا حتى بعد غزوها للبنان، وهو ما يمكن أن يُعتبر خرقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر العدوان. ومع ذلك، يبقى الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد الأردن أمرا غير مرجح إلا في حالة وجود ميليشيا مماثلة لحزب الله تطلق صواريخ من الأراضي الأردنية أو حدوث تصعيد آخر.
وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2024، كانت هذه القضايا تشكل مصدر قلق بارز للأردنيين، إذ بدأت “إسرائيل” غزوها للبنان في الأول من الشهر، ما دفع إيران للرد بإطلاق صواريخ عبر الأجواء الأردنية تجاه “إسرائيل”. وبالتعاون مع القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن، أعلن الجيش الأردني إسقاطه بعض الصواريخ الإيرانية في إطار الدفاع عن مجاله الجوي.
وفي اليوم التالي لاختراق الصواريخ الإيرانية المجال الجوي الأردني، قال “جوده”: “لقد كنا واضحين للغاية بأننا لن نقبل باستخدام مجالنا الجوي كساحة قتال من قبل أي طرف، وسنستخدم جميع التدابير المتاحة لحماية سمائنا ومواطنينا”.
ورغم الموقف الرسمي، الذي كان يعكس أولويات الحكومة الأردنية، إلا أن آراء العديد من الأردنيين الذين شعروا بالارتياح عندما مرت الصواريخ الإيرانية فوقهم لأن أفعال “إسرائيل” ضد الفلسطينيين لن تمر دون عقاب. وبالنسبة للبعض، كانت عمليات اعتراض الصواريخ الأردنية تعبيرا عن قرار الحكومة الأردنية بإعطاء الأولوية لعلاقتها مع “إسرائيل” والولايات المتحدة على حساب حياة الفلسطينيين. وعندما سقط أحد الصواريخ داخل أراضي الأردن وقتل مواطنا أردنيا، شعر البعض أن عمّان تضع أمن “إسرائيل” فوق أمن مواطنيها. وقال أحد الأردنيين لموقع “ميدل إيست آي”: “لماذا يستنفد الأردن قواته واقتصاده لإسقاط صواريخ لا تستهدفه؟”
وعلى الرغم من أنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت القوات الأردنية هي من أسقطت الصواريخ أم أن الجيش الأمريكي المتمركز في الأردن هو من أطلق الصواريخ الاعتراضية، فإن أيا من السيناريوهين لا يحسّن صورة الحكومة الأردنية في أعين الشعب. وقد أعرب بعض المعنيين عن شكوكهم بشأن ما إذا كان الأردن سيعترض صواريخ إسرائيلية موجهة نحو إيران.
وأيا يكن موقف الأردن، سواء بالانخراط أو البقاء على الحياد، سيكون من الصعب عليه تجنب الانجرار إذا نشبت حرب شاملة بين “إسرائيل” وإيران. فكما أوضح مدير “مركز الدراسات الإستراتيجية”، زيد عيادات، فـ”حتى لو لم يكن الأردن طرفا نشطا، فإنه سيكون جزءا من الحرب”.
ومع قدوم إدارة ترامب، فإن بعض المخاوف التي كانت غير محتملة باتت أكثر احتمالا، فعندما سُئل “بني ارشيد” من الجبهة الإسلامية عما يمكن أن يفعله الأردن إذا فاز ترامب بالانتخابات وسمح لإسرائيل بفعل ما تريد، أجاب: “ستكون أزمة دولية، ولدى الأردن بدائل؛ ربما لا يكون أحدها الانخراط في حرب، ولكن يمكن أن يعيد النظر في جميع اتفاقاته مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاق الأمني”.
وعندما أُشير إلى أنه إذا جرى غزو الأردن، فإن جميع هذه الاتفاقات ستصبح لاغية، قال: “إذا حدث ذلك، فسيكون بداية مرحلة جديدة؛ وسيكون للأردن حركة مقاومة، وبالتالي من الجنون أن يُقدم ترامب على ذلك، فالولايات المتحدة ستفقد مصالحها الاستراتيجية في الأردن، مثل قواعدها العسكرية”. وأوضح أنه يعتبر هذا السيناريو بعيدا جدا.
ومع ذلك، اعتقد آخرون أنه إذا فاز ترامب، فإن إسرائيل ستشعر أنها حصلت على فرصة غير مسبوقة لتحقيق أهداف كانت تبدو مستحيلة في السابق، مثل الاستيلاء على أراضٍ إضافية.
ومع بلوغ ديون الأردن 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف التنمية الاقتصادية، وعدم كفاية المياه لسكانه الحاليين، لا تحتاج إسرائيل إلى غزو الأردن لدفعه إلى حافة الانهيار.
إن محاولة “إسرائيل” إجبار بعض من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية على الانتقال إلى الأردن تشكل تهديدا وجوديا للمملكة. وقد أكد الملك عبد الله رفضه التام لذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2024، مشيرا إلى المتطرفين الإسرائيليين، حيث قال: “يشمل ذلك أولئك الذين يواصلون نشر فكرة الأردن كوطن بديل، لذا دعوني أكون واضحا للغاية — هذا لن يحدث أبدا، لن نقبل أبدا التهجير القسري للفلسطينيين، الذي يُعد جريمة حرب”.
وذكر العديد من الذين حاورتهم الباحثة خطاب الملك عبد الله هذا، وأعربوا عن دعمهم لموقفه الواضح بشأن فلسطين، رغم أن بعضهم يعارض موقفه في مسائل أخرى. فعلى سبيل المثال، قال “بني ارشيد”: “في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض جلالة الملك [الضم]، وهذا يمثل موقف أغلبية الأردنيين”.
وأشار العديد أيضا إلى أنه قبل ذلك الخطاب، سمح الملك الأردني لوزير خارجيته، أيمن الصفدي (الذي لا صلة له برئيس مجلس النواب أحمد الصفدي)، بأن يكون المتحدث الرئيسي عنه في إدانة أفعال إسرائيل. وأوضح “عيسى” من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن “الصفدي قال بوضوح إن إجبار الفلسطينيين على الانتقال إلى الأردن هو بمثابة إعلان حرب ضد الأردن”.
ورأى البعض أن نجاح الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية دفع الملك للإبقاء على “الصفدي” وزيرا للخارجية، بهدف الاستمرار في التعبير عن إحباطات الأردنيين من السياسات الإسرائيلية. ويرى هؤلاء أنه لو حقق الإسلاميون عددا أقل من المقاعد، ربما لم يكن الملك ليختار الإبقاء على وزير خارجية يتمتع بهذا القدر من الصراحة.
إن نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، سواء نتيجة التهجير المباشر أو هربا من العنف الإسرائيلي، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير. وسيجد الملك نفسه أمام خيارين صعبين: إما الاستجابة لمطالب شعبه والرد بقوة على “إسرائيل”، أو مواجهة التداعيات السياسية المترتبة على الامتناع عن ذلك. وعلى الأرجح، سيحاول الملك عبد الله الحفاظ على التزامه بالاتفاق مع “إسرائيل”، مع السعي للحصول على دعم من الولايات المتحدة لتلبية احتياجات مئات الآلاف أو حتى الملايين من اللاجئين الجدد. ومع ذلك، تبدو احتمالية الحصول على مثل هذا الدعم ضعيفة في ظل إدارة ترامب.
في هذا السيناريو، قد يتعرض النظام الملكي في الأردن لخطر الإطاحة به، حيث سيجد الملك عبد الله نفسه عاجزا عن توفير الموارد اللازمة للتعامل مع احتياجات وإحباطات شعبه إلى جانب احتياجات الفلسطينيين النازحين من الضفة الغربية. ومع انهيار النظام، قد يلجأ العديد من الأردنيين والفلسطينيين النازحين إلى مهاجمة “إسرائيل”، سواء من خلال جهود فردية كما حدث سابقا، أو عبر تشكيل ميليشيات منظمة. وفي المقابل، من شبه المؤكد أن ترد “إسرائيل” بهجوم عسكري واسع النطاق.
ويبدو أن العنف وعدم الاستقرار الناجم عن هذا الوضع قد يوازي في شدته أزمة اللاجئين السوريين في الفترة 2014-2015، التي أحدثت اضطرابات كبيرة في السياسة الأوروبية. أما بالنسبة للأردنيين، فستكون التداعيات أكثر حدة، مما يعمق معاناتهم ويزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية.
ومع استمرار الدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة للحكومة الإسرائيلية، من غير المرجح أن يشكل العنف منخفض المستوى القادم من الأردن رادعا للسياسيين الإسرائيليين. بل إن السيناريو الذي قد يُقدم فيه نظام أردني جديد -بعد الإطاحة بالهاشميين- على تنفيذ هجوم ضد “إسرائيل” سيُفسَّر على الأرجح باعتباره مبررا إضافيا لتعزيز دعم واشنطن لتل أبيب.
هذه الديناميكية، القائمة على توفير الولايات المتحدة دعما غير محدود لإسرائيل بغض النظر عن تصرفاتها، تشجع السياسيين الإسرائيليين على اتخاذ المزيد من القرارات التصعيدية. وهو ما يتعارض بشكل واضح مع المصالح الأمريكية المعلنة ورغباتها في تحقيق الاستقرار. كما أن التداعيات السلبية الناتجة عن هذه السياسات تعرض الولايات المتحدة لخطر الانجرار إلى صراع كان بالإمكان تجنبه لو التزمت الإدارات الأمريكية بقانون البلاد، الذي يحظر نقل الأسلحة إلى الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تعيق وصول المساعدات الإنسانية.
واللافت أن على الرغم من الحماس الذي أبداه اليمين الإسرائيلي بعد انتخاب ترامب، يبقى الاحتمال واردا أن يفرض ترامب في الواقع عقوبات أكبر على إسرائيل مقارنةً بما فعله بايدن. فإذا شعر ترامب أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يحاولان استغلاله، قد يكون أقل تساهلا من بايدن حيال هذا السلوك الإسرائيلي. ومن المحتمل أن يدرك ترامب وفريقه أن الموافقة على ضم الضفة الغربية قد تعرقل محاولاته لإقناع السعودية بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، وهي خطوة يسعى من خلالها للحصول على جائزة نوبل للسلام.
وإذا استمر محمد بن سلمان في تمسكه بموقفه الذي يربط فيه التطبيع مع “إسرائيل” بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، فستظل العلاقات السعودية–الإسرائيلية بعيدة المنال. ومع ذلك، قد يكون هذا التحدي كافيا كي يفرض ترامب ضغوطا على نتنياهو تثنيه عن ضم الضفة الغربية، مما قد يسهم في تجنب الفوضى في الأردن.
خاتمة الملف
لطالما صور قادة الأردن مملكتهم على أنها “على حافة الانهيار” بهدف تشجيع الحكومات الأجنبية على تقديم الأموال اللازمة للحفاظ على استقرارها المالي. وعلى الرغم من أن هذه السردية كانت دقيقة بشكل أو بآخر، إلا أنها استُخدمت بشكل استراتيجي لمساعدة الهاشميين على البقاء في السلطة. وكما أشار “جودة”، ففي الخمسينيات والستينيات، كان البعض في المنطقة يقول: “أيام الأردن معدودة”، إلا أن الأردن صمد لفترة أطول من كل تلك الأصوات والأنظمة، مما يعني أن هناك شيئا صحيحا فيما نفعله!
وفي الماضي، كانت عمان تعتمد على حكومة أمريكية تدعم الأمن الأردني وتعزز الاستقرار الإقليمي، وكذلك على حكومة إسرائيلية تدرك قيمة معاهدة السلام التي تحكم أطول حدودها. لكن مع وجود ترامب في البيت الأبيض واعتماد نتنياهو على دعم المتطرفين اليمينيين في ائتلافه الحاكم، لم يعد بإمكان الملك عبد الله الاعتماد على أي منهما.
إن تقويض استقرار الأردن بشكل جدي قد يفاقم من المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة. فمنذ إدارة كلينتون، كان الاستقرار في الأردن عنصرا أساسيا في السياسة الأمريكية تجاه بلاد الشام. وإذا أدى ضم إسرائيل للضفة الغربية إلى دفع الأردن نحو حافة الانهيار، سواء من خلال أزمة لاجئين ضخمة أو الإطاحة بالهاشميين، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ستخسران الأساس الذي ترتكزان عليه حاليا.
وفي الوقت الذي تعهد فيه ترامب بسحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا، فإن اندلاع فوضى في الأردن سيجعل الوفاء بهذا الوعد صعبا للغاية. إذ تستمر الميليشيات في العراق في العمل بحرية نسبية، في حين أن الهجوم الإسرائيلي على لبنان قد زاد من هشاشة الوضع، وسقوط الأسد يهدد بدفع سوريا نحو الفوضى.
وعلى الرغم من أن ترامب بنى حملته الانتخابية على وعده بإنهاء الحروب في المنطقة، إلا أنه إذا استمر في تجاهل تصرفات إسرائيل، فقد يشهد تصاعدا في الصراع الإقليمي قد يجر الولايات المتحدة إلى الحرب، خاصة إذا قُتل أفراد من الجيش الأمريكي وطالب الجمهور الأمريكي بالانتقام.
علاوة على ذلك، إذا فشلت الولايات المتحدة في منع “إسرائيل” من ضم الضفة الغربية، لا سيما إذا تسببت هذه الخطوة في تفكيك الوضع الراهن الهش في القدس، فإن رد فعل شركاء أمريكا في المنطقة سيكون سريعا.
وعلى الرغم من أن الحكام من الرباط إلى القاهرة ومن أبو ظبي إلى الرياض قد رحبوا بفوز ترامب في الانتخابات بسبب استعداده لمكافأتهم في ولايته الأولى، إلا أنهم سيواجهون ضغوطا داخلية شديدة للرد بحزم إذا مضت إسرائيل في الضم. كما أظهرت الحرب الإسرائيلية على غزة مرة أخرى أن قضية فلسطين تبقى قضية محورية للجماهير العربية والإسلامية.
ويسعى ترامب إلى إثبات قدرته على تحقيق تطبيع سعودي مع “إسرائيل”، وهو ما فشل بايدن في تحقيقه. لكن إذا فشل في منع “إسرائيل” من تصعيد الأزمة، قد يشهد ترامب انهيار اتفاقات التطبيع. وبدلا من استعادة الاستقرار، قد ينتهي الأمر بترامب إلى تسهيل تورط الولايات المتحدة في حرب أخرى غير ضرورية في الشرق الأوسط.