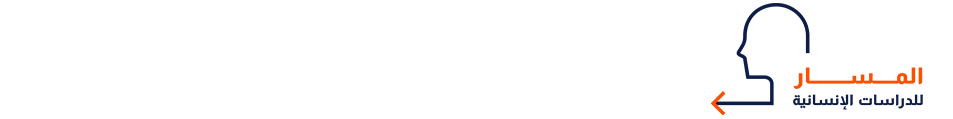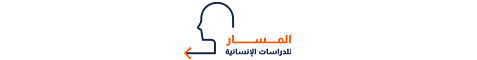تداعيات الاتفاق الأمني مع السعودية على الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة
المحتويات
مقدمة المترجم
ملخص تنفيذي
خلفيات الاتفاق
النفط والأمن القومي في العلاقات الأمريكية-السعودية
تبعات الاتفاق على السياسة الخارجية السعودية
- تأثير الاتفاق على العلاقات السعودية-الصينية
- كيف ستستغل السعودية الاتفاق الأمني؟
- تأثير الاتفاق على التقارب السعودي-الإيراني
- البعد النووي في الاتفاق
- مآلات الاتفاق على القضية الفلسطينية
خاتمة الورقة
مقدمة المترجم
في أوائل عام 2023، وبالتزامن مع تكثيف الولايات المتحدة الأمريكية جهودها لإبرام اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل”، تصاعد الحديث حول اتفاق أمني بين واشنطن والرياض يجري التفاوض حوله، كمقايضة سعودية لإنجاز اتفاق التطبيع.
وبعد مرور عام ونيف على هذه الجهود، كشف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في 29 أبريل/نيسان 2024، أن المملكة والولايات المتحدة اقتربتا “للغاية” من إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين، تشمل اتفاقا أمنيا.[1]
في هذا السياق، نشر معهد “كوينسي” الأمريكي ورقة بحثية حملت عنوان: “توقيع الولايات المتحدة لاتفاق أمني مع السعودية.. التبعات والتداعيات”. وترجع أهمية هذه الورقة إلى موضوعها الذي يرتبط بالعديد من التطورات المهمة في المنطقة.
فهو من جهة يرتبط بالحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة وآفاق وضع نهاية لها، ومن جهة أخرى، يرتبط الملف بتطورات العلاقات السعودية-الإيرانية، بالتزامن مع تصاعد الصراع بين إيران و”إسرائيل”.
علاوة على ذلك، فإن واشنطن تتوقع من الاتفاق الأمني المزمع أن يُبعد السعودية عن الصين في وقت تتصاعد فيه حدة التنافس بين القوتين العظميين. وقبل هذا وذاك، يدور حديث عن أن الاتفاق المزمع سيصحبه صيغة ما، حول وضع مسار لحل القضية الفلسطينية.
ومما يضفي أيضا على هذه الورقة أهمية أن كاتبها، بول بيلار، كان مسؤولا أمريكيا بارزا في إدارات جورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن. إذ عمل “بيلار” لمدة 28 عاما في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، قبل أن يصبح أستاذا زائرا في برنامج الدراسات الأمنية بجامعة “جورج تاون” الأمريكية.
وشغل “بيلار” مناصب عليا في الحكومة الأمريكية منها أنه كان ضابط المخابرات الوطنية المسؤول عن الشرق الأدنى وجنوب آسيا، ونائب رئيس مركز مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، والمساعد التنفيذي لمدير الاستخبارات المركزية الأمريكية. هذا فضلا عن كونه أحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام وضابط متقاعد في احتياطي الجيش الأمريكي.
وحيث إن ورقة “بيلار”، التي نشرها معهد “كوينسي”، استعرضت تلك الموضوعات المترابطة والمتداخلة من منظور نقدي يتبناه جزء من النخبة الأمريكية، فقد آثر “مركز المسار للدراسات الإنسانية” ترجمة هذه الورقة، حتى يتسنى للقارئ العربي فهم أبعاد هذا الاتفاق الذي وصفه السفير الأمريكي لدى الرياض، مايكل راتني، بأنه “اتفاق تاريخي لديه القدرة على تغيير المشهد في الشرق الأوسط”.[2]
وإليكم نص الورقة، التي تبدأ بـ”ملخص تنفيذي”.
ملخص تنفيذي
خلال الآونة الأخيرة، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى التوصل إلى اتفاق تقدم فيه السعودية اعترافها الدبلوماسي الكامل بإسرائيل، مقابل تقديم الولايات المتحدة ضمانة أمنية للسعودية، ومساعدتها في تطوير برنامج نووي، ورفع القيود عن المزيد من مبيعات الأسلحة إليها.
ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يفاقم تورط الولايات المتحدة في نزاعات الشرق الأوسط ويزيد حدة الانقسامات الإقليمية. ومن شأنه أيضا أن يقوض جهود الدول الإقليمية لتسوية خلافاتها بعيدا عن الولايات المتحدة، كما شهدنا في الانفراجة التي حدثت في العلاقات السعودية-الإيرانية بوساطة صينية. وهي جهود تصب في صالح واشنطن في نهاية المطاف.
وإلى جانب كونها دولة استبدادية تفتقر إلى وجود قيم مشتركة مع الولايات المتحدة، فإن السعودية تسعى بقوة إلى الهيمنة الإقليمية في عهد محمد بن سلمان، ولا سيما من خلال حربها المدمرة في اليمن.
وبناء على ذلك، فإن الضمانات الأمنية الأمريكية -إذا ما قُدّمت- ربما تحفز ابن سلمان على الانخراط في سلوك أكثر مجازفة، يجر الولايات المتحدة إلى صراعات لا مصلحة لها فيها، مثل الصراع الطائفي الذي دفع السعودية إلى قطع علاقاتها مع إيران.
وبخصوص البرنامج النووي السعودي الموسع، فسيكون له بُعد عسكري بالإضافة إلى بُعده المدني، فابن سلمان لا يُخفي اهتمامه بامتلاك سلاح نووي. ولذلك، فإن تلبية الطلب السعودي للمساعدة في تخصيب اليورانيوم سيكون بمثابة ضربة لنظام منع انتشار الأسلحة النووية، وارتداد عن سياسة أمريكية راسخة. وربما ينشأ، بسبب ذلك، سباق تسلح نووي بين إيران والسعودية.
علاوة على هذا، فإن تلبية مطالب ابن سلمان لن تحد من العلاقات السعودية-الصينية، والتي تضرب بجذورها في المصالح الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون.
وفي المقابل، يمكن للولايات المتحدة أن تنافس الصين في المنطقة بفعالية أكبر، لكن ليس من خلال تحمل التزامات أمنية إضافية، بل عبر محاكاة الصين في الانخراط مع كل دول المنطقة بهدف الحد من التوترات.
وفيما يخص إسرائيل، فإن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينها وبين والمملكة لن يكون “اتفاق سلام”، نظرا للتعاون الأمني واسع النطاق القائم بالفعل بينهما.
وحتى هدية الولايات المتحدة لإسرائيل، المتمثلة في التطبيع مع الرياض، لن تؤدي على الأرجح إلى تخفيف مواقف إسرائيل المتشددة فيما يتعلق بالحرب في غزة والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بشكل عام. بل لن يؤدي التطبيع السعودي-الإسرائيلي إلا إلى تقليل دوافع إسرائيل لحل هذا الصراع.
خلفيات الاتفاق
إن الزخم حول التوصل إلى اتفاق أمني محتمل مع السعودية يرجع، في جزء كبير منه، إلى توسط إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتحسين العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية.
ففي البداية، شمل الوصول إلى علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، ثم تبعتها البحرين والمغرب والسودان. ومثّل هذا التطور خروجا عن “مبادرة السلام العربية” المطروحة على الطاولة منذ عام 2002، والتي تعرض إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، مقابل إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والسماح بإقامة دولة فلسطينية.
كما شكلت تحركات إدارة ترامب سابقة من نوعها، حين قدمت الولايات المتحدة عطايا ضخمة للأنظمة العربية المعنية، كحافز للانتقال إلى علاقات كاملة مع إسرائيل. ويمكن القول إن هذه الأنظمة كانت مدفوعة بما ستتحصل عليه من الولايات المتحدة، أكثر من كونها مدفوعة بأي شيء تأمل في الحصول عليه من إسرائيل.
فعلى سبيل المثال، وعدت الولايات المتحدة الإمارات بتوفير طائرات مقاتلة من طراز “F-35″ وطائرات بدون طيار من طراز “MQ-9 Reaper“، وهو ما سيجعل الإمارات، في حالة الوفاء بهذا الوعد، أول دولة عربية تحصل على أي من هذه الأنظمة المتقدمة أمريكية الصنع.
وبالنسبة للمغرب، كانت المصلحة التي حصلتها من الولايات المتحدة هي الخروج عن الإجماع الدولي، عبر الاعتراف بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وعلى هذا، أعلنت إدارة ترامب رفع مستوى العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل وسط ضجة كبيرة، وأعطت تلك الصفقات عنوانا مهيبا: “اتفاقيات أبراهام”.
لكن السعودية كانت السمكة الكبيرة التي لم يتم اصطيادها بعد، ولذا، أصبح الوصول لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل أولوية عاجلة لسياسة بايدن في الشرق الأوسط.
وقد استلزم الحصول على موافقة الرياض على التطبيع، التقليل من الانتقادات الحادة التي وجهها في السابق الرئيس بايدن لسجل النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان؛ هذا بالرغم من أن بايدن حين كان مرشحا للرئاسة، وعد بمعاملة هذا النظام باعتباره “منبوذا”.
وبالإضافة إلى التطبيع المأمول للعلاقات مع إسرائيل، فإن تأثر أسواق الطاقة العالمية، بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير/شباط 2022، وما تبعه من عقوبات على روسيا، أضاف هدفا آخر سعت الإدارة الأمريكية إلى تحقيقه بالتعاون مع الرياض.
إذ تسببت الحرب والعقوبات في ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما ساهم في ارتفاع التضخم داخل الولايات المتحدة وأوروبا، وصاحب ذلك عواقب سلبية على بايدن في السياسة المحلية الأمريكية.
ولذلك، كان الحصول على مساعدة سعودية في استقرار أسعار النفط أحد أهداف رحلة الرئيس بايدن إلى المملكة في يوليو/تموز 2022، والتي التقى فيها بالحاكم الفعلي للسعودية، محمد بن سلمان.
وعلى الرغم من أن النتائج المتعلقة بالتعاون في مجال النفط كانت -في معظمها- مخيبة للآمال، إلا أن فكرة مقايضة التطبيع مع إسرائيل مقابل خدمات أمريكية للسعودية كانت لا تزال قائمة. وقد أوضح ابن سلمان أن هذه الخدمات، التي على الولايات المتحدة تقديمها مقابل التطبيع السعودي مع إسرائيل، يجب أن تتجاوز ما قدمته واشنطن للدول العربية الأخرى.
وتشمل مطالب ابن سلمان اتفاقا أمنيا رسميا مع الولايات المتحدة، إلى جانب المساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، وتخفيف القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة.
وعلى الرغم من أن الصفقة ربما كانت قريبة اعتبارا من منتصف عام 2023، إلا أن تزايد العنف الإسرائيلي-الفلسطيني في الأراضي المحتلة جعل من الصعب على أي حاكم عربي، حتى لو كان مستبدا مثل ابن سلمان، أن يُقدِم على ما يمكن اعتباره لفتة ودية تجاه إسرائيل.
وفيما بعد، بدا أن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعه من هجوم إسرائيلي كاسح ضد قطاع غزة، قد وضعا فكرة التطبيع السعودي-الإسرائيلي جانبا تماما.
لكن بدلا من التخلي عن هذا المسعى، أعادت إدارة بايدن توظيفه. فمع احتفاظها بأهدافها الأخرى، حاولت الإدارة الأمريكية استخدام إمكانية التطبيع مع السعودية كوسيلة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، باعتبار أن صفقة التطبيع هذه غنيمة تدرك إسرائيل قيمتها.
وفي هذا السياق، تتلخص أهداف واشنطن في الآتي: دفع إسرائيل إلى تخفيف العمليات العسكرية التي حولت قطاع غزة إلى كارثة إنسانية، واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، من خلال حل الدولتين.
ونظرا للمعارضة القوية التي تبديها حكومة اليمين الإسرائيلي لتقييد عملياتها العسكرية في غزة، ومعارضتها الأقوى لحل الدولتين، فقد برزت تكهنات مؤخرا تفيد بأن الولايات المتحدة والسعودية ستمضيان في صفقة منفصلة -تشمل اتفاقا أمنيا- على أن تكون هذه الصفقة إطارا للمشاركة الإسرائيلية المأمولة لاحقا.
وهذا احتمال لا يمكن استبعاده، على الرغم من أن التطبيع الدبلوماسي السعودي-الإسرائيلي لا يزال الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية.
لكن من ناحية أخرى، قد تكون مشاركة إسرائيل في الصفقة أمر ضروري؛ لضمان أي موافقة مطلوبة من الكونغرس على اتفاق أمني مع الرياض.
النفط والأمن القومي في العلاقات الأمريكية-السعودية
يعود إدراج قضية النفط في رحلة الرئيس بايدن إلى السعودية -المشار إليها آنفا- إلى بداية العلاقات الأمريكية-السعودية، عندما التقى الرئيس، فرانكلين روزفلت، مع مؤسس المملكة، عبد العزيز بن سعود، على متن مدمرة أمريكية في قناة السويس، خلال الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.
وكان تمكين الشركات الأمريكية من الوصول إلى الاكتشافات النفطية الكبرى في السعودية هدفا رئيسيا للولايات المتحدة في ذلك الوقت. لكن الوضع فيما يتعلق بالنفط تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين، خاصة في ضوء ثورة التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة.
إذ تحصل الولايات المتحدة حاليا على 5 بالمئة فقط من وارداتها النفطية من السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الولايات المتحدة مصدّرا صافيا للبترول، والفارق بين ما تصدره من بترول وما تستورده يفوق أربع مرات الكمية التي تحصل عليها من السعودية.
وبالتالي، فإن أهمية صادرات النفط من السعودية ودول الخليج الأخرى بالنسبة لواشنطن لا تنبع في الوقت الراهن من امتياز وصول الشركات الأمريكية لحقول النفط السعودية، بل إن الأهمية تكمن في الدور الذي يلعبه الخليج في تجارة النفط العالمية؛ ذلك أن أي تعطيل في تلك التجارة يمكن أن يكون له تداعيات اقتصادية تعم العالم بأسره، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وعلى هذا، فإن وجود علاقة خاصة بين الولايات المتحدة والسعودية، أو أي تبادل للمصالح بينهما، لا يلعب دورا كبيرا في تعزيز أمن الطاقة أو الأمن الاقتصادي الأمريكي.
وبدلا من ذلك، ينبغي أن يكون هدف الولايات المتحدة في منطقة الخليج هو تعزيز السلام والاستقرار، كي تحد من مخاطر الاضطرابات الاقتصادية المدمرة.
والعكس بالعكس، فإن أي شيء يزيد من حدة الصراع ويميل إلى تقسيم المنطقة إلى كتل متصارعة من شأنه أن يزيد من هذه المخاطر.
وبعيدا عن موضوع النفط، فإن السعودية ليس لديها سوى القليل -أو لا شيء أصلا- لتقدمه للولايات المتحدة فيما يتعلق بالأمن.
وعلى الرغم من أن الصفقة الأمنية المرتقبة يمكن وصفها بأنها معاهدة أو اتفاق أمني “متبادل”، إلا أنها ستكون في الواقع التزاما أحادي الجانب، تكون فيه الولايات المتحدة هي المانح للأمن والنظام السعودي هو المتلقي له.
ونحن لا ننكر أهمية الاتفاقات الأمنية عموما، ففي أوقات أخرى أو مناطق أخرى، ربما يوفر الارتباط الأمني مع حليف أضعف منصة لواشنطن، كي تتعامل بفعالية مع تهديدات تثير قلقها أو قلق حليفها.
لكن أي وجود عسكري أمريكي كبير في السعودية ثبت بالفعل أنه يمثل عبئا على الولايات المتحدة، لا رصيدا لها، كما أنه يزيد من التهديدات التي تواجه المصالح الأمريكية بدلا من تقليلها.
فعلى سبيل المثال، كان نشر القوات الأمريكية في المملكة خلال “عملية درع الصحراء” -استعدادا لطرد القوات العراقية من الكويت في عام 1991- أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تطرف أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة.
وبعد عدة سنوات، في عام 1995، فجرت مجموعة من الإرهابيين “مجمع أبراج الخبر”، شرقي السعودية، مما أسفر عن مقتل 19 طيارا أمريكيا في سكناتهم. وتبع ذلك، نقل معظم القوات الأمريكية الموجودة في السعودية إلى قاعدة جوية أبعد، ثم نقلها لاحقا إلى قطر.
ووفقا للمبرر الرسمي الأمريكي، فإن ما يقرب من 2600 من العسكريين الأمريكيين الذين يؤدون وظائف الدعم في السعودية موجودون هناك “لحماية القوات الأمريكية ومصالحها في المنطقة، ضد أعمال إيران العدائية والجماعات التي تدعمها”.
وبهذا، فإن المصالح الأمريكية الأكثر عرضة للتعرض لأعمال عدائية هناك هي نفسها القوات العسكرية الأمريكية، الأمر الذي يقودنا إلى المنطق الدائري القائل بأن القوات الأمريكية منتشرة هناك لحماية القوات الأمريكية المنتشرة هناك.
أما بالنسبة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع السعودية، فإن هذا التعاون لم ينجم عن أي علاقة خاصة أو كمقايضة مقابل خدمات تمنحها واشنطن للرياض. وبدلا من ذلك، كان الأمر يتعلق بما إذا كان السعوديون يعتبرون أنفسهم هدفا للإرهاب أم لا.
فلسنوات عديدة، كانت السعودية جزءا كبيرا من مشكلة الإرهاب ولم تكن بتاتا جزءا من الحل، حتى إلى الحد الذي بدا فيه أن مسؤولين سعوديين ساعدوا بعض منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
ولم يصبح النظام السعودي جادا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولم يبدأ التعاون الفعال مع الولايات المتحدة، إلا بعد سلسلة من التفجيرات في الرياض عام 2003. فحينها اقتنع السعوديين بأنهم يمكن أن يكونوا ضحايا للإرهاب الدولي أيضا، وبدأوا حينها في التعاون جديا بهذا الخصوص.
تبعات الاتفاق على السياسة الخارجية السعودية
- تأثير الاتفاق على العلاقات السعودية-الصينية
إن محمد بن سلمان حاكم استبدادي لا يشعر بأي صلة أيديولوجية بالديمقراطية الغربية، وسياسته الخارجية هي سياسة تحصيل ما يمكن تحصيله من أي اتجاه، بغض النظر عن الأيديولوجية.
ومثلها مثل العديد من دول ما يسمى مجازا بـ”الجنوب العالمي”، تعارض السعودية الاختيار بين الشرق والغرب أو بين القوى الكبرى بشكل عام. إذ يسعى النظام السعودي إلى عدم الالتزام بالتعاون مع جانب واحد، بل يعمل على أخذ ما يريده من كل جانب في طرفي المعادلة. ولا ينظر ابن سلمان إلى أي اتفاق مع أية قوة خارجية في مسألة ما، على أنه التزام سعودي بالانحياز إلى تلك القوة في المسائل الأخرى.
وبالمتابعة نجد أن الأساس المنطقي الذي يستشهد به المسؤولون الأمريكيون، ومنهم بايدن، لنسج علاقات وثيقة مع السعودية، هو التنافس الأمريكي-الصيني على النفوذ في الشرق الأوسط.
لكن العلاقات السعودية-الصينية واسعة النطاق بالفعل ومتجذرة في مصالح اقتصادية كبرى وغيرها، ومن المستبعد أن تتغير كثيرا بسبب أي اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة.
فالمملكة هي أكبر مصدر للنفط في الصين، وتشتري الأخيرة النفط من السعودية أكثر من أي بلد آخر. علاوة على ذلك، فإن السعودية هي أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط، والصين هي أكبر شريك تجاري للسعودية بشكل عام. وتعد الصين أيضا مستثمرا مهما في خطط ابن سلمان الطموحة للتنمية الاقتصادية خارج نطاق النفط، والتي تحمل عنوان: “رؤية السعودية 2030”. وتتشابك العديد من المشاريع في تلك الخطط بشكل طبيعي مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.
كما أبدت الصين استعدادها للتعاون مع السعودية في بعض المسائل العسكرية، والتي يعود تاريخها إلى بيع الصين للمملكة صواريخ باليستية متوسطة المدى في صفقة أبرمت عام 1986، ولم يكتشفها الغرب إلا بعد عامين. واللافت في تلك الصفقة أنها عُقدت قبل وقت طويل من الحديث عن انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وتركها “فراغا” هناك.
واليوم، تساعد الصين المملكة في بناء صواريخها الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب.
وإذا ما نظرنا إلى العامل الرئيسي الذي يجذب النظام السعودي للعمل مع الصين، سواء في المسائل الاقتصادية أو العسكرية، سنجده يتمثل في أن بكين لا تهتم بأوجه القصور في مجال حقوق الإنسان لدى شريكاتها من الدول.
لكن في المقابل، كانت انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان -مثل قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي- هي أحد الأسباب الكبرى لتوجه بايدن، في بدايات فترته الرئاسية، لمعاملة السعودية كدولة منبوذة.
أضف إلى ذلك أن النظام السعودي عندما ينظر إلى المزاج العام لمواطنيه، يجد أنهم يفضلون الصين. وربما يعكس هذا شعورا بين السعوديين العاديين بأن الولايات المتحدة تتعامل معهم بشأن قضايا مثيرة للقلق كالتهديدات الأمنية، بينما الصين تقدم لهم ما قد يحسّن أسلوب حياتهم.
وفي هذا السياق، أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2022 أن 41 بالمئة فقط من السعوديين يعتبرون وجود علاقات جيدة مع الولايات المتحدة أمر “مهم للغاية” أو “مهم إلى حد ما”، في حين كان الرقم المقارن للعلاقات مع الصين 55 بالمئة، ومع روسيا 52 بالمئة.
وإذا ما قارنّا علاقات المملكة مع كل من روسيا والصين، سنجد أن علاقاتها بالصين أوسع؛ وذلك ببساطة لأن روسيا ليس لديها الكثير لتقدمه.
لكن على أي حال، فقد نمت العلاقات السعودية-الروسية خلال السنوات الأخيرة. وتتمثل المصلحة المشتركة الرئيسية بين الرياض وموسكو في تعظيم عائدات النفط، وهو الهدف الذي يتناولونه في المقام الأول من خلال تحالف “أوبك بلس”.
أما الولايات المتحدة، فهي بالنسبة للسعودية قوة أخرى يجب التعامل معها على أساس مصلحي، يسعى من خلاله ابن سلمان لتحصيل أكبر قدر ممكن من المنافع، مقابل أقل تنازلات ممكنة.
وإزاء الاتفاق الذي يجري الحديث حوله، ربما يرى ابن سلمان نفسه في موقف تفاوضي قوي، وأنه ليس في عجلة من أمره لإنجاز هذا الاتفاق.
ويمكنه في ذلك أن يتخذ من الغضب الشعبي حيال الكارثة التي حلت بقطاع غزة ذريعةً للتباطؤ في أي اتفاق يتضمن التطبيع مع إسرائيل.
وهنا، لابد أن نأخذ في الاعتبار أن التطبيع ورقة يعرف ابن سلمان أنه لا يمكنه اللعب بها إلا مرة واحدة.
وفي الوقت نفسه، قد يرى ابن سلمان أن الرئيس بايدن متلهف للتوصل إلى اتفاق. فلقد طرأ بالفعل تحول ملحوظ على موقف بايدن، إذ بدأ فترته بالحديث عن معاملة السعودية كدولة “منبوذة” ثم انتقل الآن للحديث عن توفير ضمان أمني لها.
أيضا ربما يعتقد ابن سلمان أن الوضع في غزة والمشاكل السياسية الداخلية التي يسببها لبايدن تجعل الأخير أكثر حرصا على إبرام اتفاق.
ومؤدى ذلك باختصار، أن ابن سلمان لديه أسبابا كافية لجعلها مساومات صعبة على الإدارة الأمريكية.
- كيف ستستغل السعودية الاتفاق الأمني؟
يشير ما سبق إلى أن أي صفقة أمريكية-سعودية ربما ستكون أكثر وضوحا في الجزء الذي يتحدث عن الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه المملكة، بينما ستكون أكثر ضبابية بشأن أي تغييرات مأمولة في سياسات السعودية تجاه الصين أو مستويات إنتاج النفط. فعلى أية حال، ستظل سياسات الرياض في هذه الملفات خاضعة لمصالحها ودوافعها الخاصة.
ولقد حافظت السعودية على استقلالها وسيطرتها على أراضيها طوال وجودها المستمر منذ قرن تقريبا، من دون معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة أو ما شابه ذلك.
هذه الحقيقة تثير تساؤلات حول الأسباب التي تجعل ابن سلمان يرى مصلحة في مثل هذا الاتفاق.
يكمن جزء من الإجابة في مفارقة تعيشها المملكة تتمثل في أن نظامها ملكيا وراثيا مطلقا، لكنه يحكم دولة يفترض أنها تسعى إلى التحديث في القرن الحادي والعشرين.
وإدراكا لعدم الاستقرار المتأصل في هذا المزيج، فإن أي حاكم سعودي سيرحب بأن تحتضنه القوة العظمى عالميا؛ كي يتسنى لنظامه البقاء في ظل هذه المفارقة.
وهناك سبب آخر يدفع السعودية لإبرام اتفاق أمني مع الولايات المتحدة، وهو أن مثل هذا الاتفاق أصبح في متناول يدها؛ بفضل مجموعة من الظروف المتعلقة بغزة، والنفط، والسياسة الأمريكية الداخلية.
ويتعلق جزء آخر من الإجابة بالسياسات السعودية في الإقليم، إذ أنها باتت عدوانية باضطراد، حتى من قبل وصول ابن سلمان إلى السلطة، لكنه عززها منذ ولايته للعهد.
ففي السنوات الأخيرة، أصبحت السعودية في المرتبة الثانية بين القوى الإقليمية، بعد إسرائيل، في نطاق استخدامها للقوة العسكرية خارج حدودها. وشمل هذا الاستخدام التدخل العسكري في البحرين عام 2011 لدعم نظام سني لا يحظى بشعبية في دولة ذات أغلبية شيعية.
والأهم من ذلك، الحرب السعودية في اليمن، التي بدأت عام 2015؛ ليس بسبب أي هجمات يمنية على السعودية، ولكن لإعادة تثبيت النظام اليمني الذي أطاح به التمرد الحوثي من العاصمة. وتسببت الحرب الجوية السعودية في دمار واسع، حوّل اليمن إلى واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية غير الطبيعية في السنوات الأخيرة.
وحتى دون وجود معاهدة أمنية، انخرطت الولايات المتحدة جزئيا في الصراع من خلال توفير الدعم الاستخباراتي واللوجستي للسعودية. وربما كانت ستشارك على نطاق أوسع لو كانت هناك اتفاقية أمنية سارية المفعول بينها وبين المملكة.
وعلى الرغم من الإحباطات التي مُني بها السعوديون في اليمن والتي دفعتهم للانسحاب من عملياتهم هناك، فليس هناك سبب يجعلنا نعتقد بأن الطموحات الإقليمية الأكبر لابن سلمان قد تضاءلت.
فقد تجلت هذه الطموحات ليس فقط في التدخلات العسكرية، ولكن أيضا في الجهود التي قادتها السعودية لاستخدام الحصار والعزلة كأداة لإرهاب جارتها قطر -التي تستضيف وجودا عسكريا أمريكيا كبيرا- وذلك لإجبارها على الخضوع لها.
وفي ظل هذه السياسات العدوانية، فإن الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة يتمثل في أن الالتزام الأمريكي الرسمي بأمن المملكة من شأنه أن يمنح ابن سلمان ارتياحا وشعورا أكبر بالحرية في اتخاذ خطوات عدوانية، باعتبار أن واشنطن ستدعمه إذا وقع في مشكلة.
علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى التفكير في نوع النظام الذي ستحميه عند إبرام اتفاقية أمنية مع السعودية. فليس هناك وجه شبه على الإطلاق بين الاتفاق الأمني مع السعودية وتأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي تضمن الدفاع عن ديمقراطيات أوروبا الغربية ضد الاتحاد السوفييتي تحت زعامة ستالين، أو معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الجنوبية، الدولة الديمقراطية التي تواجه نظاما شموليا مدججا بالسلاح في شمالها، والذي لم يتخل عن هدفه المتمثل في السيطرة على كوريا بالكامل.
فليست هناك قيم مشتركة بين الولايات المتحدة والنظام السعودي الاستبدادي. حتى إن السعودية لا تتمتع بميزة في قيمها على الدول المجاورة لها وأعدائها المحتملين؛ فالمملكة أقل ديمقراطية من النظام السياسي الإيراني الذي ينطوي على عناصر ديمقراطية ولو كانت محدودة.
وليست الحقوق السياسية فحسب هي الغائبة في المملكة، فحقوق الإنسان الأخرى تتعرض لانتهاكات خطيرة ما زال يشنها النظام السعودي حتى الآن.
- تأثير الاتفاق على التقارب السعودي-الإيراني
كثيرا ما يستخدم المسؤولون الأمريكيون التهديد الإيراني المحتمل كمبرر لتوسيع الالتزامات الأمنية الأمريكية في السعودية أو في أي مكان آخر في الشرق الأوسط.
ومن الحوادث المحددة التي يُستشهد بها كثيرا في هذا السياق، الهجوم الجوي على منشآت النفط السعودية في “بقيق” و”خريص” في سبتمبر/أيلول 2019، الذي أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عنه، لكنه ربما كان من عمل إيران. وورد في وقت لاحق أن القادة السعوديين كانوا غير راضين عن أن واشنطن لم ترد بمهاجمة إيران.
إن الحقيقة الأكثر أهمية حول هذه الحادثة هي ما شهدناه بعد ذلك، فلم تشن إيران مزيدا من الهجمات ضد السعودية لأنها لم تُردَع بشكل كافٍ مثلا. بل على النقيض، رأينا تقاربا بين البلدين.
وبوساطة صينية، تُوجت عدة جولات من المحادثات بين الدولتين المطلتين على الخليج، في مارس/آذار 2023، باتفاق لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة تنشيط اتفاقية التعاون الأمني التي انقضت.
وكان لدى كلا الجانبين أسباب مصلحية قوية لتحقيق هذه الانفراجة في العلاقات على الرغم من التوترات المستمرة بين الجانبين.
فمن جانبها، أرادت إيران توطيد علاقاتها مع جميع جيرانها وإظهار أنها ليست معزولة. وبدورها، أرادت السعودية ضمانات ضد أي هجوم خارجي، في الوقت الذي تركز فيه على خطة التنمية الاقتصادية لرؤية 2030. كما أن كلا البلدين سيتضررا من أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تعطيل تجارة النفط.
والدرس الرئيسي المستفاد من هذه الواقعة هو أن الولايات المتحدة عندما تمتنع عن التدخل في صراع إقليمي، سواء برد عسكري أو بوعود أمنية، فإن كلا الجانبين المعنيين سيكون لديهما حافز أكبر لحل الأمور بمفردهما. وهذه بالتحديد النتيجة التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة، فهي لا تكلف الولايات المتحدة شيئا، وفي الوقت نفسه تقلل خطر نشوب حرب إقليمية.
وعلى العكس من ذلك، فإن انحياز الولايات المتحدة إلى أحد الجانبين بطريقة تعيد تسليط الضوء على الانقسامات في المنطقة هي سياسة من شأنها أن تؤدي إلى تقويض هذا التطور الإيجابي في العلاقات السعودية-الإيرانية.
علاوة على ذلك، فإن شحذ خطوط الصراع بطريقة تستهدف إيران لا يعني أن الأخيرة ستكون راضية وستتحمل العزلة.
بل إن المتوقع هو أن ترد طهران من خلال تعزيز علاقاتها مع العراق وسوريا ولبنان، فضلا عن الميليشيات والجماعات غير الحكومية المرتبطة بها. كما أنها ستزيد من اعتمادها على روسيا، بكل ما يعنيه ذلك من إمداد عسكري بين البلدين.
ولكي يلبي تحالف مناهض لإيران، سواء مع السعودية أو مع أي دولة إقليمية أخرى، احتياجات الولايات المتحدة، فإنه يجب أن يكون قائما على ردع أي عمل قد تبادر به إيران ضد المصالح الأمريكية ذاتها، بدلا من أن تكون واشنطن طرفا في تنافس إقليمي لا مصلحة لها فيه.
والجدير بالذكر أن دوافع طهران في تقاربها مع الرياض هي نفسها مثبطات تمنعها من المبادرة بأي عمل هدّام يزعزع استقرار المنطقة.
وتواجه إيران، باعتبارها دولة ذات أغلبية فارسية وشيعية، تحديا مزمنا يتمثل في محاولة كسب النفوذ في منطقة أغلب سكانها من السنة والعرب. وفي الأشهر الأخيرة، فعلت ذلك جزئيا عبر قبولها الهادئ للإجماع العربي والإسلامي في المنظمات الدولية، لصالح إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني عبر حل الدولتين.
أما بالنسبة لاحتمال أن تكون إيران هي البادئة بالصدام، فتجدر الإشارة إلى أن هجوم عام 2019 على منشآت النفط السعودية لم يأت من فراغ، فقد جاء عقب شن إدارة ترامب حربا اقتصادية لا هوادة فيها ضد إيران، بهدف خفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر.
وبهجومها هذا، أرادت إيران إيصال رسالة كانت تحاول إيصالها قبل ذلك بشهور بشكل أقل عنفا، وهي أنه إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها، فلا ينبغي للمنتجين الآخرين أن يطمئنوا إلى تصدير نفطهم.
أما الأمر الذي قد يخبرنا عن نوع الصدام الذي غالبا ستدخل فيه إيران والسعودية إذا انهار التقارب الحالي بينهما، فهي الحادثة التي دفعت البلدين إلى قطع العلاقات في عام 2016.
ففي ذلك العام، أعدمت المملكة رجل دين شيعي بارز كان مناصرا صريحا لمصالح الشيعة السعوديين، الذين يعاملهم النظام السني كمواطنين من الدرجة الثانية. وقوبلت عملية الإعدام بإدانة واسعة النطاق في العالم العربي وأماكن أخرى. واقتحمت حشود السفارة السعودية في طهران ونهبتها، ثم أعلن النظام السعودي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين من المملكة. وظلت العلاقات مقطوعة حتى استعادتها العام الماضي 2023، بوساطة صينية.
هذا الصراع الطائفي بين السنة والشيعة، الذي يشعل فتيله قمع داخلي يمارسه حليف لواشنطن، هو بالتحديد نوع الصراع الذي على الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عنه؛ لأسباب وجيهة.
- البعد النووي في الاتفاق
وبخصوص البعد النووي من الاتفاق، فبإمكان السعودية أن تقدم حجة معقولة مفادها أنها تتطلع لتلبية بعض احتياجاتها من الطاقة؛ إذ تستخدم حاليا النفط أو الغاز لتوليد 99 بالمئة من طاقتها الكهربائية، وتستهلك ربع إنتاجها من النفط في ذلك وفي استخدامات منزلية أخرى.
ومن المتوقع ألا يزيد إنتاج النفط السعودي بشكل يواكب النمو السكاني في البلاد، وبالتالي فمن المنطقي بالنسبة للسعوديين تطوير مصادر جديدة للطاقة؛ ليتمكنوا من تأمين المزيد من النفط والغاز للمبيعات الأجنبية والإيرادات التي تحصلها من تلك المبيعات.
ومع ذلك، فإن مصادر الطاقة البديلة الأكثر منطقية هي مصادر الطاقة المتجددة: طاقة الرياح وبالأخص الطاقة الشمسية. ومع وفرة أشعة الشمس الساطعة والمساحة الفارغة التي يمكن تثبيت الألواح الشمسية عليها، تتمتع السعودية بواحدة من أعلى إمكانات الطاقة الشمسية في العالم.
وتحدث ابن سلمان عن أن نصف طاقة المملكة ستأتي من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، علما بأن الطاقة الشمسية جزء من خططه للتنمية الاقتصادية. لكن المملكة متخلفة كثيرا حتى الآن في تطوير الطاقة المتجددة، مقارنة بدول أخرى تمتلك إمكانات مماثلة.
وعلى هذا، فإن تفكير النظام السعودي في طلب المساعدة الأمريكية في البرنامج النووي يدور جزئيا حول تنويع مصادر الطاقة، ولكن المؤكد أن له بعدا عسكريا أيضا. فابن سلمان نفسه تحدث أكثر من مرة علنا عن أن بلاده ستسعى للحصول على سلاح نووي إذا شعرت بالتهديد.
لكن الديناميكية الأكثر إثارة للقلق في حالة مساعدة الولايات المتحدة للسعودية في التطوير النووي هي احتمالية أن تمتلك السعودية وإيران أسلحة نووية.
فمن خلال التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في عام 2015، أظهرت طهران استعدادها لإغلاق جميع الطرق أمام سلاح نووي محتمل، مقابل تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها. وبالفعل، أوفت طهران بالتزاماتها طوال مدة سريان الاتفاق. ولكن انسحاب إدارة ترامب منه عام 2018 أعفى إيران من تلك الالتزامات، ومنذ ذلك الحين تغيرت الصورة كثيرا.
فبعد هذا الانسحاب، وسعت إيران برنامجها النووي وقلصت “فترة الاختراق النووي” التي تمكنها من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية الصالحة لصنع سلاح نووي خلال أقل من أسبوع.
وفي آخر إشارة له إلى أن المملكة ربما تقرر تطوير سلاح نووي، ذكر ابن سلمان أن حصول إيران على سلاح نووي من شأنه أن يمثل دافعا لبلاده لفعل الشيء نفسه.
ومن جانبها، أطلقت طهران تلميحات مماثلة لا تُحمد عقباها. إذ قال كمال خرازي، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، مؤخرا، إن إيران لم تتخذ قرارا بتطوير سلاح نووي، ولكنها قد تغير عقيدتها إذا اعتقدت أن وجودها مهدد.
وكان “خرازي” يشير على وجه التحديد إلى التهديدات الصادرة عن إسرائيل، لكن تصريحه يوضح أيضا أن إنكار خامنئي السابق -بشأن نية إيران امتلاك أسلحة نووية- لن يشكل عائقا أمام حصولها على مثل هذه الأسلحة.
ولذلك، فإن مساعدة الولايات المتحدة للمملكة في تطوير برنامج نووي تنطوي على خطر أن يؤدي ذلك إلى سباق نووي بين السعودية وإيران، ربما يتعلق بالتوترات بشأن قضايا أخرى. ذلك أن تصور طهران أو الرياض بأن إحداهما تقترب من امتلاك سلاح نووي من شأنه أن يحفز الأخرى على السعي لفعل الأمر نفسه.
هذا المشهد سيكون معضلة أمنية كلاسيكية، مع مسحة نووية. وحيث إن هناك شكوكا تتوجه عادة نحو إيران وأنشطتها النووية، فمن الطبيعي أيضا أن يساور الزعماء الإيرانيين نفس الشك فيما ينوي السعوديون فعله.
ومما يعمق الأزمة هو أن مثل هذا السباق سيترتب عليه العديد من المخاطر الإضافية. أحدهما سيكون تقويض الانفراجة في العلاقات السعودية-الإيرانية، وخلق مناخ أكثر توترا للتعامل مع أي قضية أخرى تتعلق بهاتين الدولتين.
والسبب الآخر هو الخطر المتمثل في شن إسرائيل هجوما عسكريا على إيران؛ ذلك أنها هاجمت بالفعل أكثر من مرة دولة أخرى (العراق)، كي يستمر احتكارها للسلاح النووي في الإقليم. وهددت إسرائيل في غير مرة أنها ستكرر ذلك ضد إيران.
وصحيح أن الحكومة الإسرائيلية تنظر حاليا إلى السعودية باعتبارها حليفا في مواجهة إيران، لكن الكيفية التي ستنظر بها إسرائيل إلى المملكة عندما تكون على عتبة امتلاك سلاح نووي، سوف تمثل حالة أخرى خطيرة من عدم الاستقرار في المنطقة.
وإذا تمكنت السعودية وإيران من الحصول على القنبلة النووية، فإن المخاطر المترتبة على كل نزاع في المنطقة، وكل صراع ينطوي على فرصة للتصعيد، سوف تصبح أعلى بمراحل.
ومن الممكن أن يكون هناك أيضا تأثير الدومينو، فعلى سبيل المثال، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في غير مرة تذمره بشأن ما يعتبره ظلما بسبب عدم امتلاك تركيا لأسلحة نووية.
وحتى لو لم يتحقق أي من هذه السيناريوهات الأكثر خطورة، فإن تقديم الولايات المتحدة المساعدة النووية التي يريدها ابن سلمان سيكون بمثابة ضربة لسياسة منع الانتشار النووي العالمي.
صحيح أن من المفترض أن تكون هناك ضمانات مصاحبة للصفقة السعودية، لكن الضمانات لا يمكنها فعل الكثير.
والجدير بالذكر هنا أن السعودية أعلنت اعتزامها تحديث اتفاق الحد الأدنى الحالي من الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن، كما أنها لم تنضم إلى البروتوكول الإضافي للوكالة، الذي ينص على المزيد من المراقبة والتفتيش الدقيق.
ومن الممكن أن تعيد السعودية برمجة المعرفة التقنية والعديد من القدرات التي تكسبها في برنامج نووي مدني؛ كي تحوله لأغراض عسكرية إذا تخلت عن التزاماتها السابقة.
ومما يثير قلقا خاصا هو إصرار السعودية على امتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها. وإذا وافقت الولايات المتحدة على هذا الطلب، فإنها بذلك تبتعد عن سياستها السابقة لمنع الانتشار النووي. فتقليديا، ترفض الولايات المتحدة مساعدة دول أخرى لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي، وإذا خرقت واشنطن هذه السياسة من أجل السعودية، فسيصعب عليها أن تقول “لا” للآخرين.
إن منح ابن سلمان هذا الجزء من قائمة رغباته، من شأنه أن يشكل تناقضا صارخا مع ما فعلته الولايات المتحدة بإيران عبر الاتفاق النووي.
فالولايات المتحدة لم تساعد إيران على تعزيز قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية، بل قيدت قدرة طهران على ذلك، عبر الاتفاق النووي الذي أبعدها عن تطوير هذا السلاح.
لكن موافقة الولايات المتحدة على طلب ابن سلمان من شأنها أن تجعل السعودية أقرب إلى امتلاك سلاح نووي.
- مآلات الاتفاق على القضية الفلسطينية
ويرتبط بالاتفاق الأمني المزمع عقده بين الولايات المتحدة والسعودية، تطبيع دبلوماسي بين إسرائيل والمملكة، لكنه لن يكون بمثابة اتفاق سلام، تماما كما كان الحال في اتفاقات التطبيع السابقة، إذ أي من تلك الدول لم تكن أصلا في حرب مع إسرائيل.
والسعودية بعيدة تماما عن كونها في حرب مع إسرائيل، بل إن لديها بالفعل تعاونا واسع النطاق معها، بما في ذلك تعاون أمني. ولهذا التعاون تاريخ طويل، يعود إلى قضية مشتركة في الحرب اليمنية في الستينيات.
وفي الآونة الأخيرة، استخدمت السعودية برنامج التجسس الإسرائيلي المعروف باسم “بيغاسوس”، في ترتيب انخرط فيه ابن سلمان شخصيا. كما شاركت السعودية معلومات استخباراتية حول إيران مع إسرائيل، ساعدت في صد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في أبريل/نيسان 2024.
لكن التعاون السعودي-الإسرائيلي لا يصب كله في صالح الولايات المتحدة بالضرورة. ويتضح ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي ينطوي عليها استخدام النظام السعودي لبرنامج “بيغاسوس” لاستهداف المعارضين المحليين.
ونظرا لهذا التعاون القائم أصلا، فمهما كانت المصلحة التي تأمل الولايات المتحدة في الحصول عليها من التعاون السعودي-الإسرائيلي، فإن بإمكانها أن تحصّلها الآن، حتى دون إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل.
لكن أهمية الارتقاء إلى التطبيع الدبلوماسي الكامل تكمن في القيمة الرمزية التي يحملها ذلك بالنسبة لإسرائيل. وبخصوص الولايات المتحدة، سيكون التطبيع بمثابة هدية تتطلع إليها الحكومة الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن إدارة بايدن ترى أن هذه الرغبة الإسرائيلية ورقة للضغط على تل أبيب، فإن فهم عواقب التطبيع يتطلب النظر في أسباب رغبة الحكومة الإسرائيلية في التطبيع مع الرياض.
أحد هذه الأسباب هو استخدام التطبيع كأساس لتعزيز التحالف المناهض لإيران وجعله تحالفا مستداما. وهذا يعزز هدف السياسة الخارجية الإسرائيلية المتمثل في إذكاء أقصى قدر من العداء تجاه إيران وعزلها. وسيحقق لها ذلك عدة أهداف: توجيه اللوم لإيران على أي خطأ يحدث في المنطقة، وصرف الانتباه بعيدا عن تصرفات إسرائيل، وإضعاف منافسها على النفوذ الإقليمي.
لكن تأجيج إسرائيل المستمر للتوتر مع إيران ليس في مصلحة الولايات المتحدة، خاصة عندما يقوض بشكل مباشر الدبلوماسية الأمريكية، كما حدث أثناء التفاوض على الاتفاق النووي.
ذلك أن أي شيء يعزز ويديم التوترات في منطقة الخليج يحمل في طياته خطر التصعيد إلى الحرب. وإذا انجرت الولايات المتحدة إلى تحالف ثلاثي أعمق مع إسرائيل والسعودية، فإن ذلك يخاطر بجرها إلى صراعات قد تخدم أهدافا إسرائيلية أو سعودية، لكنها لن تخدم أهدافا أمريكية.
والهدف الإسرائيلي الآخر من التطبيع مع السعودية هو التمتع بعلاقات طبيعية مع الدول الأخرى في المنطقة، وأن يراها العالم تتمتع بهذه العلاقات على الرغم من استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
إن اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية بعيدة كل البعد عن كونها “اتفاقيات سلام”، بل هي بالنسبة لإسرائيل “اتفاقات عدم سلام” مع الفلسطينيين. ولذلك، ستكون محصلة التطبيع مع السعودية هي تقليص أي حافز إسرائيلي لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، إن كان موجودا أصلا.
إن مفهوم إدارة بايدن المتمثل في الاستفادة من رغبة إسرائيل في التطبيع لحملها على تخفيف هجومها المدمر ضد قطاع غزة أو التحرك نحو حل الدولتين للصراع بشكل عام، هو مفهوم يصطدم بتعنت إسرائيلي شديد في كلا الأمرين.
كما أن استمرار الهجوم، الذي تسبب في معاناة هائلة لسكان قطاع غزة، يعكس بالفعل المشاعر السائدة على نطاق واسع داخل المجتمع الإسرائيلي. فالأمر لا يقتصر على حاجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مواصلة الحرب لتجنب الصعوبات السياسية والقانونية التي يواجهها، بل إن هناك دعما شعبيا لها.
ومؤخرا، تصاعد استخدم نتنياهو وحكومته للهجة شديدة وصريحة لرفض أي حل على أساس الدولتين. وربما تحاول إدارة بايدن حل هذه المعضلة عبر تضمين صياغات غامضة في الاتفاق المزمع تقدمها على أنها مفيدة للفلسطينيين، لكن في الوقت نفسه دون أن تراها إسرائيل عائقا أمام تحقيق أهدافها.
وبالفعل، تستخدم الإدارة الأمريكية منذ فترة مثل هذه الصياغات الغامضة علنا، مثل قول مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، في أوائل شهر مايو/أيار 2024، بأن هدف بلاده هو أخذ “خطوات ذات مغزى نيابة عن الشعب الفلسطيني”.
غير أن هذه تحركات منخفضة السقف. وعلى سبيل المثال، يمكن وصف إجراء مثل الرصيف العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة لجلب المساعدات الإنسانية المنقولة بحرا إلى غزة، بأنه “خطوة ذات معنى نيابة عن الشعب الفلسطيني”، على الرغم من أنه لم يقدم شيئا يذكر لإبطاء الهجوم الإسرائيلي المدمّر.
والمؤكد أن ابن سلمان يهتم بالضمانات الأمنية والمصالح الأخرى التي سيتحصل عليها من الولايات المتحدة أكثر من اهتمامه بسلامة الفلسطينيين، ولذلك ربما يقبل أي صيغة فضفاضة حول الالتزامات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
ومصداق ذلك ما جاء في ملخص المحادثات التي أجراها مع سوليفان، في مايو/أيار 2024، من أن السعودية تريد اتفاقا على “مسار موثوق” نحو حل الدولتين. وهذه لهجة أضعف من تلك التي كانت تستخدمها المملكة في الماضي.
إن إسرائيل، وخاصة نتنياهو، لديهما سجل في قول ما يكفي لامتصاص الضغوط الأمريكية أو الغربية المباشرة التي تطالب بفعل شيء ما بشأن الصراع مع الفلسطينيين، لكن ذلك يكون مؤقتا.
وتجلى هذا في تراجع نتنياهو، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء، عن “اتفاقية واي” لعام 1998 التي دعت إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من الضفة الغربية.
وعلى هذا، فإنه إذا تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل هذا العام 2024، فمن المرجح أن تتعامل إسرائيل بالطريقة ذاتها التي لا تسفر عن أي تقدم حقيقي.
وبذلك، فإن الاتفاق المرتقب لن يغير شيئا، وسيظل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعيد المنال -على الأقل- كما كان دوما.
خاتمة الورقة
بعيدا عن أهداف السياسية الداخلية التي يسعى إليها بايدن عبر إبرام مثل هذا الاتفاق الأمني مع السعودية، فإن الاتفاق لن يقدم سوى فائدة استراتيجية ضئيلة أو معدومة للولايات المتحدة، بل إنه، على العكس من ذلك، ينطوي على مخاطر جسيمة على مصالحها.
إن مثل هذا الاتفاق سيكون له تأثير سلبي واضح على منع الانتشار النووي والوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسيكون فخا لجر الولايات المتحدة إلى صراعات لا مصلحة لها فيها.
ومن عجيب المفارقات هنا أن المنافسة مع الصين هي أحد المسوغات التي يُستشهد بها كأساس منطقي لهذا الاتفاق الجاري التفاوض حوله. لكن إذا أبدت الولايات المتحدة التزاما أعمق تجاه جانب بعينه في صراعات الشرق الأوسط، فإن هذا من شأنه أن يضعف قدرتها على التنافس مع الصين وسيؤجل سياسة “التوجه نحو آسيا” إلى أجل غير مسمى.
وفي المقابل، فإن التنافس بشكل أكثر فعالية مع الصين يتطلب محاكاة ما تفعله بكين في تعاملها مع الشرق الأوسط، وهو عدم تقسيم المنطقة وعسكرتها، بل الانخراط مع الجميع والعمل على خفض التوترات وخفض خطر الحرب بدلا من رفعه.
وبالتأكيد، فإن السعودية دولة إقليمية مهمة يمكن للولايات المتحدة، بل وينبغي لها، أن تتعامل معها على نطاق واسع. ولكن الانخراط البنّاء لا يتطلب منح ذلك النوع من الهدايا الأمنية والنووية التي تجري مناقشتها حاليا.
يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتفاوض مع النظام السعودي حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا مع الأخذ في الاعتبار أن المصالح الأمريكية تختلف بشكل كبير عن المصالح السعودية حول العديد من هذه القضايا، وأن السعودية في نهاية المطاف تعتمد على الولايات المتحدة أكثر من اعتماد الولايات المتحدة عليها.
أما بالنسبة للقضايا المتعلقة بإسرائيل، فإنه إذا أرادت الإدارة الأمريكية حقا ممارسة قدر من النفوذ على إسرائيل، فإن المساعدات الأمريكية الضخمة والغطاء الدبلوماسي الذي تمنحه إياها هما مصدران لنفوذ أمريكي أكبر على إسرائيل، وأكثر مباشرة من مجرد مناورة التفافية تنخرط فيها السعودية.
المصادر
[1] فيصل بن فرحان يعلن اقتراب السعودية وأمريكا من إبرام اتفاق أمني.. وهكذا رد على “تحييد إيران”، سي إن إن، 29 أبريل/نيسان 2024 – الرابط
[2] Frankly Speaking: How close are we to a ‘historic’ US-Saudi deal?, Arab News, June 2, 2024 – Link