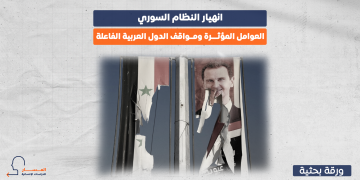المحتويات
مقدمة
المحور الأول: سنتكوم.. عقيدة التأسيس ودور الدول العربية فيها
- مواجهة صدمات النفط
- مواجهة السيطرة السوفيتية
- دور الدول العربية في سنتكوم
المحور الثاني: سنتكوم.. تطورات العقيدة مع نقل الكيان الصهيوني لها
المحور الثالث: سيناريوهات مستقبل سنتكوم من حيث علاقتها باحتمالات تطور الصراع
- سيناريو استقرار نشاط سنتكوم
- سيناريو تراجع المكون العربي في سنتكوم
- سيناريو زيادة نشاط سنتكوم
خاتمة
مقدمة
تمثل القيادة المركزية الأمريكية المعروفة اختصارا باسم “سنتكوم” القوة العسكرية الأبرز في المنطقة، والتي تلعب دورا حيويا في كبح جماح المغامرات الإقليمية لكثير من اللاعبين؛ وعلى رأسهم إيران؛ على نحو ما حدث إبان الضربة الجوية الإيرانية على الكيان الصهيوني، أو تلعب دور المحفز لهذه المغامرات في بعض الأحيان، على نحو ما حدث مع تجاوز الكيان الصهيوني لكثير من معادلات الردع وقواعد الاشتباك في تعاملها مع إيران وأذرعها الإقليمية، أو على نحو ما حدث في اليمن عبر عملية “عاصفة الحزم” التي قادها ما سمي “التحالف العربي في اليمن”، التي قدمت فيها “سنتكوم” للتحالف دعما لوجيستيا واستخباراتيا، وبخاصة بعد تولي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مقاليد الرئاسة الأمريكية، وإلغائه بعض الحظر العسكري الأمريكي على السعودية، الذي فرضه الرئيس الأسبق، باراك أوباما؛ بسبب قصف المدنيين خلال عملية “عاصفة الحزم”.
تثير هذه القوة العسكرية الأمريكية تساؤلات مهمة، وبخاصة بعد الضربة الجوية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني. هذه الأسئلة تتعلق بمستقبل هذه القوة حال استمرار المواجهات بين الطرفين، وتصاعد حدتها، وهو المستقبل الذي يمكن معه الحديث عن عدة سيناريوهات، ترتبط جميعها بتساؤلات بالتبعية عن مستويين من معطيات عالم الأحداث الإقليمية: أولهما عقيدة “سنتكوم”؛ وتطورها عبر الزمن، وثانيهما: رشادة عملية صنع القرار في المنطقة وعلاقته بتوازنات القوة فيها، وعلاقتها النسبية بتطور عقيدة المنطقة قتاليا.
في هذا الصدد، تتناول هذه الورقة عقيدة “سنتكوم” قبل تكونها، وعند تكونها، والفارق بين مسارات هذه العقيدة قبل وبعد انضمام الكيان الصهيوني لها. ويعقب هذا بطبيعة الحال فحص سيناريوهات المستقبل بالنسبة لقوة “سنتكوم” في ضوء هذه المعطيات والمتغيرات.
المحور الأول: سنتكوم.. عقيدة التأسيس ودور الدول العربية فيها
دشنت القوات المسلحة الأمريكية قيادة “سنتكوم” في مطلع يناير/كانون الثاني من عام 1983، في إطار تطوير ما كان يعرف تاريخيا -آنذاك- باسم “قوات التدخل السريع”،[1] ولا يمكن فهم عقيدة التأسيس الخاصة بقيادة “سنتكوم” من دون التعرف على عقيدة “قوة الواجب المشترك للرد السريع”، والمعروفة اختصارا باسم “قوة التدخل السريع”، وظروف نشأتها.
تأسست “قوة التدخل السريع” في مارس/آذار من عام 1980. ويرتبط اسم هذه القوة بالتوجيه الرئاسي الأمريكي الذي أصدره الرئيس الأمريكي الأسبق، جيرالد فورد، والذي حمل رقم ” ب د. 18″، وصدر بعد استقالة الرئيس “نيكسون”[2]، وارتبط تاريخيا بقرار منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، “أوابك”، والذي اتخذ مرتين، أولاهما في 6 يونيو/حزيران 1967، بحظر صادرات النفط إلى إسرائيل والدول الداعمة لها في عدوانها على العالم العربي، الأمر الذي تسبب فيما ذهب في التاريخ باسم “صدمة النفط الأولى”، وثانيهما في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1973.[3]
1. مواجهة صدمات النفط
تعلق التوجيه “ب. د. 18″بصدمة النفط في المقام الأول، وتضمن التأكيد على الاستعداد العسكري الأمريكي للتدخل في دول الخليج، والعمل على بناء قوة عسكرية إضافية؛ لا تؤثر على وضع القوات المسلحة الأمريكية ومهامها آنذاك، وشرعت القوات المسلحة الأمريكية في بناء هذه القوة، والتي أعلن عنها مع تولي الرئيس الأسبق جيمي كارتر، ودشنت في إطار المبدأ الذي حمل اسمه في التاريخ الأمريكي، والذي يقضي بحماية النفط المنتج في المنطقة المحيطة بالخليج العربي من احتمالات السيطرة السوفيتية[4].
وكان الاتحاد السوفيتي قد اجتاح أفغانستان في 24 ديسمبر/كانون الأول 1979، وهو ما مثل غطاء لإعلان “كارتر” عن مبدئه، والذي كان يهدف –بصورة أساسية- لمنع تكرار “صدمة النفط[5]” بشقيها الطاقي والركودي. ما تبدى بصورة أوضح في تصريح وزير الخزانة الأمريكي في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، ريتشارد نيكسون: “إن هؤلاء العرب لا يملكون النفط، هم يجلسون عليه فقط”[6]. وفي هذا الإطار، هددت الولايات المتحدة علنا بغزو منطقة الخليج[7].
في هذا السياق، أعلن “كارتر” مبدأه، والذي قال مع إعلانه: “يجب أن يكون موقفنا واضحا تماما: إن أية محاولة من جانب قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج العربي سوف نعتبره اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم صد مثل هذا الهجوم بأية وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية”. حمل الإعلان رسالة مبطنة لدول المنطقة بأن تكرار قرار حظر النفط أصبح غير مسموح به. ومما يدلل على ارتباط الموقف الإستراتيجي الأمريكي بقضية النفط، أن “مبدأ كارتر” استُخدم لإدارة المشهد الإقليمي بعد غزو العراق للكويت في 2 أغسطس/آب 1990.[8]
لم تكن “عقيدة كارتر” الفصل الأول في مساعي الولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة، ولم تكن الأخيرة. لقد بدأت فصول هذه القصة مع الاجتماع الذي دار بين كل من الرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، والملك عبد العزيز آل سعود، في البحيرة المرة الكبرى بالبحر الأحمر، في 14 فبراير/شباط 1945، والذي انتهى إلى ما يعرف في التاريخ باسم “تفاهم كوينسي”، نسبة للمكان الذي عقد فيه الاجتماع، وهو متن الطراد الأمريكي “يو أس أس كوينسي”.[9]
عُقد هذا الاجتماع في أعقاب عودة الرئيس الأمريكي من “مؤتمر يالطا”، والذي رسمت معه ملامح الإستراتيجية الأمريكية في الحلول محل بريطانيا في مستعمراتها، والسيطرة على منطقة الخليج، ومنابع النفط فيها، وإن لم يذكر موضوع النفط ضمن موضوعات التفاهم.
ويضاف إلى ذلك، مبدأ “نيكسون” نفسه والذي كان يميل لاستعمار الخليج استعمارا جديدا ناعما مرتبطا بالقوة الاقتصادية والتنمية،[10] وهو ما ارتبط بدعم الخليج له فيما يتعلق بمسار “الذهب الأسود”، والذي أنهى العمل بـ”قاعدة الذهب” على الصعيد المالي العالمي.
ومن جهة ثانية، لم تكن “عقيدة كارتر” نهاية المطاف، بل تبعتها فصول أخرى، كان أهمها “مبدأ ريجان”،[11] والذي يعد امتدادا لـ”عقيدة كارتر”، لكنه كان أكثر وضوحا فيما يتعلق بنفط المنطقة، حيث تضمن المبدأ التزام واشنطن بالدفاع عن سلامة نقل نفط الخليج ضد التهديدات من داخل الشرق الأوسط، وهو المبدأ الذي لا يزال عاملا إلى اليوم بوضوح.
2. مواجهة السيطرة السوفيتية
كانت قوة التدخل السريع، قيد الإعداد عندما أقدم الاتحاد السوفيتي الغابر على غزو أفغانستان. والمسافة بين الغزو وإعلان تشكيل القوة لم تكن طويلة، بحيث يمكن القول بأن الغزو كان غطاء فعالا للإعلان عن تشكيل القوة باعتبار الأمر لا يتعلق بالعرب، لكنه يتعلق بـ”الخطر السوفيتي”، وكان -كذلك- مصدرا لإسباغ الشرعية العربية عليه؛ بعدما طلب العرب الحماية من الخطر السوفيتي.
وأدى الغزو السوفيتي لأفغانستان لتواجد قوات سوفيتية على بعدة 300 كيلومتر من المحيط الهندي وعلى مقربة من مضيق هرمز، وهو المضيق المائي الذي يتدفق معظم النفط في العالم من خلاله. وبدا -من وجهة نظر الولايات المتحدة- أن الاتحاد السوفييتي يحاول أن يقوي من سيطرته الإستراتيجية على هذه المنطقة، وعلى هذا فإن تحركه الأخير يشكل تهديدا خطيرا لحركة النفط في الشرق الأوسط.
تأسست قوة التدخل السريع، ووجدت قاعدة برية لها في كل من قاعدة دييجو جارسيا في جزيرة جوام، علاوة على القواعد العسكرية التي تركزت في سلطنة عمان بموجب اتفاق وقعه الطرفان في 4 يونيو/حزيران 1980، منحت بموجبه السلطنة للولايات المتحدة عدة قواعد، أبرزها قاعدة صلالة الجوية، وقاعدة مصيرة البحرية، بالإضافة إلى قاعدتين أخريين،[12] كما وقعت واشنطن اتفاقا مع كينيا لنفس الغرض، بالإضافة للدعم اللوجيستي الذي اتفقت مع كل من مصر والصومال على توفيره.
واجهت قوة التدخل السريع صعوبات، بعضها سياسي؛ يتمثل في غياب كيانات تابعة تبعية واسعة للولايات المتحدة يمكن الاعتماد على مساندتها الحيوية في ترتيبات أوسع للتدخل العسكري في المنطقة، بالإضافة للظروف الطبيعية القاسية، والتي تتطلب ترتيبات وتدريبات أعمق، علاوة على اتساع رقعة العمليات الخاصة في المنطقة، ما أدى لتطوير وضع قوات التدخل السريع باتجاه تحويلها لقيادة تجمع وحدات أوسع برية وجوية وبحرية؛ علاوة على القوات الخاصة المدربة على ظروف المنطقة، وهي القوات التي انحدر منها القائد الحالي لقيادة “سنتكوم”، مايكل كوريلا.[13]
في هذا الإطار وانطلاقا من التحديات السياسية – العسكرية، والطبيعية، واتساع مسرح العمليات، أتى قرار الرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريجان، بتطوير قوات التدخل السريع إلى قوة قيادة عملياتية في الأول من يناير من عام 1983.
جدير أن نلفت إلى أنه قبيل –وبعد- انهيار الاتحاد السوفيتي، تحولت إيران إلى موضوع رئيس لمجال عمل قوات التدخل السريع، ومن بعدها قيادة “سنتكوم”، مع إضافة مسارح عمليات أخرى بحسب الحاجة العملياتية، منها أفغانستان ما بعد طالبان، والعراق ما بعد غزو الكويت وإلى حين سقوط بغداد، حين تحولت العراق إلى مقر عملياتي لا مسرحا للعمليات.
في هذا الإطار، يمكن الربط بجلاء ما بين الثورة الإسلامية الإيرانية وبين بلورة عملية تحول إيران إلى موضوع رئيس لمجال عمل “قوات التدخل السريع”؛ ومن بعده “سنتكوم”. فقد كانت الثورة الإيرانية، والتي أظهرت نتائجها الأولية بوصول آية الله الموسوي الخميني إلى طهران، في 1 فبراير/شباط 1979، مؤشرا على معاودة ميراث رئيس الوزراء، محمد مصدق، مجددا في إيران، ليبدأ ميراث العداء مع استيلاء الطلبة الإيرانيين على مقر السفارة الأمريكية في طهران في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1979، هذه جميعها قد سبقت مباشرة “خطاب حالة الاتحاد”، في 23 يناير/كانون الثاني 1980؛ والذي أعلن فيه “كارتر” عن هذه العقيدة.
3. دور الدول العربية في سنتكوم
تفاوت دور الدول العربية في تقديم الدعم لسنتكوم وسلفها. ففيما يتعلق بقوات الدعم السريع، نجد أن هذه القوات كانت أمريكية خالصة، ولم يكن ثمة ثقة في القدرات العسكرية للدول العربية من وجهة نظر أمريكية؛ ما دفع الولايات المتحدة لحصر الدعم المقدم من الدول العربية في توفير القواعد العسكرية.
وفي هذا الإطار، ترافق مع التأسيس توقيع اتفاقات للتعاون العسكري مع عدد من الدول العربية وغير العربية. فمثلا، الدول العربية نجد ثمة كل من سلطنة عمان التي وقعت معها الولايات المتحدة اتفاقا في 4 يونيو/حزيران 1980، منحت بموجبه السلطنة للولايات المتحدة عدة قواعد، أبرزها قاعدة صلالة الجوية، وقاعدة مصيرة البحرية، بالإضافة إلى قاعدتين أخريين. بالإضافة للدعم اللوجيستي الذي اتفقت مع كل من مصر والصومال على توفيره، حيث التزمت الأولى بموجب اتفاق السلام والملاحق المرتبطة به، والتي منحت الولايات المتحدة نفوذا على القوات المسلحة المصرية. وتعد “قاعدة غرب القاهرة الجوية” أحد أبرز القواعد المجهزة لتقديم الدعم اللوجيستي للطيران العسكري الأمريكي.
وبعد تطور قوات التدخل السريع لتتحول إلى قيادة عسكرية متكاملة، تغير الوضع فيما يتعلق بدور الدعم العسكري العربي. فمن جهة، استمر عامل توفير الدول العربية قواعد عسكرية، وتزايد عدد القواعد، وبخاصة بعد حرب الخليج، حيث بات يتمركز في المنطقة نحو 30 ألفا من الجنود الأمريكيين بشكل دائم في العشرات من القواعد العسكرية المنتشرة في أكثر من 15 دولة من دول المنطقة، إضافة إلى عشرات آلاف أخرى من الجنود تتغير بحسب المناسبات والظروف، مع ترسانة ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة[14].
ومن جهة أخرى، بدأت القوات الأمريكية تعتمد على سلاح المنطقة، وهو ليس بسلاح منتج من داخل المنطقة، بل بات عرفا أن تشتري دول المنطقة سلاحا يكون مملوكا لها اسما؛ لكنه يخص القوات الأمريكية، ويتعلق بأدائها مهامها، وبخاصة فيما يعلن بأنه دفاع عن المملكة، أو لتحقيق التوازن الإستراتيجية في منطقة الخليج[15]. ولا يتعلق الأمر فقط بمبيعات الأسلحة، بل إن بعض الأسلحة التي تستخدمها القوات الأمريكية تكون مستأجرة، إما بصورة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة[16].
وخلال الهجوم الجوي الإيراني على الكيان الصهيوني في 14 أبريل/نيسان 2024، كان لافتا أن تذكر وسائل إعلام أن الأردن قام بتشغيل بطاريات دفاع جوي لأول مرة التصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية،[17] وهو ما يعني أنها ليست ملكا للأردن، وأن استخدامها يكون بإذن أمريكي حصلت عليه الأردن بموجب اتفاق التعاون الدفاعي الموقع بينها وبين الولايات المتحدة.
ومن جهة ثالثة، عملت الولايات المتحدة على تجهيز بعض وحدات القوات المسلحة في عدد من الدول العربية للقيام بمهام محددة، منها وحدات بحرية، ووحدات قوات خاصة، وهو ما ترتبه الولايات المتحدة من خلال المناورات والتدريبات المشتركة الدورية مع عدد من دول المنطقة.
المحور الثاني: سنتكوم.. تطورات العقيدة مع نقل الكيان الصهيوني لها
اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قرارا بنقل تبعية الكيان الصهيوني إلى نطاق عمليات “سنتكوم” في الأول من يناير/كانون الثاني من عام 2021، ودخل القرار حيز النفاذ تحت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 15 سبتمبر/أيلول 2021. كان الكيان الصهيوني قبل ذلك يتبع نطاق عمليات القيادة المركزية لأوروبا “يوكوم”[18].
ويبلغ نطاق عمل قيادة “سنتكوم” مساحة واسعة من منطقة قلب العالم، وهي المنطقة التي سميت باسمها هذه القيادة، فهي قيادة مركزية نسبة لمنطقة مركز العالم، وهو المصطلح الذي صكه عالم الجغرافيا السياسية وأبو الجغرافية الإستراتيجية “هالفورد ماكندر”، ضمن نظريته عن الإمبراطورية البحرية.[19] ويتسع نطاق عمل هذه القيادة ليشمل مساحة جغرافية واسعة تبدأ -اليوم- من مصر في غرب منطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى وأجزاء من جنوب آسيا. وتعد مصر الدولة الأفريقية الوحيدة في هذه القيادة، بعد تأسيس القيادة الأمريكية لأفريقيا “أفريكوم” في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2007.[20]
ويمكن ربط نقل الكيان الصهيوني إلى هذه القيادة العسكرية الأمريكية بالنظر للخبرة التاريخية للرئيس الذي قام بعملية النقل هذه. فالرئيس ترامب، هو الذي منح الكيان الصهيوني بعضا من أفضل العطايا الجيوسياسية التي تلقاها الكيان على مر تاريخه، فهو الذي اتخذ القرار التنفيذي بنقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني إلى مدينة القدس، وهو الذي منح الكيان الصهيوني كذلك اعترافا أمريكيا بضم هضبة الجولان التي كان الكيان قد احتلها في عام 1967، لكن الأهم أنه قاد الموجة الثالثة للتطبيع، والتي تخللها توقيع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان اتفاقات للتطبيع مع الكيان الصهيوني.[21]
شهدت فترة رئاسة “ترامب” أعلى درجات التوتر بين إيران من جهة، ودول الخليج من جهة ثانية، وبخاصة مع إقدام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على خوض معركة “عاصفة الحزم”، والتي أدت لأقسى مواجهات بين السعودية وإيران منذ الثورة الإسلامية في مارس/آذار 1979، بلغت حد وقوع العاصمة السعودية، الرياض، تحت نيران قصف الصواريخ والطائرات المسيرة، خلال الفترة ما بين 2017[22] وحتى 2022[23]. ولم تنج العاصمة الإماراتية من هجمات عدة للحوثيين، تنفيها الإمارات، لكن وسائل الإعلام العالمية أشارت إليها، سواء منها هجمات 2017 أو حتى هجمات 2022، والتي أدت إلى مقتل 3 إماراتيين[24].
لم يكن تهديد النفط وحده التهديد ذي المصدر الإيراني خلال العقدين الأخيرين، بل استدعى التمدد الإيراني غطاء دعائيا يرتبط بالصراع مع الكيان الصهيوني، ما أدى إلى تصاعدت المواجهات في منطقة الشام. وبالنظر لنجاح الجبهة اللبنانية في الضغط على حزب الله لتحجيم المواجهات مع الكيان الصهيوني، اقتصرت أغلب المواجهات في الشام على صراع الفصائل الفلسطينية مع الكيان الصهيوني، ما أدى لنشوب عمليات مثل: “الوهم المتبدد” التي انتهت بأسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط في 2005، و”معركة الفرقان” في 2008، و”حجارة السجيل” في 2012، و”العصف المأكول” في 2014، ومواجهات 2018، ومواجهات الشيخ جراح عام 2021، ومواجهات الجهاد الإسلامي في 2022 وتكللت هذه العمليات بحرب “طوفان الأقصى”، التي اندلعت عملياتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.
كانت أصداء العون الذي تسديه إيران إلى فصائل المقاومة الفلسطينية يتردد طيلة هذه العمليات[25]، ما جعل إيران لا تهدد فقط معين النفط الخليجي، بل تهدد أيضا الركيزة الثاني من خصائص اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة، وهي الركيزة المتعلقة بأمن الكيان الصهيوني. أدى هذا التهديد الإيراني المزدوج من وجهة نظر أمريكية إلى بناء تصورين:
= التصور الأول تصور عملياتي محض، يقوم على وجود عدو مشترك يهدد كل من الكيان الصهيوني وأمن الخليج، وهو التصور الذي أدى إلى نتيجتين أساسيتين قادت أولاهما إلى الثانية أو مهدت لها. النتيجة الأولى أدت إلى توقيع سلسلة اتفاقات تطبيع بين قطاع من الدول الخليجية موضوع التهديد، وهي الموجة الثالثة من التطبيع، وشاركت فيها عن دول الخليج كل من الإمارات والبحرين بالفعل، فيما اتجهت المملكة العربية السعودية لبدء خطوات تطبيعية بالفعل، مع ترقب الفرصة لتوقيع ما يسمى “اتفاق سلام”، توفرت شروطه الجيوسياسية والقانونية عبر شراء جزيرتي تيران وصنافير، ما يوفر أساسا قانونيا يرتب ضرورة توقيع اتفاق بين السعودية والكيان الصهيوني نتيجة اختلاف الدولة صاحبة السيادة على الجزيرتين عن الدولة التي وقعت معاهدة السلام التي تنظم علاقة كل من مصر والكيان الصهيوني بهاتين الجزيرتين اللتين تمثلان مدخل الكيان الصهيوني للبحر الأحمر[26]. كما توفرت غالبية الشروط السياسية للاتفاق؛ باستثناء اتفاق تفصيلي للتعاون الدفاعي الأمريكي – السعودي، وهو ما تأجل مؤقتا بسبب عملية “طوفان الأقصى”.
= التصور الثاني تصور ثقافي – إستراتيجي. ويقوم هذا التصور على أن الموجة الثالثة من التطبيع لم تكن اتفاقات سلام بارد كما هو الحال مع موجة التطبيع الأولى التي قادتها مصر، ثم الموجة الثانية التي ارتبطت بتداعيات تفاهمات مدريد 1990، والتي انتهت بتوقيع “اتفاقية وادي عربة” مع الأردن، ثم سلسلة أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية. لقد تميزت الموجة الثالثة من التطبيع بتوفير أساس فلسفي ديني تبلور في مفهوم “الاجتماع الإبراهيمي”،[27] وهو تصور يقوم على وحدة تجمع الديانات السماوية، وبخاصة الإسلام واليهودية عبر رعاية مسيحية (بروتستانتية)، ما يوفر أساسا دينيا لمعاهدات السلام التي لم تقتصر نتائجها على دول المرحلة الثالثة للتطبيع، بل امتدت لتشمل الأردن كذلك، وذلك عبر ضغوط خليجية – أمريكية مشتركة؛ استغلت الضعف الاقتصادي للأردن.
هذه التغيرات تكشف أن “سنتكوم” أصبحت إطارا عسكريا يجمع حلفاء بينهم روابط دينية، نابعة من أيديولوجيا، قديمة حديثة، قديمة قدم فكرة مجمع الأديان؛ القديمة القائمة على الفكرة التي طرحتها “جماعة الإخاء الديني” في نهاية السبعينات، والتي ارتبطت ماديا بفكرة البناء التاريخية لمجمع الأديان في “وادي الراحة” في سيناء؛ والتي رفضها علماء الدين الإسلامي قديما[28]، والتي تزامن طرحها مع فكرة تأسيس “قوات التدخل السريع: نفيها في عام 1980، وانتهاء بـ”الاتفاقات الإبراهيمية”، والاحتفاء الإعلامي بها في مصر عبر صدور قرار تطوير أثري في منطقة “مصر القديمة”، وتداول أخباره تحت تسمية “مجمع الأديان”[29]. في هذا الإطار، لم تعد قيادة “سنتكوم” تجمع عسكري تقود فيه دول غير إسلامية دولا تدين شعوبها بالإسلام، بل صارت تجمعا دينيا مصلحيا أمنيا.
أدى هذا التصور لتحييد الدين عن ربط دول الخليج بإيران، حيث بات الطرفان الخليجي والصهيوني مرتبطين دينيا كذلك، ليزيد على ذلك ارتباطهم استراتيجيا عبر التهديد الأمني الإيراني، ما دعم بناء “محور جيوسياسي خليجي – صهيوني”،[30] وهو المحور الذي بدأت لبناته مع “اتفاق التعاون الأمني” الذي وقعته البحرين مع الكيان الصهيوني في 4 فبراير/شباط 2022، أثناء زيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني، بيني غانتس، للبحرين في مطلع ذاك الشهر[31]. تضمن الاتفاق تخصيص البحرين ميناء بحريا بهدف استخدامه كقاعدة عمل لسلاح البحرية الإسرائيلية في مواجهة إيران، وذلك بشراكة أمريكية.
وتزامن مع ذلك التوقيع حدثان، أولهما تصريح رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك، نفتالي بينيت، بأن “حملة إضعاف إيران قد بدأت، وستشمل مجالات متعددة، منها مجالات نووية واقتصادية وسيبرانية وعمليات علنية وسرية ستقوم بها “إسرائيل” وحدها أو بالتعاون مع جهات أخرى”[32]، ومن جهة أخرى، فإن الولايات المتحدة كانت قد أجرت تدريبا واسع النطاق في جنوب البحر الأحمر، بمشاركة الأسطول المصري الجنوبي، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بهدف تعزيز الأمن الملاحي في البحر الأحمر، ما يعني أن الغرض الأساسي منه كان التدريب على احتواء جماعة الحوثيين في اليمن[33].
كان قد تبع توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية توقيع اتفاق للتعاون الدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة في منتصف مارس/آذار 2021[34]، لتكتمل الحلقة الإقليمية لحماية الكيان الصهيوني من أي هجوم إيراني محتمل، وهو ما كشف عن أهميته عقب الهجوم الإيراني الجوي على الكيان الصهيوني في منتصف أبريل/نيسان 2024.
في هذا الإطار، يرى فريق من المراقبين أن هذا المحور يحضر واقعيا برعاية سعودية[35]، فيما يرى مراقبون آخرون أن السعودية تسعى حتى الوقت الراهن لبناء سياسة خارجية متوازنة تقوم على بناء جسور تعاون مع الطرفين الإسرائيلي والإيراني؛ وإن كانت تحمل مخاوف جيوسياسية من الجانب الإيراني[36]، وثمة فريق ثالث يرى أن المملكة تميل استراتيجيا للجانب الصهيوني، ما تدعمه العلاقات السرية الوثيقة بين الجانبين[37]، والاتفاق الدفاعي المرتقب بين المملكة والولايات المتحدة[38].
المحور الثالث: سيناريوهات مستقبل سنتكوم من حيث علاقتها باحتمالات تطور الصراع
هل لأطروحة البعد الثقافي لتطوير “سنتكوم” من تداعيات على الصعيد العملياتي لهذا التجمع العسكري؟ وهل أثر هذا التجمع بثقافته على مسرح الأحداث خلال الاستجابة للهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني؟ للإجابة على هذه التساؤلات المرتبطة بسيناريوهات مستقبل “سنتكوم” نقدم بعض المعطيات:
= لم تكن الهجمة المركبة التي شنها سلاح الجو الإيراني على الكيان الصهيوني في 14 أبريل/نيسان 2024 هجمة ذات طبيعة إستراتيجية، بل كانت هجمة تكتيكية ذات هدف استراتيجي يتمثل في إعادة تفعيل معادلة الردع بينها وبين الكيان الصهيوني، ما اتضح من تصريح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن بلاده قد أبلغت الولايات المتحدة أنها ستضرب الكيان الصهيوني قبل الضربة بنحو 48 ساعة[39].
لكن الأهم من الإعلان الإيراني بالتبليغ، أن محللين عسكريين أمريكيين كشفوا أن السلاح الذي استخدم في الهجوم كان من أقل الأسلحة الإيرانية كفاءة، حيث صرح الخبير الأمريكي صموئيل بنديت، عضو برنامج الدراسات الروسية في “Center for Naval Analyses” في فرجينيا، أن الطائرة المسيرة “شاهد بطيئة وتحلق على ارتفاع منخفض. وكانت إيران تعلم أنها ستُسقط، وأنها طريقة رخيصة لإعلام خصمك بأن الدفاع ضد شاهد سيكون مرهقا ومكلفا”[40]. وكان الإعلان عن الإنذار بالضربة من أهم الخطوات الإيرانية، التي نقلت عبء الإخراج المسرحي لتداعيات الضربة إلى المحور الصهيوأمريكي، وجردت أي احتمال للرد، أو حتى للاستغلال الدعائي من جدواه، لكن الوصول حمل رسالة لن يكشف فاعليتها إلا بعد اختبار معادلة الردع الجديدة خلال الفترة المقبلة[41].
= ومن جهة ثانية، كان من اللافت أن التنبيه الابتدائي تبعه تحضير، تولته “سنتكوم” نفسها، بمساعدة بريطانية – فرنسية، واتخذت هذه المساعدة مسرحا لها في قطرين عربيين، أحدهما الأردن؛ والذي يربطه بالولايات المتحدة اتفاق للتعاون الدفاعي وقعه الطرفان في منتصف مارس/آذار 2021[42]. في هذا الصدد، كتبت صحيفة “هاآرتس” العبرية عن دور الأردن بشكل خاص في مواجهة القصف الجوي الإيراني، ذاكرة أن القوات المسلحة الأردنية قد “قامت بتشغيل دفاعاتها الجوية لأول مرة؛ ولعبت دورا نشطا في اعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية، فضلا عن تفعيل الإذن الممنوح للولايات المتحدة للعمل من المجال الجوي الأردني”[43]، وأدى هذا الانخراط إلى سقوط شظايا صواريخ إيرانية فوق شوارع المملكة، في مدينتي عمان العاصمة والطفيلة[44].
= القطر الثاني الذي انخرط في المواجهة بطريقة إيجابية، لكنها غير مباشرة؛ كان العراق، والذي يتعاظم فيه النفوذ الإيراني، فيما لا يرتبط بعلاقات تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة، إذ كان آخر اتفاق قد وقع بين الطرفين يعد اتفاقا أمنيا في 2008، تضمن توافقا بين الطرفين على انسحاب القوات الأمريكية من العراق في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول 2011[45].
وعلى هذا، فإن الدولة الثانية التي شاركت في إحباط الهجوم الإيراني لا تربطها اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة. ما يعني كذلك أن “سنتكوم” تتواجد في العراق مستغلة حالة السيولة الأمنية التي سببها الوجودين الداعشي[46] والإيراني[47] في هذا البلد، حيث عوقت حالة السيولة الأمنية التي أنتجها هذان العاملان وصول “اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية” لقرار بسحب كامل القوات الأمريكية خارج العراق، رغم الاتفاق على إطار زمني لهذا الغرض؛ ما بيناه عاليه.
وكما حدث في الأردن، ونتيجة للمشاركة في القصف، سقطت شظايا صاروخية إيرانية كذلك على شوارع إقليم أربيل في كردستان العراق[48]. وفي التعليق على الضربة، اكتفى مكتب رئيس الوزراء العراقي بالتأكيد على أنه “لم تطلق صواريخ من أراض عراقية خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل”[49]. وهو إن أشار فإنما يشير لاعتراض عراقي على استخدام أراضيه لصد الهجمات، ما استدعى توجيه اتهام لبلاده لإسكاته؛ بسكوتها عن إطلاق صواريخ من أراضيها تجاه الكيان الصهيوني؛ ليقف الأمر مع العراق عند حد نفي هذا الاتهام، أو لمنح العراق ذريعة يحفظ بها ماء وجهه أمام إيران؛ لتبرر سكوتها عن استخدام أراضيها لإدارة الهجمة الإيرانية؛ حيث يمكن بأن تعتذر لإيران بأنها كانت محل اتهام بدعم إيران.
وفي أعقاب الضربة، بدأت دول الخليج في سعي محموم لمنع اتساع رقعة الصراع[50]. معلوم أن ثمة خشية لدى دول الخليج من تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة، وبخاصة من بوابة الصراع الإيراني مع الكيان الصهيوني، لأن الأضرار الجانبية ستكون أشد جسامة من الأضرار المباشرة، كما أن هذه الأضرار الجانبية ستكون من نصيب دول الخليج وحدها، ربما باستثناء سلطنة عمان، ما دفع الدول الخليجية من قبل لاحتواء الرغبة المحمومة لدى رئيس وزراء الكيان الصهيوني، “بنيامين نتنياهو”، في دفع المنطقة نحو مواجهة مع إيران، وذلك خلال فترة وجود الرئيس الأمريكي السابق “ترامب” في البيت الأبيض[51]، وفي هذا الإطار، أكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة “كينجز كوليدج” بلندن، أندرياس كريج، أن دول الخليج تتشارك “إدراكا عاما بأن الصراع مضر للأعمال (Business)، وأن تجنب النزاع أصبح الآن أمرا ضروريا مهما كلّف الثمن”.[52]
ويقود هذا المشهد الإقليمي لوضع عدة تصورات لمستقبل قوة “سنتكوم” في ضوء احتمالات تزايد حدة المواجهة مستقبلا في حال قام الكيان الصهيوني بالرد على الضربة الإيرانية. هذه السيناريوهات تتمثل فيما يلي:
1. سيناريو استقرار نشاط سنتكوم
في تصور الباحث، فإن هذا السيناريو يعد السيناريو الراجح. ويعني هذا السيناريو استمرار المشهد الراهن، مشهد الحفاظ على حضور فعال لقيادة “سنتكوم” في المنطقة. هذا السيناريو لن يكون ممكنا إلا في حال تهدئة مخاوف الخليجيين. وتتضمن تهدئة مخاوف الخليجيين كبح احتمالات تصاعد الصراع في المنطقة أكثر من تعهدات الولايات المتحدة بالدفاع عن أمن هذه الدول، وصياغة مواقف تحفظ ماء وجه الأنظمة المنخرطة في علاقات تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة، وتكسب هذه الأنظمة “شرعية شراء السلام والردع بالمال”، فهذه الصيغة أضحت أحد مصادر شرعية دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، التي تسعى للموازنة بين التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة كمصدر لمعادلة ردع إقليمية، وبين احتواء التصعيد؛ بحيث تمثل – أي السعودية – أحد صمامات الأمان لإيران، ما يحافظ على كفاءة هذه المعادلة.
في هذا الإطار، فإن زيادة قوة “سنتكوم” ستعني إضافة مزيد من التوتر إلى المنطقة، ما من شأنه أن يؤدي إلى “أكرنة” منطقة الخليج. مصطلح “الأكرنة” مصكوك على غرار مصطلحات البلقنة واللبننة، وما على شاكلتها من المصطلحات، ويستقي المصطلح أصوله مما قادت إليه المخاوف الروسية من تمدد حلف شمال الأطلسي “الناتو” واقترابه من حدودها؛ ما قادت إليه هذا المخاوف من ضربة استباقية روسية لإنتاج صدمة لأوروبا؛ تفضي إلى توفير مخاوف حقيقية مستقبلا من احتمالات الصدام المرتبطة بتوسع الحلف شرقا.
كذا الحال في منطقة الخليج، قد يؤدي تزايد شعور إيران بالتهديد جراء تنامي حضور “سنتكوم” في المنطقة إلى مساع لبناء تحالف دولي، والمغامرة بشن ضربة استباقية غير تكتيكية لأي من دول المنطقة، أو لتوجيه ضربة إستراتيجية لأي من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما قد يهدد بنذر حرب إقليمية قابلة للاتساع حال توفر شروط اتساعها.
وبعيدا عن دول الخليج، فإن التزام إيران بسقف تكتيكي لضبط معادلتها الخاصة بالردع والتوازن مع الكيان الصهيوني تمثل أحد مصادر استمرار الوضع بالنسبة لقيادة “سنتكوم”، حيث إن كلا السيناريوهين الأقصى (تمدد سنتكوم) أو الأدنى (تراجع سنتكوم) غير واردين على نحو ما سنرى في الحيثيات الراهنة.
2. سيناريو تراجع المكون العربي في سنتكوم
يمكن اعتبار هذا السيناريو من السيناريوهات الضعيفة، لأن “سنتكوم” من القيادات الإقليمية التي تعول عليها الولايات المتحدة لاحتواء الصين وروسيا،[53] ومن ثم فإن تراجعها الكمي غير وارد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن تقلص “سنتكوم” غير وارد إقليميا (خليجيا) لارتباطه بعدم توفر إرادة إيرانية في الرجوع خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بمشروعها الإقليمي من جهة، أو قدرتها النووية من جهة أخرى، ما يعني أنها ستكون دوما مصدرا للتهديد الإقليمي، غير أن شروط هذا التهديد قد تختلف ما بين تهديد الجانب العربي أو جانب الكيان الصهيوني.
في هذا الإطار، فإن الصيغة المطروحة في هذا المحور، والمتعلقة بتقلص “سنتكوم” تتعلق بتقلص حضور الدول العربية في هذه القوة، أو تقلص قابلية الدول الخليجية للتعاطي مع هذه القوة. وبشكل عام، ترتبط قابليات التعاطي العربي – الخليجي إيجابيا مع هذه القوة طالما ظلت إيران لا إسرائيل مصدرا للتهديد.
ويرجع هذا الاقتصار لكون الطرف المساند للمنطقة الخليجية طرف أمريكي، وهو طرف تجمعه بالكيان الصهيوني اعتبارات عدة، أهمها أبوكاليبتيك “apocalyptic” (يتعلق بنهاية العالم)،[54] وهو اعتبار لا يمكن إهماله، أو سيكون من الخطأ إهماله، فضلا عن الاعتبارات المصلحية الأخرى، وأهمها المعروض العالمي من الطاقة، ما يجعل الحضور الأمريكي مرهون باستمرار حقبة النفط / الغاز، ويجعل حضور “سنتكوم” مستقرا.
3. سيناريو زيادة نشاط سنتكوم
ربما نكون قد عرضنا لهذا السيناريو عند تعرضنا للسيناريو الأول، وموجز هذا السيناريو ببساطة أنه رهن بأمرين، أولهما، التيقن من غياب قابليات “أكرنة” منطقة الخليج، وثانيهما استمرار الرشادة في تعاطي صانع القرار الإيراني مع مستويات الضغوط الإقليمية خاصة والعالمية / الغربية عامة. ومن أبرز أمارات الرشادة نوعية الرد التكتيكي الذي استجابته به إيران للاستفزازات التي وجهها الكيان الصهيوني. فهذه النوعية من الاستجابات هي التي حمت إيران والمنطقة من تصاعد حدة الصراع لدرجة قد تؤذن بنهاية ركام القوة الإيرانية من جهة، وتهاوي البنية التحتية الخليجية من ناحية أخرى، وكلاهما أمر تخشاه منطقة الخليج بشكل عام، بما فيها إيران، وهو ما يفسر الحراك الدبلوماسي المحموم الذي تقوم به دول الخليج لاحتواء رد الكيان الصهيوني على الضربة الإيرانية.
ومع تزايد الضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني على الولايات المتحدة لمزيد انخراط عسكري في الأزمة المتعلقة بحرب السابع من أكتوبر/تشرين أول، أو أزمة الانخراط الإيراني في المواجهة،[55] يمكن القول بأن ذلك متعذر لعدة عوامل، نوجزها فيما يلي:
= السوابق التاريخية تفيد بأن الرؤية الإستراتيجية تضعها الولايات المتحدة وتلزم بها الكيان الصهيوني. ومن أبرز السوابق على هذا الخضوع الإستراتيجي سابقة حرب الخليج الثانية، والتي شهدت إقدام العراق على قصف الكيان الصهيوني بالصواريخ، وألزمت الولايات المتحدة الكيان الصهيوني بالصمت حيال الأمر، وانصاع الكيان لهذا التوجيه الإستراتيجي.
= رغم البعد المتعلق بنهاية العالم، والذي يعد أحد الأبعاد الحاكمة للنهج البروتستانتي في التعاطي مع الكيان الصهيوني، إلا أن الضوابط العلمانية المرتبطة بنفوذ الولايات المتحدة على النخب الموالية لها، وعلى التغطية الإعلامية العالمية لحضور الولايات المتحدة في المنطقة، والتداعيات الشعبية المرتبطة باحتمال تصاعد الرفض الجماهيري العربي والإسلامي للموقف الأمريكي، كل هذه الاعتبارات تمثل ضوابط بالغة الأهمية، تدفع لتعامل حذر مع توظيف مثل هذا العامل؛ لئلا يعود بنتائج عكسية على الحضور الأمريكي.
= ومن جهة ثالثة، فإن إدارة بايدن اتخذت من الإجراءات ما تظن أنه كاف لتحقيق نتائج ترضي الكيان الصهيوني في قطاع غزة، على الأقل ديموغرافيًا؛ حيث تتجه الولايات المتحدة لتزويد الكيان الصهيوني بنحو 1800 قنبلة تزن كل منها نحو 900 كيلوجراما، و500 قنبلة أخرى تزن 100 كلج[56]، وهو ما يمكن إدراك تبعاته الديموغرافية، وهو ما يعني تباعا – من وجهة نظر أمريكية – ضرورة احترام قادة الكيان الصهيوني لمصالح النخبة الديمقراطية الأمريكية الحاكمة في البقاء في البيت الأبيض، وفي احتواء الدعاية التي تواجهها هذه النخبة بسبب مساندتها للكيان الصهيوني في حربه الجائرة ضد الشعب الفلسطيني.
ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن ضربة إيران المحسوبة، والتي أخبرت إدارة بايدن بها قبل 48 ساعة، ساهمت في احتواء الصراع، وصبت في مصلحة إدارة بايدن، لأن خروج هذه المواجهة عن السيطرة سيؤدي لإخراج الديمقراطيين من البيت الأبيض، وإعادة “ترامب” إلى المكتب البيضاوي[57].
لكن من ناحية أخرى، فقد يزيد نشاط “سنتكوم” في المنطقة خلال الفترة المقبلة، غير أن الهدف ربما لا يكون بالضرورة استهداف إيران، بل ردعها للحفاظ على الوضع الراهن. فالولايات المتحدة غير معنية في الوقت الراهن بتصعيد عسكري مع إيران، في الوقت الذي تحاول فيه احتواء صعود الصين والتصدي للغزو الروسي لأوكرانيا.
وهذا ما نصت عليه “استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2022“، التي انتقدت تركيز السياسة الخارجية الأمريكية بشكل رئيسي، على مدى العقدين الماضيين، على التهديدات الصادرة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث لجأت في كثير من الأحيان إلى سياسات ترتكز على القوة العسكرية، وتستند إلى ثقة غير واقعية في استخدامها، وتغيير النُظُم (السياسية). وأكدت الاستراتيجية أن الولايات المتحدة أخفقت في تقدير الفرص البديلة في ساحة عالمية تتضارب فيها الأولويات، كما فشلت في تقدير الآثار الجانبية لسياساتها.
ولذلك قالت الإدارة الأمريكية في استراتيجيتها: “نحن لن نستخدم جيشنا لتغيير الأنظمة أو إعادة تشكيل المجتمعات، ولكن بدلا من ذلك سنقصر استخدام القوة على الظروف التي تكون فيها ضرورية لحماية مصالح أمننا القومي، وبما يتفق مع القانون الدولي، مع تمكين شركائنا من الدفاع عن أرضهم ضد التهديدات الخارجية والإرهابية”. وعلى هذا، فإن زيادة نشاط “سنتكوم” ربما يأتي لردع إيران، دون مهاجمتها كما ترغب حكومة نتنياهو.
خاتمة
الراجح أن “سنتكوم” تأسست، هي وسالفتها – قوة التدخل السريع – لمنع حدوث صدمة نفط عالمية أخرى، بما لها من أبعاد تتعلق بالطاقة، وأخرى تتعلق بالاقتصاد المعتمد على منتجات النفط. تزامن مع فترة التأسيس حدثان مثلا موعين إضافيين لهذه القوة، أخطرهما تمثل في تمدد الاتحاد السوفيتي الغابر باتجاه منطقة الخليج، خزان النفط الأكبر في العالم، وثانيتهما الثورة الإسلامية في إيران، وما ارتبط بها من عنف في مواجهة الولايات المتحدة، ثم العنف في مواجهة الكيان الصهيوني، ثم بداية تموضع “المشروع الصفوي” كمحرك مهيمن على السياسة الإقليمية الإيرانية.
استمر الأمر إلى قبيل إدماج الرئيس الأمريكي الأسبق “ترامب” للكيان الصهيوني ضمن فعاليات هذه القوة العسكرية الأمريكية، حيث بدأت هذه المرحلة تشهد زخما يحاول جاهدا بعث مشروع فكري نشط في أعقاب الثورة الإسلامية، وبزوغ مشروع “التقريب بين المذاهب الإسلامية”، لينشط في مقابله مشروع يتعلق بما ذهب تاريخيا في مصر باسم “جماعة الإخاء الديني”. يرتبط بهذا المشروع الأخير توفير أساس أيديولوجي؛ يحمل قراءة في الأديان المختلفة، على خلفية العيش المشترك، في مغالطة فكرية تقوم على افتراض تسوية ما بين الديانة اليهودية والحركة الصهيونية. لكن الراجح من الاحتفاء الخليجي؛ وخاصة الإماراتي، والتهليل الإعلامي المصري، أن هذا إعادة إنتاج هذا البعد الثقافي من شأنه توفير قراءة دينية أو صوفية لحالة التحالف العسكري الأمريكي – الصهيوني – الخليجي، وهو ما كاد أن يوفر غطاء لإقدام دول عربية على المشاركة في التصدي للضربة الجوية الإيرانية؛ لولا أن المشروع الثقافي لم يكتمل، ما حدا بالأردن لتبرير مسلكها بحماية التراب الوطني الأردني، في سابقة تمثل كشفا عن محور عملياتي ميداني مركزه الكيان الصهيوني، وأطرافه مجموعة النظم السياسية المحافظة في الإقليم، مضافا إليها مصر بطبيعة الحال.
الضربة الإيرانية دفعت للتساؤل عن مستقبل “سنتكوم” وسيناريوهاته، ليؤول التقييم إلى 3 سيناريوهات، يحكمها عوامل تتعلق بالتخوفات مما أسماه الباحث “أكرنة المنطقة”، علاوة على مستوى الرشادة لدى صانع القرار الإيراني. في هذا الإطار يبدو السيناريو الراجح أن يتوقف حجم حضور “سنتكوم” عند هذا الحد، مستندا لعدم توفر إرادة إيرانية بتحجيم المشروع القومي، علاوة على الدواعي الجيوسياسية التي تدفع الولايات المتحدة للاحتفاظ بهذه القوة للمساهمة في احتواء قوى العالم القديم من الجهة الغربية، كما تقوم قوة مماثلة بممارسة هذا الاحتواء من الجهة الشرقية (القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادي). هذا الاعتبار الأخير يقلص فرص سيناريو تقلص حضور “سنتكوم” كقوة ميدانية إقليمية تتولى تحقيق أهداف قوة عظمى كالولايات المتحدة. كما يقلل من فرص تمدد “سنتكوم” في منطقة الخليج مخاوف دول المنطقة من “الأكرنة”، وهي مخاوف مشروعة بالنظر لكون هذه الدول أحد مسارات تمويل “سنتكوم”، علاوة على أن بأيدي هذه الدول استدعاء القوة الصينية المتنامية، والتي ما زالت تتنامى؛ رغم سيل الدعاية الغربية عن تراجعها، وتهافت مستوى التقنية فيها.
المصادر
[1] Jim Garamone, A Short History of U.S. Central Command, United States Department of Defense, March 28, 2019
[2] صفاء عبد الوهاب المبارك عكاب يوسف الركابي، قوة التدخل السريع الأمريكية في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي 1979 – 1988.. دراسة في تشكيلها وأهدافها وتطورها، مجلة كلية التربية بجامعة البصرة، ع: 6، ص ص : 135 – 136.
[3] Samantha Gross, The 1967 War and the “oil weapon”, Brookings Institution, June 5, 2017
[4] هاني حبيب، النفط إستراتيجيا وأمنيا وعسكريا وتنمويا، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 2006، ص 113-114
[5] صفاء عبد الوهاب المبارك عكاب يوسف الركابي،مرجع سابق، ص 137.
[6] إميل أمين، أمريكا.. هل هي وراء تهديد امن الخليج أم استقراره، موقع “صحيفة آراء“، 1 يناير 2006.
[7] صفاء عبد الوهاب المبارك عكاب يوسف الركابي، مرجع سابق، ص 136.
[8] Gabriel Collins, Jim Krane, Carter Doctrine 3.0: Evolving U.S. Military Guarantees for Gulf Oil Security, Baker Institute, April 27, 2017
[9] Bruce Riedel, 75 years after a historic meeting on the USS Quincy, US-Saudi relations are in need of a true re-think, Brookings Institution, February 10, 2020
[10] Mohd Naseem Khan, The US Policy Towards the Persian Gulf: Continuity and Change, Strategic Analysis: IDSA, May 2001
[11] Jonathan Marshall, Saudi Arabia and the Reagan Doctrine, Middle East Research and Information Project, November/December 1988
[12] Gawdat Bahgat, Security in the Gulf: The View from Oman, SAGE Publications, December 1999
[13] Biography of Commander, General Michael E. Kurilla, United States Central Command (CENTCOM)
[14] المحرر، القوات الأميركية في الشرق الأوسط.. قواعد وجنود لحماية مصالح واشنطن، الجزيرة نت، 26 فبراير 2024
[15] المحرر، أمريكا تنشر قواتها بالسعودية “لمواجهة تهديدات جدية لقواتها ومصالحها” بالمنطقة، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 20 يوليو 2019.
[17] Mark Gollom, Why Jordan, and maybe even Saudi Arabia, helped defend Israel, CBC News, April 18, 2024
[18] المحرر، هل أصبحت إسرائيل على أبواب إيران بعد أن ضمها ترامب لعمليات “سنتكوم“؟، موقع “قناة فرانس 24 بالعربية”، 15 يناير 2021.
[19] Matt Rosenberg, What Is Mackinder’s Heartland Theory?, ThoughtCo, September 10, 2018
[20] About the Command (AFRICOM), United States Africa Command
[21] Ruth Margalit, Trump’s Legacy in Israel, The New Yorker, January 12, 2021
[22] المحرر، اعتراض صاروخ باليستي استهدف الرياض من اليمن، موقع “صحيفة الشرق الأوسط” السعودية، 5 نوفمبر 2017.
[23] المحرر، الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا حوثيا استهدف الرياض، موقع “قناة سكاي نيوز عربية“، 6 ديسمبر 2021.
[24] Editor, Saudi led-coalition launches airstrikes on Yemeni capital after deadly Houthi drone strike in Abu Dhabi, CNN, 17th January 2022.
[25] ليلى بشار الكلوب، ما هو “محور المقاومة” وما علاقته بالنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط؟، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 12 مارس 2024.
[26] إدارة المجلس، التداعيات الأمنية لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، المجلس الأعلى للعلاقات الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، د.ت.
[27] Marcy Grossman, What the opening of the Abrahamic Family House Synagogue in the UAE means for the Jewish community and the rest of the world, Atlantic Council of United States, February 27, 2023
[28] انظر: محمد البهي.. الإخاء الديني ومجمع الأديان وموقف الإسلام، القاهرة مكتبة وهبة، ط:1، مايو 1980.
[29] سيد الخلفاوي، مجمع الأديان بمصر القديمة قبلة الجميع.. تطوير المنطقة بالكامل ضمن مشروع مسار العائلة المقدسة.. ترميم المعبد اليهودى والعقارات المحيطة بالكنائس.. وإنشاء ساحة لمسجد عمرو بن العاص.. صور، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 22 سبتمبر 2022.
[30] Omar Rahman, The emergence of GCC-Israel relations in a changing Middle East, brookings, July 28, 2021
[31] المحرر، وزير الدفاع الإسرائيلي يوقع في المنامة اتفاقية تعاون عسكري مع البحرين، موقع “قناة فرانس 24″ بالعربية، 4 فبراير 2022.
[32] وكالات، رئيس الوزراء الإسرائيلي: حملة إضعاف إيران بدأت، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 1 فبراير 2022.
[33] أشرف عبد الحميد، مناورات بحرية مصرية أميركية لحماية الملاحة وأمن البحر الأحمر، موقع “قناة العربية“، 1 نوفمبر 2021.
[34] المحرر، اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وأمريكا، موقع “عمون” الاردني، 16 مارس 2021.
[35] شرحبيل الغريب، محور “إسرائيلي خليجي” بغطاء سعودي.. لماذا البحرين؟، الميادين نت، 7 فبراير 2022.
[36] المحرر، في علامة أخرى على الانفراج.. السعودية وإيران تناقشان التعاون العسكري، الجزيرة نت، 1 ديسمبر 2023.
[37] جوناثان ماركوس، إسرائيل والسعودية: ما الذي يُشكل “التحالف” السري بينهما، موقع “قناة بي بي سي” بالعربية، 27 نوفمبر 2017.
[38] وكالات، مصادر: السعودية تشترط دفاع أمريكا عنها كي تطبع مع إسرائيل، موقع “قناة دويتشه فيله” بالعربية، 29 سبتمبر 2023
[39] وكالات، إيران: أبلغنا واشنطن وجيراننا قبل 72 من الهجوم على إسرائيل، موقع “قناة العربية“، 14 أبريل 2024.
[40] مترجمون، ماذا نعرف عن مسيّرات “شاهد 136″ التي استخدمتها إيران لمهاجمة إسرائيل؟، موقع “قناة الحرة” الأمريكية بالعربية، 17 أبريل 2024.
[41] المحرر، إسرائيل قررت كيفية الرد على هجوم إيران.. وخلاف على التوقيت، موقع “قناة العربية“، 17 أبريل 2024.
[42] المحرر، اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وأمريكا، موقع “عمون” الاردني، 16 مارس 2021.
[43] مراسلون، دول عربية تصدت لهجوم إيران على إسرائيل “قد تواجه عواقب شعبية“، موقع “قناة الحرة” الأمريكية بالعربية، 17 أبريل 2024.
[44] المحرر، مراسلو المملكة: سقوط شظايا صواريخ إيرانية في عمّان والطفيلة، موقع صحيفة المملكة” الأردنية، 14 أبريل 2024.
[45] المحرر، الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية، الجزيرة نت، 9 مايو 2011.
[46] وكالات، «سنتكوم»: 94 عملية ضد «داعش» بالعراق وسورياموقع “صحيفة الاتحاد” الإماراتية، 7 أبريل 2024.
[47] وكالات، “سنتكوم“: قوات أمريكية شنت غارة فى العراق استهدفت قياديا بكتائب حزب الله، موقع “صحيفة اليوم السابع” المصرية، 8 فبراير 2024.
[48] المحرر، مشاهد لصاروخ سقط على أراضي كردستان العراق أثناء الرد الانتقامي من إيران على إسرائيل، موقع “قناة روسيا اليوم” بالعربية، 14 أبريل 2024.
[49] وكالات، العراق ينفي إطلاق صواريخ أو مسيرات من أراضيه خلال هجوم إيران، موقع “قناة سكاي نيوز عربية“، 17 أبريل 2024.
[50] المحرر، دول الخليج تسعى لإنهاء التصعيد بين إيران وإسرائيل لحماية أمنها ومصالحها الاقتصادية، موقع “قناة فرانس 24″ بالعربية، 16 أبريل 2024.
[51] المحرر، نحو حوار بين دول الخليج العربية وإيران، تقرير قسم الشرق الأوسط رقم: 226، مجموعة الأزمات الدولية، بلجيكا،أغسطس 2021، ص ص: 21 – 22..
[52] Talek Harris, Robbie Corey-Boulet and Callum Paton, ‘Bad for business’: Gulf states scramble to avert wider war, Al-Monitor, April 16, 2024
[53] Jim Garamone, Great power competition adds to challenges in Middle East, United States Central Command, February 9, 2021
[54] Stephen Mihm, Many evangelicals see Israel-Hamas war as part of a prophecy, The Japan Times, November 3, 2023
[55] Daniel Larison, Biden should not follow Netanyahu into war with Iran, Responsible Statecraft, April 12, 2024
[56] المحرر، تقرير: “الولايات المتحدة توافق على تزويد إسرائيل بمزيد من القنابل والطائرات الحربية“، موقع “آي24 الإخباري“، 29 مارس 2024.
[57] المحرر، ضربة إيران والانتخابات الأميركية.. هل تخدم بايدن أم ترامب؟، موقع “قناة سكاي نيوز عربية“، 16 أبريل 2024.