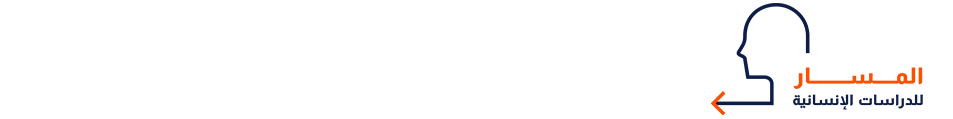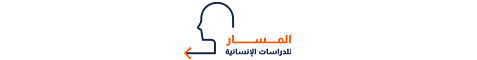المحتويات
- مقدمة المحرر
- مقدمة الكتاب
- الفصل الأول: التحليل المنظومي للمفهوم المركب
- الفصل الثاني: ما معنى “الشريعة الإسلامية” في سياق الدولة المدنية؟
- الفصل الثالث: الدولة المدنية سياسيا.. التعددية في ضوء مقاصد الشريعة
- المراجعة الختامية
مقدمة المحرر
أفرزت التحولات التي أعقبت موجة الربيع العربي، وخاصة منذ عام 2015، حالة واسعة من إعادة التفكير في قضايا الدولة والسياسة داخل المجال العام العربي والإسلامي. ومع تعثر غالب المسارات الثورية وتبدل موازين القوى، برزت تساؤلات متعددة حول طبيعة النظم السياسية الممكن بناؤها، وحدود الضغوط المتعلقة بمتطلبات الحكم في السياقات المعاصرة، وهو ما انعكس في صدور عدد من الكتب والدراسات التي سعت إلى مقاربة هذه الإشكاليات من زوايا فكرية ومنهجية مختلفة، ومحاولة استيعاب التحولات التي شهدتها المنطقة في تلك المرحلة.
في هذا الإطار، يأتي كتاب “الدولة المدنية: نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة” للدكتور جاسر عودة، بوصفه محاولة فكرية تسعى إلى قراءة هذه التحولات واستيعاب دلالاتها، من خلال مقاربة تنطلق من المنهج المقاصدي. ويُعد الكتاب محاولة نقدية ذاتية تنطلق من داخل التيار الإسلامي، وتسعى إلى مراجعة عدد من التصورات التي حكمت التفكير السياسي خلال العقود الماضية، دون القطيعة مع المرجعية الإسلامية. ويهدف هذا النقد إلى تقديم تصور لسمات نظام سياسي إسلامي قادر على تجاوز الاستبداد، من خلال إعادة التفكير في مفهومي “السياسي” و”الإسلامي”، وفي طبيعة العلاقة بين القيم الدينية ومتطلبات الدولة في العصر الحالي.
ولفهم مقصد الكتاب على وجه الدقة، فإن هذا النموذج الذي ينظّر له ليس النموذج الأمثل كما يراه، بل ينص الكتاب على أنه نموذج مرحلي يناسب المرحلة الراهنة، دون أن يكون تمثيلا دقيقا للنموذج الإسلامي في صورته المعيارية المثالية. كما أنه حين يتحدث عن المرجعية المقاصدية، فلا يقصد بالضرورة أنها مرجعية عامة شاملة، بقدر ما يقصد أنها مرجعية لنموذج الدولة المدنية الذي يتبناه الكتاب بشكل خاص.
وتتصل أهمية الكتاب كذلك بمكانة مؤلفه العلمية والفكرية، إذ يعد الدكتور جاسر عودة أحد رواد المدرسة المقاصدية المعاصرة، ويتمتع بخلفية علمية متعددة التخصصات، جمعت بين الدراسات الشرعية والفكر السياسي. وقد أسهم هذا التكوين في تقديم معالجة تجمع بين التأصيل النظري والانشغال بأسئلة الواقع.
وانطلاقا من ذلك، آثر “مركز المسار” عرض هذا الكتاب والتعريف بأبرز ما يطرحه من أفكار، في إطار السعي إلى تقديم ومناقشة التصورات الفكرية المطروحة في هذه المرحلة المفصلية. ولا يعني هذا العرض تبني المركز لما يرد في الكتاب من رؤى أو خلاصات، بقدر ما يهدف إلى الإسهام في إتاحة النقاش، وفتح المجال أمام قراءة تحليلية هادئة للاجتهادات الفكرية والسياسية المعاصرة.
وقد صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في بيروت عام 2015 عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ويقع في 319 صفحة.
مقدمة الكتاب: الثورات العربية بين حلم العدالة وواقع الاستبداد
تنطلق المقدمة من أن المشكلات التي يعانيها العالم اليوم هي بالأساس أعراض لأمراض أخلاقية وفكرية وعقلية، ومن تمظهراتها ضعف الممارسة الأخلاقية وطريقة التفكير الاستبدادية عند بعض الراديكاليين من مختلف التيارات. وحتى تنجح الثورات فهي بحاجة أولا إلى ثورات فكرية. والأزمات السياسية في أعماقها كلها أزمات أخلاقية، وهي فرع عن الممارسة الميكيافيلية للسياسة. ويدلل الدكتور جاسر عودة على ذلك بالإشارة للواقع اللاأخلاقي عالميا وإقليميا، في مجالات متعددة، كالصحة والتعليم والفن والاقتصاد والبيئة وملف المرأة، وما إلى ذلك.
ومن وجهة نظره، فإن التغيير الحقيقي يلزمه مقدمتان. الأولى: تغيير بناء الإنسان نفسه، الثانية: تغيير في بناء الدولة ذاتها.
من جهة الإنسان، لا يمكن إصلاح أزمة الاستبداد بتغيير أعلى السلطة فقط، فترسيخ العدالة يحتاج تغييرا اجتماعيا أوسع.ومن جهة الدولة، فالدولة العربية في بنائها إشكال جوهري يعزز الاستبداد والفساد. وهي ليست مفهوما طبيعيا لا يتغير، بل هي كيانات تاريخية قريبة النشأة، وقابلة لإعادة التعريف.
ويُلاحَظ أن توصيف المؤلف لجذر الإشكال يتشابه مع أطروحات كثير من الإسلاميين؛ إذ يركز على أن الإشكاليات الحالية تعود لمشكلات في المُثل والأفكار، بينما يقل التركيز على البُعد المادي، الذي قد يفسر كثير من مسائل الواقع.
فعلى سبيل المثال، الإشكالات المتعلقة بجشع شركات الدواء، أو الانحياز الإعلامي لا تُعَد نتاج سوء في التصور المفاهيمي، بقدر ما هي مُخرَج من مخرجات هياكل القوة وأنماط الإنتاج، وكذلك التشويش الأخلاقي هو جزء من خطاب واقع هياكل القوة.
ورغم ذلك، فـ “عودة” لا يهمش العوامل الهيكلية بالكلية، إذ يرى أن التغيير ينطلق بالأساس من تغيير الإنسان والدولة، فهو لا ينتمي لتيارات الخلاص الفردي وإنما يرى ضرورة العمل المنظم، ومشروع كتابه يعد تأطيرا لسمات نموذج يسعى له، وهو أمر في حد ذاته يؤكد على حرصه على بعض صور التغيير الهيكلي.
والحل إذن -وفق عودة- يتمثل في بناءدولة مدنية تعددية بمرجعية مقاصدية، وهو ما سيتناوله الكتاب بالتفصيل. فمدار الكتاب بالأساس ثلاث مفاهيم: التعددية، والمدنية، والمرجعية المقاصدية. المدنية في مقابل الاستبداد العسكري والقبلي، والتعددية الشاملة تفترض شمول “السياسي” لكل الحركات والهيئات المدنية في مقابل الأحادية أو التعددية الضيقة التي تقصر التنوع على شكل واحد من التنظيم السياسي (الحزبية)، والمرجعية أي الأرضية الفكرية والفلسفية والقيمية لهذه الدولة.
ومقاصد الشرعية الإسلامية -كما ذكر المؤلف- تضبط الأولويات، وتشمل مختلف التخصصات، فلا تتقيد بمجال، ويظهر فيها حكمة وصلاح التشريع لكل عصر ومكان، ولها دور مركزي في مشروع الكتاب، نقرأه هنا في ثلاث أدوار أساسية.
الدور الأول للمقاصد في الكتاب ذو طبيعة فلسفية؛ إذ ينتمي الكتاب للتيار الذي يؤكد على وجود مشترك الإنساني يبرره من داخل منظومته القيمية الدينية، وهذا بخلاف الإنسانوية العلمانية، أو بعض الإسلاميين الذين يبالغون في التأكيد على الخصوصية القيمية وتمايز النماذج الحضارية، ولذلك يتعاطى الكتاب بانفتاح على مسألة الاستفادة من المجهودات الغربية.
أما الدور الثاني فهو استراتيجي داخلي للإسلاميين، إذ يعمل على نقل التركيز مما يعتبره قضايا جزئية تهم المسلمين أو المتدينين وحدهم، للهموم الأولى في ميزان الإسلام. والأهم أن المقاصد توفر إجابة عن سؤال “لماذا؟”، وهو محرك العمل الحركي، وسبيل صياغة المشاريع تحت مظلة أخلاقية.
الدور الثالث استراتيجي في علاقة الإسلاميين بالمجتمع والعالم؛ ذلك أن أي مشروع أيديولوجي يحمل في طيّاته تحدي الوصول لأرضية توافقية مع مكونات المجتمع المختلفة، خصوصا في نظام تعددي. والمقاصد، بدورها، كمعاني سامية كلية وأهداف كبرى رفيعة، تمثّل مرجعية تحظى بقدر مُعتبَر من التوافق بين التيارات المختلفة، حيث يتفق على حسنها “عقلاء كل الأمم”.
وفي سياق النهضة العربية والإسلامية وصراعها مع الاستبداد، يرى “عودة” أن الدولة المدنية مرحلة أساسية لتجاوز الاستبداد، فالدولة المدنية التعددية شرط لنجاح الدولة الوطنية المعاصرة، وهي نموذج وهدف مرحلي في سبيل الوحدة المنشودة، لأن الانتقال من مرحلة الدويلات المستوردة إلى مرحلة الوحدة الإسلامية الواسعة لن يتحقق دون التخلص من الاستبداد، وتأسيس نظام سياسي يضع نصب عينيه مصالح الشعوب.
وهي من الإضافات المهمة والأفكار التي تستحق انتباها أوسع، فنموذج الدولة الوطنية الذي يدعو له، إنما هو مرحلة في رحلة عودة الأمة الإسلامية إلى مكانتها. فهو لا يكتب عن الصورة النهائية للدولة النموذجية الجامعة للأمة الإسلامية، ولا ينكر حق الأمة في الطموح لذلك المثال بدعوى الواقعية، وإنما يرسم معالم مرحلة محددة في رحلة العودة هذه. وكثيرا ما يعبَّر -في الأوساط الإسلامية- عن أن بناء الدولة الإسلامية الجامعة سيكون عملا تدريجيا. ولعل بإمكاننا أن نسكّن هذا الكتاب باعتباره بيانا لما يمكن أن تكون عليه إحدى النقاط في هذا المسار المتدرج. وهي فكرة جديرة بالاهتمام لأنها تخفف من الضغط الشعبي المتعلق بتحقق “النموذج الإسلامي”، وتقلل من تخوف بعض الفئات من هذا النموذج، دون أن تنزع عن المشروع إسلاميته أو حلمه البعيد.
وبهذا، يستهدف الكتاب المساهمة في تطوير علم “السياسة الشرعية” لما يرى من اتساع الهوّة بينه وبين الواقع، والحاجة لمراجعة المناهج التي تعامل بها القضايا في هذا العلم. ولذلك، فإن الكتاب يخصص فصلين في التأصيل النظري، الأول لمنهجية تحليل المفاهيم السياسية، والثانية لمنهجية الحكم على المرجعية. ثم يطبقهما على مفهوم “الدولة المدنية” في الفصل الأخير.
الفصل الأول: التحليل المنظومي للمفهوم المركب
أولا: مقدمة في مفهوم التحليل
يستهل الفصل بالإشارة إلى بعض القضايا المفاهيمية المطروحة في الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر، والمتصلة بكيفية توظيف عدد من المفاهيم التراثية، مثل “أهل الحل والعقد” و”دار الإسلام” و”الفرق”، في مقاربة واقع الدولة والمجتمع اليوم، مشيرا إلى بعض إشكالياتها. ويبين أن إسقاط هذه المفاهيم على السياق المعاصر يثير أسئلة منهجية وشرعية وعملية، تستدعي مزيدا من التدقيق وإعادة النظر، وأن مفاهيم السياسة الشرعية تولدت في سياقات وأنماط من التفكير زمانية، ولذا، فإن إعادة توظيفها في عصرنا دون أخذ مستجدات الواقع في الاعتبار ستقود إلى أزمة فكرية حقيقة.
ثم انتقل المؤلف للتأكيد على أهمية “المفاهيم” وأنها جزء كبير من صراعات اليوم، وأن عملية نقل المفاهيم، والحكم على تبنيها بالصحة أو الخطأ هو فرع عن تصورها أولا. وأول خطوات التصور هي “تحليل المفهوم”، ليُفهم أصل المفهوم وتطوره التاريخي وبعده العقائدي والفلسفي وعلاقته بالإسلام في جميع هذه المستويات. وسيكون المفهوم محل النظر في هذا الكتاب هو مفهوم “الدولة المدنية”.
لكن في البداية، تناول الكاتب مفهوم “التحليل” نفسه، حيث يعتبر أن تراثا فلسفيا واسعا شرقا وغربا لم يخرج عما أسماه “تراث التحليل التجزيئي” في مقابل ” التحليل المنظومي“، وهذا الأخير هو الذي يتبناه “عودة”. ويقصد بـ “التحليل التجزيئي” ذلك الذي يفتت المفهوم إلى مكوناته الأولية ولا يتضمن النظر لشيء ككلية متكالمة أو نظام ذي غاية. ولهذا النمط ثلاثة أخطاء منهجية، وفق الكتاب:
1- الاختزال المخل: بحصر النظر في العلاقات الثنائية التبسيطية بين الأسباب والمسببات. وقد تجاوز أعلام من التراث الإسلامي هذا الاختزال، كحديث ابن سينا والشاطبي عن الكليات، ومناقشة الأصوليين للجمع بين المتعارض، والمفسرين للنظم القرآني.
2- اتباع المنطق التبسيطي: بتركيزه في العلاقات المباشرة بين عنصرين محددين كالمقدمة والنتيجة، دون أن يفهم النسق الذي تتفاعل فيه هذه العناصر، حيث تتشابك العلاقات وتعدد المقدمات والنتائج، فلا يمكن رصدها إلا بالوقوف على وظائف النظام وغايته وعملياته الداخلية وتفاعله مع محيطه. وقد بات يُنظر اليوم إلى البنية المنطقية للمفهوم على أنها طيف، أي أن بين أطراف المفهوم مساحات نسبية، على سبيل المثال “نظام الدولة” لم يعد يقسم إلى ثنائية حتمية إما ديني أو مدني، والجماعات إما إسلامية أو غير إسلامية، بل بات الأمر أشبه بمساحة متدرجة من الصيغ، تتداخل فيها النماذج ولا تنحصر في ثنائيات حادة.
3- عدم اعتبار عنصر الزمن: فالتجزيئية تركز على العلاقات الساكنة، وتغفل جوانب الحركة والتغيير. والمفاهيم في حقل الدراسة (الحزب، الشرعية السياسية، الحرية) تتغير عبر الزمن، ما يستدعي دراسة حركتها التاريخية لتصورها تصورا صحيحا.
وبين الاختزال والتبسيط تشابه، إذ بحصر الشيء في بعض أجزائه، تُبني علاقة بسيطة بين العنصرين لأنك بذلك تهمش باقي المكونات التي كان يمكن أن تشترك في بناء المفهوم. وبحث العلاقة المباشرة بين فاعلين اختزال لباقي الفواعل. والاختزال والتبسيط من أدوات العلم وخصوصا في الدراسات الإمبريقية (التجريبية). ولكن يجب أن يوظفا بشكل منهجي معلل وواعي من الدارس، فالخرائط التي تحوي جميع التفاصيل قد تكون أصعب في المتابعة وأعلى في التكلفة بما ينافي تحقيقها الغرض المنوط بها، وكذلك المفاهيم، وهذا مبحث طويل معروف في كتب علم المناهج.
ثانيا: التصور والإدراك للمفهوم قبل الحكم عليه
يبدأ العنوان بتجاوز الطريقة القديمة في تعريف المفاهيم بـ “الماهية” و”الحد”. إذ يرى أن المفاهيم تصورات ذهنية لا تستلزم طبيعة ثابتة بالضرورة. فإذا كانت المفاهيم مرتبطة ومعتمدة على تصورات الذوات (البشر)، فإن إدراكها يحتاج وعيا مركبا بظنية المفاهيم السياسية وتعقيدها واعتماد تصورها على الثقافة والسياق الذي ولدت منه. ويعرّف المؤلف المفهوم بأنه “مصطلح له وظيفة يمكن أن يتطور بحسب تصورنا لأبعاده”.
ويدعم “عودة” موقفه هذا بالنقد التيمي للتراث اليوناني وباقي الفرق الإسلامية، حيث احتج بأن مقصود “التعريف باعتماد الحد هو على أية حال التمييز بين المفاهيم لا أكثر”. واستدل من التراث على أن الفقه نفسه تصور ينشأ في الذهن لا في الواقع، مؤكدا أن هذه العملية الاجتهادية عملية ذهنية تحتمل الخطأ، وليست كشفا مباشرا.
فيرى أن علاقة المفهوم بالواقع علاقة “تقابل” دون انفصال أو تتطابق. فهي وسيلة لتنظيم تفاعل الإنسان مع العالم، ونظام لتصنيف المدخلات وفهم دلالتها. والمفاهيم ليست سمة بسيطة إما أن تتواجد أو تنعدم، و إنما هي مجموعات معايير متعددة الأبعاد، فتنشأ منها فئات ليست حتمية. وهذا الفهم يرتبط بفكرة الطيف التي أشرنا إليها آنفا، والتي تعطي قدرا من التقريبية والظنية للمفاهيم. ومن حسن ربطه التأصيل بالتطبيق، يمهد “عودة” بهذا لتناوله لمفهومي “الإسلامية” و”المقاصدية” في الفصل التالي، بحيث تعتبر الدولة أكثر إسلامية كلما حققت قدرا أكبر من أبعاد المقاصد الشرعية.
ثالثا: رصد تطور المفهوم وتجدده عبر الزمن
إن التجدد والحركة لا يقتصران على الوجود المادي فحسب، بل هما من خصائص الدين ذاته، إذ يأتي مجدد المئوية ليجدد الأفهام وطرائق التنزيل. وعلى هذا، فإن المفاهيم الشرعية والسياسية تتجدد مع الواقع، ولكن المفاهيم المركزية تتغير عبر القرون عندما تتغير “رؤية العالم”. وهي -أي رؤية العالم- مجموعة من الفرضيات المسبقة التي نركّب بها العالم. وتتشكل هذه المنظومة العقائدية الأساسية من عناصر مختلفة بحسب النظريات، ومنها مفاهيم مفاهيم الكون، والحياة الآخرة، والأخلاق، والطقوس، والتاريخ، والعالم الطبيعي، والأسطورة، والإنسان، والزمان، وغيرها. ويمكن أن نفهم التغيرات الثقافية الإدراكية الجمعية في إطار تحولات هذه العناصر، بما يستتبع وقوع تغيرات مفاهيمية كبيرة، إذا تتغير مرتكزات المفاهيم.
رابعا: استيعاب تعدد أبعاد المفهوم في الواقع المعيش
يؤكد المؤلف أن لكل مفهوم وجوه، وتتعدد زوايا النظر لكل مفهوم. ويضرب في ذلك أمثلة شرعية، كتقسيم الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ويقسم المرجعية الإسلامية لأبعاد الكتاب والسنة، والفقه، والمقاصد، والتاريخ. ويقسّم المجال السياساتي (policy making) لأبعاد اجتماعية وبيئية وأمنية وقانونية واقتصادية، وغيرها.
ويرتبط تعدد الأبعاد بنسبية التقسيمات، كطيف الألوان المتنوع بين الأبيض والأسود، أو كما أسماه علوم الإدراك بالرتبة. والمصالح والمفاسد والحجية والمشروعية والحق والواجب في السياسة الشرعية كطيف الألوان، لها مراتب تستوعب التنوع الموجود في الواقع. وتَظهر النسبية في تنوع الانتماء في عصرنا، حيث ينتمي الفرد إلى بلاد مختلفة بدرجات مختلفة إذا اكتسب جنسية أخرى. ويطبق الكاتب هذه الفكرة في المجال الشرعي، منتقدا الخلط في المستوى اللغوي بين الوضوح وقطعية الدلالة، وفي المستوى التاريخي بين قطعية الثبوت والآحاد، وفي المنطق بين اختزال الحجية في اللزوم/القطع المنطقي وعدم اللزوم.
خامسا: الاهتمام بالبعد المقاصدي والقيمي للمفهوم
يشكل سؤال “لماذا؟” أي البعد الغائي للمفهوم عنصرا أساسيا يسعى الكتاب لتعزيز حضوره في دراسات السياسة الشرعية المعاصرة، ويقرأ ضعف الإنتاج بأن البحث الشرعي الحالي يركز على دلالات الألفاظ والعلاقات السببية حتى في مجال تطبيقي كالسياسة، مستحضرا قول الإمام الطاهر بن عاشور “ومعظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع، وقصارى ذلك كله أنها تؤول إلى محامل ألفاظ الشريعة في انفرادها واجتماعها وافترافها…”.
وسبب هذا الإحجام -في نظر الكاتب- هو الجدل الكلامي حول سؤال: هل أفعال الله (عز وجل) -بما فيها إنزاله الشريعة- معللة بأغراض؟ على ما في ذلك من خلاف معروف في كتب العقيدة بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. وتاريخيا، هيمن الموقف الأشعري، إلا أن كثيرا من الأعلام تبنوا موقفا أقرب للماتريدية، كالإمامين الشاطبي وابن تيمية.
ومن النماذج الشرعية البارزة في تفعيل دور المقاصد الإمام الشاطبي -خلافا للرأي الأشعري المعروف- حيث اعتبر اعتبر المقاصد الشريعة هي غاية التشريع، وأنها أقرب ما تكون للقطع باستخدام المنطق الاستقرائي، بل وأرسخ عنده من أصول الفقه.
ومشكلة الحرفية والنصوصية ظاهرة إنسانية ظهرت في مختلف الثقافات، بل كانت مهيمنة في فلسفة القانون الغربي، وممن تصدى لها في الغرب الفيلسوف الألماني يرنغ، ومن أقواله: “الفعل الذي يبنى على السبب يكون غالبا سلبيا،…. أما في حالة المقصد فإن الفعل الذي يتغيا مقصدا هو فعل إيجابي ذاتي،… السبب يحلينا للماضي، والإرادة القاصدة للمستقبل،… لا يمكن تصور فعل بدون مقصد، فـ “الفعل” و”الفعل من أجل مقصد”، هما بمعنى واحد، واستحالة الفعل من دون مقصد كاستحالة الفعل من دون سبب”.
ويؤكد “عودة” أنه باستقراء المقاصد نصل لاعتبارها في أمور السياسية الأصل الشرعي الأصيل، ولذلك فإن لها أثرا هاما في تحليل المفاهيم والنظم. لينتقل بعد ذلك لمناقشة مقصد من مقاصد الشريعة وهو “مراعاة السنن الإلهية”.
سادسا: مقصد مراعاة السنن الإلهية
وهي سنن تقصد الشريعة مراعاتها وعدم التناقض معها، فهي الحكمة كمشترك بشري، ولو كان غير إسلامي، ولذلك يمكن “الاستفادة من مفاهيم الآخرين، دون أن يلزمنا نقل الأشكال العملية التي اتخذتها”. ويعرّف “عودة” السنن بأنها قوانين مطردة، تحكم كل شيء في هذا الكون، من الذرة للمجرة، خلق بها الله الكون وسيّره على وفقها.
وهي مرعيّة بشكل خاص في مجال المجتمع والدولة، فالله لا يشرع شيئا ضد الفطرة البشرية أو طبيعة الكون، فالإنسان ليس مكلفا مثلا بالعزلة التامة عن البشر، أو عدم التملك بالكلية، أو عدم الزواج. بل ينظم الشرع طبيعة الإنسان بما يحقق مصلحته، وفي ذلك فائدة بأن الأنظمة السياسة التي تعارض الفطرية الإنسانية يكون انهيارها سريعا، بحسب المؤلف.
طرق التعرف على السنن؟
أوضح الكتاب أن هناك مصدرين للتعرف على هذه السنن، كتاب مقروء وكتاب منظور، القرآن والكون. لكنه يميز بينهما في أن دراسة الكون لا تنتج علوما يقينية ولا عامة ولا مطردة، بعكس السنن التي يعلمنا إياها القرآن. فيرى أن الدراسات الإجتماعية والطبيعية قد تنتج سننا ولكنها ليست بالضرورة سننا إلهية لازمة؛ لأنه قد تكون مقصورة زمنيا، أو خاصة بظرف ثقافي، أو وقع فيها الخطأ أثناء جمع البيانات. أما السنن الإلهية فلا تتغير ولا تتبدل.
ويرصد عددا من السنن الإلهية:
الأولى سنة الوحدة: وهي أن الكون وحدة متصلة مترابطة، وهي مستفادة من تعبير “كل شيء” المتكرر في آيات عديدة. ويستفيد منها في فهم أن القرارات السياسية حتى لو استهدفت عنصرا واحدا فهي بالضرورة تؤثر في عوامل أوسع بكثير، لأن الكون مترابط، ولا يتحرك شيئ حتى يتأثر الكون كله. ويطبق المؤلف نفس المبدأ على المستوى الإنساني، أي أن هناك وحدة بين البشر، فبنو آدم كلهم من تراب، خُلقوا من نفس واحدة. ومن فوائد تلك الفكرة مراعاة المشتركات الإنسانية في التدبير السياسي ومعاملة غير المسلمين.
الثانية سنة الزوجية: وفي إطار الوحدة هناك زوجية، موت وحياة، ذكور وإناث، سلم وحرب، غنى وفقر، وما إلى ذلك. ومراعاة السنة هنا تستلزم أن يتكامل الأزواج داخل الوحدة التي تفرّعا عنها بما يحقق التوازن. فاتفاق الذكر والأنثى مثلا يحقق السكينة. لكن من الملاحظ في هذه السنة أنه لم يستشهد لها بآية قرآنية رغم ادعائه أن القرآن هو مصدر التعرف على تلك السنن.
الثالثة سنة التنوع أو الاختلاف: ويذكر هنا المؤلف أن الحيوانات والنباتات على ما بينها من وحدة، إلا أنها تتنوع في أشكالها، وأن النبي (صلي الله عليه و سلم) لم يأمر بقتل الكلاب كلها مراعاة للتنوع، وأن الحفاظ عليها سنة إلهية. فسنة التنوع لا تقتصر على البشر فقط، والإسلام “لا يقصد أبدا أن يلغي نوعا ولا مكونا من مكونات المجتمعات الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية”. ويربط “عودة” هذه السنة بالتعامل مع الأقليات كموضوع حساس في هذا العصر، فلا يجب أن تؤسس وحدة على أنقاض الأقليات، لا باسم الوطنية ولا باسم الأغلبية. ويرى الكاتب أن النظم التي تلغي الآخر دينيا أو سياسيا أو اقتصاديا هي النظم الفاشلة والتي تؤدي دائما لاضرابات لمعاندتها هذه السنة.
وبحسب الكاتب، فإن السنن الثلاث (الوحدة، والزوجية والتنوع) يجب أن تتكامل ولا تتناقض، ولا يحق لنظام سياسي أن يعارض هذا التنوع وإلا عارض سنة إلهية، وانتهى بالفشل.
الرابعة سنة التوزان: حول صورتها المادية، يقول تعالى: “ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون”، ويستنتج “عودة” من ذلك أن البيئة في الأصل متزنة مع نفسها. وحول صورتها الشرعية، يقول تعالى: “الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان”، فنزول الكتاب مقترن بالميزان، ما يؤكد مركزية العدل، الذي هو “سبيل التوازن مع مراعاة التنوع”. إن تحقيق هذا التوازن يتطلب فاعلية إنسانية واعية لإقامة العدل، باعتباره ثابتا إسلاميا قادرا على تحويل الصراع الناشئ عن الاختلاف إلى مسار أقرب إلى السلم.
الخامسة هي سنة التداول: ينطلق المؤلف فيها من قوله تعالى: “وتلك الأيام نداولها بين الناس”، ليقرر أن الوجود في جوهره قائم على الحركة والتغير من حال إلى آخر. وفي هذا السياق، يستعرض الكتاب أمثلة وصورا متعددة للتغير في حركة الطبيعة والمجتمعات، مثل تعاقب الفصول ودورات الحضارات، موضحا أن هذا يأخذ وقتا ويتحرك وفق تقدير كالأفلاك. فالحضارات تمر بأطوار في صعودها وهبوطها. وانطلاقا من سنة التداول، اعتبر أن التداول السلمي للسلطة هو من المعاني الحميدة.
وفي الحقيقة، فإن هناك عدة إيجابيات في طرح مفهوم السنن، كما ذكره عودة، منها:
– تأكيده على وجود فطرة إنسانية، وهو بذلك يقابل مدارس أخرى ترى الإنسان منتجا تاريخيا محضا. ففهم الطبيعة البشرية مدخل أساسي في الإصلاح، والعوامل الهيكلية ليست وحدها التي تنتج الأزمات الإنسانية، وإنما طبيعة الإنسان وقدرته على الشر مدخل مهم لفهمه وإصلاح أحواله.
– تأكيده على المشترك الإنساني، بخلاف بعض الأصوات الراديكالية الصاعدة داخل أجزاء من التيارات الإسلامي التي تحط من قدر المشترك الإنساني لتضخم جوانب الخصوصية الحضارية، بكل ما ينتج عن ذلك من إشكالات فكرية في التعامل مع التراث الغربي والعالمي. فالكاتب هنا يتجاوز هذه الإشكالات بتأكيده على هذا المشترك وفي استفادته من المنتوج الغربي بشكل منهجي دون حرج.
غير أن هناك عدة إشكالات في مفهوم السنن، كما يطرحه “عودة”، منها:
1- في طرق معرفة السنن: قول المؤلف إن معرفة السنن تفيد اليقين إذا كان مصدرها قرآني فقط، قول يحتاج للمراجعة من وجوه متعددة. أولا: إذا أدرك أصحاب العلوم المذكورة -حتى من غير المسلمين- تلك السنن التي ادعى أنها قرآنية يقينية لا غيرها، فقد أثبتوا إمكان بلوغ اليقين الذي حجبه عنهم، علما بأن السنن التي استشهد بها الكتاب هي بالفعل مذكورة في علوم مختلفة وفي ثقافات مختلفة.
ثانيا: قوله إن الخطأ في عملية البحث هو مما يقدح في إمكان الوصول لليقين في هذا العلم، قول غريب؛ لأن الخطأ يقع في إدراك كل العلوم من كل البشر، كما سيشير بعد ذلك في حديثه عن علم الفقه، بأن هناك مساحة تأويلية في فهم النص. ثالثا: استدلاله بآية “ولن تجد لسنة الله تبديلا” ربما به قصور، إذ تعاطى “عودة” مع الآية بشكل حرفي، على النحو الذي ينتقده على طول الكتاب. فأين سياق الآيات؟ وأين مقصدها في هذا السياق؟ إن تأسيس معنى مركزي بهذا الاستدلال العابر يفتقد لعامل المناسبة بين حجم المستدل عليه وعمق الاستدلال.
2- التمييز بين ما هو واقع وبين ما هو مطلوب: هناك تمييز غائب في الكتاب، وهو التفريق بين السنة التي تعبر عن الواقع كما هو، كسنة الوحدة والزوجية والتنوع، والسنة التي تطالب الإنسان بفعل معين كحديثه عن العدل في سنة التوازن. ويمكن أن نسميها هنا تجوّزا “سنة إصلاحية”. وهذا التمييز بين المفاهيم القيمية والتوصيفية غائب في عموم الكتاب، وإشكاله أن سنة التنوع مثلا لا تنتظر فعلا إنسانيا لإيجادها، في حين أن تحقيق التوازن ليس سنة مستقرة بالفعل يجب مراعاتها، إنما هي بالأحرى غاية يصبو إليها المصلح.
يتفرع عن هذا إشكالية الاستدلال بالسنن على المسائل الجزئية والقضايا السياساتية؛ فوجود سنة لا يعني أن المسلم مطالب بتفعيلها في كل المواقف الجزئية بشكل تلقائي ودون اجتهاد. فلا يجب أن تُقبل كل دعوة للوحدة، ولا أن يُسعى إلى زيادة كل أشكال التنوع. فعلى سبيل المثال، عند الاستدلال على أفضلية نظام معين بدعوى موافقته لسنة بعينها، يمكن أن يقول أحدهم إن “نظام الحزب الواحد” هو الأفضل مراعاة لسنة الوحدة، أو إن الاكتفاء بحزبين فقط يراعي سنة الزوجية، أو إن تعدد الأحزاب هو الأوفق مراعاة لسنة التنوع. بل يثار أيضا تساؤل عملي: إذا كان بلد ما يضم تنوعا من الأحزاب اليسارية فقط، فهل تُستحدث أحزاب يمينية لتحقيق سنة الزوجية وخلق التوازن؟ هذه الإشكالية ظهرت في ربطه بين سنة التداول والمفهوم المعاصر للتداول السلمي للسلطة.
3- التمييز بين وجود الشيء وقدر من الشيء: من إشكالات كثير من الكتابات الفكرية الإسلامية عموما هي كثرة العموميات، فدعوى أن المتناقضات ظاهريا يجب أن تتكامل، دعوة حسنة، ولكنها كثيرا ما تتجاهل الأسئلة الصعبة، مثل: ما معيار الترجيح بين تغليب الوحدة وتغليب التنوع؟ ولعل الكاتب لم يفصّل لأن هذا لا يقع في دائرة تركيزه في الكتاب، ولكنه نمط متكرر فأردنا الإشارة إليه.
4- فكرة أن السنن سياقية وتتفاعل مع الزمن: مع أن الكتاب يمدح منذ البداية أهمية اعتبار الجوانب السياقية، إلا أنه انتقد مصادر معرفة السنن الأخرى لأنها سياقية، وادعى أن القرآن يقدم السنن مطردة. غير أن الأمثلة التي قدمها لا يمكن فهمها إلا بتأويل وسياق، فمتى يكون التداول إيجابيا؟ وما كيفيته؟ وما مقداره؟ كلها أسئلة مفتوحة دائمة، فقد يكون الحد من قدر التداول هو الأفضل لتحقيق التوازن، وكل هذه التقديرات زمانية. ذلك أن تجليات كل سنة وصورها وعلاقتها بالمصالح كلها مرتبطة بالسياق.
سابعا: التعامل مع المفاهيم غير إسلامية الأصل
قسّم المؤلف الموقف من المصطلحات السياسية الغربية لأربعة مواقف: الرفض، والتوظيف، والتبني، والنقد:[1]
| الرفض | التوظيف | التبني | |
| الموقف | رفض المفاهيم الغربية جملة وتفصيلا، واتهامها بالكفرية | توظيف المفاهيم دون الإيمان بها | تبني المفاهيم الغربية جملة وتفصيلا |
| المجموعة | السلفية المعاصرة | الجماعات الحركية | الاتجاهات الليبرالية والعلمانية المعاصرة |
| التبرير | الخطاب المعرفي الإسلامي مختلف | تبرير اعتذاري: تعيد تأويل المصطلحات الغربية من باب المصلحة | أفضل طريق لنهوض الشرق هو في إتباع الغرب والسير على خطاه |
| إشكالاته | -عمليا كان عداؤها للغرب وولاؤها للحاكم المتغلب، وبذلك يعززون الواقع الاستبدادي للأمة. -نظريا لا يقدمون بديلاً معرفياً للنموذج الغرب في مواجهة الاستبداد وبذلك يبقى الواقع حبيس نموذج الإمام المتغلب -الخصوصية الإسلامية لا تنفي وجود مساحات تقاطع إنساني | أنها ليست تحررية بحق، لأنها لا تخرج عن الأطر الغربية، النهضة تحتاج استفادة من الآخر وتطويرها ضمن إطار نظرة إسلامية | أن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة والحياة، ومحاربة الدين، مما لا ينتج إلا تبعية فكرية واقتصادية وثقافية وسلباً للهوية |
| ما يمكن تعلمه | الدفاع عن الهوية الإسلامية والثوابت، بدون تفسيرات المؤامراتية وبدون أو يوظفنا أصحاب السلطان | توازنات المصالح والمفاسد، وأهمية التعامل مع ضغوط الواقع، بدون السقوط في براغماتية | الانفتاح على معارف الآخرين، بدون أن نكون جزءا من خطة الأعداء |
والجدول أعلاه يتضمن المواقف الثلاثة الأولى، ونفصّل هنا الموقف الأخير: النقد
تعرض الكتاب للمواقف التراثية المختلفة من الانفتاح على التراث الفلسفي للآخر، بعد تأكيده على أهمية الانفتاح وأنه الوسيلة المثلى للانتفاع بالحكمة الإنسانية.
الموقف التراثي الأول: العلماء الذين رفضوا أية محاولة للاستفادة من الفلسفة غير الإسلامية، وحرّموا دراستها، وكانت تدرس سرا. والموقف التراثي الثاني: العلماء الذين رفضوا لكن قدموا نقدا علميا مدروسا، بل وحاولوا طرق أفكار بديلة كابن حزم وابن تيمية.
الموقف التراثي الثالث: الموقف الذي ساد في النهاية موقف الغزالي، وهو نبذ كل ما يتعلق بالماورائيات وقبول المنطق اليوناني كآلية مجردة. والموقف التراثي الرابع: موقف ابن رشد ويوافقه “عودة”، وهو الانفتاح على المعرفة البشرية مع عرضها على ضابط الشريعة، ويرى إمكان تأويل النصوص بمقدار ما تسمح اللغة عند تعارض العقل المنطقي السليم والنص الصريح الثابت.
ثامنا: مفهوم الدولة المدنية
يضع الكاتب تحت هذا العنوان سمات الدولة المدنية وخصائص نموذجه للدولة الوطنية المعاصرة. وبالرغم من أن مفهوم “المدنية” جرى تسييسه على نطاق واسع، وأخذ دلالات متعارضة، وهو غير مستقرٍ فلسفيا وتاريخيا، إلا أنه يرى فيه فرصة لتحقيق توافق مجتمعي بين مختلف التيارات، على شكل الدولة وعلى قيمها المدنية، وهذه القيم المدنية يأتيها كل توجه ديني وفلسفي، لتجتمع في معانٍ مجردة: العدالة، الحرية، والمصلحة العامة.
وبناء هذا التوافق عند “عودة” أصبح ضرورة لتجاوز حالة الاستقطاب والتشظي المجتمعي العربي الواسع، وهذا يسلتزم التمييز بين مساحة التوافق التي تدخل في تعريف النموذج وبين المساحة المتروكة لتنافس الأيديولوجيات التي لا ينبغي لأي منها احتكار النموذج. والمساحة المتفق عليها تتمثل في:
1- حكم المدنيين، وألا يرتبط نظام الحكم بالعسكريين
2- ضمان الحقوق والحريات وتساوي المواطنين أمام القانون
3- سيادة القانون واستقلاله الحقيقي واحترامه لقيم المجتمع ومبادئ الشريعة الإسلامية
4- كفالة حرية المعتقد
أما ما لا يدخل في تعريف الدولة -وفق عودة- فيشمل العناصر الأيديولوجية محل الخلاف، مثل العلمانية أو الليبرالية أو الاشتراكية أو الإسلامية، أي العناصر الأيديولوجية محل الخلاف، فلا يدخل في تعريف أصل النموذج حقوق ينادي بها الليبراليون أو شكل للدولة ينادي به الاشتراكيون أو أحكام خاصة يرجحها إسلاميون.
وفي هذا الإطار، يناقش عودة علاقة المدني بالديني من خلال تصور قائم على التقاطع بين المجالات، حيث لا يرى تعارضا بين المفهومين إذا فُهمت مناطق الالتقاء والافتراق بينهما. ويقسم هذه العلاقة إلى ثلاث أقسام رئيسية:
القسم الأول: الديني البحت: التعبديات والعقائد التي تخص كل دين ولا تتعلق بالنظام العام، وهي مما لا يصح للدولة الدخول فيه وإلا أصبحت دولة شمولية.
والقسم الثاني: المدني البحت: مما للإسلام تدخل فيه عن طريق المعاني لا عن طريق الأحكام الشرعية التفصيلية، وهو مجال توزيع السلطات والقوانين التي تنظم الهيئات والتجمعات. وهذا يدخل في “شؤون الدنيا” على التقسيم السابق في مناقشة السنة.
القسم الثالث الديني-المدني، وفيه الأحكام التي يناط بالأمة تحويلها لقوانين عامة. ويقسمه عودة إلى ثلاثة مستويات، في محاولة لتفادي الصراع الذي يهدد التوافق المنشود:
أ: الذي يمكن لكل أهل دين التحاكم فيه لدينهم: وهي في الغالب مساحة الأحوال الشخصية، والتي لا بد أن يكون قانون الدولة فيها معتبرا لخصوصية كل دين. فهناك حاجة واقعية قوية لحضور الدولة بتطبيق الأحكام التفصيلية القطعية الكثيرة في هذا الباب.
ب: مساحة محل توافق: وهي الأحكام الإسلامية التي يتفق الغالب عليها، كقانون القصاص في القتل العمد، ومنها أيضا دعم الدولة لدور العبادة، والإجازات الرسمية في الأعياد الدينية، وبعثات الحج الرسمية وما إلى ذلك.
ج: الذي لا يتوافق عليه الجميع: كجمع الجزية، ومنع غير المسلمين من الخدمة العسكرية، والربا في المعاملات البنكية، وتطبيق الحدود. وهي من الشريعة، لكن يرجح “عودة” عدم طرحها في هذه المرحلة ضمن الجدل الدولاتي أو في إطار التقنين والتشريع، بل إبقاؤها في دائرة العمل التربوي والثقافي، وإحداث التغيير فيها عبر مسارات اجتماعية وأخلاقية متعددة دون إدخال الدولة طرفا مباشرا فيها.
ومرة أخرى، من المهم فهم ما يطرحه “عودة” باعتبار طرحا مرحليا يراه مناسبا للوضع الراهن، وليس النموذج الإسلامي بصورته المكتملة.
الفصل الثاني: ما معنى “الشريعة الإسلامية” في سياق الدولة المدنية؟
يعد وصف “الإسلامية” من الأوصاف المختلف حول دلالتها، ما الذي يجعل أمرا ما إسلاميا؟ وخيار المؤلف في هذا الكتاب أن معياره المرجعية، فإذا كانت مرجعية النشاط الإنساني إسلامية، فهو نشاط إسلامي.
ويقصد بالمرجعية غاية العمل، ومصدر أخلاقه، ومرد الأمور عند النزاع، وعلامة الصحة. والمرجعية غير المشروعية، كاختلاف الفكر الإسلامي عن الفقه الإسلامي، فالأول متعلق بالأفكار والمؤسسات والثاني بأحكام الحل والحرمة. ويرى الكاتب أن مرجعية الدولة المدنية التعددية هي المرجعية المقاصدية، فهي تعَرِّف غايتها ويرد لها خلاف ويقاس بها النجاح.
وفيما يلي المرجعيات الإسلامية التي ترجع إليها مختلف التيارات الإسلامية في أمور السياسة:
أولا: المرجعية التاريخية
الاستدلال بالتجارب التاريخية الإسلامية باعتبار أنها المرجعية هو استدلال مُشكِل -بحسب المؤلف- لأن وقوع الشيء ليس دليلا على مشروعيته. ولكن تكمن أهميته في أنه يحقق مصالح ظاهرة في مسألة تعزيز الهوية الإسلامية. ويقصد بالهوية هنا تفرد الكيان الإسلامي بمجموعة من الصفات والخصائص، التي يرى “عودة” أن في ضياعها استعبادا للأمة، وتقمصا مشوها لأنماط حياة لا تنتمي لها. ويقسم الكتاب تعاطي الساحة الإسلامية اليوم مع التاريخ للأقسام التالية:
| الطوباوي التمجيدي | التبريري الاعتذاري | النقدي الإصلاحي | النقدي التفكيكي | |
| موقفه | يمجد كل ما ورد إلينا من التاريخ الإسلامي | يرى الكمال في النظم المعاصرة (الغربية) | يقدم نقدا للتاريخ الإسلامي | اتجاه ما بعد حداثي في تفكيك التاريخ الإسلامي |
| موقعه | يرى أن التاريخ الإسلامي مفترى عليه، أننا بحاجه للدفاع عنه | يعيد قراءة التاريخ ليوسع حجم القيم الغربية في الموروث | هذا النقد يتمحور حول مناهج الكتابة وزوايا تناول المحتوى | يعرض للمآسي فقط، ولا يرصد الجوانب الإيجابية |
| إشكاله | المبالغة في مدح نظم سياسية كانت استبدادية ودموية | لا يحاول تطوير المفاهيم، بل ينسخها ويشرعنها | مجرد النقد غير كافي | يعرّض الهوية الإسلامية للخطر |
| لإكمال الصورة | تمجيد ولكن مع الاعتراف بالأخطاء | يصلح فقط في الخطاب الشعبي العام لتبرير اختيارات معاصرة | يجب أن تتحول لمشروع أكبر جاد | الاعتراف بجوانب القصور التاريخية والتوبة الجماعية منها بدون جلد للذات |
وبحسب المؤلف، فقد شابت كتابة المسلمين لتاريخهم إشكالات، أبرزها: التوسع في توثيق تاريخ السلطة والصراع على حساب تاريخ الحضارة بكل مكوناتها الثقافية والعلمية والفنية الاجتماعية؛ وتركيز نظريات السياسة الشرعية على الحاكم وتهميشها للمحكوم.
ويمكن القول إن الكاتب يقدم موقفا وتصنيفا مفيدا في فهم الاتجاهات المتباينة داخل الحركات الإسلامية، ولكن النظرة الهوياتية للتاريخ التي يقدمها ينقصها النظر بعين الاستفادة العملية، وليس الوقوف على الرمزية التاريخية فحسب. إن الناظر للتجربة التاريخية إما أن يستفيد منها مؤسساتٍ يمكن إعادة إحيائها لأنها تؤدي أدوارا هامة نحتاجها، أو أنها أمثلة على تفاعل القيم مع الواقع في تجربة زمانية لا يمكن نقلها، فتكون إلهاما لإبداع غيرها بما يحقق مقصودها.
لم يتطرق كذلك لدور التاريخ الإسلامي في تأكيد المشترك الإنساني، ليس فقط في جوانب الاشتراك في النجاحات، بل الأهم تعرض التجربة الإسلامية لأزمات وانحرافات مشابهة للتجارب الإنسانية الأخرى. وهي من المعاني التي يدعو لها ولكن لم يوظف فيها التاريخ.
ولعل من الأمور التي يتفاوت فيها التقدير، ولكن يجب ذكرها، قبوله فكرة التمجيد، لأنها في نظره تلعب دورا مهما في مكون الهوية. ولكن الناظر اليوم لتجربة بعض الحركات الإسلامية قد يقدر أن عقود الخطاب التمجيدي أدت لانتفاخ الذات، وتوسع في تصور الخصوصية. إن الذي يحول دون تطوير المفاهيم –كما يدعو عودة- ليس فقط الاعتذارية ولكن تضخم الأنا الجمعية.
ثانيا: مرجعية الفقه الإسلامي
يرى المؤلف أن باب السياسة الشرعية باب مهم، لكنه لا يحتكر الصورة كاملة؛ فالفقيه يجتهد في إطاره، وهو اجتهاد يظل محكوما بتصوره وإدراكه. ويشير إلى وجود دعاوى “إجماع” غير دقيقة في هذا الباب، ويرجح قول المصوبة في مسائل السياسة، باعتبار أن الآراء فيها متعددة بطبيعتها، إذ يقولون إن الحكم هو ما غلب على ظن المجتهد صوابه، وإن الحق فيها متعدد. ويبدو أن غاية الكاتب هنا هي بيان المسافة بين النص والحكم، ليؤسس من خلالها لمبدأ التعددية السياسية. فغياب هذه المسافة يدفع الأمة إما إلى احتراب المذاهب بدعوى حيازة المعلوم من الدين بالضرورة، أو إلى الجمود عبر توسيع دائرة القطعي. وأخيرا يمر الكاتب على تاريخ الفقه، ليؤكد بشريته وسياقيته دون أن يغفل أهميته كمرجعية مهمة لما يستجد في السياسة وغيرها. ويقسم الساحة في علاقتها بالفقه لما يلي:
| الجمود على المنقول | القياس مع الفارق | التجاوز الكلي | المؤامرة السياسية | |
| الموقف | الاجتهاد قد أغلق، ولن يصل الخلف إلى ما وصل إليه السلف | إدراك للواقع ولكن إصرار على العودة للنص الفقهي، ولو كان بعيدا لتبرير الاجتهاد | السياسة المعاصرة لا يدخل فيها الفقه | السياسة الشرعية مؤامرة من السلطان خضع لها الفقهاء |
| التعليل | شروط المجتهد عسيرة | |||
| الإشكالية | ليّ الواقع والنصوص | جمود على المنقول | معارضة لحقيقة الشريعة، تهدر تراكم الجهد العلمي للأمة | تاريخانية الفقه |
| ما يمكن تعلّمه | الثبات على مسائل الإجماع | القياس على الفتاوى التراثية مع مراعاة الفارق، وله دور في خطاب العام | الفقه ليس الصورة كاملة، ولكن هناك فقه للواقع وحساسيته | الحفاظ على مسافة بين الفقيه المعاصر والسلطان |
ثالثا: مرجعية السنة النبوية الشريفة
أجرى المؤلف مسحا أُفقيا على أقوال المذاهب في دلالة السنة (قولا وفعلا وتقريرا) وفي علاقتها بالقرآن، ومعنى كونها وحيا بين أمور الدين والدنيا، ومساحة الاجتهاد النبوي، وتصنيف الأحاديث ثبوتيا. ويريد من خلالها الإشارة لما يلي:
1- أن التفريق بين “أمور الدنيا” -كما وردت في حديث “أنتم أعلم بأمور دنياكم”- وما ليس كذلك، يبقى غير محسومٍ، وهذه الرمادية تؤثر في دلالة السنة خصوصا في مجالات لها تعلق واسع بأمور السياسة.
2- أن مصطلحات كـ “العقل” و”القطع” و”التعارض” تحتاج تجديدا وتحديدا لما تحدثه من اضطراب بسبب التباس أو فضفاضية معانيها.
3- المقاربة الاختزالية والتجزيئية للسنة، باعتبار دليل واحد وإهمال دلالة المعاني كلية. ونقد بعض العلماء هذه الظاهرة انطلاقا من أنها تنتج ظنا لا يصل لليقين، أي أن دلالة السنة في تلك المسائل لا تنتج القطع، بينما يركز “عودة” في نقده لتلك الممارسة على أن الإشكال في المنطق التجزيئي نفسه، وعلى أهمية إدراج الأدلة الكلية في الاستدلال على قضايا السياسة الشرعية.
4- أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قائد الأمة السياسي، فيلزم فهم سنته في ضوء سياقها السياسي، واعتبار مقاصد أفعاله في سنته أكثر من التعلق بذات الفعل، مع سعة الاجتهاد في المسائل السياسية.
رابعا: مرجعية القرآن الكريم
لقد عرض التقسيم الفقهي لدلالة الألفاظ من جهة وضوحها إلى “الواضح، المحكم، النص، المفسر” ومن جهة عدم وضوحها إلى “الخفي، المشكل، المجمل، المتشابه”. ومن جهة الدلالات التي تتضمنها الألفاظ دلالة “اعتبار، إشارة، قياس جلي، اقتضاء”. وأخيرا من جهة شموله إلى “عام وخاص”. ويسعى الكتاب من خلال عرض هذه التقسيمات والخلاف الحقيقي أو اللفظي حولها إلى استنتاج ما يلي:
- أن هذه التقسيمات “الأصولية” تشكلت مع زيادة التأثر بالفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني على وجه الخصوص، فشابهتها في البنية والمضمون، ويرى أنها تصنيفات متوهمة لا تلزم المجتهد.
- وينتقد في عدة مواضع أن هذه التقسيمات والعناية الزائدة بالبعد اللغوي (الحرفية) أدت ببعض المذاهب للوصول لأحكام سيكون لها تأثير سلبي وخطير على المجتمع وعلى مقصد حفظ النظام والعدالة.
ونستشهد هنا من كلام المؤلف بمثالين: في مناقشة اللفظ الخفي، ذكر الخلاف حول معنى “القاتل”، في الحديث “لا يرث القاتل [أي من المقتول]”. فقد ناقش بعض الفقهاء ما إذا كان اللفظ يشمل صورا أخرى كالتحريض أو القتل الخطأ، في حين ركز آخرون على الفعل المباشر وحده، دون الالتفات إلى قصد الفاعل أو صور الإعانة عليه. ويلاحَظ أن هذه الآراء، على اختلافها، اشتركت في التركيز على الدلالة اللغوية المجردة، دون مناقشة الآثار والمفاسد الاجتماعية المترتبة على الفعل.
وفي مناقشة دور “مفهوم المخالفة” في مسألة مقادير الزكاة، وكيف أدى الاطراد في المفهوم للقول بالنسخ، ينتقد ضعف العناية بمقصد الزكاة، ومصلحة الفقراء والتيسير على المكلفين. ويرى إمكان الجمع بين الدلالات المختلفة لا عن طريق اللغة ولكن بأن تتفاوت بحسب ظروف دافعي الزكاة.
وإجمالا، يعتبر “عودة” أن الاستنباطات اللغوية من ألفاظ القرآن الكريم قد تكون ضرورية لتحديد أفعال العبادة المحضة، إلا أنها -وفق تعبيره- لا يجوز اعتبارها مصادر كافية للحكم في أمور السياسة، والتي تتعلق بالمصالح العامة، وتندر فيها العبادات المحضة. والتعامل الأمثل في هذه المساحة -بحسب الكتاب- هو منهجية تقوم على القيم والمقاصد، بحيث تكون القيم والمقاصد مظلة لفهم وتطبيق النص القرآني.
خامسا: مرجعية مقاصد الشريعة
يبدأ هذا العنوان وينتهي بفكرة مركزية في الكتاب، وهي أن المقاصد الشرعية هي المنهج والمرجع الأصل في قضايا السياسة الشرعية، فهي حاكمة على فهم وتطبيق جميع المرجعيات الأخرى (قرآن، سنة، فقه، تاريخ). والاختيار بين الآراء الاجتهادية لا يحسمه ترتيب المذهبِ للإجماع والقياس وعمل أهل المدينة ورأي الصحابي، وما إلى ذلك. بل أن ترجح بينها المقاصد كمرجعية أولى في مسائل هذا الباب على وجه الخصوص. وبما أن المقاصد هي مدار الفكر والفقه السياسي الإسلامي فهي مرجعية الدولة المدنية.
وقد ناقش تقسيمات متنوعة للمقاصد: الدين، النفس، العقل، النسل، العرض، المال. ومن جهة أخرى ضرورات، حاجيات، تحسينيات. وهناك ما أسماه الكليات العامة: العدل، مراعاة الفطرة، حفظ نظام الأمة ومعاني كلية كالتيسير، والتعاون، والأمانة. مدللا على أن الاعتماد على هذه المبادئ ليس فقط موقفا قيميا ولكنه مفيد سياسيا لأنها مما يجتمع عليه العقلاء من كل ملة، فيوفر بذلك أرضية مشتركة. كما تعرّض في ثنايا شرح المقاصد لقضايا معاصرة شائعة كحرية الأقليات في معتقداتهم، والأسرة، وحقوق الإنسان الأساسية، والحقوق والملكيات الفكرية.
وعطفا بالتأصيل على التنزيل، فيما سبق ذكره من أبعاد المفهوم، فإن المؤلف يقيس مدى إسلامية الدولة بقدر ما تحققه من أبعاد مفهوم المقاصد وبما تترقى فيه من درجات داخل كل بُعد. أي أننا يمكن أن نقول إن الدولة أكثر إسلامية، أي أكثر تحقيقا للمقاصد.
ثم عاد لمناقشة دليلي “السنة” و“سد الذريعة” بصورة أكثر تفصيلا، وأعاد في ذلك بعض ما سبق طرحه مع إضافة جديدة. ويمكن فهم هذا الرجوع في ضوء أن المنهج الحرفي، الذي سينقد تعاطيه مع مفهوم “التعددية” في الفصل القادم، يستند إلى هذين الدليلين في بناء موقفه، فهو يقدم مفاهيميا لزاوية نقده. وقد أراد من هذا الرجوع التأكيد على أمور:
1- منهج الرجوع للمقاصد تضبطه وتقيده أمور كالتعبديات والمقدرات والقطيعات، حتى لا تتحول المعاني والكليات لسيولة تامة.
2- أن السنة ثلاثة أقسام: بيان مباشر للرسالة السماوية، اجتهادات صحيحة ولكنها مرتبطة بسياقها، مجال الحياة البشرية المعتاد.
3- إدخال المقاصد في تقييم متن الأحاديث، فيحكم بشذوذ المتن، إذا لم يوافق المبادئ القرآنية الراسخة، وليس فقط لمعارضته حديثا أعلى ثبوتيا. ويرى المؤلف أن المقاصد تساعد على سد الفراغ السياقي في كثير من الروايات التي لا يظهر فيها ظروفها المحيطة.
وفي مناقشة تدعم تفسيرنا السابق لهذا الاستطراد، تناول دليل “سد الذريعة” ليخلص إلى أنه، بوصفه منطق تفكير لا دليلا مستقلا، قائم على الاعتبار السياقي؛ إذ إن الفعل الواحد، كـ “بيع السلاح” أو “بيع العنب” أو “سفر المرأة”، قد يؤدي لعواقب متنوعة بحسب مكان سفر المرأة أو زمن بيع السلاح.
مراجعة فصل المرجعيات:
بداية، يمكن القول إن تطبيق الكتاب للتفكير المنظومي في هذا الفصل جيد، فهو لا يقع في الاختزال والتجزيء، ويراعي السياق التاريخي لكل مرجعية وتعدد أبعادها.
ولا يهدف الكتاب في مناقشة المرجعيات (عدا المقاصد) إلى التأصيل لها، أو التركيز على سبل الانتفاع بها، أو المعالجة الدقيقة لأحد مفاهيمها، ولكنه يقدم موقفا نقديا للممارسات المتعلقة بهذه المرجعية سواء المعاصرة منها أو التراثية. وذلك من خلال مسح أفقي -هو في تقديرنا لا يروي الأجنبي عن المجال ولا يزيد المطلع عليه- ولكنه يصل بالقارئ إلى أمرين:
أولا: تعقيد المشهد وتشعبه وتعدد الأقوال فيه، فهناك مذاهب كثيرة وتقسيمات تراثية عديدة وتاريخ من الخلاف. ثانيا: أن هناك جوانب مُشكلة في التعامل مع هذه المرجعيات، بل وهناك أسئلة غير مجاب عنها حتى الآن، وأنها لا تحوي إجابات أُحادية ولكنها مظلات وأطر مركبة، معقدة الماضي والتشكل، ومفتوحة المستقبل.
والفصل يصل بالقارئ ضمنيا إلى حاجة الحركة الإسلامية لتجديد ممارساتها وبنيتها العلمية الشرعية. والأهم والأكثر ارتبطا بمقصود الكتاب أمران: دور المقاصد والكليات في الإجابة على الأسئلة المعلقة أو المناطق الرمادية غير المحققة داخل هذه المرجعيات، كأنه يبين أدوارا تفصيلية لها، ويشير إلى مساحات مفتوحة هي قادرة على أن تظلها. والأمر الثاني أنه يمهد لفكرة التعددية بالتأكيد على وجود مسافة بين الفقيه والنص؛ وسعة الظنية؛ وحجم وتاريخ الخلاف.
ومن الملاحظ أنه قد ركز في مرجعية التاريخ على تعاطي الساحة المعاصرة معها، وركز في مرجعية السنة والقرآن على ما يراها جوانب مشكلة أو تحتاج تطويرا في الصنعة الأصولية والفقهية.
أما في مناقشته للمقاصد وهي شغله الأكبر، فهو لم يتعرض لتحديات تفعيلها، ولا حرر معانيها عدا المعنى العام المعروف منها. فلم يسع إلى تقديم إضافة للنظرية المقاصدية، ولكن للتأكيد على أنها المرجعية الأهم (خصوصا في باب السياسة).
ومن التصورات المُشكلة التي قد يستبطنها أو يصدّرها هي الحديث عن توفير المقاصد لأرضية مشتركة، هو تصور أن المقاصد بدلالتها العامة، التي يشترك فيها عقلاء كل أمة، هي أرضية قيمية كافية، بل إن مدار تنازع البشر داخل كل ملة وبين الملل ليس في حسن المعاني الكلية، ولكن في مدلولها ومقتضيات المدلول في الواقع. وتنازع هذه المعاني تحديدا ليس أمرا صوريا، بل يأخذ المعنى الواحد، مثلا “الحرية”، مدلولات متناقضة لا يمكن الجمع بينها.
الفصل الثالث: الدولة المدنية سياسيا: التعددية في ضوء مقاصد الشريعة
ينطلق الفصل من أولوية مفهوم “التعددية السياسية” في بناء الدولة المدنية التي يؤصل لها. ويحاول من خلاله معالجة مختلف آراء الطيف الإسلامي حول الموضوع. ومن جوانب تميز المعالجة أنها لم تقسم الآراء من جهة موقفها من التعددية، بل من جهة منهجها في الاستدلال على موقفها، وبهذا يتفرع آخر الكتاب عن مبتدأ اهتمامه بالمنهج، فالإشكال الأبرز يتعلق بالمنطق التجزيئي الاختزالي في بناء المفاهيم. فليست التعددية موقفا فقط، إذ قد تتعدد الآراء الحرفية، لكنها ستظل حالة عارضة أو براغماتية مؤقتة، ومنشود الكتاب هو تقديم طريقة مقاصدية ومنهجية منظومية كلية في النظر، ولذلك أَثنى عن مَن أعمل منهج الموازنات ولو خلص إلى رفض التعددية الحزبية.
ويفرق الكاتب بين التعددية كضرورة سننية اجتماعية والتعددية الحزبية، لأن الأنظار تنحصر غالبا في الجدل حول النوع الثاني. ولذلك بدأ به:
أولا: المنهج الحرفي
ينطلق تعاطيه من قناعته بأن الشرع لم يتناول ملامح النظام السياسي على نحو تفصيلي، فالسكوت عن توزيع السلطات ونظام تداولها وآليات صناعة القرار، كل ذلك مقصوده ترك الاجتهاد مفتوحا متجددا في هذا المجال، بما يوافق احتياجات كل عصر. ثم قسّم المفاهيم التي يُستدل بِهَا لرد منظومة التعددية الحزبية إلى سبعة أقسام. واتساقا مع منهجه ومخالفة لتقسيمه سنقسمها باعتبار زاوية نقده لكل قسم منها:
1- إسقاط العقدي على السياسي:
التوصيف الجامع لعدد من الاستدلالات المشكلة، هي إسقاطها لمعنى عقدي على التنظيم السياسي، ويدخل في ذلك نقد التعددية بمفهوم “الولاء والبراء”. وردّ المؤلف بأن ولاء المؤمنين لبعض لا يقطعه التقاتل فكيف يقطعه الخلاف؟ فلا يلزم أن ينتفي الانتماء للقبيلة أو الحزب بالانتماء للدولة، ولا مع الدولة بالانتماء لله ولرسوله والمؤمنين، بل يشمل الأخيرُ جميعَ ما سبق. وهناك صور من الانتماء للحزب مذمومة بلا خلاف، ولكن ذلك لا ينفي مشروعية النظام نفسه.
وبنفس المنطق رد المؤلف استدلالهم بنصوص ذم الاختلاف والتنازع والتفرق والتنابذ ونصوص الفرقة والجماعة الناجية، بأنها متعلقة بالفُرقة والتنازع العقدي وليست متعلقةً بالأحزاب السياسية المعاصرة. وأضاف أن استدلالهم رسّخ لقبول نموذج “صاحب الشوكة” أو “المتغلب”، وهو ما يعتبره المؤلف خطأ تاريخيا في فقه السياسة الشرعية، يشرعنُون به سلطة الذي يملك البطش لا الحق، وهذا التصور لا ينافي التعددية المنشودة فقط، بل يدعم النظم الاستبدادية القائمة اليوم.
2- الخلط بين السياق التاريخي والمعاصر:
جعل أصحاب المنهج الحرفي الانضمام لحزب ما بمثابة “بيعة” تنازعُ “بيعةَ” رأس السلطة السياسية، أي الأمير. وأنزلوا عليها أحاديث ظهور أمير بعد تولية أمير. وردّ “عودة” لها هنا هو من باب أن آلية الانتخابات المعاصرة ابتدءا ليست آلية الاستخلاف والبيعة، فهناك قفز على الواقع في ترتيب علاقة آلية التولية بالانضمام الحزبي.
3- تنزيل معنى صحيح على واقع غير مطابق:
يرفض المؤلف قياس خوض الحزب السياسي للإنتخابات على طلب الإمارة المنهي عنه شرعا في بعض الحالات. ويرى فيمن استدلوا بقصة سيدنا يوسف لفتح استثناء لمَن يطلبها لإقامة الدين في نظام علماني، خطوة جيدة في كسر الحرفية ولكنها غير كافية، مؤكدا أن الحكم في المسألة راجع لباب المصالح والمفاسد.
وقد لا تكون معالجة الكاتب لهذا الإشكال محكمة، وربما لم يأخذ بجدية إشكالية الحرص على السلطة في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة. فقد لا يعود هذا الأصل على فكرة التعددية الحزبية كلها بالنقد، ولكنه قد يضبطها أخلاقيا أو يستلزم تغييرا هيكليا في طريقة عملها، لا لحرفية في قراءة النص ولكن للمفاسد التي يشير لها نص الحديث، المرتبطة بالطبيعة الإنسانية بعيدا عن السياق التاريخي. ولعله لم يفصّل لأنه مهتم برد ما أشكل على أصل فكرة التعددية.
4- الخلط بين التعبدي التوقيفي والفعل الإجرائي المصلحي:
انتقد “عودة” وصف بعضهم للتعددية الحزبية بأنها “بدعة”، معتبرا هذا الطرح حرفيا وانتقائيا، إذ يغيب عنه ما استخدمه الرسول (صلى الله عليه وسلم) والصحابة من بعده من وسائل الأمم الأخرى، ولا يستوعب التقسيم التأصيلي بين نصوص الوسائل ونصوص المقاصد. كما يقوم هذا الوصف على إنكار كل جديد لمجرد أنه لا يروق لأحدهم، ويعكس خلطا منهجيا بين التجديد في المساحات التوقيفية، وبين ما يتعلق بدنيا الناس من الإجراءات المصلحية.
5- حصر معنى صحيح في صورة معاصرة:
انتقد الكاتب كذلك القول الذي ذهب إلى أن تكوين الأحزاب السياسية واجب شرعي نص عليه القرآن، فالقراءة الحرفية لآية: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)، أيضا غير مقبولة في وجهة نظره لأنه يرى أنها تكرس الجمود. فالأحزاب السياسية وإن كانت أداة للإصلاح في زماننا فهي ليست حكرا على مخيال المسلمين، فقد يبدعوا نظما أقرب لمقاصد الشريعة ويغيروا بما يناسب الواقع المتجدد دون أن يكون تجاوز النظام الحزبي تركا لفرض شرعي.
6- الحرفية في استدعاء التاريخ: وقف الكتاب عند إشكال شرعنة تركيز السلطة في يد شخص واحد “الأمير”، بدعوى موافقتها للتجربة التاريخية للمسلمين أو لكونها الوسيلة السياسية في السيرة النبوية الشريفة، مع أن التاريخ ليس حجة، على ما سبق بيانه.
7- التوسع في سد الذرائع:
لم يكن مناسبا تسكين هذه المناقشة تحت المنهج الحرفي لأنها لا تتعلق بمنهج قراءة النصوص، ولكنه على الأرجح ضمّنها لأنها منهج لذات الفئات التي تمارس الحرفية. وبعد أن ذكر المفاسد التي يذكرها المنكرون للتعددية الحزبية، حَكم بأنها تقع في بعض الحالات ولكنها ليست مسوّغا لمنع التعددية في كل صورها. فلا عبرة بسد الذريعة إذا لم تكن المفسدة غالبة أو قطعية. ولكن الكاتب لم يفصل في تقدير هذه المفاسد، ولا تكلفة الخيارات الأخرى، ولم يذكر أمثلة لصور الحزبية التي لا يشملها النقد، وهذا يُضعف حجته لأن تقدير المفاسد من صميم منهجه في الاختيار.
ثانيا: منهج التبرير المشرعن للواقع الاستبدادي
مصدر الإشكال عند هذه المجموعة هو جعلها الواقع مرجعا أصيلا وإن خالف مقاصد الشريعة، يطوعون النصوص له. فمنهم من رفض التعددية لواقع استبدادي يبرره، ومنهم من قبلها لنموذجٍ شرقيٍ أو غربيٍ يريد استدعائه. وفي الحالتين “يعتذر هذا المنهج لحقائق مسبقة لا يحاول أن يحسنها أو ينتقدها أو يغيرها”.
وما يرفضه فيما يدعى بـ “الاشتراكية الإسلامية” أو “الديمقراطية الإسلامية” أو “النسوية الإسلامية” وكل هذه التأويلات، هو تعسفها لتبرير مفاهيم كأنها حقائق مسبقة تقتضي تأويل النص، لا مجرد أدوات تُقيَّم في إطار كفاءتها في سياق تفعيلها وتجربتها. ومن المفاسد الكبيرة التي تقع إذا غاب هذا التمييز المنهجي، أنه قد وقعت تبريرات في التاريخ الإسلامي يظنها الناس اليوم جزءا من التشريع نفسه، بما يعوق عملية الإصلاح، وضرب مثالا بكتاب “الأحكام السلطانية” للماوردي. ويُلاحَظ هنا أن “عودة” متسق في تركيزه على المنهج لا مجرد الموقف، وفيما يلي تجليات ذلك:
1- التشبث بالسلطة وعدم تداولها: بدعوى أنه لا يوجد في النصوص إشارة لإمكانية كتابة دستور يقيد فترة الحكم، وهو عند “عودة” مردود لجواز إضافة شروط في البيعة، ولأن طريق التولية يقدر فيها الأنفع.
2- التبرير للعنف السياسي على اعتبار أن المعارضين خوارج: وهذا راجع للخلط السابق ذِكره في مفهوم البيعة، والعجيب أن خلافة الإمام علي (كرم الله وجه) استوعبت حتى الخوارج، بخلاف الأنظمة المعاصرة التي استحلت دماء وأعراض المعارضين السياسيين.
3- التبرير للنظام الحزبي بتعدد المذاهب والفرق: هناك أقوال تقيس الأحزاب السياسية على المذاهب الفقهية، لأنها -في نظرهم- أشبه ما تكون بحزب فكري، بل وكان لها كفاح وحركة في سبيل مواقفها التي يمكن تشبيهها بالبرنامج السياسي للأحزاب المعاصرة. هذه الأقوال اعتبر “عودة” أن لها وجاهة في تأكيد التنوع والتعددية كمبدأ، وليس بالضرورة كنظام سياسي. لكن مدخل اختلافه أن في هذا القياس تبريرا للواقع المعاصر، يوظف التاريخ بدلا من التفكير في مصالح هذه المنظومة في سياقها الحالي.
ويمكن القول إن اعتراض “عودة” هنا يتسق مع منهجه، لكنه قد يُفضي إلى إهدار دلالة المذاهب الفقهية، على الأرجح بسبب الإطار الذي يحصر قراءة التاريخ في زاوية الهوية. وقد ظهر هذا الميل سابقا في تعامله مع السيرة بوصفها “تاريخا” ضمن نقاش سابق.
صحيح أن تشبيه المذاهب الفقهية بالأحزاب السياسية يثير إشكالا من جهة المطابقة؛ فالمذهبية ليست تنظيما سياسيا بالمعنى الحديث. لكن يمكن الاستناد إلى المذاهب لتأكيد معنى آخر أكثر صلة، وهو أن الاختلاف في الاجتهاد الشرعي ممكن ومشروع، وأن الاعتراف بهذا الاختلاف يُعد شرطا لازما لأي تعددية سياسية منشودة. ومن هنا يتبدّى الإشكال المنهجي في إهدار الخبرات التاريخية بحصرها في باب الهوية، بدل النظر إلى أن الشريعة تتجسد في تجارب تاريخية يمكن الإفادة منها بهذا الاعتبار.
والمذاهب الفقهية ليست مجرد “قوالب تاريخية” منفصلة عن حقيقة الاجتهاد الشرعي، بل هي تعبير مؤسسي عنه. فلو كان الاجتهاد مذهبا واحدا لانكمش مجال الخلاف ليقتصر على الجوانب الفنية وتقدير الواقع، بينما يتيح التنوع القائم في مستوى التقدير الشرعي بنيةً تحتية لصور متعددة من التنوع، دون أن ينفي طرفٌ مشروعية ممارسة الطرف الآخر. وهذا الشرط ضروري للعمل الحزبي، وإن لم يكن كافيا للقول بمطابقة المذهبية للعمل الحزبي؛ إذ قد يتجلى هذا التنوع في أنظمة سياسية مختلفة، وهو ما يؤكد عليه المؤلف.
ثالثا: مراجعات الإسلام والسياسة بين النقد والتفكيك
يُمَوقِعُ مَطلَعُ هذا الفصل الكتابَ في خانة المراجعات النقدية الداخلية الإسلامية، التي تهدف إلى إعادة تقييم مدى واقعية بعض الأفكار السياسة من داخل الفكرة الإسلامية، بحيث يصبح البنيان خالٍ من التناقضات الداخلية ومتسقا مع غايته. ويعرض فيه مراجعات معاصرة متعلقة بالتعددية السياسية.
1- نقد رواية الحديث بناء على كليات القرآن: عرَض المؤلف لدراسات معاصرة تنتقد أحاديث يُستند لها في حد الردة وغيره من قضايا السياسة الشرعية، واستحسن هذا المنهج لأنه اعتبره تصويبا “لأحاديث تنفرد بمعان غريبة عن روح الإسلام ومقاصده”.
2- نقد الاستدلال بجماعات تاريخية تختلف عن الأحزاب السياسية: نقد القول بقياس الحزبية على ما حدث من خلاف بين المهاجرين والأنصار في السقيفة؛ إذ يرى أن مجرد ترشيح رأس للدولة ليست كافيا لاعتبارهم حزبا، وهي حرفية في تناول المرجعية التاريخية كما سبق أن بيَّن.
3- نقد الاستبداد الذي ساد في تاريخ الإسلام: تبنّى المؤلف الموقف الكلاسيكي لكثير من الجماعات الإسلامية بخصوص قراءتها لتاريخ المسلمين السياسي، حيث كانت المرحلة النبوية والراشدة ذهبية، ثم انحرفت البوصلة أكثر مع تعاقب الدول بما رسّخ الاستبداد ونموذج المتغلب، وكان التاريخ الإسلامي في مجمله خليطا بين العدل والاستبداد.
4- نقد التقليد للنظم والمفاهيم والممارسات الحزبية غير الإسلامية: قدم عرضا طويلا لما اعتبره تمحيصا للتعددية الحزبية من منظور إسلامي، ومن أساسياته التأكيد على المسؤولية الأخلاقية الفردية للنواب، وألا تدور مواقفهم تبعا للحزب الذي ينتمون إليه بل للحق، وألا يكون جامع الحزب أغراض شخصية، أو عصبيات عنصرية أو طبقية، وأن يكون التنوع في إطار الوحدة الإسلامية لا يقدح في خصوصيتها ومزاجها الإسلامي، وألا تكون منافسة لمحض شهوة السلطان، وألا ينافسوا بالدعاية الخاوية، وأن يكون لدى الأحزاب انفتاح بحيث لا ينقطع بينها الحوار، وغير ذلك من الضوابط.
والواضح هنا أن هذا التمحيص اشتمل على نقدٍ صحيحٍ للممارسة الحزبية إلا أنه ظل نقدا أخلاقيا، تعرض له حتى مفكرين غربين كما أشار المؤلف في مثال ماكس فيبر. ثم عاد في نهاية العنوان للتأكيد على أن هذه التحديات الأخلاقية لا تقدح في أصل التعددية الحزبية، لأنها أوفق لمقاصد الشريعة من نظام الحزب الواحد، ولكنه لم يتفاعل مع هذا التمحيص بالنقد والتفصيل.
ويمكن القول إن ما يفتقده هذا النقد وغيره بعمق هو طرح ما تستلزمه هذه الأخلاقيات من تغيير في نظام العمل الحزبي. فحتى لا تتبع قرارات النائب البرلماني أهواء حزبه عصبيةً، لابد من أن تحفز البيئة والهياكل التي يعمل فيها هذا السلوك، بدءا من كيفية التأهل للترشح، مرورا بالتحديات المالية للحملات الانتخابية، وليس انتهاء بتوزيع الصلاحيات داخل البرلمان. إنها عملية معقدة لم نذكر منها إلا مستوىً واحد، وهي المعايير التي قد ترسخ بدرجات متفاوتة تبعية العضو البرلماني لحزبه. ويمكن قياس التعقيد ذاته في جميع الإخفاقات الأخلاقية المرصودة، ولعل السبب في مثالية المعالجة هو تهميش العوامل المادية والهيكلية التي أشرنا لها في بداية هذا العرض.
وكذلك المقترحات والفرز الذي نقله “عودة” عن عدد من المفكرين الإسلاميين، كان منه أقوالٌ أخرجت الأحزاب عن تعريفها أصلا وجعلتها جمعيات أو جماعات ضغط، لكن لم يستوقفه ذلك. وربما يمكن القول إن الكتاب بالغ -من حيث لا يقصد- في إنكار دور العصبيات في الممارسة السياسية والطبيعة الإنسانية، ووقع في مثالية عندما تحدث عن مفهوم المصلحة العامة.
وما يبدو من إنكار للعصبية هنا، هو في الحقيقة به وجه شبه بالليبرالية في تصوراتها عن العقلانية والفردية، وهو مخالف حتى لواقع التجارب الرائدة. كما يُلاحظ وجود بعض العمومية التي تصادر على المطلوب في التعامل مع مفهوم المصلحة العامة على طول الكتاب. فمن الصعب القول بأن الحل يكمن في هذا المفهوم إذا ما توجهت له العزائم، وذلك لأن مدار المنازعة هو في المفهوم نفسه أصلا، سواء في تعريفه أو في توهم وجوده في كل القضايا، إذ من المتعذر تحقيق مصالح كل المواطنين في كل الوقت وكل القضايا، فلا محالة من قضايا تُلجئ إلى منطق الترجيح بين المصالح المتعارضة. وفهم مفهوم المصلحة العامة على صورة صحيحة مفيد في تصور عمق التنوع والتعددية وتحدياتها وأزمتها.
5- نقد اعتماد نظام التعددية الحزبية تحت الاحتلال الأجنبي: هنا ناقش “عودة” تأويلات موقف الإمام الشهيد حسن البنا من الحزبية ليرجح الرأي الذي يفهم موقفه في سياق ما يناسب مصر في مرحلة السعي للاستقلال، ويستفاد منه أهمية مراعاة سياق الاحتلال للأمم الناشئة في تقدير مصلحة التعددية الحزبية حتى لا يستغل المحتل الخلافات الحزبية لصالحه.
6- النقد الذاتي للجماعات والأحزاب الإسلامية: في إطار النقد الذاتي كتب عدد من مفكري الحركات الإسلامية نقدا لدعاوي القداسة التي تضفيها بعض الجماعات على نفسها، والجمود على ممارسات خاطئة موروثة، وممارسات غير شورية. ويؤكد المؤلف على دور النقد الداخلي في ترسيخ التشبع والاتساق في المبادئ التي يتبناها المصلحين.
رابعا: إشكالية الفتاوى السياسية
يدعو الكاتب إلى إدخال خطاب جديد في توجيه العلماء للمسلمين لما يعرض في أمور السياسة الجزئية التفصيلية، فبدلا من الإفتاء باستخدام ألفاظ “الوجوب” و”الحرمة”، يستخدمون بـ “المصلحة” و”المفسدة”، حتى لا تحمل الشريعة ما لا تحتمل في قضايا خلافية اجتهادية تتسع فيها الآراء، كقرار التوقيع على بيان أو المشاركة في مظاهرة، وما إلى ذلك. ولا يتعارض هذا مع الرجوع للأدلة الجزئية في الأسئلة المتعلقة بالربا والقتل والزكاة وغيرها.
ومن نماذج الفتاوى الإشكالية، وفق الكتاب:
1- فتاوى الانتخابات: فالفتاوى التي توجب انتخاب أحد المرشحين تهدم جوهر العملية الانتخابية وتعارض منطقها، وتتسبب في إشكاليات واقعية حقيقية، وكذلك الفتوى بوجوب المشاركة الانتخابية، والمشاركة تعني ثلاث صور:
حق الترشح: ويرى “عودة” أن الأحاديث الواردة في طلب الإمارة هي أخلاقيات سلوكية تهذب سلوك المترشح ولا تغير نظام الانتخابات نفسه.
حق الانتخاب: يرى إمكانية الفتوى بتجرد المصوت ومراعاة مصالح المجموع. ولكن يخضع نطاق من يحق له التصويت لنظام الدولة وتوافق الشعب. ولا يوافق من يستدل بالشورى على مبدأ الانتخاب، لأن وسائل الشورى أعم من هذه الصورة المعاصرة. فالشورى وسنة التنوع ثوابت، ولكن وسائل صناعة القرار الجمعي وواقع المجتمع متغيرات.
ويرى أن الخلاف المعاصر حول جواز التحالف مع الأحزاب غير الإسلامية غير مقبول منهجيا من الموقفين، لأن افتراض أن الحزب الذي يسمي نفسه “إسلاميا” أقرب للإسلام هو أمر يحتاج مراجعة. فإمكانية التحالف مع الأحزاب الأخرى متعلق بكون أهدافها وخططها تستهدف المصلحة العامة وبذلك تكون إسلامية المضمون، “ولا يصح قياسهم على مشركي مكة”، بحسب الكاتب.
2– فتاوى الثورة والعصيان المدني: لا بد من اجتهاد جديد يناسب العصر ويكون جزءا من ثقافة المسلمين السياسية، وينظم عملية عزل الحاكم بشكل سلمي إذا لم يقم بمهامه. وينبغي -بحسب الكتاب- ألا تقصر أسباب عزل الحاكم على مجرد ارتكابه بعض المعاصي الفردية الظاهرة كشرب الخمر.
3- الفتاوى المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة: بعد عرض الأقوال المختلفة، يرى “عودة” أن الإشكال في مقاربة هذه الأسئلة فقهيا أصلا، وبالتالي الإجابة عنها بالقوالب الفقهية. في المقابل، يربط سؤال المرأة بتعريف العدالة، فهو لا يراه أمرا تعبديا، فتتحول المعالجة عنده من الأدلة الجزئية من الكتاب والسنة لتقدير المصلحة من مشاركة نصف المجتمع في العملية السياسية. ويذكر أن الحديث النبوي وأقوال الصحابة يجب أن تفهم في “إطار الثقافة السياسية السائدة في عصرهم وليس في إطار الأحكام الشرعية المطلقة”. فالمصالح العليا في عصرنا ترتب من وجهة نظره تشجيع المرأة على المشاركة في المستويات كلها.
4- الشورى غير ملزمة للحاكم: يذهب المؤلف إلى أن الواقع المعاصر لا يتحمل أن يكون الموقف من الشورى جدالا حول فتوى على فرد الحاكم بالحل أو التحريم في شخصه، وإنما يجب أن تكون أساسا للنظام السياسي، على أن تميز اللوائح بعد ذلك بين مجالات الاستشارة والفئات المستشارة. وفي ذلك يقول “يلزم كل من له سلطة بالمشورة إلزاما وكجزء لا يتجزأ من النظام”. لكن ربما تظل هناك بعض الضبابية في ضبطه لمدلول الشورى وما يترتب على إلزاميتها، غير أن دافعه هو تحرير المناقشة من تعلقها بفرد، والاستدلال عليها بالألفاظ إلى اعتبار حفظ النظام العام وتحقيق المقاصد.
ولعل تطبيقات المؤلف في العنوان السابق توضح إشكالية في مقاربته، وهي أن إحالة الجدل من النصوص الجزئية للمعاني الكلية، قد لا تؤدي لتغيير المنشود. على سبيل المثال إذا أحلْت دور المرأة لمعنى العدالة، فستتنازع المواقف المتناقضة اندراج موقفها تحت مظلة العدالة. بل إن مقصد الزوجية والتوازن الذي يستدل به حتى يساوي الرجال والنساء في القضايا العامة يمكن أن يكون مدخلا للقول بضد استنتاجه، فالمخالفة في التكوين ثنائية قد يقول البعض إنها تستتبع تقسيم المهام بين المجال العام للرجل والخاص للنساء.
وليس المقصود هنا مخالفة استنتاجه ولكن بيان ما تتركه الكليات من ضبابية، والأهم هو عدم تعرضه لسؤال “كيف تتركب المعاني الكلية؟”، ليس من جهة استقراء الشريعة لإثبات أصل مفهوم العدل، ولكن بتتبع الجزئيات لبيان دلالة المفهوم التفصيلية وتجسده في الحالات. بالفعل، قد يكون اختزال السياسة في مدخل الفتوى أمرا مشكلا، ولكن لا يظهر أن عملية الرجوع للمقاصد حاسمة أو بسيطة على نحو يُيسّر تحقيق التوافق كما يستنبط الكتاب.
خامسا: التعددية الحزبية كخطوة ضرورية نحو المدنية المعاصرة
يهدف الكتاب هنا لتقسيم وعرض حجج التعددية السياسية التي أوردها الإصلاحيون المعاصرون:
1- حل لإشكالية تداول السلطة: إذ تقدم معالجة لإشكالية تاريخية مرتبطة بنموذج المتغلب، باعتبارها وسيلة لتحقيق التداول السلمي للسلطة.
2- التخلص من الاستبداد بكل أشكاله: يحجّم من قدرة استبداد شخص أو مجموعة بالحكم، ويوفر الأساس لمحاسبة السلطة.
3– تحقيق المصلحة العامة: ترفع الوعي العام بأهمية المؤسسات المدنية ودورها، وتساهم في توزيع السلطة، وتعزيز التنظيم الذاتي للمجتمع وقدرته على ضبط انحراف الدولة.
4- تحقيق الشورى والحريات: وسيلة معاصرة مناسبة لتفعيل مبدأ الشورى الإسلامي، وتوفير المجال لتشاور الأحرار، وسير المختلفين نحو غاية واحدة، وإن قصرها كثير من الإسلاميين على الأحزاب الإسلامية فقد خالفهم البعض، ورأى فتحها للجميع للمصلحة، ولتجنب خطر نشوء تنظيمات سرية، ولأن العبرة ببرامجها وسعيها لتحقيق حياة أفضل للمجتمع المسلم.
5- من أجل التربية الإسلامية: الأحزاب مؤسسات للتنشئة السياسية الربانية ورفع الوعي الشعبي العام للقيام بالمهمة الرسالية، وتنظيم الأمر بالمعروف للحاكم.
لكن ربما من جوانب الضعف في محتوى النقاط السابقة، أن مجموع النصوص التي ذكرها تصدّر صورة مثالية حالمة عن التعددية الحزبية، ومن المتفهم أن يناقش في هذا العنوان الجوانب الإيجابية، وأن يغلّب الجانب المشرق من العمل الحزبي، ولكن ذكر المميزات وعدم الواقعية أمران مختلفان.
كذلك، قد تكون من جوانب الضعف في الكتابة والتنسيق، الإكثار من الاقتباسات وما يتكرر بينها من المعاني، وفي ذلك إطالة قد لا تضيف كثيرا. بالإضافة إلى تشتت المواضيع داخل الاقتباس الواحد بما يخرج عن مدلول العنوان، فقد يكون تحت عنوان “التربية” ويتوسع في ذكر الصور السابقة لمحاسن التعددية الحزبية.
6- التعبير عن الأقليات غير الإسلامية ضمن حقوق المواطنة: عرض الكتاب لجدل طويل حول موقع الأحزاب غير الإسلامية في الدولة الإسلامية، ثم عالجه من زاوية استراتيجية، فقال بأن مدار الجدل هو شكل “التعددية في الدولة الإسلامية”، ولكنه يضع تصورا لدولة وطنية معاصرة مدنية دستورية، إسلامية بالأغلبية السكانية والمرجعية المقاصدية، وهذا النموذج لا يتناقض مع أن يكون لغير المسلمين تنظيماتهم وأحزابهم. فالنموذج التي يتحدث عن “عودة” بالأساس، كما أوضحنا في المقدمة، ليس النموذج المعياري المثالي، بل نموذجا مرحليا يراه مناسبا للواقع الراهن.
7- كوسيلة لإقامة الدولة الإٍسلامية: تدور الاقتباسات المستشهَد بها حول معنى “التنظيم” والعمل الجماعي في مجال السياسة، وأهميته في مواجهة الاستعمار ثم الاستبداد ثم في نشر الدين وترسيخ حضوره في المجال السياسي، والأحزاب كوحدة تنظيم سياسية وسيلةٌ فعالة في هذا المسار.
وبعد أن عرض للجدل حول معنى “الدولة الإسلامية”، انتهى إلى أن كثير من الصور التي تصبغها فئات مختلفة داخل التيار الإسلامي كاعتماد الإسلام كمرجعية في الدستور أو التقوى الفردية لرأس السلطة لا تلزم بالضرورة، فليست كل دولة ينص دستورها على أنها إسلامية ينطبق عليها هذا الوصف. وإنما يلزمها كدولة معاصرة -بحسب الكاتب- أن تكون مقاصدية، وهو ما يساهم نموذج الدولة المدنية التعددية في تحقيقه.
8- التعددية السياسية في التراث والواقع الغربي: يستخلص من التراث الغربي عددا من فوائد التعددية الحزبية منها أن التعددية الثقافية والاجتماعية هي قاعدة التعددية السياسية، وأنها توفر التنافسية للأطراف المختلفة دون أن يهيمن أحد الأطراف، وتوفر موارد للمرشحين الفقراء في مواجهة الأغنياء، وتعكس الاتجاهات العامة لآراء المواطنين وغيرها من المنافع.
سادسا: نحو التعددية شاملة: تمكين الأحزاب المدنية
يأخذ هذا العنوان خطوة إلى الوراء، ليضع نقاش التعددية -كما عالجه المؤلف عبر فصول الكتاب- في إطار أوسع من مجرد الحزبية. ويفعل ذلك من خلال الإشارة إلى جهود عدد من المفكرين الإسلاميين والغربيين في إعادة تعريف مفهوم “السياسي”، بما يخرجه من ضيق الدولة، وما يرتبط بها من أحزاب وتداول سلطة وحكومة وإجراءات، إلى سعة الأمة والمجتمع. وفي هذا التصور، ينتقل ثقل الفعل السياسي إلى القوة الشعبية المدنية، بما يحد من احتكار السلطة ويعيد توزيع أدوارها.
هذا التغيير يعني عند المستشار طارق البشري التأكيد على الاستمرارية التاريخية للتعددية، أي أن تُمارس التعددية من خلال المكونات السياسية والاجتماعية التقليدية للمجتمع، مثل الطوائف والهيئات والتنظيمات القائمة، بما يسمح بتطورها بشكل طبيعي ومتدرج. وفي هذا السياق، يستشهد المؤلف بنقد الدكتورة هبة رؤوف عزت، التي رأت أن الجدل الإسلامي حول الأحزاب، بمساريه المؤيد والمعارض، ظل حبيس فكرة “الحزبية” ذاتها، دون الالتفات إلى وحدات وصور تنظيمية أخرى يمكنها استيعاب التنوع المجتمعي خارج إطار الأحزاب.
ويشير الكتاب إلى أن توسيع التعريف ليشمل المؤسسات الاجتماعية الأوسع، كالنقابات والهيئات المهنية وغيرها، من شأنه أن يفتح المجال أمام شورى أوسع، ويعزز دور المجتمع الرقابي والفاعل في الشأن العام. وضمن هذا التوجه، يرجح المؤلف نموذج “الدولة الصغيرة”، حيث تقتصر مهام الدولة على مجالات محددة، مثل الدفاع والأمن والنظام العام، بينما تتنافس الأحزاب على إدارتها. ويأتي ذلك في إطار تصور أشمل للتعددية، يقلل من مركزية الدولة، ويضع قدرا أكبر من المسؤولية على عاتق الأمة. فيصبح “السياسي”: كل نشاط يحقق المصلحة العامة عن طريق تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.
ويمكن قراءة الحديث عن إعادة تعريف “السياسي” في سياق الكتابة خلال مرحلة ما بعد الانقلاب، وما رافقها من انغلاق لمسارات الممارسة السياسية التقليدية. ففي هذا الإطار، لا تبدو إعادة التعريف ليست فقط صحيحة معرفيا، بل تمثل أيضا محاولة لفتح أفق أوسع للعمل السياسي في منطقة/دولة بات مسار العمل الحزبي فيها مغلقا. كما يمكن فهم هذا الطرح في سياق المراجعات الفكرية التي برزت بعد الانقلاب، حيث حظيت أصوات إسلامية متعددة بانتشار لافت، وأكدت وجود أزمة ناتجة عن التركيز المفرط، في مرحلة ما بعد الثورة، على ممارسة السياسة بمعانيها الإجرائية الضيقة.
المراجعة الختامية
يقدم الكتاب في مجمله إضافة نوعية، ليس بسبب المواقف التي يدافع عنها، ولكن في طريقة تناوله لها، وهو من مزايا الكتاب التي قصدها مؤلفه، فتصريحه بأولوية المنهج، ومراجعة أنماط التفكير لتغيير الإنسان واضح منذ المقدمة. ومن حسناته انفتاح الكاتب على الاستفادة من التجارب الغربية، وتوظيف مناهج بحثية كالتحليل المنظومي، دون أن يقع أسير سرديات الطهورية الحضارية، مع محاولته في الوقت نفسه تأصيل الأفكار تاريخيا وربطها بالتراث الإسلامي.
ومن جوانب التميز، الخصوصية التي يعامل بها المجال السياسي، فبالرغم من أن السياسة الشرعية باب من أبواب الفقه إلا أنها تحتاج خصوصية منهجية تستوعب تعقيد ودينامية هذا المجال، فحتى وإن كانت هناك ملاحظات على أن المقاصد -كما قدمها “عودة”- تعالج هذا التحدي، إلا أن إثارة هذا الوعي، ودعوة الجميع للاجتهاد أمر مفيد.
ويدعو الكتاب لإعادة التفكير في مفهوم “السياسي” على نحو يؤسس لتعددية شاملة، ولكن يمكننا قراءة معنىً آخر هام يمارسه الكتاب دون أن يصرح به، وهو التفكير في “السياسي” كسؤال استراتيجي، كفاعل يقدر السياق ويحدد أهدافه ويتموقع بما يعينه على الوصول لهدفه، وهذا بخلاف المبالغة في المقاربات الفقهية (اختزال المجال السياسي في الفتوى الفقهية) والمقاربات القانونية وغيرها. وهو معنى ضمني في الكتاب ولكنه شديد الأهمية في سياق مقصود المؤلف من تطوير الحراك الإسلامي، لأنه نمط يهيمن على بعض فئات التيار الإسلامي بمعناه الواسع. ونرصد ذلك في مستويات ومواضع مختلفة من الكتاب:
أولا: الإطار العام للكتاب: فكرة تأسيس نموذج مرحلي، تتجاوز الخطابات المعيارية والحمولة المثالية في مناقشة الدولة الإسلامية كحالة نهائية، وتتضمن الانطلاق من الواقع لنقطة إصلاحية ممكنة. فزمانية المفاهيم والنماذج لا تتعلق فقط بإدراك السياقات التاريخية ولكن يمكن أيضا أن تتعلق بالنموذج المستقبلي، وما يتحمله واقعنا من تغيير في إطار معرفتنا بقوة الروافع التي نمتلكها.
واستدعاء المقاصدية والمدنية كذلك لم يقم في الغالب على شرعنة معيارية، فالمقاصد كقوالب قيمية مجردة عامة والمدنية كمفهوم مطاط، ارتبط دورهما التأسيسي بهدف استراتيجي، وهو تحقيق النموذج للتوافق في هذه المرحلة التاريخية دون أن يخل كذلك بمظلة أخلاقية تبقيه إسلاميا.
ثانيا: ظهر البعد الاستراتيجي أيضا في نقد مناهج التفكير في سؤال التعددية والحزبية وفي عنوان “إشكالية الفتاوي السياسية“. فبدلا من المشاركة في الجدل حول دلالة الألفاظ، انطلق من أن الأصل في دعم المبادرات والجماعات التي تخدم الإسلام وأهدافه هو الإباحة، وأن الحكم عليها يكون من باب تقدير مآلاتها الواقعية، التي تقدَّر بالاستعانة بالعلوم الاجتماعية، وبناء على المرجعية الأخلاقية والمقاصدية لا بناء على آليات الفتوى بالحل والحرمة، فالأمر كله في تقديريه يدور في دائرة المباح مبدئيا.
وهو بذلك يحرر الخيال السياسي من حرفية القراءة ومن هيمنة النماذج القائمة، فوجود النظام الحزبي اليوم لا يعني أنه التمثيل الأفضل للتعددية للأبد، وارتباط الشورى بشكل الانتخابات المعاصرة لا يعني حصرها في تلك الصورة. إن رفض الإجابات الجاهزة المطردة في الزمان دعوة ضمنية لفتح أبواب الإبداع السياسي.
ثالثا: في مواضع متفرقة من الكتاب تعامل الكاتب بما يمكن وصفه بـ “العملية”: كتقديره لإمكانية توظيف المرجعية التاريخية والفقهية في الخطاب الشعبي لتبرير خيارات معاصرة، ليس من باب انضباط الاستدلال ولكن من جهة المنفعة السياسية. وفي نفس الوقت نبه للأثر السلبي لهذه الممارسة في قضايا كان شاهدا عليها، عندما ذكر أن المنهج الحرفي التبسيطي في قراءة بعض نصوص وتنزيل الآيات فيما لا يرتبط بسياقها بالكلية، بغرض تحريك الجماهير الإسلامية أدى لضعف ومثالية في نظر هذا الجمهور، بما شكل ضغطا على صانع القرار داخل التيار الإسلامي نفسه لتحقيق أهداف غير واقعية سياسيا.
ويمكننا أيضا أن نقارن فكرة المرحلة الانتقالية بفكرة الدولة الاشتراكية التي تمهد الطريق للمجتمع الشيوعي، والدوافع بينها قدر من التشابه، عندما تدرك الحركة أن الفجوة بين واقعها ومثلها أكبر من أن تقفز في قفزة واحدة، والأهم من ذلك، أن قوتها أقل بكثير من أن تقوم بهذه القفزة، فإنها تنظر لمرحلة انتقالية تتملك فيها زمام القوة، أي الدولة، لتكون وسيلة لتمهد الطريق أمام المرحلة التالية. ولكن هناك فروق جوهرية أيضا، فـ “عودة” لا ينتظر من المرحلة التي تليها أن تحوي مجتمعا مثاليا، كما لا ينتظر من المرحلة الانتقالية أن تكون استبدادية عمالية أو استبدادية إسلامية مثلا، ولكن على العكس تماما، أن تكون تعددية. ولا يظهر من الكتاب ملامح واضحة للمرحلة التالية أو النهائية إلا أنها شكل من الوحدة الإسلامية.
وعلاوة على ذلك، يُحسب للكتاب عدم اختزال مفهوم “السياسي” في “الفقهي” اختزالا كاملا، وهو توجه يفتح المجال أمام فهم أوسع للممارسة السياسية. ومع ذلك، يلاحظ أن الفصل بين المجالين عنده لا يقوم دائما على معيار محدد بوضوح، إذ لا تتبين على نحو كاف الحدود التي تفصل بين ما يدخل في دائرة الفتوى وما يخرج عنها. ففي بعض المواضع، يشير المؤلف إلى عدم الإشكال في الإفتاء بالضوابط الأخلاقية لاختيار المرشح السياسي، مقابل التحفظ على الإفتاء بترجيح مرشح بعينه، وهو تمييز يبدو واضحا في هذا المثال تحديدا. غير أن غياب معيار جامع قد يفضي إلى قدر من الالتباس عند تطبيق هذا التفريق على مسائل أخرى.
ومن الأساليب المطردة في الكتاب ما يمكن أن نسميه التأكيد على مركزية السياق، وهذا أمر حسن جرى توظيفه في مسائل عديدة بشكل متميز، ولكن أيضا المبالغة في هذا الخط ستؤدي للتاريخانية التي حذر منها الكاتب نفسه، وظهرت إشكالات ذلك في مواضع أشرنا لها في المراجعة.
وربما تكون الإشكالية المنهجية الأبرز هنا، والتي نكتفي بالإشارة لها دون تفصيل، هي أن الكاتب أشار لمسألة السيولة التي قد تلحق المعاني الكلية للمقاصد ودور النص في ضبط هذه المعاني. ولكن في التطبيق، عندما عالج القضايا بدا أحيانا أنه ينتقل مباشرة من الإشكال إلى لمقاصد دون وسيط، بما سيؤدي عند الاطراد في تطبيق هذه الممارسة، إلى السيولة التي لا يريد هو نفسه السقوط فيها.
ومن جذور هذا الإشكال منهجيا هو غياب باب العلة والأصول الخاصة لأبواب الفقه في إطاره، فالخروج من الحرفية لا يعني القفز للمعاني الكلية دفعة واحدة، ولكن يكون بالنظر في علة المسألة، والتي تتحصل من مجموع نصوص الواقعة محل البحث. ثم بالنظر إلى الأصول الخاصة لباب الفقه الذي يشمل موضوع البحث، وتلك الأصول هي المعاني الكلية التي يدور عليها الباب وتستفاد من مجموع علله (مقاصد الباب). وأخيرا تتحقق الأصول الخاصة في أحد مقاصد الشريعة.
فالخلاصة إذن أن الخروج من “حَرفية فهم النصوص” تحتاج تدرجا ومستويات وسيطة بين المقصد والحرف، وقد أشار الكاتب لما يشبه هذه المنهجية في مناقشته لـ “القياس الواسع” ولكنه قد يكون غائبا في التطبيق. إن عملية التدرج تقطع سبل السيولة، وكذلك تقوض مستهدف التوافق المجتمعي الذي يسعى إليه الكاتب بنموذجه.
وفي النهاية يتركنا الكتاب مع ملامح نموذجه، مُحمِلا إيانا مسؤولية التفكير في سؤال استراتيجي شديد الأهمية، وهو باعتبار واقعنا العربي اليوم، ومع صعود الأنظمة الاستبدادية وتراجع الديمقراطيات في العالم: كيف السبيل لتحقيق هذه الدولة المدنية التعددية ذات المرجعية المقاصدية؟
[1] تجدر الإشارة إلى أن الجداول الواردة في هذا العرض كتبها المحرر بناء على فهمه للتقسيمات الواردة في الكتاب.