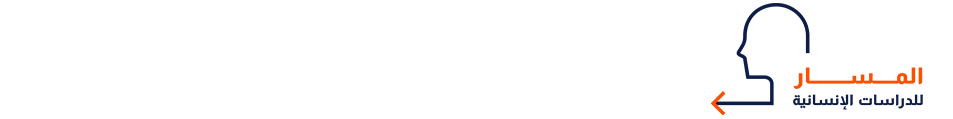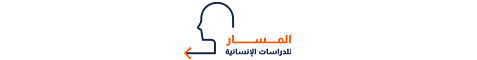مسار التغيير في مصر بعد 10 سنوات من ثورة يناير 2011
عمار فايد[1]
ملخص |
تنطلق هذه الورقة من سؤال بالغ التعقيد: إلى أين تمضي مصر بعد 10 سنوات من ثورة يناير 2011؟ ولأنه من المبالغة توقع إجابة قاطعة، فإن الورقة تسعى للإجابة عن الأسئلة التي أعتبرها ضرورية حول الحاضر وكيفية فهم ما يحدث في مصر بالفعل الآن؛ ليس من أجل التوصل لإجابة صارمة حول المستقبل، ولكن من أجل فهم مسارات العمل التي يمكن أن تساهم في تشكّل هذا المستقبل أو على الأقل الاستعداد له. تدعو هذه الورقة بوضوح لنفي العشوائية عن سياسات النظام المصري الحالي، وتجادل بأنه ينتهج سياسات مقصودة تخدم مصلحة محددة متفق عليها، ومجمع عليها داخل الدولة، وهي جعل عملية التغيير غير ممكنة. كما تستنتج الورقة أن المصاعب الاقتصادية التي تواجه المصريين حاليا ليست مقصودة في ذاتها لإرهاقهم كما تفترض تفسيرات المؤامرة، ولكنها نتيجة “ثانوية” لخيارات النظام السياسية والاقتصادية والأولويات التي لا يمكنه تأجيلها. لذلك، يكتفي النظام بالتعامل مع هذه التداعيات الاقتصادية بسياسة الاحتواء وكسب الوقت، وضمان تجنب أن ينتج عنها موجات غضب شعبية مستندا لسطوة أمنية هائلة. التحليل الذي تعرضه الورقة يدعم الاتجاه الذي يرجح أن الوضع الحالي – رغم أسسه الهشة – مازال قابلا للاستمرار طالما تمتع بدعم الجيش وأجهزة الدولة الأمنية، وطالما ظلت الدولة بصورة عامة موحدة تجاه رفض التغيير؛ خاصة أنه لا يوجد نخبة معارضة فاعلة تمثل بديلا أو منافسا، يمكنها الاستفادة من أخطاء النظام، التي مهما كانت فداحتها قد لا تكفي لانهيارهذا الحكم الاستبدادي. وبينما يظل الهدف الرئيسي للنظام هو حماية الدولة القائمة وإبقائها في موقع غير قابل للتحدي من قبل المجتمع، تجادل الورقة بأنه من غير العملي الفصل بين النظام السياسي من ناحية والدولة من ناحية أخرى، في الحالة العربية عموما وفي حالة مصر بصورة خاصة. ومن ثَمَّ، سيكون على المشغولين بعملية التغيير إما اللجوء لمساومات ومفاوضات مع الدولة لتحقيق تغيير تدريجي مقبول، أو توقع مقاومة ضارية من الدولة التي لا يمكنها التعامل مع مساعي تغيير النظام السياسي بمعزل عن مخاوف تقويض الدولة نفسها.
العقد الطويل: من احتواء الثورة إلى استعادة الدولة
بعد مرور عشر سنوات من ثورة يناير 2011، ونحو ثماني سنوات من الانقلاب العسكري، يرسل النظام الحاكم في مصر إشارات متضاربة، تعكس بعضها ثقة بالغة تجاه السيطرة الشاملة على الأوضاع الداخلية، في حين لا يمكن فهم الإشارات الأخرى سوى أن استقراره الحالي بالغ الهشاشة ويفتقد لمقومات الاستمرار. في الواقع يختلف تقييم الحالة المصرية ليس فقط وفق زاوية النظر من حيث الانتماء للنظام أو المعارضة أو التواجد خارج المشهدين؛ ولكن أيضا، وفق الأهداف التي يتصور كل طرف أن على السلطة تحقيقها. لذلك من الضروري فهم أهداف وأولويات النظام الحقيقية، وليس التوقعات التي ينتظرها منه المعارضون أو عموم الرأي العام.
أحيانا يتطلب تحقيق أهداف النظام وحماية مصالحه ممارسات وسياسات تقدر باقي الأطراف أنها مؤشرات ضعف أو ارتباك، على حين أنها تعكس مضي خططه قدما. على سبيل المثال، من السهل الحديث بشكل مفصَّل عن مؤشرات مثل معدلات الفقر وتآكل الطبقة الوسطى وتصاعد الضغوط الاقتصادية. لكنّ اعتماد مثل هذه المؤشرات لقياس “نجاح” أو “إخفاق” أجندة النظام يتطلب بالأساس التأكد من أن التصدي للفقر أو حماية الطبقة الوسطى ضمن أولويات النظام الاقتصادية والاجتماعية. بينما لو تم التوصل إلى أن أولوية النظام الاقتصادية هي السيطرة على أنشطة الاقتصاد وتخفيف أعباء الدولة الاجتماعية تجاه مواطنيها، قد نكتشف أن النظام يحقق النجاح الاقتصادي الذي يسعى إليه. في هذه الحالة، ستكون حالة الفقر مجرد “آثار جانبية” يكفي التعامل معها بسياسة رد الفعل والاحتواء المؤقت، كلما ارتفعت نسبة تهديدها للاستقرار السياسي.
مثال آخر، حيث يتم التأكيد دائما على غياب المعارضة السياسية في الداخل، وحالة العزوف العامة عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية كمؤشر على افتقاد النظام للشرعية وفشله في بناء قاعدة اجتماعية موالية له. الحقيقة أن الاستنتاج قد يكون صحيحا، لكنه أيضا يُقيّم الموقف من وجهة نظر المشاهد واستنادا إلى الأهداف التي وضعها بشكل مسبق لطبيعة الممارسة السياسية. لكنّ النظام لا يبحث عن معارضة، ولا يكترث لمشاركة في العملية السياسية سواء من قبل قوى سياسية أو من قبل الجمهور؛ بل هو يعتبر صراحة أن هذا الجمهور غير واع وغير مؤهل للبت في شؤون البلاد التي تواجه تحديات مصيرية، كما أن القوى السياسية لا تعرف مصالح البلاد، وكادت أن تتسبب في انهيار الدولة. ومن ثم فاقتصار الممارسة السياسية على النظام، وعلى من يقوم هو بتأهيلهم واعتمادهم، هو عين الهدف المطلوب والنجاح المنشود. غياب المنافسة السياسية هو، من وجهة نظر النظام، ليس إلا إبعاد غير المؤهلين عن السياسية حتى لا يقوموا بإفسادها، سواء كان غير المؤهلين هؤلاء هم القوى السياسية نفسها ، كونها تبحث عن مصالح خاصة كما يزعم النظام، أو ناشطون “كل ما يتحركوا يتلخبطوا ويهدوا البلد” بحسب تعبير “السيسي”[1]، أو جمهور يتم التلاعب به باسم الدين أو بهتافات الثورة أو باستغلال ظروفه الاقتصادية.
الخلاصة، أنه لتقدير مدى تقدم أجندة النظام، أو تعثرها، يجب ابتداءً معرفة هذه الأجندة. وللحكم على مدى نجاحه أو فشله، لابد أن يتم تعريف النجاح وفق أهدافه هو وليس وفق الأهداف التي تفترض المعارضة أو المراقب الخارجي أنها يجب أن تكون أولويات الحكم، مثل العدالة الاجتماعية، والانفتاح السياسي. من المبالغة حقا اعتبار النظام فاشلا لأنه لم يحقق أهداف المعارضة وأولوياتها. لا يعني هذا عدم النقاش حول جدوى تحقيق النظام لأهدافه، ومدى ما توفره هذه الأهداف له في حال تحققها من إمكانية الاستمرار في الحكم وبناء نظام مستقر لسنوات طويلة قادمة كما يطمح. لكن هناك فرق بين تقدير “نجاح” أو “فشل” النظام، وبين التقييم الأخلاقي والسياسي لجدوى هذا النجاح، من باب الصواب والخطأ، ومن زاوية تحقيقها مصلحة المجتمع بصورة عامة.
ما الذي يسعى إليه النظام حقا؟
إذا أمكن تلخيص ما يسعى إليه نظام السيسي في عبارة واحدة، فهي: “استعادة الدولة”. لقد مثّل صعود الإخوان لرئاسة البلاد إحساسا لدى المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن ونخبة البيروقراطية بأن الدولة تم اختطافها؛ ليس فقط لأن الإخوان هم عدو الدولة التاريخي، ومنافسها الإيديولوجي، ولكن لأن هذا تزامن مع تهديد بــ “استباحة الدولة” بصورة عامة: وزراء الحكومة والمحافظون، تعينات القضاء والنيابة العامة، الدراسة في الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، تركيبة مجلس الشعب والشورى والجمعية الدستورية.. إلخ. مثّل هذا تهديدا لنخبة الدولة التي تتوارثها منذ عقود، والذين نظروا لهؤلاء الوافدين على الدولة من خارجها كغرباء وطارئين، ليس من حيث تأهيلهم أو قدراتهم الشخصية كأفراد، ولكن في الأساس من حيث كونهم ببساطة مواطنين عاديين لا ينتمون اجتماعيا ولا أيديولوجيا لشبكة النخبة ودوائرها.
وسبق أن وصف لي أحد الأكاديميين المصريين حالة الحسرة والامتعاض التي تحدث بها أمامه مجموعة من أعضاء بأحد النوادي الاجتماعية التابعة للجيش، في يوم انتخاب الدكتور “محمد سعد الكتاتني” لرئاسة مجلس الشعب. لم يكن “الكتاتني” من طبقة اجتماعية دنيا، اقتصاديا أو علميا، كما لم يكن طارئا على الممارسة البرلمانية والسياسية. لكنه لا ينتمي لدوائر العلاقات التي من المفترض أن يأتي منها من يتسلم مثل هذا المنصب الرفيع. في مناسبة أخرى ليست بعيدة زمنيا، عبّر قائد كبير بالمجلس العسكري عن نفس الحالة قائلا لأحد المسؤولين البارزين في عهد الرئيس الراحل “محمد مرسي”، عقب الانقلاب العسكري خلال محاولة لإقناعه بالعمل مع النظام الجديد: “هذه دولة محمد علي، فيها باشوات وفلاحين”. هنا، الانتقال من جمهور “الفلاحين” إلى طبقة “الباشوات” لا يتم بمستوى اقتصادي معين أو تأهيل أكاديمي أو خبرة تخصصية. بل ولا حتى تم من خلال العمل في جهاز الدولة في منصب رفيع خلال عهد الرئيس “مرسي”؛ لكن شرط الانتقال هو العمل مع نخبة الدولة التاريخية بناء على دعوتها هي.
لم يكن من الممكن التعامل مع “الفلاحين” كأصحاب حق في هذه الدولة. وهي حالة تعكس نظرة الدولة لنفسها ولمن هم خارجها من “عامة الناس” الذين لا يمكن ائتمانهم على الدولة وعلى مصالحها؛ ليس فقط لأنهم من خارج دوائر علاقات نخبة الأجهزة التي تحتكر السلطة منذ عقود، ولكن أيضا، وربما نتيجة لهذا، لأنهم لا يعرفون مصالح البلد ولا يمكنهم حمايتها. “الفلاحون” غير مؤهلين لحكم البلاد حتى لو حازوا درجات علمية وخبرات متنوعة. طالما أنهم خارج الدولة، فهم بحاجة لنوع من التأهيل لا يمكن أن يتوفر إلا في أجهزة الدولة ذاتها.
ولذلك، فإن تأمل إجراءات النظام وسياساته الاقتصادية والأمنية، يجعل من الراجح أن تحديد النظام للمشكلة التي عليه التصدي لها لا تتمثل فقط في ثورة يناير 2011 واحتمالات تكرار موجاتها فحسب، ولكن أيضا تتمثل في نظام حكم “حسني مبارك” الذي “أضعف الدولة”، وأفقدها السيطرة اللازمة/الطبيعية على السياسة والاقتصاد، ومن ثم جعل الثورة ممكنة، وهيأ المناخ لتحدي الدولة من قبل المجتمع. لذلك، لا تستهدف إجراءات “استعادة الدولة” العودة لنظام “مبارك”، بل تقويض ما بقي منه، وبناء نظام جديد، على صعيد نخبة الحكم، شبكة العلاقات الداخلية والخارجية، توزيع الأدوار والنفوذ، والسيطرة على الموارد. هذا النظام الجديد لا يجب أن يكون قادرا على قمع جهود التغيير إذا تجددت فحسب، بل يجب أن يُنشئ آليات استباقية تحد من إمكانية التمرد على الدولة واستباحتها مجددا.
من بين أهم ما يمكن الإشارة إليه كمثال لهذه الخطوات والآليات، ما يلي:
أولا: إعادة صياغة المزاج الشعبي
من أجل مقاومة الخطاب العام الذي كان يضع الأولوية لتعزيز الديمقراطية وضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، كان على النظام تطوير خطاب آخر وفرض أولويات أخرى. لذلك، كان من الضروري هزيمة، ليس فقط الدعم السياسي والاجتماعي لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن أيضًا إيمان الرأي العام في مجمله بأولوية الثورة والديمقراطية والتغيير. لذا، ومن خلال هيمنة شاملة على الخطاب الإعلامي المقروء والمرئي والمسموع، عملت الدولة على تصدير متطلب آخر أكثر إلحاحا: الأمن؛ ليس في جوانبه الشاملة التي تشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي على سبيل المثال ، ولكن الأمن في مفهوم بدائي تماما: الأمن الشخصي بمفهوم “هوبز”، أي الحماية من الأذى المادي ومن الاعتداء على الممتلكات، بدلاً من الحماية من انتهاك الخصوصية أو العمل على تحقيق ظروف حياة أفضل. الأمن متمثلا في أن يخرج الشخص من بيته ويعود إليه دون أن يعتدي عليه أحد في الطريق، أو أن يسطو على بيته أثناء غيابه. من هذه الزاوية يتم استدعاء سلطة الدولة، والإيمان بضرورتها كمزود للأمن، قبل أن تكون مسؤولة عن التنمية. كما تتحول الديمقراطية نفسها إلى نوع من الرفاه الذي يمكن تأجيله أو حتى التضحية به[2].
الحقيقة أن هذه ليست حالة مصرية فريدة. فالأنظمة الاستبدادية عموما لا تمارس الهيمنة على المجتمع من خلال العنف وممارسة القهر وفرض الطاعة من أعلى فقط، ولكنّها أيضا تطور أشكالا مخادعة للسيطرة والإقناع، وبتعبير “بياتريس هيبو Béatrice Hibou”: “لا تُفرض السلطة من الأعلى، ولكنها تتحايل على الرغبات، وعلى تلك العناصر الإيجابية التي تحرك الأفراد”. ومن ثم، تصبح الدولة وسلطتها مطلوبة، وتخلق ما يسميه فوكو “رغبة الدولة”، حيث يكون مطلب تدخل الدولة وحضور سلطتها “يتعلق بالأمن والاستقرار بقدر ما يتعلق بالحماية وبالبناء الوطني أو العدل والمساواة”[3].
في هذه المعادلة الجديدة، يتم تقييم أداء السلطة بشكل أساسي وفق قدرتها على إرساء النظام وفرض الاستقرار، وليس بناء على نجاح اقتصادي، أو تحسن ظروف معيشة المواطنين. حتى جوانب الأمن التي ترتبط بالاقتصاد، مثل قدرة الشخص على استكمال تجارته، أو التوجه إلى مصنعه، أو الذهاب إلى مؤسسات عامة أو خاصة لإجراء معاملات معينة، كل هذا أصبح مرتبطا “بضرورة” أن تقوم الدولة بفرض الأمن والاستقرار، وهو ما كان يتم ترجمته بشكل حصري في التصدي للاحتجاجات السياسية والعمالية، وحتى العصف بمجموعات الأولتراس، كونها تعطل الاقتصاد وتؤثر على مصالح الآخرين، أو تهدد بجر البلاد مجددا إلى حالة عدم الاستقرار.
قد تفسر”معادلة الحماية” هذه مؤشرا يستحق التأمل. فبينما تتدهور الأوضاع الاقتصادية، تظهر استطلاعات للرأي ثقة لافتة في قدرة الحكومة على توفير الحماية للمواطنين. كما تظهر دائما نسبة ثقة مرتفعة في مؤسسة الجيش، رغم أن مسؤولية الجيش عن إدارة البلاد كان من المتوقع أن تجعله عرضة بنسبة متزايدة للمحاكمة الشعبية على نجاح وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. لكن يبدو أن الوظيفة الأولى التي مازالت تهمين على خيال الرأي العام هي مدي قدرة الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن، على فرض النظام وتحقيق الأمن الذي بات الخيار بينه وبين الفوضى أو حالة الانهيار التي روجت لها بشكل مدروس وسائل الإعلام. وبتعبير هيبو: “المطالبة الدائمة بهذه الدولة تُترجم في المقام الأول بالثقة بأنها تضمن توفير الانتظام والهدوء” [4].
وبحسب استطلاعات مشروع “الباروميتر العربي”، منذ 2016، يعتبر نحو 80٪ من المواطنين أن الحكومة ” تضمن أو تضمن بالكامل” توفير الأمن، مقارنة بـ 19% عام 2013، الذي شهد ذروة استخدام الدولة لهواجس غياب الأمن وخطر الإرهاب. في المقابل، وفي نفس الوقت، لا يشعر سوى 20٪ من المواطنين بالرضا إزاء الجهود التي تبذلها الحكومة لخلق فرص العمل، غالبيتهم من الطبقة الثرية أصلا. كما ارتفعت نسبة الراغبين في الهجرة من 10٪ عام 2011، إلى 30٪ عام 2019. ثمة مؤشر آخر بالغ الدلالة، وهو “إمكانية الثقة في معظم الأشخاص”، حيث أجاب 30% فقط بنعم عام 2019 مقابل 55% عام 2011. وهو مؤشر أيضا يمكن فهمه ضمن نفس سياق الحاجة إلى الأمن، حيث تكون الحاجة للدولة مرتبطة بضمانها توفير الحماية حتى من الأشخاص العاديين الغرباء. هذا الاستنتاج لا ينفي الحاجة للتأني في التسليم بدقة نتائج “الباروميتر العربي” التي تُظهر ثقة غير مفهومة في الرئيس المصري “بدرجة كبيرة أو كبيرة للغاية” بلغت 68٪؛ والحاجة لمقارنتها بنتائج أخرى، مثل استطلاع مركز “زوغبي” عام 2018. حيث كشف عن نسب تأييد الجيش والشرطة والقضاء تبلغ 41٪، 37٪، 39٪ على الترتيب، وهي أقل من المستويات التي تُظهرها نتائج “الباروميتر العربي” [5].
ثانيا: من الدولة العميقة إلى تمثيل الدولة
تجربة سنوات الثورة فيما يبدو جعلت الجيش يراجع جدوى الاكتفاء بدور “الدولة العميقة”. فجأة وجدت قيادة المؤسسة العسكرية نفسها في معادلة تقتضي تحصين وضعها الحالي والمستقبلي ليس فقط من خلال الأمر الواقع، أو تفاهمات ما وراء الكواليس؛ ولكن كان لابد من تقنين هذا الوضع، وتحصينه بنصوص دستورية وقانونية معلنة. أي تقرر الانتقال من حالة الدولة العميقة، إلى إعلان تمثيل الدولة بشكل سافر؛ ومن ممارسة دور الشريك الصامت في أنشطة اقتصادية، إلى التحكم في السوق من خلال قوانين وشركات رسمية وعقود واتفاقات. لا يعني الانتقال من حالة الدولة العميقة إلى التمثيل المعلن للدولة تراجع السيطرة، أو التخلي عن النفوذ البيروقراطي والأمني. علي العكس، الاعتراف بالسيطرة وممارستها بشكل معلن يوفر ميزة اكتشف قادة الجيش أنهم يفتقدون إليها في أشهر الثورة، وهي ميزة التمتع بوضع دستوري وقانوني لا يخضع لمساومات أو لتطمينات أي وافد على الدولة من خارجها، كما في حالة حكومة الرئيس الراحل “محمد مرسي” أو لجنة كتابة الدستور عام 2012.
صحيح أن الثورات إذا قامت لا تكترث بالقوانين المكتوبة ولا مواد الدستور الذي تثور ضده، لكن بافتراض أن هذا احتمال وارد، فسيكون حينها التفاوض رسميا معلنا وليس محل تفاهمات ضمنية لا يتمتع فيها الجيش بأي صفة أو مركز قانوني وسياسي معترف به كما كان الحال في المرحلة الانتقالية السابقة. حينها لن يتم التعامل مع جنرالات لهم مصالح خفية، أو مؤسسات لها نفوذ ضمني مسكوت عنه، ولكن التعامل مع عشرات أو مئات من التعاقدات، ومراكز قانونية واقتصادية مستقرة ومتداخلة مع السوق المحلي والأجنبي، فضلا عن مؤسسات وشركات باتت جزءا رسميا من الاقتصاد ليس من السهل تجاوزها أو تأسيس أوضاع جديدة تهمل تواجدها. لذلك، أصبحت هيمنة الجيش على السياسة كمرجعية لممارستها دورا دستوريا وليس مجرد نتيجة تاريخية، وأصبح استقلال الجيش في إدارة “شؤونه” المالية والإدارية حق دستوري وليس تفاهمات ضمنية مع القيادة السياسية. أما اقتصاد الجيش (“عَرَقه”، كما وصفه اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير[6])، والذي تحول لنوع من الهيمنة على قطاعات بعينها، فبات مفهوما ومفسرا قانونيا، ومجسدا اقتصاديا في مشروعات واستثمارات وشركات في البورصة وأيدي عاملة مرتبطة بهذا الاقتصاد[7]، ولم يعد من المثير للقلق الحديث عنه في تسريبات صحفية غامضة.[8]
ثالثا: تطوير الرقابة الشاملة وتعزيز السيادة
ليس من قبيل المصادفة أن النظام يبدو على عجلة من أمره تجاه إجراءات لا يجب أن يكون لها الأولوية، على الأقل من وجهة نظر مراقبين، مثل مشروعات ضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق التي تعيد رسم خريطة القاهرة، أو إجراءات أخرى كان من الممكن تأجيلها مثل مسألة تقنين أوضاع المنازل “المخالفة”، وتسجيل العقارات غير المسجلة. فضلا عن إجراءات تنظيمية متنوعة تبدو عادية، مثل تسجيل شرائح الهاتف المحمول وربطها بالرقم القومي، وتسجيل عقود إيجار العقارات في قسم الشرطة، وتركيب الشريحة الإلكترونية للسيارات بشكل إلزامي..إلخ. للوهلة الأولى، تبدو هذه الإجراءات غير مترابطة، ولها طابع اقتصادي-تنموي، أو تنظيمي إداري، لكنها جميعا، رغم اختلاف حجمها ومجالها، تشترك في سياق واحد: تطوير آليات الرقابة، وتحقيق السيادة الشاملة.
من أوجه الفوضى التي يؤمن “السيسي” أن عليه التصدي لها، هو عدم سيطرة الدولة على المواطنين بشكل كاف. أظهرت الثورة أن أعدادا قليلة يمكنها توظيف وسائل تكنولوجية حديثة بشكل غير نمطي بالنسبة لأجهزة الأمن، وهو ما يمكن أن يطلق سلسلة من الأحداث التي قد تخرج عن السيطرة. ولكي تكون الدولة قادرة على إجهاض مثل هذه التحركات، ثمة بنية تحتية لابد من استكمالها حتى يتم تحقيق مفهوم السيادة الشاملة، الذي أشار إليه ميشيل فوكو “لا أحد من رعاياي يمكنه الهروب، ولا أي من أفعالهم غير معلومة”[9]. يجب أن تكون الدولة قادرة على معرفة ما يقوم به المواطنون في أي وقت، أين يسكنون، تحديد مكانهم متى أرادت، مع من يتحدثون عبر الهاتف، وماذا يكتبون على شبكات التواصل.. إلخ.
صحيح أن هذه طبيعة الدولة الحديثة، وأن أغلب هذه الإجراءات بديهي في غالبية الدول، بغض النظر عن مستوى الحريات والتزام أنظمة الحكم بحقوق المواطنين وحماية خصوصياتهم. لكنّ إعطاء الأولوية لهذه المشروعات والإجراءات في ظل الحالة الاقتصادية للبلاد يعكس أهميتها من وجهة نظر النظام. من زاوية اقتصادية وتنموية سيبدو اهتمام الدولة ببناء عاصمة جديدة ضربا من العبث أو البروباجاندا السياسية، في ظل حقيقة أن نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية تبلغ فقط 56%، وفي الريف تبلغ 15٪. بعبارة أخرى، وفق الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نحو 10 ملايين و340 ألف أسرة من إجمالي عدد الأسر المصرية البالغ 23.5 مليون أسرة، يعيشون بدون صرف صحي[10]. من زاوية اجتماعية وسياسية يبدو صادما جدا، ومستفزا، أن تلوح الدولة بهدم المنازل، وأن تفرض إجراءات التقنين في ظل ظروف جائحة كورونا. لكنّ وضع هذه الإجراءات في سياقها الأمني الواسع يجعل أولويتها مبررة في أجندة النظام.
وبحسب ملاحظة “إسحاق ديوان” وآخرين[11]، فإن مسارات توجيه الحكومة لمواردها تعكس إرادة سياسية وأولويات مختارة بشكل مقصود، وليس نتيجة عدم توفر الموارد اللازمة. فالدولة عن عمد توجه نفقاتها ومواردها لمشروعات معينة وخطط تعطيها الأولوية، بينما يتراجع الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، حتى بما يخالف النسبة التي حددها دستور 2014. إذ تراجع الإنفاق على قطاع الصحة إلى 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.6% في عام 2016/2017، بالرغم من تحديد الدستور نسبة 3% كحد أدنى لقطاع الصحة. كما يعمل حوالي نصف أطباء مصر المسجلين، خارج البلاد بحثا عن ظروف أفضل، ويقترب متوسط عدد الأسرّة في مستشفيات مصر البالغ 1.3 سرير لكل ألف مواطن، إلى المتوسط في البلدان الإفريقية الفقيرة جنوب الصحراء الكبرى (الذي يبلغ 1.2)، وأقل من متوسط 1.6 المسجل في الدول العربية عدا الدول ذات الدخل المرتفع. وفي جانب التعليم، تنفق الحكومة 2.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، بينما ينص الدستور على نسبة تبلغ 4%، وهي حوالي نصف ما كانت تنفقه الدولة حتى مطلع العقد الأول من الألفية الحالية، 4%-5%. ومن بين 173 دولة، تأتي مصر في المرتبة 133 من حيث جودة التعليم الابتدائي في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017-2018. الخلاصة، أن تأجيل الدولة لأولويات أساسية مقابل تخصيص مواردها المالية والبيروقراطية لأمور أخرى يعكس حقيقة أن ثمة اعتبارات أخرى تحرك السياسة، وتمثل أولوية للنظام الحاكم.
تمثل العاصمة الإدارية الجديدة في جوهرها مشروعا أمنيا قبل أي شيء آخر. أظهرت الثورة أن الدولة “مكشوفة” أمام سكان العاصمة الهائلة، وأن تركُّز مؤسسات استراتيجية في منطقة وسط البلد أصبح يمثل تهديدا أمنيا. لذلك، وبعقلية أمنية بحتة، يجري على قدم وساق إعادة رسم ساحة جديدة للمواجهة القادمة، حتى لو كانت الدولة تعمل بشكل حثيث لتجنب حدوث هذه المواجهة. ستصبح منطقة وسط البلد مستقبلا على هامش البلد! بعد أن فقدت المؤسسات الاستراتيجية. بل إن الميدان نفسه الذي احتضن الثورة سيتحول إلى جراج كبير تَحُول تضاريسه الجديدة دون احتواء مئات الآلاف كما السابق[12]. وعموما، أعيد رسم خريطة العاصمة العجوز بشبكة الطرق والكباري التي تفتقد للكثير من منطق العمران ومعايير الجمال، بحيث بات يسهل أمنيا التحكم فيها وفصلها إلى مربعات أمنية منعزلة. يحتاج الأمر من المختصين دراسة مستفيضة عن الكيفية التي يسعى بها النظام إلى تفتيت القاهرة، حيث كانت احتجاجات سبتمبر 2019 كاشفة لهذه الحقيقة: خلال ساعات قليلة تحولت القاهرة إلى مربعات أمنية منعزلة يسهل من الناحية الأمنية احتواؤها بشكل منفصل. لكنّ القاهرة، التي من المقرر أن ينمو عدد سكانها بأكثر من نصف مليون نسمة في عام 2021، ستظل أكبر من أن يتم ترويضها، وتظل احتمالات تمردها واردة. لذا كان من الضروري أن ينتقل قلب الدولة، “وعقلها”، إلى العاصمة الجديدة، حيث يتم البناء والتخطيط العمراني ابتداء وفق هندسة أمنية، كما سيتم التحكم في طبيعة العاملين والقاطنين، وعددهم، بحيث تظل العاصمة دائما تحت السيطرة، ودون عبء ديمغرافي، ومن ثم لا يتكرر سيناريو محاصرة الدولة كما حدث في ميدان التحرير وماسبيرو والاتحادية.
أما في الجانب الإلكتروني، فإن الحكومة تقوم باستثمار متقدم في منظومات “البيانات الضخمة Big Data” ليس فقط من أجل تجميع معلومات المواطنين من كافة قطاعات الحكومة الخدمية والأمنية، ولكن من أجل تحليلها واستخدامها وفق المتطلبات الأمنية. كما أصدرت الدولة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون رقم 175 لسنة 2018)، الذي يجعل المواطن عاريا إزاء سلطة أجهزة الدولة المطلقة في الحصول على كافة بياناته ومعلوماته التي يُلزم القانون شركات الاتصالات بتجميعها والاحتفاظ بها[13]. أماالإجراءات البسيطة مثل تسجيل العقارات، وضع الملصق الإلكتروني لجميع المركبات عدا الموتوسيكل[14]، إبلاغ قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد لأي عقار[15]، تقنين مهنة “السايس”[16]، وحتى الاتجاه لتقنين مهنة حارس العمارة “البواب” لأسباب أمنية بالأساس، ليس فقط من خلال التحكم فيهم من خلال سلطة منح ترخيص مزاولة المهنة مقابل ضمان ولائهم وتعاونهم مع أجهزة الأمن، ولكن أيضا بهدف “ضبط المنظومة الأمنية بعدم اختراق أي عناصر إرهابية لتلك المهنة” حسب النائب “محمد الحسيني”، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، صاحب مشروع القانون[17]. جميع هذه الإجراءات، وغيرها، تمثل تشريعات وقوانين، تعدها الحكومة ويناقشها البرلمان ويقرها قبل أن يصدرها رئيس الجمهورية رسميا. أي أن هذه الإجراءات تستنزف جهدا رئيسيا من المجهود البيروقراطي، وهو ما يعكس أولويتها التي تتخطى فائدتها التنظيمية المباشرة المعروفة والتي لا خلاف حولها. وضعها على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، رغم وجود مشكلات أخرى قانونية وتنظيمية تعيق نمو الاقتصاد مثل الحاجة لتبسيط اللوائح التي تعرقل نمو الشركات، يعكس ذلك نظرة النظام لما يجب البدء به وما يمكن تأخيره لسنوات لاحقة.
الاستقرار الهش: المخاطر السياسية طويلة الأجل
يواجه النظام، تحديا ديمغرافيا هائلا. وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، سيرتفع عدد سكان مصر إلى نحو 120 مليون بحلول عام 2030[18]. وعموما، 60٪ من سكان البلاد تقل أعمارهم عن 30 عامًا[19]. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التحضر في مصر إلى أكثر من 60٪ بحلول عام 2030، مما يعني زيادة الطلب على الوظائف الحضرية والإسكان والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. ومن ثَمَّ، تحتاج مصر إلى خلق حوالي 800 ألف فرصة عمل سنويًا لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل في البلاد. وهو الأمر الذي يتطلب أكثر من مجرد إصلاح اقتصادي محدود، يتم تحت قيود شبكات المصالح وضمن حدود تضمن إبقاء سيطرة الجيش على أنشطته الرئيسية، دون إطلاق العنان للقطاع الخاص وتكوين مراكز قوى اقتصادية خارج إطار “الدولة”. لذلك، تمثل دعوة السيسي اليائسة للحد من معدلات الإنجاب استجابة “أمنية”، لتهديد قائم، ينذر بمزيد من الصدام بين الدولة والمجتمع.
وترجح “وحدة الاستخبارات في الإيكونومست The Economist Intelligence Unit” أن تأثير مجموعات المصالح القوية، ولا سيما المصالح التجارية الواسعة للجيش، يعيق عملية الإصلاح وتنمية القطاع الخاص في المدى المتوسط[20]. فيما ترجح IHS Markit أن يؤدي الوجود العسكري المتزايد في معظم القطاعات الاقتصادية إلى إعاقة تحرير بيئة الأعمال، ومن المحتمل أن يقيد القدرة التنافسية للقطاع الخاص. وعلى الرغم من الآفاق الاقتصادية المتفائلة على المدى المتوسط، فإنَّ تقييمها يشير إلى أن إمكانات مصر على المدى الطويل تواجه عددًا من المخاطر، تشمل ضعف البنية التحتية، ونقص العمالة الماهرة، وارتفاع معدلات البطالة الهيكلية، وانخفاض الإنتاجية، وانتشار المخاطر السياسية مع قدر كبير من عدم اليقين بشأن الاضطرابات السياسية والاجتماعية الحالية التي تجتاح البلاد، مما يجعل من الصعب توقع تخفيف كبير للتوترات على المدى الطويل، يعرض الإصلاحات الاقتصادية نفسها للخطر[21] .
وبحسب تقديرات “فيتش سوليوشنز Fitch Solutions”، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات قبل تحقيق الإمكانات الاقتصادية طويلة المدى لمصر. فبينما تتمتع مصر بالعديد من المزايا التي تجعل قصة نموها على المدى الطويل مقنعة – ذلك أنَّ بها موقعًا استراتيجيًا، وعددًا كبيرًا من السكان، وقطاعًا خاصًا وماليًا مازالا غير متطورين، وهو الأمر الذي يوفر مساحة واسعة للتوسع -، وبالرغم من هذا ، فمن المرجح، حسب فيتش، أن تؤثر حالة عدم اليقين السياسية ومسار الإصلاح الصعب على وتيرة النمو خلال العقد القادم. حيث يظل احتمال التدخل العسكري المباشر على غرار أحداث 2011 و2013 غير بعيد المنال، مما يوفر توترات داخل الحكومة والقوات المسلحة. وسيكون لعدم اليقين السياسي انعكاس سلبي على الإصلاح الاقتصادي، مما قد يقوض جاذبية مصر كوجهة للاستثمار والسياحة[22].
من اللافت أن نطالع مثل هذا التقييم السلبي لدى مؤسسات اقتصادية تثني بصورة مستمرة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتعهده حكومة السيسي منذ سنوات. أعتقد أن هذا الملمح مناسب تماما كي أبدأ في الجدال بأن الاستقرار الراهن رغم استناده إلى قبضة أمنية ورقابية قوية، وشبكة بيروقراطية عميقة، إلا أن أسسه مازالت هشة ومن المبكر افتراض أنه حقق مقومات الاستمرار، أو أنه ناتج عن معالجة الأسباب الحقيقية التي ولدت حالة الثورة، ومن ثم أعاد ترميم شرعية الحكم التي انهارت بصورة لا تقبل الشك في يناير 2011.
لا يمثل هذا تراجعا عن مناقشتي في المقدمة لمسألة تقييم “نجاح” أو “فشل” النظام. فالدولة لا تسعى لبناء نظام ديمقراطي، ولا تسعى كذلك لإبعاد الجيش عن الاقتصاد لمصلحة القطاع الخاص. لكنّ الوضع هو كالتالي: يراهن النظام على إمكانية إعادة بناء الدولة، وتعزيز دفاعاتها في مواجهة المجتمع ليس من خلال الانفتاح السياسي والاقتصادي، ولكن من خلال مزيج من تحصين دفاعات الدولة، وفرض هيمنتها على السياسة والاقتصاد، ثم في مرحلة لاحقة، يتصور أنه سيكون بمقدوره التعامل مع مسائل الفقر والأوضاع الاجتماعية، ولكن بعد أن تكون الدولة/النظام في وضع غير مهدد. ويراهن النظام على أن الآثار الجانبية، مثل فورات الغضب أو تضرر قطاعات من المجتمع نتيجة السياسات ذات الأولوية، يمكن احتواؤها من خلال الاعتماد على مزيج من المعالجة الأمنية القاسية، وفي بعض المناسبات الاحتواء السياسي المؤقت، دون أن يضطر للتخلي عن أولوياته الأساسية. المتتبع لخطابات “السيسي” يلمح حالة من الرضا عن تقدم خطوات استعادة الدولة، والترويج لما يراه النظام “معجزة” يتم صنعها رغم التحديات. كما أن التعامل الأمني والاحتواء السياسي نجحا بالفعل في التعامل مع أي فورة غضب شعبي غير متوقعة.
هكذا تبدو الصورة في مجملها، لكن البحث في التفاصيل يكشف أن النظام مازال في وضع بالغ الهشاشة، وأنه حتى على صعيد التعامل الأمني ثمة مبالغة في تقدير مدى نجاحاته، وإمكانية استمراره على نفس النهج، لدرجة أن “مؤسسة فيتش” تذهب صراحة للقول بأنه “يمكن أن يحدث انهيار النظام المدني في أي لحظة”[23]. كما تخلص دراسة مهمة لمبادرة الإصلاح العربي، أعدها “يزيد صايغ” وآخرون، إلى أنه “تم بناء استقرار الأمن والاقتصاد الكلي في مصر مؤخراً على أسس ضعيفة”، وأن محصلة السنوات السابقة، رغم نجاح النظام في فرض الاستقرار، هي عودة مصر “إلى نُقْطَة البِدَايَة، في موقفٍ يشبه إلى حد بعيد ما كانت عليه قبل ثورة 2011: مستقرة في الظاهر، ولكن في الداخل ثمّة مشكلات بنيويّة عميقة ومظالِم اجتماعيّة محتدمة، مع استنفاد كل ما يمكن أن يخفّف من حدّتها”. ولا تتردد الدراسة في طرح الاستنتاج التالي: “يواجه الاقتصاد الآن خطراً حقيقيّاً بالانهيار على المدى المتوسّط إذا لم تتحسّن الأمور الأساسيّة، وهي الاقتصاد والظروف الاجتماعيّة والقواعد السياسيّة الحاكمة”[24].
وبالعودة لتقديرات مؤسسات الاستشارات الاقتصادية، تعطي “فيتش” تقييما إجماليا لدرجة المخاطر السياسية طويلة الأجل (LTPR) في مصر يبلغ 58.7 / 100، وهي واحدة من أقل الدرجات بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير المتورطة في حرب أهلية. حيث سجلت الدولة 42.0 / 100 ” لخصائص النظام السياسي”، نتيجة حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن الإطار الدستوري المستقبلي والقيود المفروضة على القضاء. كما سجلت مصر 60.0 / 100 في “خصائص المجتمع”، نتيجة وجود قيود رئيسية تتمثل في ارتفاع درجة عدم المساواة وانتشار الفقر. وأخيرا، 65.0 / 100 في “نطاق الدولة” و”استمرارية السياسة”، في ضوء مسار السياسة الغامض للغاية الذي يتحرك اسميًا فقط نحو الديمقراطية[25].
واللافت للنظر أكثر، أن تقديرات المخاطر التي تصدرها “مؤسسة فيتش”، تشير صراحة إلى أن البيئة الأمنية في مصر “هشة”. حيث وصفت جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها الدولة بأنها “رجعية إلى حد كبير، وقاسية، مع القليل من التركيز على جمع المعلومات الاستخبارية”. وبالتالي، حصلت مصر على درجة صادمة جدا تبلغ 6.8 من 100 في تقييم الإرهاب ومخاطر العنف السياسي، لتحتل المرتبة 14 من 18 دولة في المنطقة، متقدمة فقط على ليبيا واليمن وسوريا والعراق، والمرتبة 189 على مستوى العالم من بين 201 دولة[26].
بالإضافة إلى ذلك، وفق ما يذهب إليه التقدير، لا تقتصر المخاطر على الهجمات الإرهابية، ولكن أيضا تشهد المراكز الحضرية الرئيسية اضطرابات بسبب “النوبات الدورية من الإضرابات والاضطرابات الاجتماعية”[27]. حيث يوجد في مصر عدد كبير من الشباب مع مستويات بطالة عالية، ومن ثم يمكن أن يؤدي الضغط الاقتصادي والفشل في تلبية المطالب الرئيسية التي نتجت عن ثورة 2011 إلى تأجيج الاضطرابات. كما يؤدي النمو السكاني السريع وتقلب الأسعار وانعدام الأمن الغذائي وسياسات الدعم إلى زيادة هشاشة المشهد الأمني الداخلي. وترى “فيتش” أيضا أن الانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الشرطة وأوجه القصور الهيكلية في نظام العدالة أدت إلى تقويض شرعية أجزاء من قطاع الأمن، وهو ما يمثل أيضًا تحديًا كبيرًا للاستقرار. كما أن العقاب الجماعي لمجتمعات بأكملها في سيناء يعرض الجيش لخطر خسارة المعركة النفسية والاجتماعية ضد التطرف. والخلاصة أن مخاطر العنف السياسي أصبحت لا يمكن التنبؤ بها، ومن ثم تسجل مصر 45.2 من 100 في مؤشر الجريمة والمخاطر الأمنية، مما جعلها تحتل المرتبة التاسعة من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ش.أ.ش.أ)، متقدمة على دول مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان، والمرتبة 114 من أصل 201 دولة على مستوى العالم[28].
| مخاطر الأمن والجريمة في مصر | ||||
| مخاطر الصراع | جرائم الأعمال | القابلية للجريمة | إجمالي مخاطر الأمن والجريمة | |
| درجة مصر | 28.3 | 58.7 | 48.6 | 45.2 |
| متوسط ش.أ.ش.أ | 30.4 | 43.3 | 54.1 | 42.6 |
| ترتيب مصر بين دول ش.أ.ش.أ (18 دولة) | 10 | 5 | 11 | 9 |
| المتوسط العالمي | 48.9 | 49.1 | 49.5 | 49.2 |
| ترتيب مصر عالميا (201 دولة) | 173 | 76 | 106 | 114 |
Note: 100 = Lowest risk; 0 = highest risk. Source: Fitch Solution, “Egypt: Crime and security risk report Q4.” Sep. 2020.
قصور المعارضة
مازالت أجندة المعارضة متعثرة تجاه التعامل مع الوضع الراهن. وهو التعثر الناتج عن قصور عميق في فهم ما حدث يوم 3 يوليو/تموز 2013 باعتباره “نقطة انقلاب”، أي أنه يمثل لحظة ذروة منحنى من تصاعد الأحداث في المرحلة الانتقالية، أعقب هذه النقطة تبدل تام في سلوك الفاعلين. نقطة الانقلاب لا تعني أن المنظومة كلها باتت أقل تنبؤية فحسب، ولكن تعني أن الفاعلين أنفسهم بات سلوكهم وأولوياتهم مختلفة وبحاجة لإعادة التعريف. أي أن العملية السياسية أعيد تعريفها، وانتقلت تماما لمحددات أخرى لا تختلف فحسب عن سنوات الثورة (يناير 2011-يونيو2013)، ولكن أيضا تختلف عن سنوات حكم مبارك. مثلا، لم يعد تموضع الجيش في النظام السياسي كما كان سابقا، كما لم تعد نظرته للمعارضة، أو لحالة الدولة نفسها كما كانت. لم يعد المجتمع موحدا إزاء عملية التغيير وأولويات تحققها. الأطراف الخارجية أيضا أصبح لأدوارها في الشأن الداخلي حدود مختلفة. بعبارة أخرى، انتقل كافة اللاعبين إلى ملعب جديد وبقواعد لعب جديدة.
ومن ثم، أصبحت المعارضة في ساحة صراع سياسي لم تختبرها بعد، وبدلا من محاولة استيعاب محددات المشهد الجديد وحدود الفعل الممكن، ومسارات التأثير ذات الأولوية، والتفكير في الخطوات أو السياسات التي يجب تبنيها؛ بدلا من ذلك، حاولت المعارضة بصورة متكررة إما استنساخ نموذج الثورة (حتمية العودة للميدان، وسيادة منطق “الشعب يريد”)، أو نموذج العقد الأخير من سنوات حكم “حسني مبارك” (ضرورة توحد كافة المعارضة واستنساخ حالة “كفاية” أو الجمعية الوطنية للتغيير). نتج عن هذا أن أداء المعارضة عموما جاء خارج السياق الواقعي لتطور الأحداث، وتحلى بصورة فجة في خطاب مازال غير قادر على التحرر من محددات انتهت فعليا. ومن ثم اصطدمت خططها دائما بواقع مغاير تماما أقوى من محاولات استنساخ التاريخ.
قصور المعارضة عن التحرر من نموذجي الخبرة السابقيْن وفهم محددات النموذج الجديد، جعلها، بالضرورة، تذهل عن امتلاك متطلبات مواجهة المرحلة الجديدة، من حيث الأدوات ونمط العلاقات والأولويات والموارد الملائمة للفعل السياسي الذي تمليه استحقاقات المرحلة. ومن ثم ظهرت أدواتها غير فاعلة، وغير محترفه، وأصبحت محل اتهام حتى من قبل الرأي العام الموالي لها.
غياب تفكيك الواقع الجديد، ثم التخلف عن بناء السياسات وامتلاك الآليات والوسائل اللازمة للتعامل معه كلاهما أدى إلى فشل المعارضة عموما في بناء تحالفات مشتركة فاعلة، وإلى عجز أطيافها عن إقناع الرأي العام بجدارتهم كبديل للنظام القائم. ليس لأن أطراف المعارضة غير قادرين على إدارة اختلافاتهم أو لأن مصالحهم الخاصة تتعارض عند بناء التحالفات؛ الحقيقة أن البحث عن الصدارة أو الهيمنة على التحالفات، هو من طبيعة العمل السياسي، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مصالحه من خلال التحالف مع الآخرين. المشكلة الأساسية التي تعيق بناء تحالفات فاعلة، حتى في المرات التي تمكنت فيها بعض أطرافها من الائتلاف شكليا، هو غياب تعريف مشترك للواقع، ومن ثم أولويات التحرك ومساراته وصولا إلى تحقيق مستهدف متفق عليه. العيش في نموذج مواجهة انقلاب عسكري يفرض أولويات ونمط خطاب، ويحدد حلفاء وأعداء وخيارات سياسية تختلف تماما عن محاولة استنساخ نموذج الثورة الذي مثَّل لحظة إجماع وطني نادرة. كما يختلف كلاهما عن العيش في نموذج نظام مبارك، وحدود الفعل السياسي الذي يعنيه هذا النموذج والذي سيكون في نظر النموذجين الآخرين استسلاما أو خيانة. ومن ثم حين يلتقي هؤلاء فكأنهم قادمون من فترات زمنية مختلفة، يتحدث كل طرف منهم بمنطق ولغة غير مقبولين لدى الآخرين. وبالتالي يكون الاتفاق على أجندة عمل أمرًا بالغ الصعوبة، ولا تتوفر له شروط الاستمرارية.
لا تعتبر مسألة إعادة فهم الواقع والتحرر من هيمنة الخبرات السابقة (طبعا دون التخلي عن دروسها والبناء عليها) مجرد مسألة نظرية أو سفسطة لغوية. بل ضرورة للفعل السياسي الصحيح والفاعل، وإلا فقد ينتج عن الممارسة السياسية التي لا تستجيب لتغيرات الواقع أضرار تخدم مصالح النظام وأهدافه. فعلى سبيل المثال، عدم قراءة تغيرات المزاج الشعبي، وهواجس الأمن والخوف، ينتج عنه أن جزءًا رئيسيا من خطاب المعارضة المغرق في شعارات الخبرات السابقة يتمكن النظام من ترجمته باستمرار إلى ” تهديد الفوضى وعدم الاستقرار” . فالدعوة إلى الثورة أو العصيان المدني بينما المجتمع منقسم وخائف ويقدم اعتبار الأمن حتى على اعتبار الأوضاع الاقتصادية، ينتج عنه مزيد من تغذية رواية السلطة حول بقاء التهديدات، وحول استمرار الحاجة للمعادلة التي تقتات عليه: “البقاء من أجل الحماية”. أي أن هذا النمط من الخطاب والفعل السياسي لا ينزع عن السلطة شرعيتها، بل يعيد تزويدها برصيد من الدعم الشعبي، ويساهم في تبرير ما تقوم به من إجراءات سلطوية[29]. كذلك، لا ينتبه كثيرون إلى الفارق بين شرعية الحكومة من حيث اعتبارها حقيقة عن اختيار الناس وإرادتهم، وبين “شرعية الممارسة” التي قد تتمتع بها الأنظمة الاستبدادية نتيجة أمور عدة، منها في حالتنا هذه، قدرتها على توفير الأمن وفرض الاستقرار. ويجادل “هيبو” بأن الحكومة التي تعيد للمواطنين الحياة الطبيعية والهدوء والقابلية للتوقع، في أعقاب فترات ثورية مضطربة، وأزمات اقتصادية، سوف تتمتع من دون جدال بشرعية معينة، بغض النظر عن طبيعة تكوُّن هذه الحكومة[30].
لا يدعو التقييم أعلاه إلى طي صفحة المعارضة التقليدية، أو انتهاء أدوارها السياسية المحتملة. مازالت قوى المعارضة تتمتع بجوانب قوة تفتقدها أي مجموعة معارضة جديدة ناشئة، خاصة لو كانت خارج البلاد. فعلى سبيل المثال، لا يمكن للمعارضة تعويض البنية التحتية الاجتماعية لجماعة الإخوان المسلمين التي لا تقتصر على شبكات العضوية، ولكن تمتد أيضا لدوائر علاقات اجتماعية واقتصادية متشعبة. وهي حصيلة سنوات طويلة من العمل السياسي والاجتماعي لا يتوقع أن تحوزه المعارضة بسهولة، خاصة في ظل مناخ القمع الراهن. صحيح أن هذا كله لحق به ضرر فادح، لا يمكن الجزم – بدقة- بمستواه، لكنه لا يعني أن هذا كله قد اختفى تماما. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعارضة غير الإسلامية، التي يُنظر إليها دائما باعتبارها أقل من حيث حجم العضوية وأضعف من حيث البناء التنظيمي، يتوفر لها رصيد من العلاقات داخل الدولة وخارجها، فضلا عن شبكات تأثيرها الإعلامية والسياسية، التي أيضا من الضروري الاستفادة بها. هذه الجوانب، وربما غيرها، ليس من مصلحة الراغبين في التغيير تجاهلها، وافتراض أنها لم تعد مفيدة، أو أنه لا يمكن إعادة تفعيلها. الفارق في هذه الرؤية التي أطرحها، هو أن هذه القوى – كما أظهرت السنوات السابقة بالفعل – غير قادرة على إيجاد مسار التغيير، وغير قادرة على إعادة إنتاج نفسها كمعبر عن تطلعات الناس ومخاوفهم. لكنها في نفس الوقت ستكون مؤثرة ومفيدة متى وجد هذا المسار، وستكون بما تملكه من موارد ومقومات – معطلة حاليا – دافعا لهذا المسار لا مبادرة بتكوينه وتخليقه.
تفاعل الإعلام والمعارضة الشعبية
لا تقتصر حالة المعارضة على تياراتها التقليدية. هناك جانبان من المهم الإشارة إليهما: الإعلام، وما يمكن تسميته “المعارضة الشعبية”.
ربما تمثل حالة الإعلام المعارض في الخارج المشهد الأكثر فاعلية في كافة أنشطتها، على الرغم من كل ما يوجه لهذه الحالة من انتقادات. صحيح أن بعض هذه الانتقادات يرجع لأداء المؤسسات ذاتها، لكنّ العامل الأساسي الذي يؤثر على حالة الإعلام هو غياب البرنامج السياسي للمعارضة، وهو أمر ناتج عن حالة القوى السياسية المعارضة، وليس عن ضعف في المؤسسات الإعلامية نفسها. ليس ثمة صوت مخالف يسمعه المواطن المصري بشكل منتظم إلا من خلال التغطية المتواصلة للأحداث اليومية التي تبثها تلك القنوات، وهو ما يبرر انزعاج النظام منها ووضعها ضمن أولويات إعادة صياغة علاقته بالحكومة التركية. لا يرتبط الأمر بحجم متابعة تلك القنوات، والذي يبدو غير قليل، ولكن بالأساس يرتبط بنوعية المشاهد الذي بنسبة كبيرة يمثل شريحة مختلفة عن شريحة متابعي وسائل التواصل الاجتماعي من الفئات العمرية الأصغر. هذه الشريحة تمارس دورا تاليا في عملية تداول المعلومات وتفسير الأحداث السياسية من خلال “النقاشات” الاجتماعية بين أفراد الأسرة وفي العمل وفي المسجد والمقاهي.. إلخ. وهي عملية مازالت تمثل مصدرا رئيسيا لتلقي المعلومات لدى شريحة معتبرة من الأغلبية الصامتة. حيث تأتي هذه النقاشات، بالنسبة للمصريين، في المرتبة الثانية (43٪) كأكثر المصادر موثوقية لتلقي المعلومات بعد الفضائيات العربية (51٪)، وفق استطلاع مركز “زوغبي” عام 2018، متفوقة على شبكات التواصل الاجتماعي (38٪) ووسائل الإعلام الفضائية المحلية (33٪)[31].
أما المعارضة الشعبية فيندرج تحتها الانتفاضات الجماهيرية العفوية التي شهدتها البلاد في عدة مناسبات خلال الأعوام الأخيرة، والتي تمثل الإعلان الأبرز عن فشل الدولة في تجديد شرعيتها وعجزها عن إلهام طموحات شريحة واسعة من الجماهير. ويمثل التلاقي بين الإعلام المعارض وحالة الاحتجاج الشعبي العفوي نقطة إزعاج كبيرة للنظام الذي مازال يشعر أنه لم يستكمل دفاعاته، ومن ثم يتعامل معها كتهديد كامل ينعكس على مستوى العنف الأمني الذي يستخدمه لقمعها. ومع غياب الفاعل السياسي الذي يمكنه تطوير مثل هذه الانتفاضات والبناء على رصيد الغضب الذي يختمر في المجتمع، يلجأ النظام إلى آليات أخرى لمواجهة هذه الموجات. من مصلحة النظام أن تظل السياسة غائبة، لذلك ليس واردا على أجندته توسيع هامش المشاركة السياسية لتنفيس هذا الغضب. الأهم بالنسبة له، بالإضافة لتقوية وتطوير وسائل القمع، هو وجود قنوات تفاوض لاحتواء هذه التوترات، وهو ما يتم عبر قنوات أمنية بالأساس مازالت هي الخيار المفضل للنظام، كما يتم من خلالها توظيف نفوذ الموالين للنظام من النخبة السياسية المحلية ممثلة في “مستقبل وطن”، سواء كانت جديدة أم محسوبة على هيكل الحزب الوطني. بالإضافة لذلك، يقوم النظام متى تطلب الأمر بمناورات سياسية مثل تأجيل بعض الإجراءات أو تخفيف حدتها. وبالنظر للنفور العام من تكرار حالة عدم الاستقرار، يبدو أن ثلاثية: القمع/التفاوض/المناورةالسياسية كافية لاحتواء فورات الغضب على الأقل في المدى القصير.
المعارضة الشعبية تشمل أيضا أفرادا، ومجموعات ناشئة، خصوصا في الخارج، تتبلور رؤاها مع الوقت تجاه قضايا جزئية، ومن ثم ستكون مع الوقت قادرة على طرح سياسات أو أفكار بديلة، وتقديم خطاب مختلف مرتبط بشعارات الثورة. مازالت هذه المجموعات تفتقد للموارد والتشبيك فيما بينها، وكلاهما لازم لاستدامة عملها وتراكمه حتى يحقق التطور اللازم. تسليط الأضواء على هذه الحالة، وعلى حيوية نقاشاتها ومبادراتها وتطرقها لمساحات من الفكر والعمل متنوعة وغير مطروقة، يمثل نقطة التقاء مهمة مع حالة الإعلام المعارض، وكذلك مع حالة المعارضة الشعبية التي تفتقد لنخب جديدة تعبر عنها وتوجهها.
مسارات المستقبل
من الأمور التي ينبغي الحذر منها عند التعرض لها، فضلا عن التحلي بالكثير من التواضع، هو مسألة التنبؤ بتطورات المنطقة خلال الحقبة الراهنة التي عنوانها الرئيسي عدم الاستقرار. ثمة أمور واضحة جلية، مثل انهيار شرعية الدولة العربية، وفقدان نخبتها لما يمكن أن يلهم المواطنين ويطيل صبرهم. لم يكن الربيع العربي مؤامرة خطط لها مجموعات سياسية، أو جهات خارجية. لذلك من الحماقة تصور أن قمع قوى سياسية معارضة أو غلق الباب في وجه الضغوط الخارجية في مسائل الحريات يعني أن الربيع العربي بلغ نهاية مساره. لكنّ هذا الإيمان لا يعني حتما أن التغيير سهل، أو قريب. كما أنه من الضروري الحذر تجاه محاولة إسقاط تجارب سابقة على حالتنا العربية، وتصور أن عملية التغيير ستسير وفق واحدة من هذه التجارب.
كذلك، تتطلب عملية توقع مسارات مستقبلية الكثير من الشجاعة والطاقة النفسية لتحدي هيمنة الواقع وسطوته، وتفاصيله التي نعايشها وتؤثر بلا شك على نظرتنا للأمور، وتقيمنا للتطورات، ورغباتنا في المستقبل. سطوة الواقع يعبر عنها “روبرت كابلان”، في كتابه “انتقام الجغرافيا”، قائلا: “إن الأنظمة التي انهارت بعد وقت قصير من سقوط حائط برلين – في تشيكوسلوفاكيا، والمجر، رومانيا، بلغاريا، وبلدان أخرى – كانت بلدانا عرفتها عن كثب من خلال العمل والسفر. للوهلة الأولى، كانت تبدو منيعة للغاية، ومثيرة بقدر هائل من الخوف، لذا كان انهيارها المباغت بمنزلة درس بارز بالنسبة لي، ليس فقط بخصوص عدم الاستقرار الكامن في جميع الأنظمة الديكتاتورية، ولكن حول كيف أن الحاضر، مهما بدا سرمديا وساحقا، هو زائل لا محالة. أما الشيء الوحيد الثابت فهو موقع شعب على الخريطة”[32].
وبشكل عام تبدو عملية التحول الديمقراطي بالغة الدينامية؛ فلا يمكن تعميم سيناريو بعينه أو شروط محددة لتوقع انهيار الحكم الاستبدادي، العسكري، ونشوء ديمقراطية تتمتع بقدر من الاستقرار والاستمرارية. وعلى سبيل المثال، قام “دانيال تريسمان” (Treisman, 2020) بدراسة تستحق الاهتمام، بعنوان “الديمقراطية بالخطأ: كيف تُحفز أخطاء الحكام المستبدين الانتقال إلى حكومة أكثر حرية”، قام خلالها بفحص حالات التحول من الحكم الاستبدادي للديمقراطية منذ عام 1800، حيث خلص بعد دراسة 316 عملية تحول إلى أن غالبية الحالات التي نشأت فيها الديمقراطيات لم تنتج عن فعل متعمد من النخبة الحاكمة لإجراء عملية تغيير. فقط في ثلث الحالات اختار المسؤولون عمدا مشاركة السلطة أو التنازل عنها، لأسباب متنوعة، منها: منع الثورة، وتحفيز المواطنين على خوض حروب خارجية، وتحفيز الحكومات على توفير السلع والخدمات العامة، والمزايدة على خصومهم النخبة، أو الحد من العنف الطائفي. لكن في الحالات الباقية، التي تشمل ثلثي هذه المناسبات، نتجت “الديمقراطية بالخطأ”، حيث تشير الدلائل إلى أن الدمقرطة حدثت ليس لأن النخبة الحاكمة اختارتها، ولكن لأنهم، أثناء محاولتهم منعها، ارتكبوا أخطاء أضعفت قبضتهم على السلطة. أي أن الديمقراطية قد انتشرت في أغلب الأحيان بسبب زلات الحكام المستبدين التي انطوت في مجملها على قدر كبير من الغطرسة. كانت الأخطاء متنوعة أيضا، فبعض القادة – مثل لويس فيليب – استخفوا بقوة المعارضة، وفشلوا في قمعهم أو إجراء مساومات معهم. آخرون بالغوا في تقدير شعبيتهم – مثل بينوشيه في شيلي – ودعوا إلى انتخابات أو استفتاء، ثم فشلوا في التلاعب بشكل كاف وخسروا، مما أدى إلى انقسام النخبة وتمكين المعارضين. بينما بدأت شخصيات – مثل ليوبولدو جاليتيري في الأرجنتين – بنزاعات عسكرية لتحقيق نصر خارجي، لكنها خسرت ليس فقط المعركة ولكن القوة السياسية، حيث انشق الزملاء وحُشد المنافسون. آخرون – مثل ميخائيل جورباتشوف بعد عام 1985 – قدموا تنازلات تهدف إلى تقوية النظام، لكنها كانت تقوضه في الواقع. في سيناريو آخر، أخطأت النخبة الحاكمة في التقدير، فاختاروا قائدًا – مثل خوان كارلوس أو أدولفو سواريز في إسبانيا – كان يفترض أنهم محل ثقة النظام، فقاموا بتدميره[33].
لا يعني هذا أن عملية الانتقال عشوائية، ولكنها تنتج عن عوامل متداخلة، محلية وخارجية، اجتماعية واقتصادية وأمنية، وفي كل هذه المجالات يكون حاضرا دائما ومؤثرا الفعلُ الإنساني الشخصي والانفعالي والمتسم أحيانا بالغرور وأحيانا بالخوف وسوء التقدير.. إلخ. لذلك فهي ليست عملية نمطية يمكن رسمها بناء على مدخلات ومعطيات جاهزة.
لكن، وبشكل عام، تمثل السيناريوهات المحتملة دليلًا عامًا إرشاديا، لما قد تواجهه مصر خلال السنوات القادمة. دون أن يستبعد حدوث أي منها إمكانية تطوره أو انتكاسته لسيناريو آخر. لذلك ليس المهم “توقع” السيناريو الصحيح، ولكن امتلاك الموارد والقدرات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات والاستجابة لها بفاعلية. على سبيل المثال، من السهل توقع أن تحدث انتفاضة واسعة في البلاد يمكنها تقويض حكم السيسي. لكن، حتى هذا السيناريو الممكن جدا إذا حدث في القريب العاجل قد لا ينتج عنه أي تغيير، في ظل أن موازين القوى الحقيقية بين الدولة والمجتمع لم تتغير، كما أن القوى السياسية لا يبدو أنها مؤهلة كي تكون بديلا للدولة القائمة. ومن ثم قد لا يتطور هذا السيناريو إلا حقبة جديدة من استمرارية الدولة القائمة بغض النظر عن شخص الحاكم ورموز نظامه. أي أن معرفة السيناريو الراجح دون الاستعداد له لن يختلف كثيرا عن عدم معرفة أي سيناريو.
ما يمكن الجزم به، أن الجيش سيظل أقوى مؤسسة في البلاد، خاصة مع تمتعه بالقدرة والرغبة في التحكم في السياسة والهيمنة على الاقتصاد واحتكار مفهوم الأمن وحدوده. كما أن حيازته لموقع حاسم في معادلة الحكم في مصر يظل محل دعم إقليمي مؤثر. يبدو هذا هو العائق الرئيسي لأي انتقال ديمقراطي في البلاد[34]. وعلى الرغم من أن هناك استياءً كبيرًا من عدم وجود تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي في البلاد، فالسيناريو الأكثر احتمالا هو بقاء السيسي في السلطة أطول مما يتوقع معارضوه، طالما أنه يتمتع بدعم الدولة بصورة عامة والجيش بصورة خاصة[35]. ومع التسليم بأن أولويات النظام السياسية والاقتصادية، سينتج عنها مزيد من الضغوط الاجتماعية؛ لكن، بحسب ما يجادل “عمرو عادلي” يمكن للنظام الاستمرار في مشروعه من دون قاعدة اجتماعية عريضة مرتبطة بالنظام اقتصاديا، مكتفيا بمواصلة القمع واسع النطاق[36]. خاصة في ظل تماسك الجيش والأجهزة الأمنية واستعدادهم لاستخدام أقصى درجات العنف. وإذا كان كثير من المراقبين والمعارضين استبعدوا إمكانية استمرار نمط الحكم القائم، فقد استمر بالفعل لنحو سبع سنوات، ولا يبدو أنه في أسوأ حالاته حاليا، لذا فلن يكون من المفاجئ استمراره فترة مماثلة أو أكثر، طالما أن الراغبين في التغيير لا يعملون بشكل فاعل من أجل تغيير ميزان القوى الراهن، لا بينهم وبين النظام، ولا بين الدولة والمجتمع بصورة عامة[37].
هنا لابد من الإشارة إلى حقيقة بالغة الأهمية لفهم مسار التغيير في مصر، وهي أنه لا حدود حقيقة بين “الدولة” من جهة، و”النظام السياسي” من جهة أخرى. لأسباب تتعلق بنشأة الدولة العربية، وتكون أجهزتها البيروقراطية، خاصة الجيش والأجهزة الأمنية. ثم عدم وجود تداول حقيقي للسلطة على مدار عمرها الطويل، لم يعد من الممكن عمليا الفصل بين النظام الحاكم، وبين أجهز الدولة ومفهومها. حالة التماهي بين النطاقين بالغة التعقيد في الحالة العربية عموما، وهو ما يمكنه تفسير استعداد الدولة العربية، (جمهورية وملكية – علمانية وإسلامية) لسحق أبنائها وقصفهم بالطائرات العسكرية وقتلهم وحرقهم في الميادين العامة. الثورات العربية، في الحقيقة، تهدد الدولة العربية؛ لأن خلع الأنظمة الحاكمة إذا تم بشكل كامل فإنه يقوض الدولة القائمة بصورة كاملة. لا يتعلق الأمر بمجموعة ضيقة من الأشخاص المتنفذين، أو شبكات العلاقات الخفية بين المؤسسات التي يحاول البعض التعبير عنها بالإشارة لما يسمى “الدولة العميقة”، في محاولة – غير ناجحة من وجهة نظري – لتبرير مقاومة الدولة العربية للتغيير وللدفاع عنها من خلال إضفاء طابع محايد عليها. تفترض هذه الرؤية أن “الدولة” محايدة ويمكن تغيير النظام السياسي بمعزل عنها، لكنّ المشكلة تكمن في أشخاص وعلاقات بين بعض الأجهزة ومراكز قوى تكونت داخل الدولة. الحقيقة أن تجربة الربيع العربي كاشفة تماما أن الأمر أكثر تعقيدا من مسألة الدولة العميقة التي تصلح فقط، من وجهة نظري، لتفسير تمتع بعض المؤسسات بنفوذ أوسع من دورها التقليدي داخل الدولة.
الحالة المصرية كانت كاشفة. من التضليل تصوير ما حدث في 3 يوليو/تموز باعتباره “انقلاب الجيش” على الحكم المدني. الحقيقة أن الجيش كان رأس حربة الدولة، والمُفَوض من قِبَلها باستعادة السلطة. لم يقف الجيش بمفرده، بل تمتع بدعم كافة مؤسسات الدولة المدنية: مؤسسات وهيئات الأمن، القضاء، البيروقراطية المدنية، وحتى المؤسسات الدينية الرسمية. وقد وصفه “عمرو عادلي” بـ “انتصار البيروقراطية”[38]. لذلك، وبعد نحو 7 سنوات، مازال ما يسميه البعض “جبهة الانقلاب” متماسكة وموحدة بصورة لافتة دون انشقاقات، باستثناء نخب سياسية هي في الحقيقة خارج الدولة وخارج النظام السياسي الحاكم. منذ الانقلاب وحتى الآن، كافة الصراعات الداخلية لم تكن أبدا حول منطق الحكم، أو حول ماهية علاقة الدولة بالمجتمع، أو كيفية التعامل مع مطالب التغيير وقبل ذلك تفسيرها وتقدير خطورتها؛ كان الخلاف دائما هامشيا وشخصيا وداخل حدود النظام نفسه، أي داخل الدولة. غياب الفصل بين الدولة والنظام السياسي، أو عدم إمكانية تحقيقه عمليا في الحالة المصرية والعربية عموما، يعني أن تكلفة التغيير باهظة، وأنه بدون مساومات ومفاوضات مع الدولة، وخاصة الجيش باعتباره رأس حربتها، سيظل دائما التغيير متعثرا، أو دمويا.
خاتمة
بقدر ما يتطلب الحديث عن المستقبل الكثير من الحذر والتواضع، أزعم أن فهم الواقع واستكشاف مسارات تطوره يتطلب، في المقابل، بعض المجازفة والجرأة. لذلك، تهدف هذه الورقة بشكل أساسي إلى طرح خلاصات حول الواقع، كي يتم توظيفها في رسم ملامح تطوره والمستقبل الذي من المرجح أن يفضي إليه. ومن ثم سيكون على صانع السياسة، والمعنيين بعملية التغيير بناء سياسات وتبني خيارات، للتأثير في مسار تطور الحاضر، سعيا إلى تحقيق مستقبل أفضل. لكنّ قبل هذا، وكضرورة لها، عليهم امتلاك القدرات والموارد اللازمة، وتنسيق جهودهم السياسية، والتي ستمكنهم من التعاطي بفاعلية مع التطورات، كما أنها ستكون ضرورية لإقناع أطراف من الدولة نفسها بأن ميزان القوى في طريقه لاستعادة بعض التوازن.
بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الأطراف المعارِضة لإعادة التموضع في خيال المجتمع كبديل سياسي. واحدة من محركات التغيير ليست فقط أن تفقد نخبة النظام الاستبدادي احترامها في وعي الناس كجهة حكم للبلاد؛ ولكن أيضا أن تكون هناك نخبة معارضة جديرة بأن يراهن البعض على جدارتها. المرحلة الانتقالية واضطرابها وصراعتها، ثم إخفاقها الكبير، نتج عنها أن تحولت رهانات الناس إلى الدولة، حتى لو من زاوية الأمن والقدرة على توفير الحماية. وبينما ينظر قطاع من الجماهير إلى سياسات النظام الحالي باعتبارها فاشلة أو جائرة أو جعلت حياتهم أسوأ[39]، فلا تكاد توجد جهة أو نخبة كي يراهن عليها الرأي العام كبديل، إلا – ربما – الدولة نفسها مجددا. لذا، من الضروري تراكم خطاب سياسي للمعارضة، يشمل توجهات محددة ورؤى جزئية واضحة يمكنها مع الوقت بناء وعي مشترك حول ما يجب أن تكون عليه البلاد، وهو ما يتحول عمليا إلى اطمئنان تلقائي بأن ثمة بديلا بات متوفرا.
إن عملية التحول من الحكم الاستبدادي لا يكفي فيها مراقبة فشل النخبة الحاكمة وانتظار انتفاضة الجماهير الغاضبة. فحتى في الحالات الكثيرة التي أشرنا إليها باعتبارها “ديمقراطية بالخطأ”، لم تعمل أخطاء المستبدين باعتبارها “سببا” للتغيير، ولكنها عملت كـ “محفز” لعوامل أخرى كانت موجودة بالفعل، واستفادت من ظروف قائمة لم تولد بالمصادفة بل نتيجة لجهود مقصودة قام بها فاعلون حقيقيون، قد يكونوا نخب المعارضة، أو حتى أطرافا خارجية. أي أن المستبدين خسروا الحكم بالخطأ، لكن هؤلاء الذين ورثوا الحكم لم تكن الديمقراطية نتيجة خطأ بالنسبة لهم، بل نتيجة ظروف شاركوا في إيجادها[40].
إن الواقع الذي يبدو ساحقا وسرمديا كما رآه “كابلان” في أنظمة أوروبا الشرقية، رأيناه هنا هشا وغير حتمي. مسيرته التي تبدو مظفرة خلال السنوات السبع الأخيرة استندت بصورة أساسية لممارسات العنف والقوة غير المقيدة، لكنها أيضا استفادت من أخطاء قوى المعارضة والراغبين في التغيير. غير أن الأسباب الكامنة للرفض والتمرد على الدولة العربية يتم تغذيتها، وتكثيفها، خاصة وأن أنظمة الثورة المضادة فشلت بصورة فادحة في إقناع الجماهير العربية بجدارتها السياسية والأخلاقية، وظهرت كنسخ مشوهة من الأنظمة التي أطيح بها. وإذا كنا نجزم بأن الربيع العربي ليس فورة عابرة، فمن المبكر تماما افتراض أن الواقع الحالي لا يمكن هزيمته. لكنّ احتكام الدولة العربية لمنطق العنف والتوحش وضع مسار التغيير أمام معادلة عالية التكلفة. لذلك، سيكون إعادة التوازن لهذه المعادلة ضرورة ملحة لإعادة وضع الربيع العربي على مسار أكثر قابلية للمضي قدما نحو غايته المرجوة. وهذه ليست مسؤولية الجماهير الغاضبة، ولكنها مسؤولية السياسة بشكل أساسي؛ التي يقع على عاتقها بناء جبهات قوية وتعزيز دفاعات المجتمع وإتاحة خيارات وبدائل أوسع أمام حركته التاريخية.
[1] باحث دكتوراه في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة إسطنبول أيدن. تتركز أبحاثه على سياسات الشرق الأوسط.
الإحالات:
[1] السيسي للمصريين: “لو تحركنا تزعلوا فتتحركوا فتلخبطوا وتهدوا البلد”. [فيديو]. https://www.youtube.com/watch?v=pHXXJevMA0M
[2] لمزيد من التفصيل حول توظيف الحاجة للأمن بهدف قمع رغبات التغيير، انظر: أحمد الغنيمي. (2020، 2 أكتوبر). فخاخ الاستقرار ونظام 3/7 في مصر. جدليّة. https://www.jadaliyya.com/Details/41795. وانظر أيضا حول مقايضة الديمقراطية بالأمن:
Shikaki, K. (2020, January). Stability vs. Democracy in the post Arab-Spring: What choice for the EU? EU-LISTCO, Policy Papers Series No: 4.
[3] بياتريس هيبو. (2017). التشريح السياسي للسيطرة (ترجمة غازي برو، ونبيل أبو صعب). الدار العربية للعلوم ناشرون. (ص. 89).
[4] بياتريس هيبو. سبق ذكره. (ص. 91).
[5] للاطلاع على نتائج مشروع “الباروميتر العربي”، أنظر: جمال عبد الجواد. (2013، مارس). استطلاع الرأي العام في مصر: الدورة الثالثة. الباروميتر العربي. https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%94%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A3.pdf. وانظر نتائج مصر الدورة الخامسة (2019) هنا: https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABV_Egypt_Report_Public-Opinion_Arab-Barometer_2019.pdf. وأنظر مقارنة لمؤشرات الأمن والاقتصاد والثقة في الحكومة والرئيس في: اسحاق ديوان، نديم حوري، ويزيد صايغ. (2020، 26 أغسطس) مصر بعد فيروس كورونا: العودة إلى المربع الأول. مبادرة الإصلاح العربي. .
ولنتائج استطلاع زوغبي، انظر:
Zogby Research Services. (2018), Middle East Public Opinion. https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2018/12/8a1be-2018SBYFINALWEB.pdf.
[6] وائل جمال. “العسكري: مشروعاتنا (عرق) وزارة الدفاع.. ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها”. جريدة الشروق، 27 مارس 2021. https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c-136a-4270-9a7c-79b576b91b51
[7] زعم المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، أنها بلغت 5 ملايين شخصا خلال الفترة بين 2014-2019. أنطر: الحكاية، (3/9/2019). “المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي ينفى لـ #الحكاية امتلاك الجيش صيدليات خاصة” [فيديو]. https://www.youtube.com/watch?v=DwumS4goKHg
[8] للاطلاع على التوسع الهائل في أنشطة الجيش خلال عهد “السيسي”، أنظر: يزيد صايغ. (2019، 14 ديسمبر). أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري. مؤسسة كارينغي للسلام الدولي. https://carnegie-mec.org/2019/12/14/ar-pub-80489. وأنظر أيضا: اسحاق ديوان، نديم حوري، ويزيد صايغ. (2020، 26 أغسطس) مصر بعد فيروس كورونا: العودة إلى المربع الأول. مبادرة الإصلاح العربي.
[9] Foucault, M. (2009). Security, territory, and population (G. Burchell, Trans.). Palgrave Macmillan. (p. 66).
[10] ندى الخولي، “الإسكان: الصرف الصحي يصل لـ 19% من قرى مصر.. و15% تبدأ الخدمة”. مصراوي، 20 أبريل 2017. https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2017/4/20/1064015/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%80-19-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8815-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9. وانظر أيضا: هبة حسام. “المركزي للإحصاء: 10.3 مليون أسرة تعيش بدون صرف صحي.. و700 ألف بدون مياه”. اليوم السابع، 20 أكتوبر 2017. https://www.youm7.com/story/2017/10/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-10-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D8%AD%D9%89/3449025
[11] اسحاق ديوان، نديم حوري، ويزيد صايغ. (2020، 26 أغسطس) مصر بعد فيروس كورونا: العودة إلى المربع الأول. مبادرة الإصلاح العربي. .
[12] Roux, M. (2021, February 1). A century of revolutionary centrality; Tahrir Square is Egypt’s heart. Le Monde Diplomatique.
[13] الجريدة الرسمية، العدد 32 مكرر (ج)، 14 أغسطس 2018. قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. https://manshurat.org/node/31487
وزارة الداخلية المصرية، تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة [فيديو]. https://www.youtube.com/watch?v=BdW23tg0qr4. ولمعرفة العقوبات التي ستطبق في حالة إزالة الملصق الالكتروني: انظر: عبد الرحمن السيد، “تعرف على عقوبة قانون المرور لإزالة الملصق الإلكترونى من السيارات”، اليوم السابع. https://www.youm7.com/story/2019/1/2/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4089253
[15] تمثل هذه واحدة من التعديلات التي أدخلت على قانون “مكافحة الإرهاب”! وهو أمر ينتج عن مخالفته عقوبة الحبس لمدة سنة. حيث نصت المادة (33 مكرر) على معاقبة كل من أجر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أنظر: https://www.youm7.com/story/2021/2/3/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/5188689
[16] تم تقنين مهنة “السايس” الذي ينظم عملية انتظار السيارات في الشوارع، واشتراط حصول من يقوم بها على ترخيص من السلطات المختصة، وفق القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والذي صدرت لائحته التنفيذية بقرار من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، يوم 18 يناير 2021. لمزيد من التفاصيل انظر:
وأنظر أيضا: https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18012021&id=ac46d20c-77ac-4e0c-9806-7d148e7d2692
[17] أحمد علي. “التفاصيل الكاملة لمشروع “البوابين”.. نقابة ومحل سكن ثابت وقاعدة بيانات”. مصراوي، 18 أبريل 2018. https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/4/18/1328089/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.
[18] United Nation. (2017). World Population Prospects (Data booklet). https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2017_world_population_prospects-2017_revision_databooklet.pdf
[19] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. “مصر في أرقام 2020”: تقدير عدد السكان وفقا لفئات السن والنوع 1/1/2020. (ص: 6). https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035
[20] The Economist Intelligence Unit. (2020, June). Egypt: Country forecast.
[21] IHs Markit. (2020, September 30). Country/Territory Report – Egypt: Economics and country risk.
[22] Fitch Solutions. (2020, May 1). Egypt: Country risk report, including 10-years forecasts to 2029. (pp. 25-26, 30).
[23] Fitch Solutions. (2020, September). Egypt: Crime and security risk report Q4. (p. 18).
[24] اسحاق ديوان، نديم حوري، ويزيد صايغ. سبق ذكره.
[25] Fitch Solutions. (2020, May 1). Ibd., p. 31.
[26] Fitch Solutions. (2020, September). Ibd. (pp. 8-9).
[27] أنظر التقرير السنوي الذي يعده “منتدى العاصمة” لرصد حالة الاحتجاج والاضطرابات الاجتماعية في مصر: منتدى العاصمة. (2021، 21 يناير) تقرير الحالة المجتمعية لعام 2020.
[28] Fitch Solutions. (2020, September). Ibd. (pp. 4ff.).
[29] يناقش “هيبو” هذه الفكرة من خلال استعراض تجارب سابقة في الكاميرون وتونس والمغرب. انظر: بياتريس هيبو. سبق ذكره. (ص: 38-39).
[30] بياتريس هيبو. سبق ذكره. (ص: 28-30).
[31] Zogby Research Services. (2018). Middle East Public Opinion. https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2018/12/8a1be-2018SBYFINALWEB.pdf.
[32] Kaplan, R. D. (2013). The revenge of geography: What the map tells us about coming conflicts and the battle against fate. Random House Trade Paperbacks. (p. xviii).
[33] Treisman, D. (2010). Democracy by mistake: how the errors of autocrats trigger transitions to freer government. American Political Science Review, 114(3), 792-810. https://doi.org/10.1017/S0003055420000180
[34] يخلص “عزمي بشارة” إلى أن وجود طموح سياسي للجيش، مع تماسك المؤسسة الأمنية واستعدادهم لاستخدم أقصى درجات القوة يُفشل أي عملية انتقال ديمقراطي. أنظر: عزمي بشارة. (2020). الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
[35] ثمة إجماع، بطرق مختلفة، على هذا الاتجاه العام للأمور في مصر، بين خبراء المؤسسات التي تعمل على تقدير حالة مصر خلال العقد القائم، مثل فيتش سوليوشنز، ووحدة الاستخبارات في الإيكونيميست، وآي إتش إس ماركيت. وعلى الرغم من بعض أوجه القصور التي تظهرها تفاصيل تقييمات هذه المؤسسات لواقع الحالة المصرية، إلا أن هذا التقدير بصورة عامة يستند لموقع الجيش الحاسم الذي من الصعب تخيل تحديه في المدى القريب، بالإضافة إلى ضعف المعارضة الواضح نتيجة قمع الدولة العنيف. أنظر الإحالات التي سبق ذكرها لتقارير هذه المؤسسات.
[36] عمرو عادلي. (2016، 21 يوليو). النظام المصري ومعضلات إعادة تأسيس السلطوية. مؤسسة كارنيغي. https://carnegie-mec.org/2016/07/21/ar-pub-64158. وانظر أيضا: عمرو عادلي. (2016. 23 أغسطس). لا تراهنوا على انفجار في مصر. مؤسسة كارنيغي الشرق الأوسط (ديوان). https://carnegie-mec.org/diwan/64453
[37] ثمة مفارقة هنا تستدعى التأمل، وتلخص بجلاء حقيقة ميزان القوى بين الدولة والمجتمع. حيث يشير “طارق البشري” إلى حقيقة أنه في تاريخ مصر الحديث لم تشهد البلاد تجربة نيابية ديمقراطية إلا في إجمالي نحو 9 سنوات فقط. منها حوالي ثمانية أعوام في الفترة من 1923-1952، أطولها بلغ عامين، أقصرها ثماني ساعات عام 1925. ثم برلمان 2011، الذي بلغ عمره 6 أشهر فقط. في المقابل، تملك الدولة جهازا إداريا بيروقراطيا حديثا تقريبا منذ 1820 وحتى الآن، يحكم بشكل متصل دون رقابة نيابية وبالتالي دون رقابة شعبية. بل إنه تقريبا يحكم في ظل حالة الطوارئ ثابته تقريبا خلال ثلاثة أرباع القرن الأخير. أي أن علاقته بالمجتمع تم صياغتها وتطورها في ظل غياب كامل للرقابة، وفي ظل صلاحيات الطوارئ التي تمنحه سلطات مطلقة. ومن ثم بات من الصعب فصل ثقافته عن حالة الاستبداد. ليس هذا فحسب، فالجهاز الإداري في مصر تاريخيا، حتى قبل عهد محمد علي، لم يكن فقط جهازا لإدارة شؤون السياسة، بل كان جهازا لإدارة كل شؤون المعيشة. ومن ثم أصبح هو الفاعل الاقتصادي الأول، والمسؤول الرئيسي عن التنمية، ما جعله شاملا، مستقلا عن أي تكوينات مجتمعية، منغلقا من الناحية التنظيمية. انظر: طارق البشري. (2015). جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة. دار نهضة مصر. (ص. 9-19).
[38] عمرو عادلي. (2015، 1 فبراير). انتصار البيروقراطية: عقد من إجهاض التغيير السياسي والاجتماعي في مصر. جدلية. https://www.jadaliyya.com/Details/31724. مع ملاحظة أنه ظل متحفظا، ولم يتحدث صراحة عن “الدولة” واكتفى بمصطلح “بيروقراطية الدولة” باعتبارها فاعل سياسي-اجتماعي مستقل.
[39] بحسب استطلاع مركز “زوغبي” عام 2018، اعتبر فقط 19٪ من المصريين أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. بينما اعتبر 64٪ من المصرين أن أحوالهم صارت أسوأ مما كانت عليه قبل 5 سنوات مضت. انظر:
Zogby Research Services. (2018), Middle East Public Opinion. https://foreignpolicy.com/wp-content/uploads/2018/12/8a1be-2018SBYFINALWEB.pdf.
[40] “Of course, not all incumbent errors lead to democratization. And those that do initially trigger only the authoritarian regime’s failure; democracy emerges if other conditions permit. Nor is democracy a mistake for those empowered by it.” (Treisman, 2020, p. 793). https://doi.org/10.1017/S0003055420000180