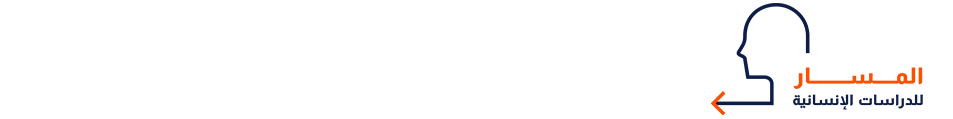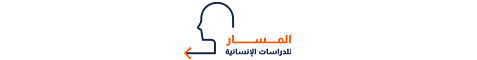المحتويات
- مقدمة المحرر
- عسكرة السياسة في مصر
- لماذا هذا الكم من التحشيد العسكري؟
- إحصائيات حول الإنفاق العسكري
- كيف يمول النظام صفقات السلاح؟
- مآلات سياسة التحشيد العسكري
مقدمة المحرر
تتعدد الأسباب والملفات التي قد تدفع مصر للتفكير في لعب دور عسكري خارج البلاد، خصوصًا في ظل حالة تكديس الأسلحة التي يتبناها السيسي، عبر شرائه السلاح من مختلف دول العالم، منذ استيلائه على السلطة في 2013.
فهناك ملف سد النهضة الذي يهدد مصر بالعطش وبوار الأرض الزراعية، وهناك الملف الليبي على الحدود الغربية لمصر وانحياز القاهرة لضابط الجيش المتقاعد، خليفة حفتر. ومؤخرًا أضيف لهذين الملفين الحرب في السودان بين القوات المسلحة النظامية وقوات الدعم السريع. كل تلك الملفات أثارت جدلًا حول احتمالية أن تلعب القاهرة دورًا عسكريًا خارج حدودها، وأن تستخدم تلك الأسلحة التي راكمتها في فرض رؤيتها في تلك الملفات.
وإزاء ذلك، آثرنا في “مركز المسار للدراسات الإنسانية” تقديم ترجمة لورقة بحثية نشرها “مركز ويلسون” الأمريكي بعنوان: “مصر وجاذبية القوة العسكرية”، للرئيسة السابقة لبرنامج الشرق الأوسط في “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”، مارينا أوتاوي.
حاولت الباحثة في ورقتها فهم نزعة قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، نحو صفقات السلاح، والأسباب التأسيسية والراهنة لانتهاج هذه السياسة. ولذا، استعرضت “أوتاوي” التهديدات التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا، وإذا ما كانت تلك التهديدات جديرة بشراء هذا الكم من الأسلحة أم لا.
وفي هذا السياق، اعتبرت الكاتبة أن أحد أهداف السيسي من تلك الصفقات هو شراء رضا القوات المسلحة، التي كانت سببًا في وصوله إلى السلطة، والتي تحافظ على وجوده فيها حتى الآن.
كما أنها عرجّت على ميزانية القوات المسلحة، والمصادر المالية التي تساعد النظام المصري في شراء السلاح، والنشاط الاقتصادي للجيش، وكيفية تصرفه في الأموال التي تعود عليه من هذا النشاط. وختمت الباحثة ورقتها باستعراض مآلات سياسة التحشيد العسكري على مصر في الداخل والخارج، وإذا ما كان تراكم السلاح سيغري مصر للتدخل عسكريًا في أزمات خارجية أم لا.
ونحن إذ نقدم ترجمة هذه الورقة، نأمل أن تساعد الباحثين والمهتمين على فهم أشمل لسياسات النظام المصري في الشأن العسكري.
عسكرة السياسة في مصر
منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، الذي أتى بعبد الفتاح السيسي إلى السلطة، عكفت القاهرة على تعزيز قوة جيشها، وتكديس الأسلحة لديه، وتنويع مصادره بمعدل متزايد.
هذه الفورة من الإنفاق تثير العديد من الأسئلة، خصوصًا وأنها تأتي في بلد يعاني من ركود اقتصادي، وليس لديه تهديدات أمنية خارجية كبيرة. ومن هذه الأسئلة التي تفرض نفسها: لماذا كل هذا الإنفاق؟ ومن هم الأعداء الذين تسعى مصر لحماية نفسها منهم؟ وكيف تدفع الدولة ثمن مشتريات الدفاع التي لا تظهر في الميزانية الرسمية للوزارة؟
جميع الإجابات تشير إلى أننا أمام دولة لديها شعور متضخم بعظمتها، وتقع تحت هيمنة متزايدة من الجيش، كما تبني ترسانة سلاح لا علاقة لها بالتحديات الأمنية الحقيقية التي تواجهها البلاد – وعلى رأسها التمرد في سيناء- في الوقت الذي لا تواجه فيه تهديدًا عسكريًا من أعداء أقوياء في الخارج.
أما السؤال الأخير المثير للقلق هو ما إذا كان هذا التحشيد العسكري – الذي يبدو غير مبرر في ظل التهديدات الحالية- سيدفع مصر إلى اتباع سياسات تزيد من خطر انخراطها في حروب مستقبلًا.
ونستطيع تفسير تعزيز الجيش المصري لقدراته باعتبارات سياسية براغماتية، بالإضافة إلى أسباب أيديولوجية.
فالمؤسسة العسكرية في قلب السياسة المصرية منذ عام 1952، بشكل علني في بعض الأحيان، وبصورة أكثر تحفظًا في أحيان أخرى. ومنذ سبعين عامًا، جاء جميع الرؤساء المصريين من مؤسسة الجيش، باستثناء الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذي انتُخب عام 2012 في الانتخابات التنافسية والنزيهة الوحيدة التي شهدتها مصر طوال تاريخها، لكن أطيح به في انقلاب عسكري بعد عام واحد من وجوده في الحكم.
وفي أواخر حكم حسني مبارك – الذي استمر ثلاثة عقود- انحسر الدور السياسي للجيش المصري، للدرجة التي تسببت في إثارة تكهنات حول ما إذا كان دور الجيش في السياسة سيتلاشى بشكل كلي.
لكن وضعت انتفاضة 2011 نهاية مفاجئة لمثل هذه التكهنات، بتدخل القوات المسلحة مباشرة في الصراع السياسي. وبعد أن أجبرت تلك الانتفاضة مبارك على التنحي، حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد لمدة عام، ثم تظاهر بالتنازل عن السلطة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، قبل أن يعود ليطيح به في يوليو/ تموز 2013.
واليوم، لا يوجد تحفظ في كل ما يتعلق بالطابع العسكري للنظام الحاكم في مصر، فالسيسي يدين للجيش بوجوده في منصبه.
أما جولتا الانتخابات غير التنافسية، اللتان عقدتا في 2014 و2018 لتثبيته في رئاسته، فلم تكونا سوى تمثيلية ديكورية. وفي حال انقلب موقف القوات المسلحة من السيسي، فإن هذه الانتخابات لن تحميه، ولذلك فهو في حاجة دائمة للحفاظ على رضا الجيش.
وهنا يأتي دور تحديث الترسانة العسكرية للقوات المسلحة المصرية، ولعب الجيش لدور محوري في اقتصاد البلاد، وتعيين الضباط المتقاعدين في مناصب إدارية بالدولة. إذ أن كل هذه الإجراءات هي جزء من آلية الدعم المتبادل بين الجيش والسيسي.
ويكاد يكون من المستحيل على أي شخص من خارج هذه المنظومة معرفة مجريات الأحداث داخلها على حقيقتها. فليس من المعروف ما إذا كان للسيسي منافسون أقوياء (داخل الجيش)، أو ما إذا كان الضباط الساخطون الذين يتطلعون إلى استبداله يتربصون به في مكان ما. لكن الواضح أن الرئيس الذي قدِم في الأساس من المؤسسة العسكرية، ثم هو يعتمد عليها في حكمه، يتوجب عليه الحفاظ على رضا تلك المؤسسة.
علاوة على ذلك، فإن هناك أسبابًا أيديولوجية لهذا التحشيد العسكري. ومن الأهمية بمكان هنا فهم الكيفية التي تحب بها مصر تصوير مكانتها بين دول العالم، وماهية تصور السيسي للدولة المصرية. في هذا الإطار، توفر لنا ديباجة الدستور المصري لعام 2014 نظرة ثاقبة حول كيفية رؤية حكام مصر لمكانة بلادهم على الصعيد العالمي.
ومن الطبيعي، ألا يبحث أحد عن الدقة التاريخية في الديباجات الدستورية – التي دائمًا ما تزخر بالصياغات الخطابية والمبالغات- لكن الوثيقة الدستورية المصرية متطرفة بكل المقاييس إذا ما قورنت بغيرها.
إذ تنص على أن “مصر هبة النيل”، وهي مقولة تقليدية، لكنها تزيد على ذلك أنها “هبة المصريين للإنسانية”. ودولة كهذه – بحكم تعريفها لنفسها- لابد لها وأن تكون قوية ونافذة.
وفي السياق نفسه، دأبت خطابات السيسي على تعزيز النظر إلى الدولة المصرية على أنها كيان شبه ميتافيزيقي، يتجاوز الخيارات المؤقتة التي قد يتخذها حكامها أو مواطنوها. من ذلك قوله: “لا يوجد شيء اسمه نظام، هناك ما يسمى بالدولة المصرية. الشعب المصري ينتخب رئيسًا قادرًا على تحقيق الاستقرار في البلاد، وليس نظامًا يتغير باستمرار. فهذا غير مقبول”. ويمكن الملاحظة هنا أن “الدولة” هي ما تنال اهتمام السيسي، وليس مواطنيها.
وفي خطاب ألقاه يوم 26 أبريل/ نيسان 2020 بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، صرح السيسي أن “الهدف الأسمى للدولة هو الحفاظ على بقائها، وأن تعظيم القدرات الشاملة للدولة هو أولوية لديها”. وبالتأكيد، فإن مثل هذه الأفكار تجعل تعزيز القدرات العسكرية للجيش المصري أمرًا لا مفر منه.
لماذا هذا الكم من التحشيد العسكري؟
تساعد السياسة والأيديولوجيا إلى حد كبير في تفسير سبب بدء السيسي والجيش في حشد هذا الكم الكبير من الأسلحة، حيث إن التهديدات الأمنية التي تواجهها مصر لا يمكنها تفسير هذه السياسة؛ بسبب أنها تهديدات داخلية، وليست خارجية.
لذلك، لا يبدو أن أنواع الأسلحة التي تحصل عليها الدولة المصرية مناسبة لمواجهة هذه التحديات الداخلية، التي قد تؤثر على استقرار النظام، لكنها لا تهدد بقاء الدولة ككل.
وبالنظر إلى الخارج، نجد أن مصر خاضت حربها الأخيرة مع إسرائيل عام 1973، ولا يهددها -في العموم- أي جار آخر. فالقوى الإقليمية الأخرى – كــتركيا وإيران والسعودية- لا تهدد الدولة المصرية، بل تنافسها على الهيمنة الإقليمية. كذلك، فإن الإمارات -باقتصادها الديناميكي وعلاقاتها المتنامية مع إسرائيل- قد تشكل تحديًا لشعور مصر بالتفوق على أقرانها في الإقليم، ولكنها ليست عدوًا. وعلاوة على ذلك، تنظر القاهرة لأديس أبابا على أنها مصدر تهديد لأمنها المائي بسبب “سد النهضة”، غير أن هذه المشكلة ليست عسكرية في المقام الأول.
لكن في المقابل، هناك نوعان من المشكلات الداخلية التي تهدد الاستقرار الداخلي في مصر. أولها هو وجود جماعات إسلامية متطرفة، لها ارتباط غامض بـ”تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) – ولاية سيناء”. وهذه مشكلة عسكرية، على الأقل جزئيًا. أما المشكلة الثانية، فهي إمكانية اندلاع انتفاضات جديدة، على غرار تلك التي هزت البلاد عام 2011، غير أن هذه مشكلة لا يمكن لوجود جيش قوي أن يعصم البلاد منها.
ومن المؤكد أن الجيش المصري جيش ضخم، لكنه – ككل الجيوش التقليدية- يواجه صعوبة في مواجهة التمرد، كالذي في سيناء. وهذا بالضبط ما تعلمته الولايات المتحدة من تجربتها القاسية في أفغانستان، وقبلها في فيتنام. فالتفوق العسكري وحده لا يكفي لمواجهة عدو عنيد ومراوغ.
أضف إلى ذلك أن مصر لا يبدو أن لديها استراتيجية لكسب قلوب وعقول سكان سيناء – تلك المنطقة النائية والمهملة. ومن المؤكد أن الطائرات المقاتلة وحاملات المروحيات التي تستوردها مصر لا تستطيع فعل الكثير ضد المجموعات الصغيرة من المسلحين، الذين يستمرون في تكبيدها خسائر، ثم يختفون.
وكما أسلفنا، فإن سيناء ليست المصدر الوحيد في عدم الاستقرار الداخلي الذي تعاني منه مصر، فلا تزال تلك الظروف، التي قادت البلاد إلى انتفاضة 2011 والإطاحة بمبارك والاضطرابات التي أعقبت ذلك، قائمة. ذلك أن معظم المشروعات الاقتصادية الضخمة التي يتفاخر بها السيسي – مثل توسيع قناة السويس، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة- لا تعالج المشكلات الأساسية المتمثلة في الفقر والبطالة وتردي قطاع الإسكان. وإزاء ذلك يبدو مستقبل الشباب قاتمًا.
ومن المرجح أن يزداد الفقر باضطراد؛ لأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تهدد إمدادات القمح في مصر بشكل مباشر، حيث تستورد الدولة أكثر من نصف استهلاكها من القمح، وحوالي 80 بالمئة من هذه الكمية تأتي من روسيا وأوكرانيا.
إحصائيات حول إنفاق السيسي العسكري
منذ استيلاء الجيش على السلطة في 2011، لم تتغير الميزانية الرسمية لوزارة الدفاع المصرية كثيرًا. إذ تُظهر دراسة موثّقة أجراها “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)”، عام 2020، أن ميزانية الجيش المصري لم تتغير كثيرًا، وإن كانت تغيرت بالزيادة أو النقصان ، فإن ذلك كان بنسب طفيفة. وما يعقّد من عملية الوصول لأرقام دقيقة في هذا السياق، هو انخفاض قيمة الجنيه المصري عام 2016 بنحو 48 بالمئة.
وإذا ما استخدمنا الدولار الأمريكي كأداة لقياس حجم الميزانية العسكرية الرسمية، سنجد أنها تقلصت بشكل طفيف من 3.7 مليار دولار في 2011-2012، قبل الانقلاب مباشرة، إلى 3.3 مليار دولار في 2019-2020. أما إذا ما استخدمنا الجنيه المصري، فسنجد أنها تقلصت بنسبة 18 بالمئة في تلك السنوات.
ووفقًا للأرقام الرسمية للميزانية، فإن مصر حلت في المرتبة الأخيرة بين 12 دولة في الشرق الأوسط في عام 2019، من حيث “العبء العسكري”، أي: إنفاقها على الجيش مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي. فبينما تخصص مصر 1.2 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لقواتها المسلحة، يبلغ متوسط إنفاق بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على القطاع العسكري 4.4 بالمئة.
أما في واقع الأمر، فقد زاد الإنفاق العسكري في مصر بشكل كبير بعد عام 2014، هذا مع وجود جزء كبير من هذا الإنفاق خارج الميزانية الرسمية للجيش من الأساس، مثل رواتب أفراد القوات المسلحة وشراء السلع والخدمات. ومن ذلك أيضًا الإنفاق على قوات الأمن المركزي التي ينخرط جزء منها في القتال في سيناء، حيث تندرج تلك النفقات في موازنة وزارة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فإن مشتريات الأسلحة لا تظهر في ميزانية وزارة الدفاع المصرية، رغم أن هذا هو البند الذي ينطوي على زيادة حادة في الإنفاق العسكري.
وبعد أن صعد السيسي للرئاسة، وبالتحديد في الفترة ما بين في 2014-2019، زادت مشتريات الأسلحة بوتيرة متسارعة وتنوعت مصادرها. والملاحظ أنه في الفترة ما بين 2000-2009، كان ما نسبته 75 بالمئة من الأسلحة المستوردة يأتي من الولايات المتحدة. لكن بين عامي 2010 و2019، هبطت هذه النسبة إلى 23 بالمئة فقط، مع صعود فرنسا وروسيا كأكبر موردي الأسلحة لمصر.
فعلى سبيل المثال، استوردت مصر طائرات مقاتلة من طراز “رافال”، وفرقاطة مسلحة بصواريخ مضادة للسفن، وحاملة مروحيات من فرنسا، وطائرات مقاتلة من طراز SU-35 بصواريخ جو – جو من روسيا.
وفي عامي 2019 و2020، قدمت مصر طلبات للحصول على أنظمة أسلحة متطورة إضافية بقيمة 15 مليار دولار من روسيا وألمانيا وإيطاليا، كما أنها تخطط للمزيد. وما بين عامي 2015 و2019، أصبحت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد السعودية.
كيف يمول نظام السيسي صفقات السلاح؟
المشتريات السابق ذكرها لا توضحها ميزانية الدفاع، كما أن تحديد مصدر تلك الأموال صعب للغاية. وفي محاولة لفهم تلك المصادر، أشار “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” إلى أن بعض تلك النفقات مدرج في موازنة وزارات أخرى. لكن هذا التفسير لا يُعطي الصورة الكاملة. كذلك، فإن الأموال التي يكسبها الجيش من خلال أنشطته الاقتصادية عامل محوري في تفسير مصدر مشتريات الدفاع، ولكنها أيضًا يصعب توثيقها.
وما يشار إليه عمومًا باسم “الاقتصاد العسكري” كان موضوعًا للكثير من التكهنات، لكن هناك بعض التحقيقات الجادة التي تساعد في توضيح المسألة قدر الإمكان، ذلك أن دراسة هذا الأمر ليست باليسيرة لمَن هو خارج المؤسسة العسكرية. وهنا سأعتمد إلى حد بعيد على دراسة أجراها الباحث في “مركز كارنيغي للشرق الأوسط” في بيروت، يزيد صايغ.
فقد أوضح أن بداية تطور الاقتصاد العسكري كان في عهد الرئيس المصري الأسبق، جمال عبد الناصر، عندما أرسى الجيش مشاريع إطعام وتجهيز لقواته الخاصة. ثم انتقل بعد ذلك للإنتاج للسوق المدنية. وعلى الرغم من الإصلاحات التي أُدخلت في أوقات مختلفة للحد من دور الجيش في الاقتصاد، استمر الاقتصاد العسكري في النمو والدخول إلى مساحات جديدة.
وعادة، يتكون أحد مكونات الاقتصاد العسكري من الشركات التي يمتلكها الجيش بالكامل. وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في عدد كبير من الأنشطة التي تبدو شبه عشوائية للمراقب، على الرغم من أن العامل الموحِّد – على الأرجح- هو أنها امتداد للأنشطة التي أسسها الجيش لصالحه.
فعلى سبيل المثال، ينخرط الجيش في إنتاج الأغذية وتوزيعها، إذ أنه ينتج الخبز والبيض ومنتجات الألبان، ويدير محلات الجزارة، والمحال التجارية. كما أن لديه محطات وقود، ومراكز صيانة، وينتج الغسالات، والمياه المعبأة، والمعكرونة.
وتلك هي الأنشطة التي عادة ما يذكرها المصريون عند سؤالهم عن الاقتصاد العسكري؛ وذلك بسبب أنها مرئية وتؤثر على المستهلكين بشكل مباشر. لكن هناك الكثير من الجدل حول حجم هذا الجزء من الاقتصاد العسكري. فبعض التقديرات تشير إلى ارتفاعها لنحو 50 بالمئة، وهي بالتأكيد مبالغة ظاهرة الشطط.
لكن هناك تقديرًا آخر أكد عليه السيسي مرارًا وتكرارًا، وهو أن نسبة هذه الأنشطة لا تتجاوز 2 بالمئة. لكن أيضًا هذه النسبة بالتأكيد أقل من القيمة الحقيقة. وأيًا كان الرقم الصحيح، فإن القوة الحقيقية للاقتصاد العسكري ليست في إنتاج مثل هذه السلع والخدمات.
وما يمثل الثروة المستقلة للجيش – في الحقيقة- نوعان آخران من الأنشطة. الأول هو السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي مُنحت للجيش لأسباب أمنية، حيث زادت القيمة المالية لهذه الأراضي – لا سيما تلك الواقعة بالقرب من المدن والطرق الرئيسية الجديدة- ثم بيعت أو أُجرّت للشركات.
وفي السياق نفسه، فإن الأميال من الجدران التي لا نهاية لها، وتلك الأسوار المحيطة بالمساحات الصحراوية الفارغة – التي تحير المسافرين في مصر- هي من مظاهر هذه السيطرة. كما أن الشركات الجديدة التي تظهر بين الفينة والأخرى، هي دليل على أن هذه المساحات الخالية يمكن أن تصبح قيّمة.
أما النشاط الثاني الذي يدر على الجيش إيرادات ضخمة – لا سيما منذ وصول السيسي للسلطة- هو العقود التي يتلقاها من الحكومة لإدارة المشاريع الكبرى. فالسيسي يثق بالجيش ويؤمن بكفاءته وخبرته، ولذلك كلفه بعدة مهمات، منها على سبيل المثال لا الحصر، توسيع قناة السويس وبناء العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مثل هذه المشاريع، يعمل الجيش كمقاول عام، حيث يتعاقد من الباطن مع شركات من القطاع الخاص المصري، لإنجاز بعض المهام. كما أنه يتعامل أحيانًا مع شركات أجنبية، عندما لا يكون قادرًا على إيجاد شركة محلية لديها من الخبرة والموارد ما يؤهلها لإنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة، وخلال الجدول الزمني الذي تضعه الحكومة.
أما كيفية التصرف في الأموال التي تعود على الجيش من مثل هذه الأنشطة فهو سؤال حاول العديد من المحللين إجابته، لكن أحدًا لم يتمكن من تقديم إجابة مُرضية له. غير أن المؤكد هو أن هذه الأموال توظف كآلية من آليات الحفاظ على رضا الجيش عن السيسي وتعزيز دعمه له، كما أنها ربما تدخل أيضًا في تمويل المشتريات العسكرية التي لا تدخل في الميزانية الرسمية.
مآلات سياسة التحشيد العسكري التي ينتهجها السيسي
شرعت مصر – تلك الدولة التي يهيمن عليها الجيش- في عملية تحديث وتدعيم عسكري تبدو مبالغًا فيها وفي غير محلها، إذا ما أخذنا في الاعتبار التهديدات الأمنية الداخلية التي غالبًا ما تواجهها البلاد. هذا التحشيد العسكري أصبح ممكنًا – في جزء منه- عبر النشاط الاقتصادي للجيش، وهو بدوره يزيد من قوة الجيش وسيطرته على البلاد.
وحيث إن نظام السيسي ينفذ مشاريع ضخمة أخرى، فإن واحدة من النتائج المحتملة – والتي بدأت بالفعل في الظهور- هي أن شراء أسلحة غير ضرورية يستنزف الأموال التي تحتاجها البلاد لتطوير اقتصادها المدني، وتحسين معيشة أهلها. فالإنفاق على واردات الأسلحة ليس مدًا يرفع كل السفن.
وبالإضافة إلى ضياع فرص اقتصادية على البلاد جراء تلك المشتريات العسكرية، هناك مشكلة أخرى قد تبزغ مستقبلًا، وهي أن ثقة الجيش في قوته، قد تدفع الدولة لاتباع سياسات تتطلب منها الانتشار في النزاعات الواقعة خارج حدود البلاد.
وحتى الآن، اقتصرت هذه التدخلات على الضربات الجوية، حيث قصف سلاح الجو المصري، منشآت لتنظيم داعش في ليبيا عدة مرات بين عامي 2015 و2018؛ انتقامًا لهجمات ضد الأقباط المصريين في صعيد مصر. وفي عام 2020، هددت مصر بإرسال قوات برية لدعم الجنرال خليفة حفتر، الذي كان منخرطًا في صراع مع حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا.
وعندما شن حفتر – المتمركز في شرق ليبيا بالقرب من الحدود المصرية- هجومًا آخر على الحكومة في طرابلس، على أمل الإطاحة بها، فشلت جهوده، لكنه تمكن من السيطرة على عدة مدن غربي البلاد. لكن من جانبها، طلبت الحكومة الليبية دعم تركيا، التي استجابت لها وساعدتها في استعادة السيطرة على بعض تلك المدن.
ثم طلب حفتر مساعدة مصر، لكن على الرغم من الرد الإيجابي من البرلمان المصري والسيسي نفسه، لم تُنشر أي قوات، واقتصر التدخل المصري في النهاية على ضربات جوية مثلما كان في الماضي.
وفي الشأن اليمني، أظهرت مصر نفس ضبط النفس. ففي عام 2015، وتحت ضغط من السعودية والإمارات لإرسال قوات مصرية، لمساعدة حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وافق السيسي من حيث المبدأ على المشاركة في هذه الجهود. لكن من الناحية العملية، رفَض إرسال قوات برية، ونفذ – بدلًا من ذلك- بضع عمليات قصف، بالإضافة إلى إرساله أربع سفن حربية لاستعراض القوة في مضيق باب المندب.
ولذا يمكن القول، إن طموح مصر في الظهور كقوة إقليمية لم يغلب – حتى الآن- على ترددها في الانخراط بعمق، في عمليات قد لا تنطوي على مصالح كبرى للبلاد. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال إغراء مصر بالتدخل عسكريًا خارج حدودها. فالصراع في ليبيا لم ينته بعد، على الرغم من الجهود الدولية المستمرة.
وفي الجنوب من مصر، هناك السودان، الذي تعتبره مصر جزءًا من مناطق نفوذها منذ الاتفاقية الأنجلو-مصرية (1899-1956). غير أن البلد الجار يعيش فترة من عدم الاستقرار؛ بسبب الصراعات بين التنظيمات المدنية والجيش، الذي تريد له القاهرة أن يستمر في حكم السودان.[1]
وبنفس القدر من الخطورة، وعلى الرغم من صعوبة تنفيذه، هناك العمل العسكري ضد أثيوبيا؛ بسبب سد النهضة الذي ينتهك حقوق مصر المائية، ويهدد أمنها القومي، وفق رواية القاهرة. لكن هذا العمل العسكري البعيد جغرافيًا عن الحدود المصرية سيكون صعبًا من الناحية اللوجستية. كما أن المياه المحجوزة خلف هذا السد – المملوء جزئيًا- ستهدد السودان إذا ما قُصف.
ومع ذلك، فإن مشتريات مصر الضخمة من الطائرات المقاتلة الفرنسية والروسية تعطي درجة من المصداقية لاحتمالية تكرار سيناريو استعراض القوة العسكرية.
وخلافًا لما حدث في عهد عبد الناصر، لم تنطلق مصر حتى الآن في مغامرات عسكرية. ومع ذلك، فليس هناك من شك في أن التحشيد العسكري الحالي قد يكون له عواقب سياسية، يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة غير مستقرة أصلًا.
[1] كُتبت هذه الورقة في يونيو/ حزيران 2022، أي أنها سبقت النزاع العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الذي اندلع في أبريل/ نيسان 2023. وهذا النزاع الأخير – والمستمر حاليًا- يعزز من حالة عدم الاستقرار التي تقصدها الورقة.