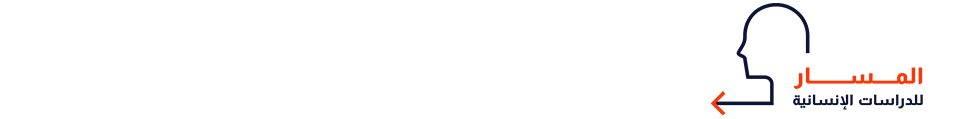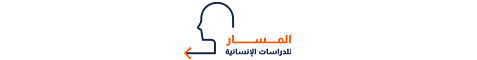المعارضة الثورية المصرية
ومستقبلها بعد 10 سنوات من ثورة يناير
قطب العربي (كاتب صحفي مصري، والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا)
يقصد بالمعارضة الثورية تلك التي تسعى إلى تغيير جذري سريع وشامل، سواء كانت تيارات أو تنظيمات، على خلاف المعارضة الإصلاحية التي تقبل الإصلاحات الجزئية المتدرجة، كما تقبل العمل وفق قوانين وهوامش النظام القائم، وتسعى لتوسيعها بمرونة وفق ما تسمح به التطورات، وعلى هذا الأساس، فقد شهدت مصر قديما وحديثا هذين النوعين من المعارضة، وإن اختلط استخدام القوة أحيانا مع المعارضة الثورية كما حدث في انقلاب 23 يوليو 1952 ، حيث كان تنظيم الضباط الأحرار تنظيما ثوريا مسلحا، كما تكرر الأمر مع جماعات إسلامية وناصرية ثورية (ظلت مجموعات محلية ذات أهداف قطرية وليس دولية، استخدمت السلاح في معارضتها أيضا، كما كان الحال مع تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية ( قبل مراجعاتها) وتنظيم ثورة مصر والتنظيم الناصري المسلح، وبعض التنظيمات الشيوعية، وكذا المجموعات الإسلامية الأخرى المحدودة، وحديثا يصدق وصف الحركات الثورية على ثلاث مجموعات هي: (الاشتراكيون الثوريون اليسارية) و(6 أبريل الليبرالية) و(حازمون الإسلامية)، أما باقي القوى والأحزاب المنتمية للثورة، فهي في أصلها أحزاب إصلاحية، ولكنها انحازت للثورة منذ إرهاصاتها الأولى وكانت ممهدة لها، وشاركت في كل فعالياتها لاحقا.
سنركز في دراستنا هذه على القوى الثورية التي ترفض العنف وتلتزم السلمية في حراكها، وهي القوى التي شاركت في تفجير ورعاية ثورة 25 يناير 2011، وسنتعرف من خلال هذه الورقة على طبيعة وخارطة هذه القوى الثورية التي مهدت لثورة يناير ثم قادتها ورعتها، حتى وقوع الانقلاب العسكري عليها في يوليو 2013، ثم موقف هذه القوى الثورية عقب الانقلاب، ومساعي التعاون والعمل المشترك بين هذه القوى، وأسباب تعثرها الدائم، ومستقبل هذه القوى والحراك الثوري عموما في ظل البيئة الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة.
المعارضة الثورية في عصر مبارك
مثلت الجماعة الإسلامية (قبل مراجعاتها)، وغيرها من جماعات العمل المسلح، سواء إسلامية أو ناصرية، الكتل الرئيسية للمعارضة الثورية في السنوات الأولى من حكم الرئيس مبارك، وقد توقف هذا النوع من المعارضة الثورية المسلحة (والتي تصنف رسميا بالإرهابية)، كما ظهرت الحركات الثورية السلمية في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، وهي التي مهدت لثورة يناير وقادت موجتها الأولى.
وبالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي مثلت دوما القوة الرئيسية المناقضة للنظام الحاكم منذ انقلاب يوليو 1952، والتي خاضت العديد من الصدامات معه، دفعت خلالها أثمانا كبيرة -كان هناك بعض الحركات والأحزاب السياسية التي لم تقبل بالسقف السياسي أو الهامش الديمقراطي الذي حدده النظام، ورفعت مطالب للتغيير أعلى مما كانت تطرحه أحزاب أخرى، ونذكر منها: حزب العمل بقيادة الراحلين إبراهيم شكري وعادل حسين والذي تم تجميده في مايو 2000، وحزب الغد في نسخته الأولى برئاسة ايمن نور (أكتوبر 2004) قبل ان يختطفه النظام بواسطة أحد رجاله (موسى مصطفى موسى الذي قبل أن يكون محللا للسيسي في انتخابات 2018)، وحزب الجبهة الوطنية (مايو 2007) برئاسة أسامة الغزالي حرب ( والذي كان قياديا في لجنة السياسات بالحزب الوطني قبل أن يترك الحزب)، وحركة “الاشتراكيون الثوريون”، وهي حركة ماركسية-تروتسكية بدأت في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، بين عددٍ صغير من الطلاب المتأثرين بالماركسية، وتم اعتماد الاسم الحالي بحلول أبريل من عام 1995، وزاد حضورها خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وحركة “شباب 6 أبريل” التي تأسست على خلفية إضراب عمال المحلة عام 2008، وغالبية أعضائها لا ينتمون لحزب سياسي معين، وإن غلب عليهم في شكلهم النهائي الطابع الليبرالي، وأخيرا حركة “شباب من أجل العدالة والحرية”، وهي مجموعة صغيرة من الناشطين، وقد عقدت الحركة مؤتمرها التأسيسي في يوليو 2010 بنقابة الصحفيين، وشارك أعضاؤها في ثورة 25 يناير، كما كان هناك حزبان ناشطان تحت التأسيس وهما: حزب الوسط وحزب الكرامة، اللذين حصلا على الترخيص الرسمي عقب ثورة يناير.
وقد انضوت غالبية هذه الأحزاب والحركات السياسية المطالبة بالتغيير تحت مظلة حركة كفاية، ثم الجمعية الوطنية للتغيير عند تأسيسهما، بالإضافة إلى ضم هذين الكيانين الجامعين للعديد من الشخصيات والرموز المستقلة أو التي تنتمي إلى تيارات سياسية وليس إلى تنظيمات.
مرحلة ثورة يناير
من الخطأ القول إن ترتيبات ثورة يناير تمت فقط عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما يروج البعض، ولكن جهود الحركات والقوى السياسية المطالبة بالتغيير خلال حكم الرئيس مبارك، والني نجحت في توحيد جهودها أخيرا تحت مظلتي “كفاية” “والجمعية الوطنية للتغيير” بقيادة محمد البرادعي كانت أسبق من دعوات الشباب للتظاهر، بل إنها بالإضافة إلى متغيرات محلية ودولية أخرى صنعت بيئة مواتية للحراك الشبابي لاحقا، كما أن هذه القوى -خصوصا جماعة الإخوان المسلمين – هي التي أعطت الثورة عمقها الشعبي الواسع في مظاهرات جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011، وهو ما مكن الثوار من الوصول إلى ميدان التحرير والاعتصام به حتى سقوط مبارك، وليس خافيا على أحد الدور الذي قامت به القوى السياسية في تنظيم الميدان والحفاظ على سخونته، وتوفير الاحتياجات اللوجستية اللازمة للاعتصام، وحماية الميدان من محاولات اقتحامه من قبل رجال نظام مبارك (معركة الجمل النموذج الأبرز وليست الوحيد).
لكن قوى ثورية جديدة ظهرت بقوة في ميدان التحرير وعقب خلع الرئيس السابق حسني مبارك، وكان أهمها: “ائتلاف شباب الثورة” الذي ضم ممثلين لعدة كتل شبابية من الإخوان المسلمين والليبراليين واليساريين والمستقلين، وهو الذي كان واجهة الحراك في ميدان التحرير، قبل أن يقرر حل نفسه يوم 7 يوليو 2012 “لإفساح الطريق أمام الأعضاء للمشاركة في كيانات تنظيمية أوسع لاستكمال أهداف الثورة، كما ظهر بقوة شباب “الأولتراس”، وكان لهم دور بارز في كل فعاليات الثورة، وأصبح لهؤلاء الشباب ثأر خاص مع العسكر بسبب مقتل زملائهم في بورسعيد (75 من أولتراس الأهلي) في عهد المجلس العسكري بعد الثورة، وفي نادي الدفاع (30 من أولتراس الزمالك- الوايت نايتس) في عهد الانقلاب.
ورغم ظهور عشرات بل مئات الحركات الشبابية بعد الثورة والتي غص بها نادي الجلاء التابع للقوات المسلحة، وغالبيتها كانت مصطنعة من قبل المجلس العسكري لإيجاد توازن مع حركات شبابية ثورية حقيقية، فإن الحركات التي ظلت صامدة كانت قليلة؛ مثل حركة “شباب 6 إبريل” التي انقسمت إلى فرعين (جبهة أحمد ماهر ) و(الجبهة الديمقراطية) كما ظهر لها فرع ثالث باسم -“أحرار 6 إبريل” لاحقا- وكذلك حركة الاشتراكيين الثوريين، في حين فشلت العديد من الحركات الشبابية الأخرى في تأسيس أحزاب أو كيانات قانونية منظمة لها رغم توافر أجواء الحرية بعد الثورة.
كما ظهر بعد الثورة عدة أحزاب جديدة تنتمي لمعسكر الثورة، ومنها حزب الوسط وحزب الكرامة وحزب غد الثورة، وحزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي، وحزب التحالف الشعبي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العدل، وحزب مصر القوية، وحزب البناء والتنمية، وعدة أحزاب سلفية أخرى، بالإضافة إلى حزب الحرية والعدالة، وإلى جانب هذه الحركات والأحزاب كان هناك تيار ثوري إسلامي واسع الانتشار يلتف حول الشيخ حازم أبو إسماعيل، وهو ما أطلق عليه تيار “حازمون”، كما كان هناك شباب الأولتراس الذين لعبوا دورا كبيرا في الثورة يوم 28 يناير، وفي المحطات التالية، وخاصة في أحداث محمد محمود، والعباسية .. إلخ.
تسببت حالة الاستقطاب السياسي التي بدأت مع التعديلات الدستورية في مارس 2011، ثم تكرست مع الانتخابات البرلمانية اللاحقة، وفي الاستفتاء على دستور 2012 – في شطر الأحزاب والحركات الثورية إلى قسمين، يؤيد قسم منها الرئيس المنتخب محمد مرسي، بينما يناصبه القسم الآخر العداء، وقد بادر القسم الأخير بتأسيس “جبهة الإنقاذ” التي تعاونت مع العسكر في الإطاحة بالرئيس المنتخب، عبر توفيرهم الغطاء الشعبي للانقلاب في 3 يوليو 2013.
الحالة الثورية بعد الانقلاب
وقع انقلاب الثالث من يوليو 2013 في وقت كان الانقسام قد مزق القوى الثورية، ودفع قسما منها لدعمه بينما بقى قسم آخر في مناهضته حتى الآن، وكان المؤيدون للانقلاب من تلك القوى يعتقدون أنه سيزيح الإخوان فقط ليخلي لهم الساحة، لكنهم أصبحوا لاحقا عرضه لقمعه بشكل متدرج بدءا من العام 2015 تقريبا؛ حيث تعرض بعض رموزها وشبابها للموت نتيجة القمع أو الإهمال الطبي داخل السجون أو خارجها مثل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ (حزب التحالف الشعبي)، أو الصحفية ميادة أشرف،(وكلتاهما في المظاهرات)، أو الكاتب اليساري المعروف محمد منير أو المخرج شادي حبش، أو الناشط بحركة 6 أبريل مصطفى جبريني (بعضهم مات في السجن وبعضهم بعد أن خرج مباشرة)، كما تم منع التظاهر وتم اعتقال عدد من أبرز الرموز السياسية مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمهندس يحيي حسين عبد الهادي المتحدث باسم الحركة المدنية، والسفير معصوم مرزوق، والدكتور حازم عبد العظيم المسئول السابق في حملة السيسي، والدكتور يحيي القزاز( تم الإفراج لاحقا عن معصوم وحازم والقزاز)، وخالد داوود رئيس حزب الدستور السابق، والدكتور حازم حسني، والمستشار هشام جنينة، ومحمد عادل، وشريف الروبي (6 إبريل بجناحيها)، وعدد من كوادر التيار الشعبي الذي انبثقت منه حركة تمرد، بخلاف الناشط علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء، والناشط أحمد دومة، والناشطة إسراء عبد الفتاح ، وعدد كبير من النشطاء، كما جرى التضييق على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ومُنعت المقالات المعارضة من النشر، ومُنعت الأحزاب والحركات من تنظيم اجتماعات بشكل طبيعي حتى داخل مقارها في الكثير من الأحيان.
ورغم هذا القمع الذي طال القوى الثورية الليبرالية واليسارية فإنها ظلت تتأرجح بين دعم النظام العسكري الحاكم، أو الصمت على جرائمه، خوفا من عودة الإخوان، أو التدرج في معارضته. واضطر بعض كوادرها للهجرة خارج البلاد ليلحقوا بنظرائهم الإسلاميين، وفي ظل هذه الأجواء سعت القوى والأحزاب المعارضة للنظام والتي تعرضت كوادرها للقمع لتشكيل تحالف معارض للنظام في أواخر العام 2017، وهو “الحركة المدنية”، التي ضمت عند تأسيسها 8 أحزاب هي (حزب العيش والحرية، وحزب الدستور، وحزب الكرامة، والديمقراطي الاجتماعي، وحزب مصر الحرية، وحزب العدل، حزب الإصلاح والتنمية مصرنا، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي) وعشرات الشخصيات المستقلة، وقد رفضت الحركة ضم الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية، أو القريبة من الإسلاميين مثل: مصر القوية وحزب الوسط، كما رفضت ضم حركة 6 إبريل، وحركة الإشتراكيين الثوريين، لأنها (الحركة المدنية) لم ترد الدخول في حالة معارضة جذرية للنظام، بل تريد فتح قنوات معه، ولكن النظام قابل هذا الموقف بالعسف؛ حيث جرى الاعتداء الأمني على نشطائها –لاحقا- خلال حفل إفطار رمضاني ، كما أعلنت بعض الأحزاب المشاركة انسحابها من الحركة على خلفية الموقف من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لتتحول الحركة إلى جثة هامدة في الوقت الحالي، خاصة بعد اعتقال متحدثها الأبرز المهندس يحيي حسين عبد الهادي.
وأما في جانب القوى الثورية الإسلامية، فقد استمرت في مناهضتها للنظام عبر الحراك الميداني والمظاهرات التي تواصلت حتى العام 2017 قبل أن تختفي نتيجة شدة القبضة الأمنية، وقتل منظمي تلك المظاهرات أو اعتقالهم، أو اضطرارهم للهجرة خارج مصر، وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب هو اللافتة التي تحركت تلك المظاهرات تحتها، وظل التحالف قائما يصدر البيانات ويحدد عناوين التحركات والمظاهرات كل أسبوع، ولكنه تعرض للتراجع بعد أن انسحبت بعض مكوناته مثل حزب الوسط وحزب الوطن وحزب الاستقلال والجبهة السلفية، وبعد أن انتقلت قيادته المتبقية للخارج، ولم يعد من التحالف الآن سوى شكل رمزي بسيط، وفي المقابل ظهر المجلس الثوري الذي تأسس في البداية كجناح خارجي للتحالف أو للحراك الميداني، ولكنه أيضا ظل مقتصرا على وجوه إسلامية او قريبة من الإسلاميين.
جهود الاصطفاف ومعوقاتها
في ظل حالة القمع الأمني الشديد التي مارسها النظام ضد جميع المنتمين لمعسكر ثورة يناير بمن في ذلك من قادوا مظاهرات 30 يونيو، ومن دعموا الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، تصاعدت دعوات الاصطفاف الثوري، والعمل المشترك، وتجاوز خلافات واستقطابات الماضي بهدف الخلاص من النظام العسكري الحاكم.
وبدأت تلك الجهود في بيانات للتحالف الوطني لدعم الشرعية قدم فيها خطابا تصالحيا تجاه قوى الثورة الأخرى، وتكرر المسعى في إعلان بروكسل وبيان القاهرة مايو 2014، ثم عند تأسيس المجلس الثوري أغسطس 2014، وما تلا ذلك من محاولات لصياغة وثائق مبادئ مشتركة، وصولا إلى دعوة تأسيس كيان جامع للقوى الوطنية المصرية، وكل تلك المحاولات تحطمت على صخرة رفض غالبية القوى والرموز الليبرالية واليسارية المشاركة في أي عمل مع القوى الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان، وفي المقابل حاولت تلك القوى تأسيس مظلات خاصة بها بعيدا عن التيار الإسلامي، لكنها لم تصمد كثيرا ، مثل: حركة ثوار وصمود وحتى الحركة المدنية الديمقراطية.
كانت قضية الدفاع عن شرعية الرئيس مرسي نقطة خلاف مفصلية بين الطرفين، حيث تمسك بذلك الإخوان وحلفاؤهم، فيما رفضتها القوى الثورية الأخرى، ورغم وفاة الرئيس مرسي، وهو ما يعني عمليا انتهاء هذه الأزمة فإن رفض التعاون ظل قائما بين الطرفين، وهنا يمكننا الإشارة إلى بعض الأسباب، منها:
- السبب النفسي، وغياب الثقة الناتجان عن حالة الاستقطاب الواسع الذي بدأ منذ استفتاء 19 مارس 2011 ، وظل يكبر مع الوقت، مرورا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، وصولا إلى الدعوة لمظاهرات 30 يونيو، ودعوة الجيش من قبل بعض القوى المدنية، للتدخل والإطاحة بالرئيس(المنتخب) بعد عجزهم عن فعل ذلك بالتظاهر.
- العامل الأمني حيث يتسبب القمع الأمني الشديد في نشر حالة من الخوف والهلع لدى المعارضين المقيمين داخل مصر على مصائرهم بعد أن شهدوا بأعينهم قتل بعض نشطائهم، أو اعتقال رؤوس كبيرة، مثل: سامي عنان ود. عبد المنعم أبو الفتوح، والفريق أحمد شفيق، ود. يحيي القزاز، ومعصوم مرزوق، ويحيي حسين.. إلخ، ولذلك فضلت القوى والرموز السياسية المعارضة في الداخل إيثار السلامة، وممارسة المعارضة في حدود الهامش الذي يسمح به النظام، وفي إطار هذا الهامش حرصت القوى الليبرالية واليسارية في الداخل على عدم الاقتراب من الإخوان، بل استمرت في كيل الاتهامات والتحريض ضدهم، وتكرر الأمر مع الرموز الليبرالية واليسارية التي هاجرت خارج مصر ( مع استثناءات قليلة) وهؤلاء المعارضون في الخارج يخشون من القمع الأمني لأسرهم في الداخل، والذي أصبح سياسة معتمدة للنظام طالت -فعلا- أسر العديدين .
- العامل الأيديولوجي، حيث لا تزال غالبية القوى الليبرالية واليسارية رافضة أيديولوجيا التيار الإسلامي، وتعتقد أن اقترابها منه والتعاون معه سيقويه على حسابها، وأن هذا التيار سيجني الثمار نتيجة أي تغيير مقبل بسبب قوته الشعبية والتنظيمية، بينما ستخرج هي خالية الوفاض.
- الخوف من فقد الأنصار، فكل طرف يخشى فقدان جزء (كبيرا كان أو صغيرا) من جمهوره وأنصاره في حال تحالفه مع الطرف الآخر من القوى الثورية، بعد حملات الشيطنة المتبادلة للفريقين، والتي أصبح معها إقناع جمهور كل طرف بالتعاون مع الطرف الآخر أمرا صعبا.
- غياب أو تغييب القيادات التوافقية، حيث ساهمت أجواء الاستقطاب وغياب الثقة- في تصدر القيادات المتشددة في كلا المعسكرين المنتميين لثورة يناير (المعسكر الإسلامي والمعسكر الليبرالي اليساري) وفي ظل هذا المناخ غابت أو غيبت القيادات والأصوات التوافقية في كلا الطرفين، بل تعرضت للنقد الشديد من داخل المعسكر الذي تنتمي إليه.
- وأخيرا، الاختلاف على طبيعة المقاومة أو المعارضة للنظام القائم، حيث ترى القوى الإسلامية وحلفاؤها ضرورة الخلاص التام من نظام السيسي، في حين ترى قوى أخرى استثمار المساحات المتاحة من داخل النظام مثل الانتخابات البرلمانية، أو التصويت برفض التعديلات الدستورية قبل ذلك.
التيار الثوري غير المنظم حركيا
إزاء استمرار حالة القطيعة بين التيارات الثورية بفصائلها الإسلامية والليبرالية واليسارية، وإزاء تصاعد الغضب الشعبي ضد النظام بسبب سياساته الاقتصادية والأمنية الحمقاء التي تضرر منها الكثيرون، أصبح الشارع مستعدا للتفاعل مع أي دعوة جادة لحراك شعبي، وقد توفر ذلك لدعوة الفنان والمقاول محمد علي، الخارج من حضن النظام في 20 سبتمبر 2019، ثم في موجتين تاليتين، حيث سادت قناعة لدى الكثير من القطاعات الشعبية والشبابية أن ثمة صراعات داخل أجنحة السلطة، وأن هذا الفنان يعبر عن أحدها بما يعني أنه يلقى دعما من ذاك الجناح، وهو ما يوفر لدعوته فرصة للنجاح ( في نظر من اعتقدوا ذلك)، ولذلك كانت الاستجابة معقولة نسبيا في المرة الأولى، ولكنها تراجعت في المرتين التاليتين مع تبدد هذه القناعة لدى الكثيرين، لكن خروج جيل جديد من الشباب لم يشارك أغلبه في ثورة يناير- حيث كان صغير السن عند قيامها- ومشاركة محافظات لم تشارك في ثورة يناير من قبل بقدر واسع فيما عرف بمظاهرات أصحاب الجلابيب أو ثورة الريف المصري.
ورغم تراجع زخم الدعوات التي أطلقها الفنان محمد علي فإن ذلك لا يعني اختفاء روح الغضب لدى الشعب المصري، بل الصحيح أن تلك الموجة كسرت حاجز الخوف لدى الكثيرين بعد أن ظن النظام وحتى المعارضة التقليدية أن القمع الأمني الشديد رسخ عقدة الخوف لدى المصريين، وبالتالي سقطت حجة أن الشعب غير جاهز لأي تحرك بسبب العقدة الأمنية.
شروط نجاح أي تحرك ثوري
وفقا لموجات تظاهر شهدتها مصر في ظل القبضة الأمنية الشديدة، -ونشير هنا إلى مظاهرات يوم الأرض (15 و25 أبريل 2016، ومظاهرات 20 سبتمبر 2019، وكذا موجة سبتمبر 2021 (20-27 سبتمبر أو ما وصف بثورة الريف المصري) – فإنه من الممكن تكرار بل تصاعد هذه الموجات، لكن ذلك يلزمه توفر بعض الشروط وفقا للحسابات السياسية التقليدية، وقد يحدث بلا مقدمات أحيانا، أو وفقا لأسباب ربما لا ندركها في حينها، لكن التحليل العلمي يقتضي أن نركز على الشروط الموضوعية اللازمة لاندلاع موجات ثورية جديدة وتحقيقها لأهدافها:
- وجود غضب شعبي عام يوفر حاضنة شعبية لأي حراك، إذ ثبت من خبرة السنوات الماضية أن غياب الحاضنة الشعبية في بعض الأحيان عرض الكثير من المظاهرات للخطر، وعرضها لصدامات مع مواطنين آخرين إما أنهم كانوا يدافعون عن مصالحهم، أو أنهم كانوا ضحايا عمليات التضليل الإعلامي وغسل الأدمغة، أو أنهم متعاطفون مع النظام قبل أن يكتووا بناره، كما أثبتت خبرة ثورة يناير ذاتها أن الظهير الشعبي كان مهما جدا لنجاح المظاهرات والاعتصامات، ونتذكر هنا أن المظاهرات التجريبية التي تمت يومي 26 و27 يناير قبيل جمعة الغضب كانت مؤشرا للقبول الشعبي المسبق بمظاهرات جمعة الغضب وشجعت الكثيرين على المشاركة فيها، كما أن موجة ما وصف بثورة الريف المصري (20-29 سبتمبر 2020) تمت في ظل حاضنة شعبية أيضا، ويمكن القول إن هذا الشرط أصبح بشكل عام متوافرا حاليا لأي حراك .
- وجود طليعة أو قيادة ثورية مخلصة ومقنعة ومقبولة شعبيا، وقادرة على التعبيرعن طموحات الشعب وآلامه، ومستعدة للتضحية، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، فالقوى والرموز الثورية الحالية قد أنهكت، من ناحية، كما أنها لا تزال تعيش في أجواء الاستقطاب السياسي، والتعصب الأيديولوجي، ولذلك لم تستطع التجمع في كيان واحد حتى اللحظة، وهذا لا يجعلها مؤهلة لقيادة أي حراك شعبي، حيث ينظر إليها من قطاعات شعبية واسعة أنها تعلي مصالحها الشخصية والحزبية على مصالح الوطن والشعب، ولعل تجربة الفنان والمقاول محمد علي؛ خاصة ظهوره الأول كانت مؤشرا على قبول الشعب لأي أصوات جديدة، غير محملة بمشاكل الاستقطاب السياسي (بالرغم من أن التجربة كان لها خلفيات أخرى كما ذكرنا سلفا).
ما سبق يؤكد أن الشعب المصري بحاجة لقيادة جديدة غير محملة بأعباء الماضي تقود نضاله وتوجه غضبه في الطريق الصحيح، وهذا يستلزم تحركا من العناصر الوطنية الراغبة في التغيير ذات الصفحات البيضاء، سواء أكانوا خبراء أكاديميين أو شبابا وطنيين، وإسلاميين، وستكون نقطة البداية لهم هي صياغة برنامج إنقاذ سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني شامل، وصياغة شكل تنظيمي لتنفيذ هذا البرنامج وعرضه على الجميع، وينضم له كل من اقتنع به، ورغب العمل من خلاله، وهذا لا يلغي ولو مؤقتا كل الجهود القائمة حاليا سواء في المجال الإعلامي أو الحقوقي أو الاتصالات مع المؤسسات الدولية لتعريفها بالأوضاع في مصر.
- حدوث تصدع في جبهة النظام وداعميه، وهذه الجبهة تقوم على عناصر صلبة حتى الآن تتمثل في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة وأدوات الدولة العميقة، وعلى دعم الكتلة المسيحية في معظمها، وكذا بعض الفئات الحريصة على الاستقرار والخائفة من أي فوضى، وحتى الآن فإن هذه الجبهة تبدو متماسكة، وصاحبة مصلحة حقيقية في بقاء السيسي، وفي اللحظة التي تتضرر مصالح بعضها، أو تشعر بخطر عام أكبر فإنها يمكن أن تعدل موقفها.
- توفر بيئة إقليمية ودولية داعمة للتغيير، ولعل تجربة يناير وغيرها من ثورات الربيع العربي كانت نموذجا لوجود تلك البيئة الدولية تحديدا الداعمة للتغيير، حيث وجدت ثورة يناير دعما أمريكيا وأوربيا بعد صمود المعتصمين في ميدان التحرير، والجدير بالذكر أن البيئة الإقليمية كانت ضد ثورات الربيع العربي على خلاف البيئة الدولية! ولذلك فقد امتصت هذه البيئة الإقليمية الصدمة الأولى ثم انقضت بثورتها المضادة على الربيع العربي لاحقا وحتى الآن.
البيئة الدولية الداعمة للتغيير هي التي ساندت التحول الديمقراطي في أوربا الشرقية أواخر الثمانينات، وهي التي ساعدت على تقويض حكم العسكر في تشيلي والأرجنتين، وعلى إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، صحيح أن هذه البيئة ليست عادلة بشكل مطلق في تعاملها مع تحركات الشعوب، إذ الثابت أنها في أحيان كثيرة تكيل بمكيالين أو أكثر، إلا أن توفرها لصالح حركة تغيير في مكان ما يساعد على نجاحها ولو في موجته الأولى، وقد كان أحدث النماذج لذلك ما حدث في السودان مؤخرا.
البيئة الإقليمية والدولية في الوضع الراهن تشهد تغيرات مهمة سواء على صعيد المصالحة الخليجية مع قطر والتي كانت مصر جزءا منها، والتي يتوقع أن تلقي بظلالها على المشهد المصري بدرجة أو أخرى، خاصة إذا وصل قطارها إلى مصالحة مع تركيا تشمل السعودية والإمارات ومصر أيضا، وعلى المستوى الدولي فقد كان أهم التغيرات فوز الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة والنيابية الأمريكية، وبذلك يكون نظام السيسي قد خسر حليفا قويا وهو ترامب، وإداراته، وفي حال نفذ الرئيس الجديد جو بايدن وعوده الانتخابية، فإن من المتوقع تحريك الملف الحقوقي المصري ولو بنسبة قليلة، وهو ما يتيح فرصة للقوى المعارضة الليبرالية على الأقل لرفع صوتها، ولو لتحسين نسبي في أوضاع السجناء، وتخفيف القيود عن وسائل الإعلام، كما أن الموقف الأوربي يشهد بعض التغييرات وإن كانت قليلة، مثل التطورات في ملف الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقرار البرلمان الأوربي الأخير حول وضع الحريات في مصر والذي دعا النظام للإفراج عن قائمة محدودة من المعتقلين، ودعا لتشكيل آلية أممية لمتابعة الوضع الحقوقي ومساءلة المسئولين المصريين المتهمين بانتهاك حقوق الانسان.
مستقبل التيار الثوري
في ضوء المعطيات السابقة يمكن القول أن الحالة الثورية في مصر لم تمت، لكنها تحت ضغط شديد، وقمع أمني واسع النطاق، وقد شهدنا ظهورا لها في العامين الماضيين في موجتي سبتمبر 2019 و2020، وإن بشكل محدود، أما الحديث عن موجة عارمة فهذا أمر لم تتوفر له البيئة المناسبة بشكل تام حتى الآن، وهو ينتظر قيادة ثورية ممثلة لكل الطيف الوطني، لا تستثني أحدا، كما ينتظر تغيرا مساعدا في البيئة الإقليمية والدولية المحيطة.
تحتاج القوى الثورية على اختلاف تصنيفاتها لمراجعة أدائها خلال الفترة الماضية، والبحث عن أدوات ومسارات جديدة لتحسين هذا الأداء، حتى تستطيع تحريك الشعب، وكسب الرأي العام العالمي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.
كما تحتاج هذه القوى لتجاوز خلافات واستقطابات الماضي، والنظر للمستقبل، كما تحتاج لتنظيم صفوفها، وإذا كان من الصعب حتى الآن توحدها في كيان جامع، فلا أقل أن تجتمع القوى المتناظرة في كيانات ( كيان يجمع القوى الليبرالية وآخر يجمع القوى اليسارية وثالث يجمع القوى الإسلامية) على أن يتم التنسيق بين هذه الكيانات والتشارك في مشروع وطني جامع يقدم أملا حقيقيا للمصريين، ويسهم في نقلهم من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي يعيشونها في ظل الحكم العسكري الراهن.
وفي النهاية ينبغي التوضيح أن القوى الثورية المنظمة بكل أطيافها وإن كانت هي الرافعة الرئيسية لأي حرك، فإن هذا لا يعني أنها وحدها تحتكر أي حراك، بل أثبتت التجربة القريبة أن الحراك تم من خارجها، وقد يتجدد ويتطور في المستقبل بعيدا عنها، إذا استمرت على وضعها الحالي.